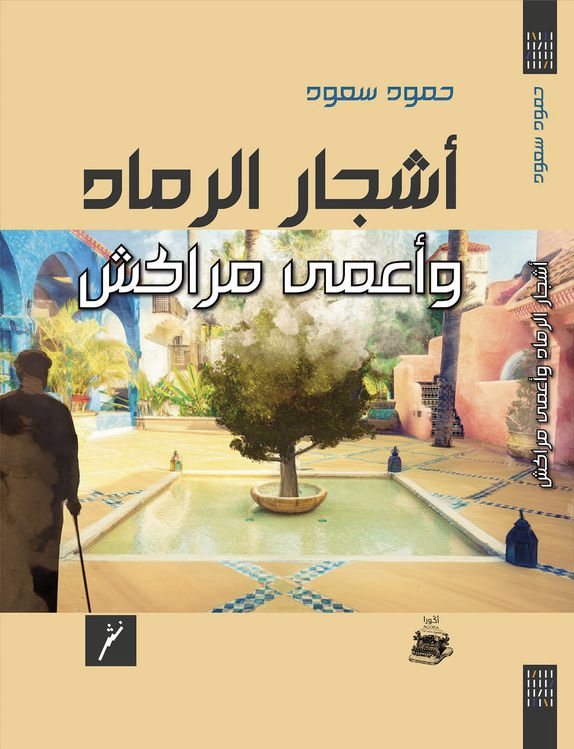لم أكن أتجاوز مشاركة حمود ظلاله بين زمن الصبا والحاضر حين أنقل له سلام (شجرة السُّمْر) في (وادي مليل) المحاذي لقريتي بجفافه اللاذع في الصيف، وفي كلّ مرة يهديني شجرة بريّة أستحضر هذه الظلال نحتا في الذاكرة بين المدينة والقرية؛ فلأشجار حمود سعود معاني تتفرّع بتفرّع الذوات التي تغرسها أو تتعاطف معها أو تقطف ثمارها أو تتفيء ظلالها أو تمرّ عليها أو تتجاهلها، معاني ليست تلك التي تستنزف حركة التشكيل المدفوعة بالهروب من ضجر رسم الظل المعتاد أو بناء علاقة مع طبيعة الاخضرار في الأشجار؛ لأنها ذات ألوان ذوات ومؤشرات تبدأ من منطلق “في كل شجرة هناك حكمة تركها طائر، وهناك ذكرى عابر، أو جرح تركته الريح “. فالكائنات في علاقتها بالأشجار مرتبطة بموقف وجودي أو غريزة بنائيّة لا تنتهي بتجاوز ظل ينكمش ثم يختفي بالغروب، أو يعود في ضوء القمر متلاشيا، إنها مدى آخر بلغة حمود سعود، تلك الفاعلة التي يختفي خلفها -كما قلت سابقا- ليعود بدالٍّ يرمي إلى مدلول متفرّع في أكثره ممّا لا يريدنا أنْ ننشغل به عنه، أو بمعنى آخر المعنى الذي يولد بكثير من المحمولات الإنسانيّة والتاريخيّة في “هسهسة لغة بارت “. لهذا يقترب الكاتب هذه المرة من نصّه أكثر كون الكتابة ذاتها الفاعلة في إقلاق المتلقي، (الخوف ذات ساردة) منطلق آخر للكتابة لا يتّفق معه الكثيرون في تعيين حدود الكتابة “فلا يمكن للنص أنْ ينغلق على الأمكنة الملوّثة بالواقعيّة، وسياج اللغة وأنيابها وتكلّساتها، ولا أنْ يطفو في توهّمات الخيال كجثّة على سطح بحيرة “. إنه الذات بكل ما يجعلها متجاوزة نافرة من الانغلاق وفي خيالها لا تترهّل لتكون نسيا أو متجاهلا أمام ذاتها الداخليّة، النص إضافة كما عند دريدا لكنّه حفْر وهوّة في صورة جسر إلى التحقّق، ملامسته تحفر جرفا في حقيقة بارت بين القراءة والنقد، كل ذلك الخطر المحدق بمغامرة الكتابة لكنّ على اللغة ــ كما يرسم لها الكاتب في تجربته ــ ” أنْ تنزل من كتب القواعد؛ لتجلس قليلا في الشارع … لتحتوي النصّ وتغسله من قلق كاتبه “. فاعليّة الكتابة بتشكيلات اللغة هي تحرر النص الذي يمكّن الكاتب من اختراع أوجه فنيّة متنوّعة للسرد بنصّ منفتح على المعنى بشكل ودلالات متجددة.
تعددت منطلقات تأسيس النص المختلف في التجربة ليبني المعنى على مجموعة من الثيمات المتفرّعة من فاعليّة الكتابة ذاتها. نجد (الصراع بين الواقع والذاكرة)؛ ” وأقول للرجل في القبر، إن البلاد ما تزال تتذكر شخصيّات رواياتك ….”، ففاعلية النص مجموعة من الملموس القلق في تصوير مختزل للذاكرة المنسية، النتيجة تكرار للنسيان كلما مسّ الذات عجز الذاكرة. كما نجد (الخطاب والفراغ )؛ ” لكنّ كلام المعلمين …”؛ وهو المحور المرجوّ لبناء وعي التلقي والتّوجس في منظومة مكررة في أبجديات الملموس العالمي، الشكل متعدد الرؤى بأدوات مستهلكة. ونجد (الحضور ليس ضد الغياب)؛ فهي حاضرة وغائبة في الوقت عينه؛ لكنه بمستوى آخر للوجع، موقف ملامسة موضوعات المشاهد “كلّ هذا البحر ولا سمكة واحدة تفسد زرقته”. هي حاجة البشريّ إلى الافتعال المتعلّق بالاغتراب؛ فحضور الأشياء ليس الاكتمال في لحظة قدرتها على جرح الذوات بفاعليّة القصدية التي يتبنّاها الكاتب في تشكيل خطاب بريء من وهم المتلقي، يكفي أن يطرح التلقي أدوات ذات علاقة بالمتخيّل ليتحقق فن اللغة كما يراه جرار جنيت، وبعدها تنفتح الآفاق ليكون الخطاب ذا فاعليّة إنتاجية. كذلك نجد أن (الذكرى لا تعيد الماضي) من خلال سيرورة الوقت التي لا تتوقّف لمشاركة اختزالات الذات ومحاولاتها في الإبقاء على اليسير من الاستعادات، ثم الوصول إلى المحسوس والمشاهد. “خيط السّرد قد قطعته المرأة الجالسة في قطار الكلام.. “؛ تداخل العوالم التي تقع في هذه الاستعادات المتكررة؛ فاعليّة الكتابة، وتشكيلات النص الفنّي / الكاتب، تبدأ هذه الفاعليّة من الوفاء للوجع الذي هو مقوّم الفنّ، وهو في الجانب الآخر ـ من خلال دراسات عزّ الدين إسماعيل- قوّة الفنان المبدعة التي تجعله مميّزا عن غيره. كل هذه المنطلقات تشكّل فعل الكتابة في مواجهة الكاتب لها باعتبارها النّص بثنائيّة ( أنا / هو )؛ لكنها بشكل آخر يطرحها حمود سعود في مواجهة نصّه أو الأخذ بيده داخل الثنائيّة.
ومن خلال ثنائيّة ( أنا / هو ) يتتبّع حمود سعود طريق عمر الثلاثين بصفته تشكيلا استثنائيّا بين مرحلة الكاتب السابقة وقادم الأيام من خلال استقراء المتغيّرات التي تضيف إلى ذات الفنّان كثيرا من المواقف النفسيّة وردّات فعلها المتغيّرة؛ على الرغم من أنك ” لا تعلم أنت كم طول الطريق حتّى تدّعي بأنّك في منتصفه “، فتبرز من هنا تحوّلات الزمن الذاتيّة من خلال مجموعة من التّأملات التي أقام عليها الكاتب رؤيته إلى العمر بصفته زمنا حادّا ووصولا إلى مرحلة وعي مؤثّرة؛ (ما بين الطفولة والشيخوخة)، ولنا أنْ ندرك العوالم المتقاربة في فهم المحيط ببساطة والقناعة بأدوات تحقّق الحياة، و(الوفاء للطفولة)؛ شكل الشجرة في الذات بكل تفاصيلها وخذلان الحلم على كثير من النوافذ. (أنت ما تريد)؛ ما يؤكد الصراع من أجل اللحظات التي لا تعود، وعلى الرغم من الألم الذي يسببه جرح الذات لكنه المنفذ إلى الحصول على عصارة اليقين. “ستجد في أحد الثقوب دمعة طفل… سترى في ثقب آخر امرأة … في ثقب جانبيّ من القلب سترى دفترا … “؛ بعمر الثلاثين تحقق باعترافك نصّك الفني / ذاتك الغائبة الحاضرة، وفي حضور قلق الضرورة هذا ومنه تولد الكتابة / اعترافك وصمتك، ما تريده وما لا تريده، الأهم من كل هذا أنْ تكون أنت / الكتابة. التجارب والحكايات هي فاعل الموقف من الكتابة. يؤسس حمود سعود بمقربة من موقدها رؤاها حول فعلها الفنّي والمتّهم الأول في القلق؛ السفر بالتجارب والخلاصات والمواقف إلى داخل الذات وخارجها دون المساس بتكوينها أو تعريضها للاسفاف، ” لا يفتحها أمام الغرباء ولا المتطفّلين .. “، لكنه يصارع قسوة مكوّنات الحكاية. وهو بالضبط ما يعنيه أنْ يلجأ الفعل إلى الاجتراح، الافتعال ليس طرح الكثير من الخيارات أمام أنْ أكتب أو لا أكتب؛ لأنها قضيّة تم تجاوزها منذ عبّر الفن عن الطبيعة البشريّة المختلفة للفنان.
( ما سقط من أوراق الكتابة )؛ مقاربات الكاتب من فعل النّص باعتباره شكلا تكوينيّا لمجموعة من الافتعالات المحقّقة للاختلاف. المعنى هو بأنْ ” لا يمكن للكتابة أنْ تكون اليقين التام ولا القلق الدائم … “؛ هو موقف المواجهة مع الفعل للانتصار على ضرورة القلق كما مرّ سابقا، لكنّ الواقع والنّص ليسا بريئين من تهمة غياب المعنى أو حضوره، ومع أنْ النص ليس بالضرورة أنْ يكون انعكاس الواقع إذا سرنا على حساسية الفنّ بالمعنى وتجنّبنا أشكال الفن الدنيويّ في تحليلات هربرت ريد، كذلك ليس بالضرورة أنْ يولد النص من رحم الواقع؛ إذ هو موقف الفنّان من متغيّرات أو انكسارات في مناطق غير مرئيّة لدى الآخرين، ولكن ” هل على النص أنْ يكون جارحا حتى يخترق حياة القارئ؟ “؛ كما يهرب الكاتب بذلك من حساسية الموقف بشكل آخر في القضيّة الأكثر حضورا في لحظة ميلاد الكتابة. فهي ” شجرة وفأس وحطّاب ورماد، ونار في البدء “، هي أنت وأنت هي / النص؛ فعل التشكّل الذي لا يمكن أنْ تنفصل عنه وإن وقفت عن تحقيقه. إنها الشجرة والتشجير بالنسبة للكاتب، عودة إلى افتعال الاخضرار ومقاومة الجفاف.
مسقط المدينة التي لا يبدو أن حمود سعود سيتصالح معها على الأقل في الوقت القريب، يعود من مراكش محمّلا بالمتخيّل وبعض الضجر الذي نعست عليه المدينة، ومفارقاتها التي لا تنتهي، وموعد مع شخصيّات تولد من أزقّتها وشوارعها وساحاتها؛ يعود إلى مسقط التي ” لا تحبك ولا أنت تحب مسقط. لا تكرهك ولا تكرهها. لا تحنُّ إليها، ولا هي تحنّ إلى الغرباء والعابرين “. هي بحق مدينة جارحة الجمال والجمود والتحوّل، لا يتصالح معها ليس لأنه لا يريد ذلك، بل لأنها عصيّة على الشكل الذي يمكن أنْ تكونه مدنٌ تشبه علاقتها بالبحر والجبل والغزاة، ” لولا حركة ظلال شجرة صغيرة أعلى جبال بوشر لقلت إن الزمن لم يمرّ من هنا “. هل هي خارج الوقت أم خارج الزمن المتدفّق من عمر الكاتب. ليس ذلك تعالي اللامنتمي الذي يرى العالم من ثقب صغير عند ولسون؛ لكنه القَلِق الذي يرى المكان فضاء مختلفا له نبضه البشريّ والتاريخيّ والنبيل، أمام الخذلان المكانيّ والشعوريّ، ” أنا ملح البلاد، وأنت جرحها “، سياقات كثيرة تولد بتهمة ودفاع واعتراف تتشكل في التجربة من خلال الفقد والانتظار والانكسار؛ ” حرّاس يحرسون وهم المدينة وأمواتها “، يولد التاريخ بأكثر من شكل يفرضه العابر على الخليج، كل ملامح المدينة انتظار لقادم آخر، والمتناقضات الوجه الأكثر حضورا في معظم أوجه المدينة الزمنيّة، ” يقف الجنرال فوق جبال بوشر لا ليطارد الأحصنة الهاربة من الضجر؛ بل ليدخّن سيجارا كوبيّا ـ رغم كراهيته لكوبا ـ ويتأمل جسد مسقط النائم “. لا تقاومه لأنها تنام بعد إنهاك حركة التاريخ عليها، تشير إليه ثيمات الصراع في التجربة ( عزّان بن قيس، الأحصنة، قلعة )، ولهذا فهي بعيدة يراقب كافكا الغريب دوران الساعة التي لا تعرف زمن البلاد. غربة وسقوط وفراغ على الرغم من كرم الكراسي الذي ينعم به الغرباء والقتلة.
تيه وليس تخلٍّ يهيمن على الغريب في مسقط، يبحث عن روحها؛ فنبض مسقط عنده أوجاع واغتراب أرواح، أرواح تدقّقت قبل قرن ونصف تتهافت على المجهول بمتحوّله الهشّ، أين أولئك الهائمون بك، أين العشاق والمجانين؛ هل تُبنى المدن بدونهم، لماذا تسحقهم شوارعك الاسمنتيّة وأزقّتك الباهتة، لماذا لا يشعر المسقطيّون بغياب المدينة عن طبيعة مسقط. كل هذه الأسئلة تولد في مواجهة المدينة المرجوّة التي خلقها الكاتب من صور مدن أخرى، مرَّ عليها الغرباء والغزاة لكنها عادت إلى ذاتها؛ فلماذا مسقط ” خذلان البحر للميناء، وخوف الميناء من سفن الغزاة والقراصنة “، بقي لنا أنْ نتوجّع بالتاريخ في الاغتراب فهل عليه أنْ يترك المدينة بلا جهة، لقد ذبلت كثير من الجهات في عينيها. إنها ذات شكل مجهول؛ “عرجاء وجذّابة وجدباء “؛ شكل آخر لألم الحب واغترابه بين مدينة وغريب قريب.
محمود حمدظلال الأشجار ورائحة مسقط
بالقرب من تجربة حمود سعود (أشجار الرماد وأعمى مراكش)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم أكن أتجاوز مشاركة حمود ظلاله بين زمن الصبا والحاضر حين أنقل له سلام (شجرة السُّمْر) في (وادي مليل) المحاذي لقريتي بجفافه اللاذع في الصيف، وفي كلّ مرة يهديني شجرة بريّة أستحضر هذه الظلال نحتا في الذاكرة بين المدينة والقرية؛ فلأشجار حمود سعود معاني تتفرّع بتفرّع الذوات التي تغرسها أو تتعاطف معها أو تقطف ثمارها أو تتفيء ظلالها أو تمرّ عليها أو تتجاهلها، معاني ليست تلك التي تستنزف حركة التشكيل المدفوعة بالهروب من ضجر رسم الظل المعتاد أو بناء علاقة مع طبيعة الاخضرار في الأشجار؛ لأنها ذات ألوان ذوات ومؤشرات تبدأ من منطلق “في كل شجرة هناك حكمة تركها طائر، وهناك ذكرى عابر، أو جرح تركته الريح “. فالكائنات في علاقتها بالأشجار مرتبطة بموقف وجودي أو غريزة بنائيّة لا تنتهي بتجاوز ظل ينكمش ثم يختفي بالغروب، أو يعود في ضوء القمر متلاشيا؛ إنها مدى آخر بلغة حمود سعود؛ تلك الفاعلة التي يختفي خلفها ــ كما قلت سابقا ــ ليعود بدالٍّ يرمي إلى مدلول متفرّع في أكثره ممّا لا يريدنا أنْ ننشغل به عنه؛ أو بمعنى آخر المعنى الذي يولد بكثير من المحمولات الإنسانيّة والتاريخيّة في “هسهسة لغة بارت “. لهذا يقترب الكاتب هذه المرة من نصّه أكثر باعتباره الكتابة ذاتها؛ الفاعلة في إقلاق المتلقي؛ (الخوف ذات ساردة)؛ منطلق آخر للكتابة لا يتّفق معه الكثيرون في تعيين حدود الكتابة “فلا يمكن للنص أنْ ينغلق على الأمكنة الملوّثة بالواقعيّة، وسياج اللغة وأنيابها وتكلّساتها، ولا أنْ يطفو في توهّمات الخيال كجثّة على سطح بحيرة “. إنه الذات بكل ما يجعلها متجاوزة نافرة من الانغلاق وفي خيالها لا تترهّل لتكون نسيا أو متجاهلا أمام ذاتها الداخليّة، النص إضافة كما عند دريدا لكنّه حفْر وهوّة في صورة جسر إلى التحقّق، ملامسته تحفر جرفا في حقيقة بارت بين القراءة والنقد، كل ذلك الخطر المحدق بمغامرة الكتابة لكنّ على اللغة- كما يرسم لها الكاتب في تجربته- ” أنْ تنزل من كتب القواعد؛ لتجلس قليلا في الشارع … لتحتوي النصّ وتغسله من قلق كاتبه “. فاعليّة الكتابة بتشكيلات اللغة هي تحرر النص الذي يمكّن الكاتب من اختراع أوجه فنيّة متنوّعة للسرد بنصّ منفتح على المعنى بشكل ودلالات متجددة.
تعددت منطلقات تأسيس النص المختلف في التجربة ليبني المعنى على مجموعة من الثيمات المتفرّعة من فاعليّة الكتابة ذاتها. نجد (الصراع بين الواقع والذاكرة)؛ ” وأقول للرجل في القبر، إن البلاد ما تزال تتذكر شخصيّات رواياتك…”، ففاعلية النص مجموعة من الملموس القلق في تصوير مختزل للذاكرة المنسية، النتيجة تكرار للنسيان كلما مسّ الذات عجز الذاكرة. كما نجد ( الخطاب والفراغ )؛ ” لكنّ كلام المعلمين…”؛ وهو المحور المرجوّ لبناء وعي التلقي والتّوجس في منظومة مكررة في أبجديات الملموس العالمي، الشكل متعدد الرؤى بأدوات مستهلكة. ونجد (الحضور ليس ضد الغياب)؛ فهي حاضرة وغائبة في الوقت عينه؛ لكنه بمستوى آخر للوجع، موقف ملامسة موضوعات المشاهد ” كلّ هذا البحر ولا سمكة واحدة تفسد زرقته “. هي حاجة البشريّ إلى الافتعال المتعلّق بالاغتراب؛ فحضور الأشياء ليس الاكتمال في لحظة قدرتها على جرح الذوات بفاعليّة القصدية التي يتبنّاها الكاتب في تشكيل خطاب بريء من وهم المتلقي، يكفي أن يطرح التلقي أدوات ذات علاقة بالمتخيّل ليتحقق فن اللغة كما يراه جرار جنيت، وبعدها تنفتح الآفاق ليكون الخطاب ذا فاعليّة انتاجيّة. كذلك نجد أن (الذكرى لا تعيد الماضي) من خلال سيرورة الوقت التي لا تتوقّف لمشاركة اختزالات الذات ومحاولاتها في الإبقاء على اليسير من الاستعادات، ثم الوصول إلى المحسوس والمشاهد. “خيط السّرد قد قطعته المرأة الجالسة في قطار الكلام.. “؛ تداخل العوالم التي تقع في هذه الاستعادات المتكررة؛ فاعليّة الكتابة، وتشكيلات النص الفنّي/ الكاتب، تبدأ هذه الفاعليّة من الوفاء للوجع الذي هو مقوّم الفنّ، وهو في الجانب الآخر ـ من خلال دراسات عزّ الدين إسماعيل ـ قوّة الفنان المبدعة التي تجعله مميّزا عن غيره. كل هذه المنطلقات تشكّل فعل الكتابة في مواجهة الكاتب لها باعتبارها النّص بثنائيّة ( أنا / هو )؛ لكنها بشكل آخر يطرحها حمود سعود في مواجهة نصّه أو الأخذ بيده داخل الثنائيّة.
ومن خلال ثنائيّة ( أنا / هو ) يتتبّع حمود سعود طريق عمر الثلاثين بصفته تشكيلا استثنائيّا بين مرحلة الكاتب السابقة وقادم الأيام من خلال استقراء المتغيّرات التي تضيف إلى ذات الفنّان كثيرا من المواقف النفسيّة وردّات فعلها المتغيّرة؛ على الرغم من أنك ” لا تعلم أنت كم طول الطريق حتّى تدّعي بأنّك في منتصفه “، فتبرز من هنا تحوّلات الزمن الذاتيّة من خلال مجموعة من التّأملات التي أقام عليها الكاتب رؤيته إلى العمر بصفته زمنا حادّا ووصولا إلى مرحلة وعي مؤثّرة؛ (ما بين الطفولة والشيخوخة)، ولنا أنْ ندرك العوالم المتقاربة في فهم المحيط ببساطة والقناعة بأدوات تحقّق الحياة، و(الوفاء للطفولة)؛ شكل الشجرة في الذات بكل تفاصيلها وخذلان الحلم على كثير من النوافذ. (أنت ما تريد)؛ ما يؤكد الصراع من أجل اللحظات التي لا تعود، وعلى الرغم من الألم الذي يسببه جرح الذات لكنه المنفذ إلى الحصول على عصارة اليقين. ” ستجد في أحد الثقوب دمعة طفل …. سترى في ثقب آخر امرأة … في ثقب جانبيّ من القلب سترى دفترا … “؛ بعمر الثلاثين تحقق باعترافك نصّك الفني / ذاتك الغائبة الحاضرة، وفي حضور قلق الضرورة هذا ومنه تولد الكتابة / اعترافك وصمتك، ما تريده وما لا تريده، الأهم من كل هذا أنْ تكون أنت / الكتابة. التجارب والحكايات هي فاعل الموقف من الكتابة. يؤسس حمود سعود بمقربة من موقدها رؤاها حول فعلها الفنّي والمتّهم الأول في القلق؛ السفر بالتجارب والخلاصات والمواقف إلى داخل الذات وخارجها دون المساس بتكوينها أو تعريضها للاسفاف، ” لا يفتحها أمام الغرباء ولا المتطفّلين .. “، لكنه يصارع قسوة مكوّنات الحكاية. وهو بالضبط ما يعنيه أنْ يلجأ الفعل إلى الاجتراح، الافتعال ليس طرح الكثير من الخيارات أمام أنْ أكتب أو لا أكتب؛ لأنها قضيّة تم تجاوزها منذ عبّر الفن عن الطبيعة البشريّة المختلفة للفنان.
(ما سقط من أوراق الكتابة)؛ مقاربات الكاتب من فعل النّص كونه شكلا تكوينيّا لمجموعة من الافتعالات المحقّقة للاختلاف. المعنى هو بأنْ “لا يمكن للكتابة أنْ تكون اليقين التام ولا القلق الدائم … “؛ هو موقف المواجهة مع الفعل للانتصار على ضرورة القلق كما مرّ سابقا، لكنّ الواقع والنّص ليسا بريئين من تهمة غياب المعنى أو حضوره، ومع أنْ النص ليس بالضرورة أنْ يكون انعكاس الواقع إذا سرنا على حساسية الفنّ بالمعنى وتجنّبنا أشكال الفن الدنيويّ في تحليلات هربرت ريد، كذلك ليس بالضرورة أنْ يولد النص من رحم الواقع؛ إذ هو موقف الفنّان من متغيّرات أو انكسارات في مناطق غير مرئيّة لدى الآخرين، ولكن “هل على النص أنْ يكون جارحا حتى يخترق حياة القارئ؟” كما يهرب الكاتب بذلك من حساسية الموقف بشكل آخر في القضيّة الأكثر حضورا في لحظة ميلاد الكتابة. فهي “شجرة وفأس وحطّاب ورماد، ونار في البدء”، هي أنت وأنت هي / النص؛ فعل التشكّل الذي لا يمكن أنْ تنفصل عنه وإن وقفت عن تحقيقه. إنها الشجرة والتشجير بالنسبة للكاتب، عودة إلى افتعال الاخضرار ومقاومة الجفاف.
مسقط المدينة التي لا يبدو أن حمود سعود سيتصالح معها على الأقل في الوقت القريب، يعود من مراكش محمّلا بالمتخيّل وبعض الضجر الذي نعست عليه المدينة، ومفارقاتها التي لا تنتهي، وموعد مع شخصيّات تولد من أزقّتها وشوارعها وساحاتها؛ يعود إلى مسقط التي “لا تحبك ولا أنت تحب مسقط. لا تكرهك ولا تكرهها. لا تحنُّ إليها، ولا هي تحنّ إلى الغرباء والعابرين “. هي بحق مدينة جارحة الجمال والجمود والتحوّل، لا يتصالح معها ليس لأنه لا يريد ذلك، بل لأنها عصيّة على الشكل الذي يمكن أنْ تكونه مدنٌ تشبه علاقتها بالبحر والجبل والغزاة، “لولا حركة ظلال شجرة صغيرة أعلى جبال بوشر لقلت إن الزمن لم يمرّ من هنا”. هل هي خارج الوقت أم خارج الزمن المتدفّق من عمر الكاتب. ليس ذلك تعالي اللامنتمي الذي يرى العالم من ثقب صغير عند ولسون؛ لكنه القَلِق الذي يرى المكان فضاء مختلفا له نبضه البشريّ والتاريخيّ والنبيل، أمام الخذلان المكانيّ والشعوريّ، “أنا ملح البلاد، وأنت جرحها”، سياقات كثيرة تولد بتهمة ودفاع واعتراف تتشكل في التجربة من خلال الفقد والانتظار والانكسار؛ “حرّاس يحرسون وهم المدينة وأمواتها”، يولد التاريخ بأكثر من شكل يفرضه العابر على الخليج، كل ملامح المدينة انتظار لقادم آخر، والمتناقضات الوجه الأكثر حضورا في معظم أوجه المدينة الزمنيّة، “يقف الجنرال فوق جبال بوشر لا ليطارد الأحصنة الهاربة من الضجر؛ بل ليدخّن سيجارا كوبيّا ـ رغم كراهيته لكوبا ـ ويتأمل جسد مسقط النائم “. لا تقاومه لأنها تنام بعد إنهاك حركة التاريخ عليها، تشير إليه ثيمات الصراع في التجربة (عزّان بن قيس، الأحصنة، قلعة)، ولهذا فهي بعيدة يراقب كافكا الغريب دوران الساعة التي لا تعرف زمن البلاد. غربة وسقوط وفراغ على الرغم من كرم الكراسي الذي ينعم به الغرباء والقتلة.
تيه وليس تخلٍّ يهيمن على الغريب في مسقط، يبحث عن روحها؛ فنبض مسقط عنده أوجاع واغتراب أرواح، أرواح تدقّقت قبل قرن ونصف تتهافت على المجهول بمتحوّله الهشّ، أين أولئك الهائمون بك، أين العشاق والمجانين؛ هل تُبنى المدن بدونهم، لماذا تسحقهم شوارعك الاسمنتيّة وأزقّتك الباهتة، لماذا لا يشعر المسقطيّون بغياب المدينة عن طبيعة مسقط. كل هذه الأسئلة تولد في مواجهة المدينة المرجوّة التي خلقها الكاتب من صور مدن أخرى، مرَّ عليها الغرباء والغزاة لكنها عادت إلى ذاتها؛ فلماذا مسقط “خذلان البحر للميناء، وخوف الميناء من سفن الغزاة والقراصنة “، بقي لنا أنْ نتوجّع بالتاريخ في الاغتراب فهل عليه أنْ يترك المدينة بلا جهة، لقد ذبلت كثير من الجهات في عينيها. إنها ذات شكل مجهول؛ “عرجاء وجذّابة وجدباء ” شكل آخر لألم الحب واغترابه بين مدينة وغريب قريب.