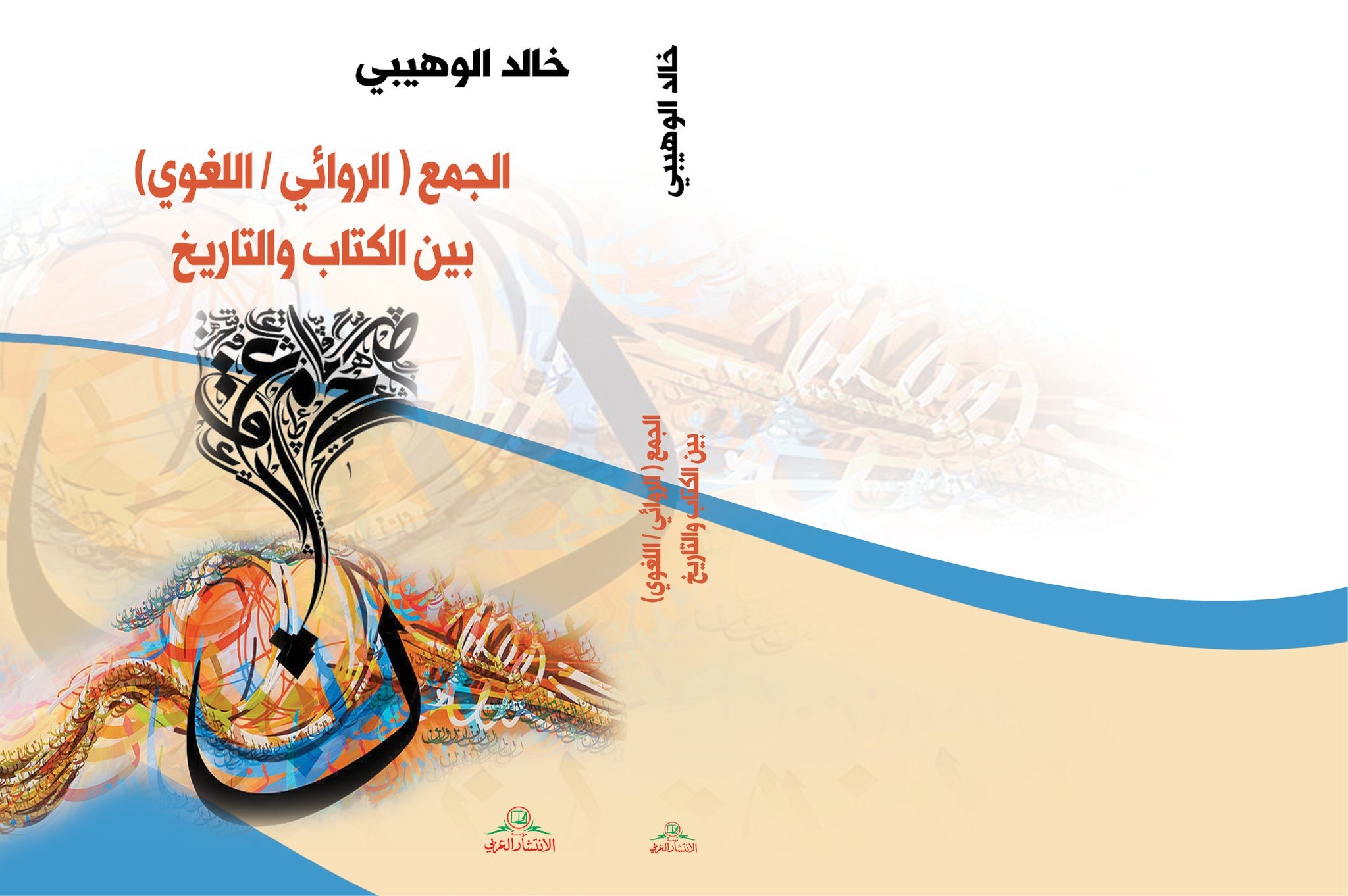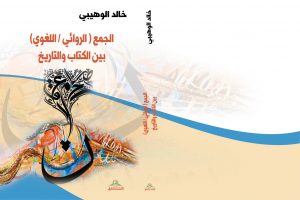كتاب يبحث قسمين كبيرين من الثقافة العربية بعد القرآن، وهما:
– الجمع الروائي؛ المنسوب إلى النبي عليه السلام والصحابة.
– الجمع اللغوي؛ وهو جمع المعاجم لأعراف وتقاليد المجتمعات العربية القديمة للكلمات ودلالاتها.
وهذا البحث يستند إلى مدى مقاربة هذا الجمع لمآلات الكتاب، والكتاب معبر عن الكون والقرآن في سياق واحد.
الرواية التي نسبت إلى النبي عليه السلام هي نقل الراوي معالم من السيرة الرسالية برؤية الراوي للكون والإنسان والغيب، فعندما ينقل ما سمعه أو شاهده أو ما تلقاه من غيره فإنه يُسقِط عليها ثقافته الزمنية وليس بالضرورة أن يتعمد الكذب أو الزيادة، فهي أمور تحصل غالبًا بمقتضى حركة الاجتماع البشري بما يختزنه من أفكار، وهذا يفسر تسرّب الكثير من الخرافات في الروايات والأحاديث المنسوبة إلى النبي.
الجمع الروائي الذي دونته المجموعات الحديثية المختلفة ونسبته إلى النبي والصحابة وتابعي الصحابة تراث إنساني يدرس بتصديق وهيمنة آيات الكتاب، وهذا يحفظ الدين من تشويش وشغب ما يرويه الناس، ويوظف الحديث معرفيًا في نطاق آيات الكتاب.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الجمع اللغوي، فرغم اقتناع المؤلف لسنوات بالآثار السلبية التي خلفها الجمع الروائي بتحجيم مآلات آيات الكتاب وتجميدها في حقب تاريخية بعينها؛ وهو ما شكَّل من بعد ما يعرف بالسلفية أو فهم السلف؛ إلا أنه أدرك بتراكم المعرفة والخبرة أن التأثير السلبي الذي خلَّفه الجمع اللغوي لا يقل خطورة عن الجمع الروائي، إن لم يكن يزيد عليه.
الجمع اللغوي الذي دُوِّن في كتب اللغة تشبع بأعراف وتقاليد شعوب وقبائل المنطقة، وعند هيمنته على الكتاب فمن المنطقي أن نحصل على مآلات برائحة ونكهة الزمن الذي تولدت فيه تلك الدلالات اللغوية، وهذا النهج قديم لخصه ابن عباس فيما نُسِب إليه بقوله: (إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ شيئاً من القرآنِ فَلَمْ يَدْرِ ما تَفْسِيرُهُ، فَلْيَلْتَمِسْهُ في الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ ديوانُ العَرَبِ).
وهذا النهج جعل الناس يتسابقون في جمع ما تعارفت عليه البوادي والحواضر من كلمات ومعانٍ، صارت هي سقف الكتاب الذي لا يجوز لأحد أن يتخطاه، وقد لاحظ الجابري في نقده للعقل العربي تأثير لغة البادية التي تشكل رؤيتها للطبيعة والإنسان، وعنون الفصل الذي تحدث فيه عن ذلك بـ(الأعرابي صانع العالم)، فهذا الجمع فيه من آثارهم وفي مقدمتها الطبيعة الحسية لتفكيرهم، فكأن السقف المعرفي لساكن البادية ببساطته وسقفه المنخفض صار مشكلاً رئيساً للجمع اللغوي؛ والكلام ذاته يقال عن جمع اللغة من الحواضر في حقب زمنية متعددة، فلا بد أن تتسرب ثقافة المجتمعات في بنية الكلمات ودلالاتها، الذي سينعكس بدوره على تعقلنا للكتاب، الذي سيكون ملتصقاً بالاجتماع البشري الزمني بكافة إشكالاته بدلاً من آيات الكون بسُننيتها.
ولتجنب الآثار السلبية للطبيعة الزمنية للجمع الروائي فلازم كشف المآلات المتجددة لآيات القرآن المرتبطة بآيات الكون، فالقرآن من الكتاب، والكتاب تمظهر نهائي لآيات الكون، هذه الطبيعة الكونية في القرآن تبدأ من أدق وأصغر مكوناته، فأصوات/حروف القرآن وكلماته وآياته وسوره مجعولة من الكتاب، تتكشف طاقتها بمقدار تراكم معارفنا وخبراتنا الكونية.
تحاول هذه الدراسة بعث وتطوير نظرية قديمة في الدراسات اللسانية، ظهرت آثارها الأولى في أبجدية الفينيقيين قبل آلاف السنين، وتبناها الفيلسوف سقراط وعباد بن سليمان وعثمان بن جني، وطورها العالم العراقي عالم سبيط النيلي رأسياً وأفقياً، ترى النظرية أن الكلمات تدل على المعاني بذواتها دلالة طبيعية، والدلالة الطبيعية مأخوذة من سُنن الكون، فأصوات/حروف الكلمة لها دلالة طبيعية (فيزيائية) تشكل بحركتها الأصل الجامع للمعاني المتعددة للكلمة، سواء:
– ما عرف الناس من معانيها
– أو من معان جديدة تستوعبها الحركة الطبيعية (الفيزيائية) لتعاقب الحروف، وهو ما يعطي الكلمة قدرة للتعبير عن متطلبات جديدة مستحدثة.
يقدم المؤلف في كتابه نظرية مفادها أن اللسان العربي متجذر وموغل في القدم، فحلقاته القديمة مترابطة بأخواتها الحديثة، حيث تطور وتدرج لآلاف السنين في المنطقة العربية عبر محطات جغرافية/تاريخية حتى كان اكتمال سُننيته في القرآن، وارتبط في زبر الأولين برسالات الأنبياء وكتبهم، التي طورت سُننيته بما مدته به من علوم وكلمات ومآلات.
وهذه النظرية تربط بين ثلاثية:
– اللسان العربي بسُننيته المتطورة عبر التاريخ.
– آيات الكون بسُننيتها.
– رسالات الأنبياء بسُننيتها.
وخلاصة رسالة الكتاب أن الكلمة العربية تقرأ من بنيتها الداخلية وتعاقب أصواتها/حروفها المرتبطة بالحركة الكونية، بما يستوعب معاني غير متناهية لمآلاتها، ولا يشترط لذلك السقف الذي حدده الجمع اللغوي؛ الذي جمد اللسان العربي بما جمعه من لغو الناس.