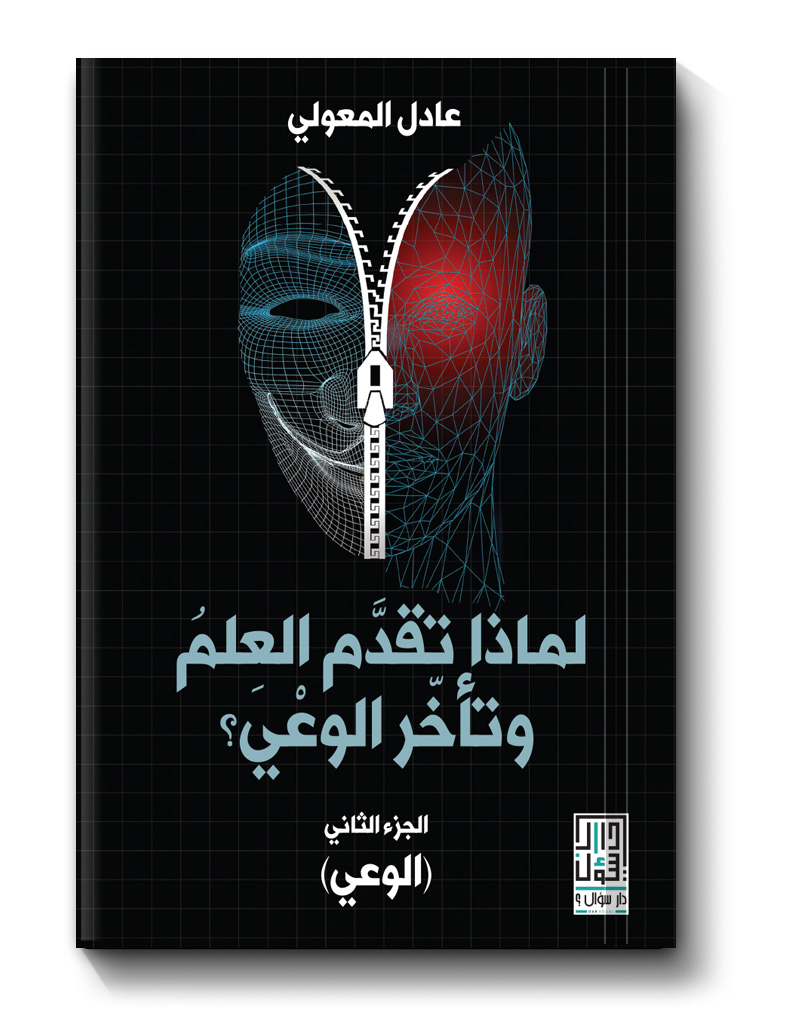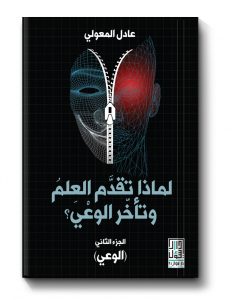إن حركة الوعي خلاف حركة العلم، فالعلم تطوره تاريخي تراكمي، فقد ولد مع حركة التمدن البشري الطموح نحو اختزال تجاربه عبر الأجيال، من جيل إلى جيل، وذلك بواسطة صيرورة التدوين والكتابة، وتقدر هذه الحركة التراكمية التجريبية للإنسان بما يربوا على سبعة ألاف سنة. أما الوعي فتطوره زمني ذاتي، أي ينال بجهد فردي يُكتسب من خلال التفكر والتأمل والترصد[1] والقراءة، وإعادة النظر في المسلمات الموروثة وفي حركة الواقع المتمثلة في الممارسات الإنسانية وتداعيات تلك الحركة على الواقع ومصداقيتها من حيث الانسجام مع القيم والمنافع الإنسانية العليا، ألا وهي حفظ حرية وكرامة وحياة الإنسان – القيمة التي أعليها هنا هي القيمة لذاتها لا قيمة المنفعة أو قيمة الفائدة. المنفعة شيء مستقل عن القيمة، فليس من الضروري أن يكون لكل قيمة منفعة أو فائدة مباشرة، فالقيم فائدتها ومنفعتها ذاتية لأنها قيمة وكفى. وقد يظن بأن هناك رابط بين القيمة والمنفعة، فالقيمة شيء والفائدة والمنفعة شيء آخر.
إذن، من مهام الوعي تشكيل معالمه الخاصة به، بطريقة التفكير المستقل بعيدًا عن تأثير الواقع، بل قراءة الواقع قراءة مغايرة عمى هو سائد لدى العام الاجتماعي. والتمييز بين ما هو واقعي وبين ما هو معقول، فليست الواقعية شرطًا للمعقول[2]، فكم من ممارسات وأنماط سلوكية ومفاهيم نتعاطها وكأنها لزوم ما يلزم. على أنها هي الحقيقة من منطلق ما هو كائن فهو جائز عقلاً، وليس كل واقع نافع بالضرورة يكون واقع حقيقيًا، فالمنفعة الواقعة شيء، والحقيقة المجردة شيء آخر، وليس الواقع المشاهد يكون بالضرورة واقع حقيقي أو علمي أو طبيعي، والواقع دائمًا طارئ والحقيقة التي ترافقه بالتالي تكون حقيقة طارئة كذلك. مثلاً، من يتحدث عن واقعة مُعيَّنة، ويقول فيها الصدق، هو يتحدث عن واقع تلك الواقعة لا عن حقيقتها، فالصدق ليس رديف الحقيقة في هذا الخط الحدثي. فكم من حديث يكون صادق القول كاذب الفعل، أو صادق القول كاذب واقعًا، أو صادق الفعل كاذب مقصدًا. وكم من حادثة تشاهد عيانًا ولكن حقيقتها خلاف تلك المشاهدة المنظورة.
فالحق شيء والحقيقة الواقعة شيء، والصدق شيء آخر. ولكي يتحقق مقصد الصدق، يجب أن تتوفر أولاً المعرفة بالشيء أو العلم بالشيء، ليتم الإخبار عنه بصدق، فليس من الصدق في شيء، أن نعبر عن شيء ونحن نجهله، وان كان ذاك الشيء موجودًا فعليًا. ولديكارت رأي في هذه القضية، حيث يقول: إذا لم يكن في مقدوري الوصول إلى معرفة أي حقيقة، فليكن أن أفعل ما هو في مقدوري على الأقل، أي التوقف عن كل حكم،[3] وأتجنب أن أعطي أي مصداقية لأي شيء باطل. وألا أقبل شيئًا على أنه حق ما لم أعرف يقينًا أنه كذلك، بمعنى أن أتجنب مغبة السبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك.
المعرفة بالشيء شرط من شروط تحقق الصدق عند نقله، والمعرفة بالشيء مقدمة على العلم به، وهناك فرق بين أن أعلم عن الشيء، وبين أن أعرف الشيء. فمثلاً، من قال: لا إله إلا الله، فقد قال الصدق والحق معًا على الحقيقة، ولكن كيف أدرك هذا القائل هذه المسلمَّة، هل عن طريق المعرفة أم عن طريق العِلم، أم عن طريق التـأمل؟ وما هي الحيثيات التي دفعته إلى أن يؤمن بأنه لا إله إلا الله، هل هي حيثيات علمية أم هي حيثيات معرفية، أم هي حيثيات فطرية؟ فبقدر حيثيات ومبررات الإيمان بالشيء، بقدره يكون مستوى الصدق، وبالتالي مستوى الإيمان فيه. فليس كل مُقال وإن صدَّقهُ الواقع يكون صدقًا على الحقيقة، فصدق الشيء من كذبه، يكون في حيز تقدير القائل ومعرفته أولاً، من ثم مع تطابقه وانسجامه مع الواقع – والشرط الأول مقدم على الشرط الثاني – ومع معرفته بالشيء والإيمان به. قد يقول أحدنا قولاً ويكون هذا القول مستوفي معيار الصدق العام – القول يطابق الحدث، أو الحدث يطابق القول – وكذلك الواقع يشهد على صدق قول القائل، ولكن في الحقيقة يكون ذلك القول الذي اعتبرناه صدقًا بمعيار مفهوم معنى الصدق، وبمعيار شهادة الواقع، هو ليس من الصدق في شيء. بمجرد أن يضمر القائل قولاً يخالف نيته أو يخالف معرفته، أو انه لا يعرف عنه شيئًا، وإن صَدَقَ قوله ظاهريًا وواقعيًا فهو يكذب على كل حال. فمثلاً، إذا انقطعت المشاهدة أو المعرفة أو العلم بالشيء قبل اكتمال دورة صيرورته يبقى الحكم عليه نسبي أو معلق أو كاذب، وتتوقف نسبية الحكم على القائل ومدى نواياه أو مدى مقاصده أو مدى معرفته أو علمه بذلك الشيء المراد الحكم عليه. وهنا أود التأكيد على أن شهادة العيان ليست كافية لتأكيد الحقيقة أو قول الصدق، فإذا كان هذا شأن شهادة العيان فكيف من يحكم على الأشياء بواسطة أحاسيسه وعواطفه؟
________________________
[1] التأمل يجعلك وجهًا لوجه مع الحقيقة، كما يقول اوشو. أما سبينوزا، فله رأي في التأمل يحث يقول: إن التأمل أرقى وأفضل أشكال الأخلاق. أما أرسطو فيرى بأن الترصد التأمل المراقب أنفع من تفسير الكتب.
[2] كل ما هو واقعي عقلاني، هذا ما قاله هيغل، وقد شرح هذه العبارة المترجم والكاتب هاشم صالح بما معناه، بأن كل ما هو موجود في الواقع له تبريره وسببيته وإلا لما وجد. فواقعية هيغل لا تعني العقلانية المحضة، ولكن تعني التبرير العقلي للواقع وحتى وان كان هذا الواقع يجافي الحق والحقيقة، وهذا يؤكد ما أشرت إليه لا ينفيه. فواقعية هيغل هي واقعية ساذجة، كما ينعتها برتراند راسل، بمعنى مقولة: إن الأشياء هي على ما تبدو عليه، وهذه واقعية زائفة. ويقول: المفكر الألماني اشبنغلر في المقابل الآخر: إن الذي عيش، هو ذاك الذي حدث، وهو تاريخ. لكن في المقابل هل كل معاش حادث واقعي وتاريخه صحيح؟ أما الدكتور علي شريعتي فيقول: للأسف خلط مفكرونا ومتعلمونا الجدد مقولتين منفصلتين تمامًا بالنسبة للقضايا الاجتماعية في أذهانهم: إحداهما الحقيقة والأخرى الواقع وأقصد بالحقيقة ما نعتقد في صحته أو ما ينبغي أن يكون، وأقصد بالواقع ما نعترف بوجوده ونعتقد أنه موجود، أما مسألة خيره وشره أو قبحه وجماله أو حقه أو بطلانه، فهي مرحلة لاحقة هي مرحلة الحكم الذهني. وفي بعض الأحيان تنطبق الحقيقة مع الواقع. وفي عبارة أخرى: إن الواقع أمر مطلق وخارجي والحقيقة أمر نسبي ونظري. أما المفكر الألماني نيتشه، فيرى انه لا توجد وقائع، بل تفسيرات. إضافة إلى ما تقدم ذكره، فكم من واقع مضحك نعيشه، ولكننا لا ننتبه إليه، حتى يأتي أديب أو فيلسوف أو حكيم يحول ذلك الواقع الممارس غير الملتفت إلية إلى قالب أدبي أو فكري، حينها فقط ننتبه بأن واقعنا الذي كنا نمارسه كان مضحكًا حد البكاء، أو مبكيًا حد الضحك. كم من ممارسات نعيشها بطريقة ساذجة أو بطريقة تدعو إلى الضحك ولكننا للأسف لا ننتبه إلى تلك الصور بحكم تعودنا على ممارستها، فالعادة ألفة، والألفة تخدير، حتى يأتي مفكر أريب يوقظنا من خدر الألفة والعادة.
[3] (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36). سورة الإسراء.