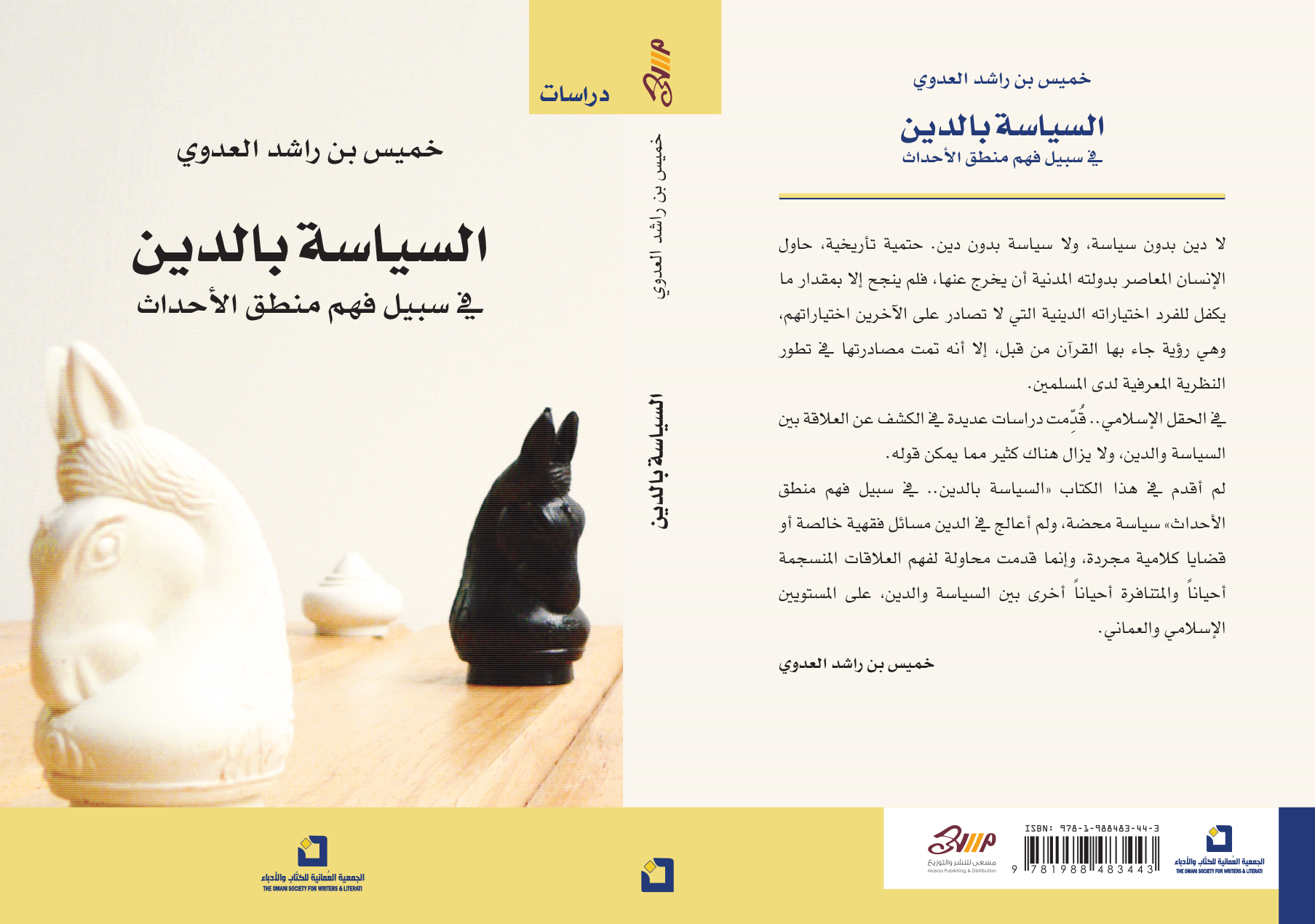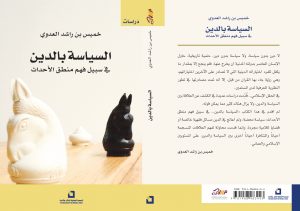يتوفّر قريبًا في معرض مسقط الدولي للكتاب كتاب “السياسة بالدين: في سبيل فهم منطق الأحداث” للكاتب خميس بن راشد العدوي عن دار مسعى للنشر والتوزيع، وبدعم من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ويقع الكتاب في 3 أبواب تتفرّع لفصول عديدة، وهي على التوالي: الدين والدولة في الإسلام، والدين والدولة في عمان، والقرآن والعقل المسلم.
“الفلق” تنقل لكم مقتطفات من هذا الإصدار تم انتقاؤها من فصول مُتفرِّقة منه.
قال الكاتب في مقدمة الكتاب: “في الحقل الإسلامي.. قدمت دراسات عديدة في الكشف عن العلاقة بين السياسة والدين، ولا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، لأمور؛ منها: الأول: التراث الهائل الذي تركته هذه العلاقة منذ بدء نزول الوحي على الرسول محمد حتّى اليوم، وهو تراث حي، بمعنى أنه لا يقبع في مسودات الكتب، وإنما يفعل فعله في الاجتماع، فهو فاعل ومتفاعل مع محيطه، ولأنه تراث فهو يشد المجتمعات المؤمنة به إلى الماضي، لعدم قدرته على مواكبة التطوّر البشري، ولأنه أصبح أداة بيد السياسي، يستغلها بشتّى الطرق، ولو بإثارة الحروب والفتك بالبشر وتدمير الأوطان. الثاني: قُدِّم هذا التراث الذي صنعته السياسة باعتباره دينًا، فحُمِلت أجيال المسلمين عليه، فأوصل المسلم إلى معاداة المختلف عنه، وإلى صراع مع مجتمعه. ”
ويُتابِع: “ولضعف الدراسات التحليلية لهذا التراث القادرة على بث الوعي في المسلمين أوغلوا في التمسك به، مما أورثهم حالة من السلفية المصابة بالعُصاب والذهان، أدت إلى تبني شريحة منهم للإرهاب، مُشَكِّلة أزمة إنسانية، من هنا استوجب أن تتواصل الدراسات بغية الخروج من هذا المأزق الحضاري.”
ويقول عن الكتاب: ” عندما بدأت الكتابة كانت المجتمعات الإسلامية؛ منها المجتمع العماني، قد دخلت في مرحلة المراجعة، ومع نهاية التسعينات القرن الميلادي الماضي، فكانت كتاباتي فيما أزعم تحمل روح المراجعة، والمراجعة كائن حي متدرج في أطوار النماء، وما دام الإنسان حيًا فأفكاره متحركة.”
ويضيف: “لم أقدّم في هذا الكتاب سياسة محضة ولم أعالج الدين في مسائل فقهية خالصة أو قضايا كلامية مجردة، وإنما قدمت محاولة لفهم العلاقات المنسجمة أحيانًا والمتنافرة أحيانًا والمتنافرة أحيانًا أخرى بين السياسة والدين، على المستويين الإسلامي والعماني.”
وورد في الباب الأول في فصل الأمة والدولة لدى المسلمين: “ان هذه الممارسات الطويلة في التفكر الإسلامي، بغضّ النظر عن مناطق القوة والضعف فيها، أو الاتفاق والاختلاف معها، عند التأمل فيها هي ممارسة للحرية الكامنة في النص القرآني، الحرية التي تفسح لآيات القرآن أن تتسع لحركة الحياة تحت إطار القيم الانسانية العليا، بما أسماه عبد الجواد ياسين خاصية الاكتناز، وأسميناه خاصية الاتساع.”
وعن العلاقة بين الدين والدولة والثقافة: “التجمع البشري في كيانات هو شأن حتمي للبشرية، وهو الحال للدين والثقافة بالنسبة للإنسان، ولذلك على مرّ العصور، وبحسبما كشف علم الحضارات، فإن الدين والثقافة هما من أهم عناصر الدولة، وبالتالي كان حتمًا عليها أن تتعامل معهما، فما من دولة قامت إلا كان من مرتكزاتها: الدين والثقافة، وإذا كانت الدولة الحديثة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الثقافة، حتّى أنها تشكل البعد الاستراتيجي الامني الأرسخ والأصلب فيها، فإنها أيضًا تتعامل مع الدين، ولا زالت تديره بكونه شأنًا يوميًا، ولو غفلت عن إدارته لحظة لأدخل خللًا بيّنًا في بنيتها.”
وحول علاقة كلٍّ من المثقّف ورجل الدين ورد: “ان المثقف لا يعتبر وجوده في مزاحمة السياسي على إدارة الدولة، وإنما وجوده في التنظير لها، وفي إعطائها المشروعية، أو سحبها منها، دون أن يعمل عمل السياسي، وهذا يرضي السياسي من جهة، ويخشاه من جهة أخرى، فيدفعه إلى إعطاء المثقف حدوج وجوده في الدولة، إن هذه المعادلة هي التي تجعل كلًا من السياسي والمثقف يعمل في منطقته ويحفظ وجوده فيها.
ويستأنِف: “وهذا بخلاف علاقة السياسي مع رجل الدين، حيث كانت في كثير من الأحوال علاقتهما علاقة صدام ومغالبة، فإذا كانت الدولة تأخذ مشروعيتها من الضرورة الأرضية لتنظيم الاجتماع، فإن رجل الدين يأخذ مشروعيته –بحسب معتقده- من الله، وإذا كانت الدولة لديها السيف والمال الفانيان لترهيب الناس وترغيبهم، فإن رجل الدين لديه الجنة والنار الخالدتان، ولذلك منعت الدولة من المسلمين من قيام سلطة لرجال الدين.”
وجاء في فصل الحاكمية والسلطة الدينية في الدولة الإسلامية: “مرتكز الإسلام السياسي هو مفهوم الحاكمية لله، وهو يشبه شعارًا قديمًا رفعه المُحَكِّمة الخوارج، وهو لا حكم إلا لله، ثم اعيد مرّةً أخرى استغلاله، بعد أن أُعيد إنتاجه؛ مفهوميًا ومعرفيًا، بصورة مختلفة، وعلى ضوئه حصل أيضًا صراع مسلح من جديد، مخلفًا جدلًا فكريًا بين منظري الإسلام السياسي ومثقفي الدولة، ودخل في هذا التداول الحامي مفكرون مسلمون آخرون؛ بصفتهم المستقلة، وبأطروحاتهم المستقلة أيضًا. وهذا الجدل أمر طبيعي، يذكرنا بالعمل الكبير الذي قام به علم الكلام من إحلال القلم محل السيف، وهو أيضًا مطلوب في هذه المرحلة التي من المفترض أن تكون انتقالية من عصر الدول الكلاسيكية إلى الدولة المدنية الحديثة، وهكذا… يظهر العنف في التحولات الكبرى للشعوب والدولة فيعقبه القلم ليخفف من وطأة السيف. ومن المفارقة أن ما تقوم به التنظيمات يسمى إرهابًا وتفريقًا؛ بينما يسمى ما تقوم به الدولة حزمًا وتوحيدًا.”
وقد جاء في فصل الإسلام السياسي من الإصلاح حتى الإرهاب: “لا يمكن تحميل أصل الدين ذاته ما يحصل في واقعنا الراهن من إرهاب وتخلف حضاري، ليس لأن الدين متعالٍ على النقد بهيبته الإلهية، وإنما لأن الدين بشقه الأخلاقي والقيمي ليس حوله خلاف، وبشقه الاجتماعي خاضع للتطور الحضاري والتغيّر في هيكل المجتمع البشري، لكن بسبب الاستبداد السياسي الذي عمل على تأخر البناء المدني، وعدم ولوج عالم الحداثة، وبسبب استغلال الدين الإسلامي في الصراع الدولي وصراع المنظومتين الماديتين؛ الرأسمالية الغربية والشيوعية الشرقية، وبسبب صناعة اجتماع آخر -الصحوة الإسلامية- يضرب نكوصًا إلى الماضي، فقد عادت الحاجة إلى النص الديني التاريخي، وبقوة، ليس للتقدم إلى الأمام، وإنما لإدارة عجلة الصراع الدولي في المنطقة.
وورد في الكتاب أيضًا: “بنظري.. هذه القضية؛ وأقصد الإجابة على السؤال المطروح جد مهمة، ليس على مستوى معالجة الأوضاع القائمة التي وصل إليها المسلمون فحسب، وإنما كذلك لأن هناك نزاعًا قائمًا وهو الحرب التي يشنها كثير من أنصار التحديث والحداثة على الدين ذاته، أخشى أنها في الموقع الخطأ أيضًا، وأنها ستستنزف الجهود والعمر والمقدرات، وتدخل في منطقة صراع آخر، بين من يخاف على دينه وهويته، فيدافع عنهما مستميتًا، وبين من يريد النهوض بمجتمعه وأمته، فلا المتدين يقدر أن يعود للدين كما يتصوره، ولا الحداثي يقدر أن يبني مجتمعه بما يأمله، ونخشى أن يدور الطرفان مرة أخرى في دوامة تعصف بكل شيء، لتكون من جديد حرب استفزاز واستنزاف وليست ملحمة بناء وإعمار.”
وفي فصل الدين وتحولات الدولة في عمان من الباب الثاني: “لقد فشلت الثورة الإباضية في إعادة مشروع الأمة، لكن مدرسة أبو عبيدة تركت أثرها العميق في التاريخ الإسلامي، حيث بلورة النظرية السياسية التي تجمع بين معاني الأمة وإرادة الدولة، وهو ما تحقق في عمان، وإن بصورة مصغّرة، تبسط الاستقرار أحيانًا، ويكتنفها الاضطراب أحيانًا أخرى، كما أنها هذا النظرية كانت الأنضج مقارنةً بالنظريات السياسية الأخرى التي وجدت في العالم الإسلامي حينذاك، من حيث ممارسة الشورى واختيار الحاكم في الدولة، ومحاسبته على إدارة الدولة، إلى درجة عزله فيما إذا انتهك الدستور.”
وعن العمانيِّين بين الأمة والدولة: “ان هذا الخط الذي تسير عليه الدولة الحديثة المتمثلة في السلطنة بصورتها الجديدة؛ ورثته من مفهوم الأمة الذي رسخه العمانيون منذ القرن الهجري الأول، وطوّروه ضمن مفهوم الدولة. وإذا كان العمانيون استطاعوا أن يتبنوا هذا المفهوم تحت عواصف تلك الأجواء، فإنهم من باب أولى لديهم القدرة على تأسيس دولتهم الحديثة في ظل السلم الذي تتمتع به عمان، وبعكس ما هو حاصل في كثير من بلدان المنطقة التي اعتمدت الدين والمذهب برؤية أحادية جزءًا من المعادلة السياسية في بلدهم، فأدى كما هو ملاحظ إلى صراع محلي واقليمي ودولي يعصف بالمنطقة، فإن الدين في عمان كان لمواجهة صعود التطرف، منذ مواجهة التيارات الشيوعية في المنطقة مع بدء مشروع الدولة الحديثة في السبعينيات، حتى مواجهة موجة التطرف المذهبي وصعود الإسلام السياسي، الذي أدى إلى قيام التنظيمات العنيفة بالمنطقة، وأخيرًا مواجهة عاصفة ما عرف بالربيع العربي. ولذلك فقد سلمت عمان كثيرًا من امتدادات هذا الصراع، وأثبت العمانيون على وجه العموم وحدتهم الوطنية، بما يحقق مفهوم الأمة في ظل الدولة. ”