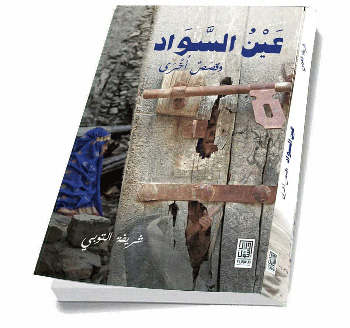أطياف ولد جَرَيْدة(1)
حكاية الدم والطين
وهبَك للحياةَ ونَذَرك للموت، تلك هي المعادلة التي كنتَ تتأرجح بين كفتيها كما أراد لك، دون أن تدرك لأيّهما أنت أقرب إلى الموت أم إلى الحياة، تتأبط بندقيّتك، تتأزّر الموت أينما ذهبت وأنت تكاد لا تقوى على حمل جذعك البشري، تتكئ عليها كعصا كلّما همّ بالمسير، لتسير خلفه وكلّما نظر إليك ترفعها عالياً بمحاذاة كتفك، تتأهب لسماع كلمته المعتادة ” اتبعني “، يرسم لك خط البداية لنهاية لا تعلمها ولمصير كان يأخذك نحوه، تتطاير ضفائرك السوداء المعقوصة المتدلّية على كتفيك، لم تعرف من طفولتك سوى صوت البندقيّة وهدفٍ عليك إصابته قريباً كان أو بعيداً، لم تلعب سوى لعبة الموت لحياة طويلة كانت بانتظارك، آمنت بما قاله لك يوماً وكفرت بأي شيء آخر
– ستحميك الرصاصة يا بنيّ من غدر العدوّ ومن خيانة الأصدقاء.
تمتطي فرس الاعتزاز والفخر باسم لم تكن تدرك معناه لرجل لا يشبه أحداً في حكايته والتي سيخالها أبناؤك وأحفادك يوماً من الأساطير التي ليس لها وجود سوى في مخيلتك، تجرّ القيد في قدميك، تتحسّس الدّم النازف على الأرض من أثر حزّ القيد، تصرخ للجدار الذي تبثه نجواك كل يوم وأنت تسند قامتك المتهالكة عليه
-هذا ما نذرتني له يا أبي !
لم تنس ذلك اليوم وأنت ابن الخامسة، حين سقطت البندقيّة من يدك وأنت تحاول الّلحاق به في مشيه السّريع. إنه الرّيح إذا مشى، كما قالت لك أمّك، وقبل أن تنحني لأخذها أوقفك صوته الهادر الأشبه بطلقة رصاصة إذا انطَلقت ستصيب في مقتل، يا لهذا الرجل الذي يزرع في قلبك الرعب والآمان في وقت واحد، أحرقتك شرارة الغضب من عينيه وهو ينهرك:
– الرجّال ما يطيّح تفقه، وإذا طاح ما ينحني ، كن رجلاً أو لا تكون.
هكذا قال لك مرة، وحينما حَاولتَ أن تأخذكَ بين يديها كي تخفّف عنك وجع ما أصابك، انتزعك منها، فتتبعه من جديد، وليسقط أيّ شيء عدا البندقية التي تظل ممسكاً بها، متوسّداً إياها، لاعباً بها لعبتك المعتادة في إصابة هدف لا تخطئه، تسير في دروب ( عين السواد)، على أرضٍ هي موطئاً لقدم رجولته، فتتبع أثر الهيبة المتبقيّة لشجاعة ما خُلقت في قلب رجل سواه.
منذ ذلك اليوم والبندقيّة لا تفارق يدك حتى اللحظة التي انتزعها الرجل الأحمر منك في معركة غير متكافئة، مصادراً سلاحك، يأمرك بالانحناء، فيصرخ كبرياء الجرح فيك :
- نحن أبناء قبيلة لا ينحني فيها الرجال .
تجرّ قيدك في مساحة الزنزانة المنفردة ، لتنعم بالعزلة التي تليق بك كما قالوا لك لحظة وقوعك في أيديهم، يلوح لك وجه أبيك في لحظة موته، حين قتله من هم أقلّ منه منزلة ومكانة، لا يغادرك وجهه ولا تغادرك عيناه الشاخصتان أمامك، حينما أتاه الموت مقنّعاً في وجوه الضعفاء الذين استبعد خيانتهم، لم يأته إلا غادراً و خائناً بأيدٍ صافحته غدراً وخيانة، أيد طالما مد لها يده ليأخذها من قبضة الموت إلى الحياة، فرحل دون أن يعلّمك أسرار اللعبة كاملة، ودون أن يترك لك شيئاً من الإرث سوى اسم وبندقية؛ إرث غير قابل للقسمة وغير قابل للتنازل عنه، أيّ موت هذا الذي لا تكاد تصدّقه لرجل كان هو الموت أينما ذهب، هل هي لعبة أخرى أراد تعليمك إياها في هذه السّن الصغيرة؟!
ما زلت تذكره سائراً مع زوجته التي هي ليست أمّك ، فوجدهم مختبئين في إحدى الطرقات التي اعتاد السير فيها ممسكين بنادقهم، سألهم إلى أين أنتم ذاهبون وما الذي تبحثون عنه ؟ فردوا بأنّهم يبحثون عن جمل، ولم يعثروا عليه. قال لهم من تبحثون عنه أمامكم ـ كما روت زوجته التي كانت تقف خلفه ـ كان الموت حاضراً أمام عينيه، مرافقاً له، ولم تكن سوى خطوات سارها متقدّماً إيّاها، مستقبلاً موته بشجاعة رجل لا يهاب الموت، حتّى اخترق الرصاص جسده الهزيل ، سقط صريعاً على الأرض والبندقيّة في يده والدماء تسيل من صدره، تركض زوجته إليه بعد أن هرب الخونة كما كان يصرخ ” الخونة يهربون ” ، تسند رأسه على حجرها، تستنطقه الشهادة ، ” قُتل ولد جريدة غدراً وخيانة “ولا يدفن جثمانه الثرى إلا وقد قُتل قاتلوه فلموته ثمن غالٍ سيتّم دفعه.
تسير، تقتفي الأثر لدماء الشهيد التي سالت في أرض عين السواد، والتي كانت له في كل يوم معبراً وحياة، متأبّطاً بندقيّته التي ما فارقته حتّى لحظة الموت، تثأر لطفولتك اليتيمة، لأبيك، لجدّك، للفقد في قلبك الذي شاب قبل أوانه، للتاريخ الذي لا يعرف سوى أبطال الزيف وأبطال الخيانات، للاسم الذي مازال باقياً رغم الموت ورغم الغياب، تثأر لكلّ من تركك وحيداً بأرض المعركة الأخيرة ، لمن سافر ليلاً ولم يعدْ مسلّماً إياك للخيانة، وللجبل الذي يعرفك كما لم يعرف غيرك، للدروب السرّية التي كنت تسلكها، للبيت الكبير الذي لم يبق منه سوى آثار طفل وطفلة يسلقون حبّات الفاصوليا الخضراء على نار هادئة، للنسوة اللواتي خرجن فارغات حتّى من البكاء أمام الفاجعة، تثأر للشتات ولرفيقة طفولتك؛ البندقية التي لا تعلم بأي يد هي الآن ، يقدم لك السجّان خبزه الجاف مصادراً منك لحظة الحلم، لم تكن قطعة الخبز التي قدمها لك تشبه الرغيف الذي كانت تعدّه لك خديجة كل صباح وأنت راجع من المسجد، في البيت العود بعين السواد، كم أنت مشتاق لفنجان قهوتها ولتمر الصباح ،ولابتسامتها ولوجهها الجبلي بملامح الحزن الجميلة فيه، تشتاق لرائحة الخبز من يدها، تؤلمك عاطفتك وأنت الذي اعتدت كل أنواع الألم عدا ألم العاطفة، تتأمّل صحنك بما فيه من عدس، إنه طعام السجين وعليك أن ترضى به صاغراً وتأكله بطعم المرارة التي ما فارقتك منذ وطئت قدماك هذه الأرض التي يفصلك فيها عن الدنيا زمان ومكان أنت لا تدركهما، فلا مجال هنا للرفض أو المقاومة، تتناوله لأنك منذ البارحة لم تأكل شيئاً ولأنك جائع جداً وموجوع الكرامة ؛ فهنا عرفت معنى أن تجوع وأن تعرى، وأن تبرد وأن تتألم وأن تُهان وأن تموت وتحيا دون أن يعلم أحد عنك شيئاً، تمسح بقطعة الخبز الأخيرة على صحنك الفارغ وتحمد الله كثيراً.
يتراءى لك وجه أبيك وكهف الجبل الذي كنت تختبئ فيه حينما كان القصف على أشدّه، والنار تحيط بك من كل صوب، تمر الرصاصات تحت قدميك، تحطمت آنية الطبخ الوحيدة التي كانت لديك ، ترسل عينيك الصغيرتين لمشهد البيت العود قبل سقوطه، لترى أنه لم يبق فيه سوى الطابق السفلي الذي كان يستخدم مخزناً للحبوب والمؤونة ليبقى شاهداً على ما حدث في ذلك اليوم، تقف وقفة العاجز عن الحركة وعن فعل أي شيء سوى الرغبة في الموت واللحاق به بعد أن فرغت يدك من الحياة التي كنت ممسكاً بها، خذلتك البندقية هذه المرة أو ربّما أنت الذي خذلتها، تبحث عن خديجة التي لم تعد تعرف عنها شيئاً، تبحث عن زوجات أبيك وأخواتك ، لتعلم أنّهن يسكنّ العراء، ويلتحفن السماء، وأنّ عليك السفر مختبئاً في مركب صغير باسم هو ليس لك.
ترى لو كان موجوداً هناك هل ستكون أنت هنا ؟! تتذكّر لحم الغزال الذي كان يُطعمك إياه كلّما عاد من إحدى رحلاته التي لا تعرف عنها شيئاً، يناولك شيئاً من غنائمه، والتي لم تكن سوى بندقية جديدة، تتذكّر الليلة التي تلقيت فيها الصفعة الأولى منه في وجبة العشاء حينما طال بك الوقت وأنت تحاول مضغ قطعة اللحم المجففة التي لم تنضج تماماً كما تهيّأ لك؛ فلم تنتبه إلا والصفعة قد أطارت قطعة الّلحم من فمك لترتد في الجدار المقابل، تصفها وأنت تتحدث عنها ” خرجت من فمي كرصاصة تعوي ” سقطت إحدى أسنانك الأمامية معها ومن يومها تعلمت كيف يأكل الرجال كما قال لك، تحتضن الأرض الباردة وتدعوها لتأتي إليك، تدخل دون أن يراها الحارس المكلّف بحراستك، تدفن رأسك في صدرها، تمسح أثار الدماء النازفة من جرح برسغيك، تفعل ما لم تكن تستطيع فعله في وجوده، ما زلت قادراً على سماع صوته :
– أريده رجلاً..
تبتعد وأنت تجر قيدك الثقيل على الأرض الباردة ، تحرص أن لا تُحدِث صوتاً حتى لا توقظ حارسك الأمين تهمس لها
-لقد قالها لا يتربى الرجال في أحضان النساء .. فاتركيني أربي رجولتي كما شاء لي .
تكبر الرجولة في داخلك كثيراً، لتكون أطول قامة من الألم الذي استفحل في جسدك رغم عجزه من الوصول إلى روحك، لم يمت، ولن يموت ما دمت موجوداً، تأخذك إلى حيث هو كان للموت يسير، تقتفي أثر خطوته لأعلى الجبل، حيث ما زالت أثار أقدامك وأقدام العابرين هناك ورائحة دمائهم التي ما زالت تزكم أنفك حتى اليوم .
لم تفكّر في الاضراب عن الطعام حينما همس حارسك في أذنك ( الاضراب لن ينفعك بشيء، هنا لا أحد يعلم عنك شيئاً، هنا الداخل مفقود والخارج مولود )، أدركت بذلك أنك لن تحقق شيئاً سوى أن تعذب نفسك وتستسلم ليأسك. فالإضراب عن الطعام في مثل هذا المكان الذي لا تعرف موقعه من أرض الله الواسعة سوى من هدير أمواج البحر وأصوات النوارس، لن يغيّر شيئاً ، فلن تكون سوى وجبة هزيلة لحيتان البحر، ورفض الطعام ليس بطولة من البطولات التي كان قد درّبك عليها يوماً، ولست سوى حبيس زنزانة تذرع مساحتها ذهاباً وإياباً لمسافة لا تتجاوز العشرة أقدام ،لتتأكد من أن قدميك ما زالتا قادرتين على تأدية دورهما الطبيعي، فهل من الممكن أن تكون الزنزانة صديقة تمنحك المساحة الكافية للحياة التي تناسب مقاسك، ولأن تأكل فيها وتشرب وتقضي حاجتك ولتطوي قامتك الطويلة بها لتعود إلى وضعك الجنيني في بطن أمّك وتستسلم للحلم الذي يأخذك إلى سجن أكبر وزنزانة أوسع، فيها رفاق، أو إنسان يقاسمك هواء الزنزانة. آه ما أقسى أن يكون كل ما تحلم به سجناً بمساحة وزنزانة أكبر، لا يهم من يكون فيها معك حتى وإن كان سارقاً أو محتالاً، المهم أن تكون لزنزانتك نافذة ودورة مياه، يكبر الحلم في داخلك لترى الشّمس التي لم تزرك منذ زمن، كم أنت مشتاق للشمس ومنظر غروبها وشروقها، يلّوح لك بيده التي طالما مدها لك لتسير معه، يفتح لك باب الزنزانة، يناولك البندقية، تحتضنها كحبيبة كانت غائبة عنك، تسير خلفه ..تسأله هذه المرة وأنت الذي لم تسأله من قبل، إلى أين يا أبي، إلى أين..؟
طرق عنيف ومرعب كطلقات رصاصة يدوي في رأسك وصوت سجّانك الذي تعرفه أكثر مّما تعرف صوتك ..
– قم لصلاة الفجر.
يداك على القضبان الباردة، يصدر القيد صوتاً على أرض الزنزانة، تختلط أصوات كثيرة متشابهة بالقرب منك دون أن تعرف أصحابها، تستأنس بأصوات القيود في أقدام لا تعلم عن جراحها شيئاً، يتركك لصلاتك، لعزلتك، لذاكرتك التي لا تملك سواها في هذا المكان الموحش، وقبل أن يمضي تخبره أن أربعة عشر عاماً مضت والبندقية ليست في يدك ..
_____________________________
(1) ولد جريّدة .. شخصية حقيقة وليس اسطورة كما يعتقد البعض واسمه على بن حمد بن عامر التوبي، وكما يقال أنه ولد سنة 1880م على وجه التقريب، اشتهر هذا الرجل في زمانه بالشجاعة والجرأة والإقدام وله العديد من المواقف والحكايات التي تشهد له بذلك حتى أصبح مثلاً بين القبائل في الشجاعة، في تلك الحقبة التي عاشها، وكانت تستعين به بعض القبائل في تلك الفترة في حل نزاعاتها وحروبها.
لا أحد يعرف تماماً لماذا لقّب بولد أو ود جريّدة، فجريّدة ليست أمه، فأمه أسمها حميدة بنت محمد التوبية ، ويقال إن جريّدة نسبة للخنجر الذي كان لا يفارقه وكان يسميها جريّدة، لم يعش ولد جريّدة طويلاً حيث قتل غدراً وهو سائر في الطريق بين بلدة إمطي وقاروت في ولاية إزكي ولم يكن معه سوى زوجته، وذلك سنة 1910م تقريباً، لكن ذكراه لم تمت حتى اليوم وما زال ذكره حاضراً في ذاكرة الكثيرين ممن سمعوا عن شجاعته.