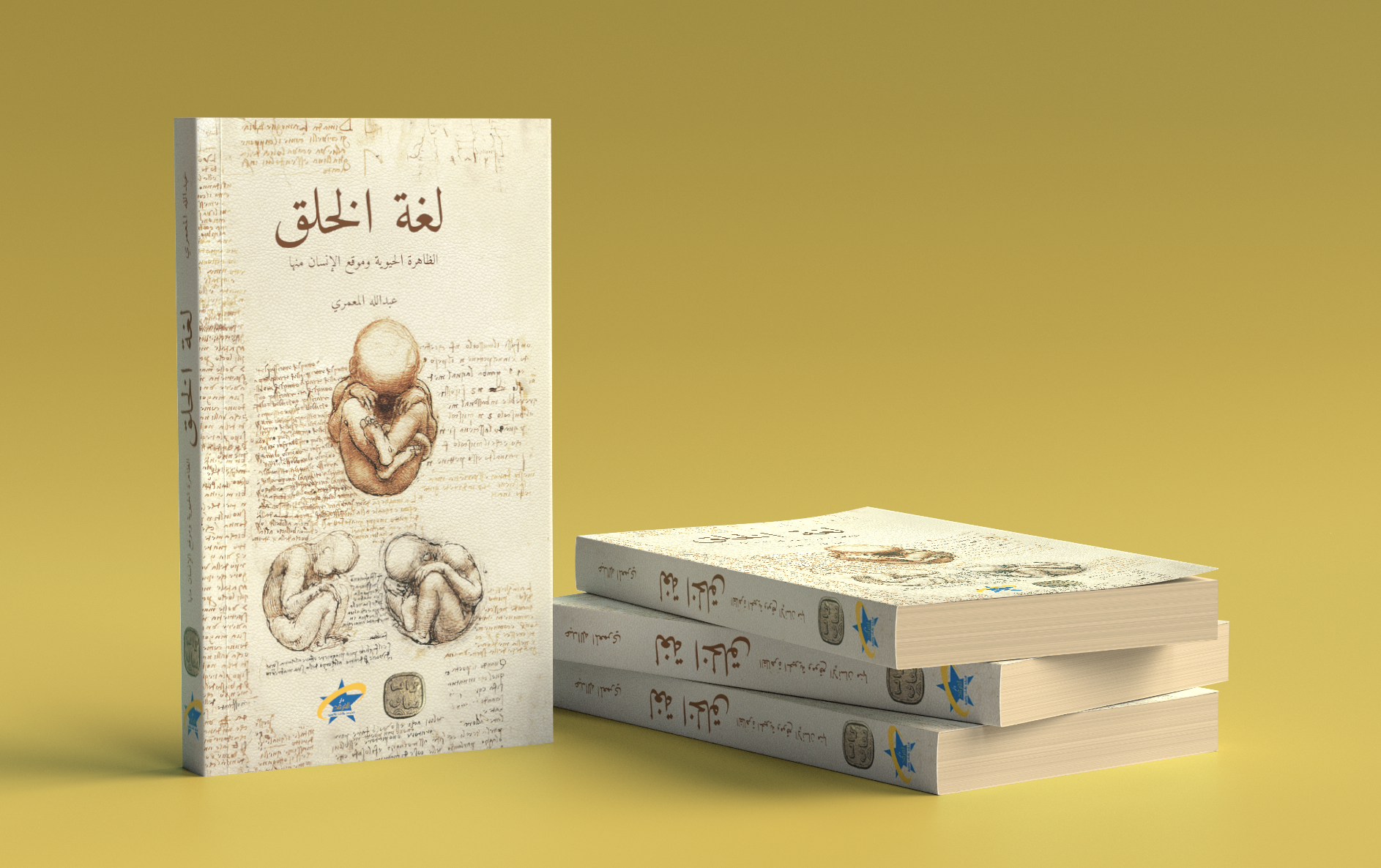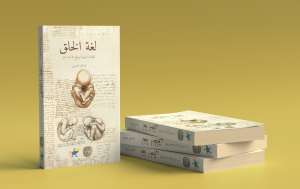الظاهرة الحيوية وموقع الإنسان منها
صدر حديثا للكتاب عبدالله المعمري عن دار الفرقد للنشر والتوزيع بدعم من وزارة التراث والثقافية العمانية كتاب يحاول فيه تقديم الفهم المعاصر لمعنى الإنسان من خلال استعراض علاقاته بالكائنات الحية وذلك من خلال تركيبته البنوية وتاريخ هذه البنية، ننشر هنا مقدمة هذا الكتاب.
المقدمة
(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) العنكبوت-٢٠
هذا كتابٌ استوجبه الاستتباع المنطقي، لم يكن في نيتي أن أكتبه، كانت الخطة أن يكون كتابًا عن اللغة البشرية؛ ما هي؟ وكيف ظهرت؟ وكيف تعمل؟ ولماذا تضج الأرض بألسنة كثيرة؟ ولماذا يكون في اللسان الواحد لهجات عدة؟ وما سبب اللبس وتعدد المعاني؟ وهل تتواصل الحيوانات باللغة مثلنا؟ إلى سائر ما يدخل في ذلك من أسئلة ومباحث، لكن الحديث عن اللغة يعني الحديث عن الإنسان، فهو آلة إنتاجها وتداولها، وهو المنفعل بها والمتفاعل معها.
كلُّ حديث عن مفهوم اللغة سيبدو مُنبتّا من الجذور ما لم يتصل بإطاره الأكبر الذي هو الإنسان؛ لنتخيل عقلًا عاريًا من أي معرفة تتعلق بنمو الأشجار وتكاثرها، ثم قدمنا إليه تفاحة، وطلبنا منه أن يشرح لنا سبب وجود هذه الحبوب الصغيرة القاسية في قلبها، من الواضح أن الجهل بنظام تكاثر الأشجار -الذي تشكل البذور جزءًا منه- سيجعل قدرته على الإجابة معدومة. ناهيك عن أسئلة أخرى مثل: لماذا هي حلوة المذاق؟ ولماذا هي حمراء؟ إلى آخر الأسئلة التي لا تجد تفسيرها إلا في الشجرة أو ربما في الغابة.
هكذا هي اللغة مع ضرورة استبطان الفرق بين الأمرين، إنها الجزء الذي يتعذر فهمه دون فهم النظام الذي يحيط به ويعمل داخله، ومن هنا كان هذا الكتاب الذي يحاول وضع إطار عام لتعريف الإنسان، ينطلق منه كل من يريد أن يدرس الظواهر البشرية. هذا الكتاب يحاول باختصار رسم صورة الشجرة، من أجل أن تبدو البذور واضحة ومفهومة.
الحاجة ماسة إلى أن نتفق -نحن المتحدثين بالضاد- على حد أدنى من التعريف المشترك لكلمة إنسان، اتفاقًا لا يلغي الاختلاف، لكن يوفر الأرض الصلبة التي تسمح بالانطلاق المشترك إلى فهم أعمق. من الضروري جدًا أن لا يكون تعريف الإنسان أمرًا ثانويًا، أو منطقة مُغْفلةً في أحراش الفكر، نستدل عليها من سياق ما يكتبه هذا المفكر أو ذاك. هذه الضرورة تتعاظم بل وتصبح جوهرية عندما يكون موضوع الدرس والنقاش مرتبطًا بحياة الناس ومعاشهم؛ لا يمكن لفقيه أن يفكر ويجتهد دون أن يكون تعريف الإنسان واضحًا لديه، لا يمكن لتربويّ أن يضع المنهج الناجح دون أن يعرف الإنسان على الحقيقة، لا يمكن لاقتصادي أن يفهم السوق دون فهم عصبه ومحركه الأول، لا يمكن لعالم سياسة أو اجتماع أو نفس أو لغة أن يقارب الظواهر التي يعتني بها دون فهمٍ عميقٍ للإنسان ومعناه، ولا يمكن أن يلتقي هؤلاء على خدمة المجتمع وبنائه دون فهمٍ مشترك.
وبسبب هذه الخطورة الجسيمة يجب أن يكون تعريف الإنسان موضع نقاش دائم، وبحث مستمر، واتفاق عام، وقابلية للتوظيف العملي، حتى تتمكن المؤسسات التعليمة والحكومات من وضع سياساتها وخططها الاستراتيجية تبعًا لهذا الفهم المشترك.
والفهم المشترك -بطبيعة الحال- يتطلب منهجا مشتركًا يحتكم إليه الجميع؛ إن تعريف الإنسان -كما هو الحال في كل ثقافة- يتسلل إلينا من الماضي، ويكون متخفيًّا في المنطقة التي لا ينتبه إليها حتى المفكر المتحرز. وليس ثمة عيب في الماضي ومعارفه ما دام استدماجها يتم تحت سمع المفكر وبصره، موازنًا بين هذا الأمر أو ذاك، لكن هذا السمع والبصر، والتيقظ والحذر، لا يصلحان بدون منهج عدل، وميزان قسط، يفصل في الحقائق، ويكشف السمين من الغث، ويتنصّل من الاتكاء على وجاهة الموروث، والتعصب لرأي الطائفة والجماعة.
هذا المنهج الذي يتسم بالقابلية للاحتكام الجمعي بسبب موضوعيته الفائقة هو المنهج الذي توخيت الاغتراف من نتائجه -المستقاة من التفكر في خلق السماوات، والسير في الأرض، وتأمل أكثر الكائنات صَغَارًا وهامشية- حتى استقام تصورٌ عام عن الإنسان، أحسب أنه التصور الأكثر حداثة ووثاقة في عصرنا.
في هذا الكتاب ستتكشف لك مقدمات صنع الإنسان؛ كيف بدأ الخلق؟ ومتى؟ وكم استغرق من الوقت؟ وما الظروف التي مر بها؟ وما قوانينه ومبادؤه؟ سيحكي لك الكتاب عن خلق الكون الذي نعرفه، وعن الأرض والكائنات التي عاشت وعاثت فيها، وغيَّرتها وتغيَّرت بها، وعن العلاقات الخفيّة بين الأحياء والأحياء من جهة، والأحياء والأموات من جهة أخرى. كل ذلك بُغية رسم صورة عامة نفهم الإنسان من خلالها. أما الأسلوب الذي اخترته فهو عبر عقد المقارنات، بين الإنسان وغير الإنسان من مخلوقات الكون المثيرة، وتحديدًا تلك التي تتمتع بخاصية الحياة: الحيوانات والنباتات وسائر ما يولد وينسل ويموت؛ إذ لا فائدة كبيرة ترجى من مقارنته بالحجارة والمعادن والنجوم، فهي مجرد كينونات جامدة، وإن سبحت في أعماقها الإلكترونات، وتحوّلت في أحشائها الذرات. في هذه المقارنات يعمد الكتاب إلى تشريح الأجساد إلى العمق الذي تنعدم فيه الحياة وتصبح العلاقة بين الكائن الحي والجماد ملتبسة، ثم يعود فيبني خصائص الحياة على نحو هرمي يتضح فيه موقع كل كائن من الظاهرة الحيوية، ثم يقدم تاريخ الأحياء في الأرض، ثم يربط كل هذه التفاصيل ببعضها في تفسير جامع.
في نهاية الكتاب ستصبح ظاهرة الحياة جليّة المعالم، وستغدو جميع تلك الأسئلة التي قد تطرأ في الذهن حول العلاقة الوجودية بين الإنسان والحيوان ممكنة الإجابة، مهما بدت أوليّة وساذجة، مثل تلك الأسئلة التي تطرحها علاقة التشابه: لماذا يمتلك الحيوان عينين ولسانا وشفتين مثلنا؟ ولماذا يتنفس ويأكل ويشرب وينام مثلنا؟ لماذا يوجد منه الذكر والأنثى وينجب الصغار مثلنا؟ لماذا يموت ويتحلل إلى تراب مثلنا؟ والأسئلة التي تطرحها علاقة الاختلاف: لماذا يختلف عنا بالريش والوبر والصوف والحراشف والمناقير والمخالب والخياشيم؟ لماذا يمشي أغلبه على أربع أو ست ونحن على اثنتين؟ وأسئلة تطرحها العلاقة التفاعلية بيننا: لماذا نستطيع التهامه ويستطيع التهامنا؟ لماذا تمتلك بعض أنواعه البالغةُ الضآلة القدرةَ على إلحاق الضرر بأجسادنا؟ وأسئلة يطرحها وجودنا المشترك: ما الذي يقدمه الموت للحياة على الأرض؟ هل نستطيع العيش في عالم ليس به حيوانات وأشجار؟ وما الضرر الذي يلحق الأرض من انقراض الفيلة في إفريقيا؟ والأفاعي في البرازيل؟ والوعول في عُمان؟ ومن أين تأتي الطاقة التي تحرك الأجساد؟ وكيف تُستهلك؟ ولماذا لا تنفد مع كثرة ما يزحف وما يدب وما يطير؟
إن كتابًا صغيرًا يدّعي إجابة جميع هذه الأسئلة يثير الشك، لكن إن لم تجد الإجابات المباشرة فيه فمن المؤكد أنه سيوفر لك المبادئ العامة التي توصلك إلى الإجابة، وتمنحك نظرة جديدة إلى العالم من حولك، أجملُ ما فيها أنها تجعل كل هذه الفوضى الظاهرية بناءً في غاية الاتساق.
يقع الكتاب في قسمين من ستة فصول، سأحدثك في الفصل الأول عن الكيفية التي نظر بها القدماء إلى الحيوانات والنباتات؛ عن الحيوان عندما كان إلهًا خالقًا، أو صنوًا للإنسان، أو أبًا وجدًا للقبائل والشعوب، أو مصدرًا للحكمة والموعظة الحسنة. وعن ذلك الميل الذي يشد النفوس قديمًا وحديثًا اتجاه الحيوان باعتباره شبيهًا ونظيرًا.
فعلت ذلك من خلال تقديم ثلاثة مفاهيم، بُغيةَ رسمِ إطار للتفكير، وامتلاكِ القدرة على تصنيف بعض المواقف البشرية اتجاه الحيوان والنبات، وتحديدِ المناطق التي يجب أن نتوجه إليها بالبحث والدراسة. من كل ذلك يعنينا مفهوم مهم يحتدم حوله نقاش ساخن بين علماء الحيوان منذ منتصف القرن العشرين وما يزال حتى يومنا هذا، وهو يتعلق بقضايا الوعي والسلوك وامتلاك اللغة، هذا المفهوم هو الأنسنة (Anthropomorphism)؛ حيث يتحول الحيوان أو النبات بفعل المماثلة وإسقاط الذات إلى إنسان سميع بصير.
ليس في نية الكتاب حسم الإشكال الأنسني بل تقديم النظام المفهومي الأصح الذي يجب أن يُعَالجَ داخله هذا الإشكال، لتكونَ بعد ذلك على درايةٍ بما تستفيض فيه المؤسسات الأكاديمية من بحث ونقاش حوله، وبالعموم يمكنك النظر إلى الفصل الأول باعتباره مُنَاسَبَةً لتفحّص موقفك الخاص من الحيوان وأسباب تشابهه معك واختلافه عنك، وكيف أن أفكارك الحالية حول الحيوانات من حولك قد يكون مصدرها هذه الأنسنة التي يُفضي اتباعها إلى متاهات فسيحة وتفلت ومطاطية في المقاربات.
سينتهي الفصل الأول بضرورة تكوين نظام مفهومي نعرف فيه وبه الإنسان، لكن هذا الإطار يجب أن يستند على منهج مشترك لإنتاج الحقائق، وهو ما سيعمل الفصل الثاني على مناقشته، وفيه سأقدّم المنهج والأداة التي يتوجب استعمالها لفهم العالم من حولنا على نحو موضوعي، المنهج الذي لا يعبأ صاحبه وافق الآباء والأجداد أو خالفهم، أنسن أو لم يؤنسن؛ فهو يزن الحقائق بالقسط، ولا يقبل منها إلا ما استقر وثبت أمام مطارق النقد والنقض. وبذلك ينتهي القسم الأول الذي يمثل مقدمة ضرورية لما سأورده في القسم الثاني من الكتاب.
يتكون القسم الثاني من أربعة فصول، اعتنيت فيها بالتشابه والاختلاف بين الإنسان والحيوان في تدرّج يستقصي التفاصيل، ويُعيد ترتيب مفاهيم الماضي بحيث تتغير الأسئلة فضلًا عن الإجابات، وبالعموم عالجت في هذ القسم أربعة قضايا هي:
١- مادة الإنسان وتركيبها ونظامها (الفصل الثالث: التركيب): وفيه شرّحتُ الجسدَ البشري، ناثرًا جلده وعظمه وعضله وعصبه وأوردته وشراينه على طاولة البحث، التي جمعت فيها أفراد الحيوانات وأسرابها وقطعانها في محاولة لدفع التشابه والاختلاف بين الإنسان والحيوان إلى نهاياته القصوى. سيبيّن لنا هذا الفصل على نحو دقيق من أي شيء يتكوّن الإنسان في مقارنة مباشرة مع الحيوان، وهل الحياة ظاهرة واحدة متجانسة أم ظواهرَ متوازية لا تلتقي؟
٢- موقع الإنسان الدقيق في الظاهرة الحيوية (الفصل الرابع: التصنيف): جمعت في هذا الفصل الكائنات الحية قاطبةً في تصنيف خلّاب، يضع كل جماعةٍ منها في موقع محدد مدروس، تظهر فيه المسافة التي يقفها كل كائن حيّ من الإنسان، وكيف يتقاطع معه ويختلف عنه. هنا ستتوفر رؤية كلية كتلك التي تتوفر لسائح ينظر إلى خارطة مدينة.
٣- موقع الإنسان في تاريخ الظاهرة الحيوية (الفصل الخامس: التاريخ): حيث سأسرد -على نحو تقريبيّ- مختصر نشأة الكون وميلاد الأرض ودبيب الحياة عليها، وهل تزامن خلق الإنسان مع خلقها؟ وهل ظهرت الحيوانات والنباتات دفعة واحدة أم في دفعات؟ هنا سيتوفر للسائح السالف الذكر خطٌ زمني للأحداث أو خارطة لكل زمن من أزمنة المدينة.
٤- خلق الإنسان (الفصل السادس: التخلق): حيث سأضع القضايا الثلاث السابقة (التركيب والتصنيف والتاريخ) في تفسير جامع نفهم منه كيف ظهر الإنسان؟ وما هي علاقته الدقيقة بسائر الحيوانات؟ وعندها ستبدو تفاصيل عملية الخلق واضحة جليّة المعالم.
لقد تدرّجت في هذه الفصول وبالغت في التدرّج، بُغيةَ أن تصل الفكرة إلى من طلبها دون عناء كبير، ودون الحاجة إلى قراءات سابقة، أو طولِ مراس في العلم وحقائقه؛ إنْ تتبعتَ الأفكارَ المتسلسلة، وأمعنت في النظر، وربطت الفصول ببعضها، سيتكون لديك فهم حديث جدًا لماهية الظاهرة الحيوية وموقع الإنسان منها.
كما تجنبت الإحالات في هذه الفصول الأربعة الأخيرة لأن ما ذكرته هو من المستقر المعروف، وكانت أغلب المراجع هي الكتب الأكاديمية التي تدرس لطلبة الجامعات في سِنيّهم الأولى، فضلًا عن أن وضعها سيجعل النص مكتظًا بالإحالات، لكني أوردت هذه الكتب في قائمة المراجع لمن أحب العودة إليها، كما تجنبت حشو النص بالمصطلحات الأجنبية، واجتهدت في تعريبها، طلبًا للتدفق والسلاسة، وأخيرًا فقد قايضت الدقة بالوضوح طمعا في إيصال المفاهيم الرئيسية التي قد تشوشها أحراش التفاصيل.
الفهم الذي يقدمه هذه الكتاب عن الإنسان يوفر الإطار المفهومي العام لكل الدراسات الحديثة التي تُعنى بالإنسان، سواء تلك المتعلقة بالتاريخ أو الاجتماع أو علم النفس أو الاقتصاد أو السياسة، وهو بالفعل يشكل حاليًا نقطة انطلاق في الجامعات الرائدة في العلوم الإنسانية في أقطاب الأرض، وهو الفهم الذي أتمنى أن يتبناه في بلداننا المشتغلون على خير الإنسان ورفاهته.
وأخيرًا لم يكن لهذا الكتاب أن يبصر النور لولا الرعاية الكريمة التي أحاطتني بها وزارة التراث والثقافة العُمانية، لقد منحتني كل ما أحتاج من أجل تحبير سطوره: الوقت والمراجع والتفقد الدائم لأحوالي ومراجعة المسودات والسهر على خروج الكتاب مطبوعًا في أبهى حلّة إلى الناس.
وقد أحسنت إليّ الأيام إذ قربتني من جماعة من النابهين، دفعت إليهم مسودة الكتاب، فطالعوه عن طيب خاطر، وأمطروني بالملاحظات الدقيقة التي بفضلها أصلحت العيوب، وأزلت المثالب، هم دون ترتيب: الروائي الطبيب حسين العبري، والمفكر الإسلامي خميس العدوي، والمتخصص في علم الجينات حمد الغيثي، فما كان من خير فبفضلهم، وما كان من سوء فبما كسبت يداي. وقد أبدع المهندس عبدالملك المسكري أيّما إبداع في تحويل بعض أفكار الكتاب إلى أجمل الرسومات.
وكان فضل ورد وأمها خلال هذا العمل فضلٌ أَكِلُّ عن وصفه، فلطالما تظاهرتا بالتشاغل عني من أجل أن أتفرغ للعمل. وحدهما من يجعل جبال الحِجْر الصلدة جنةً وارفة.