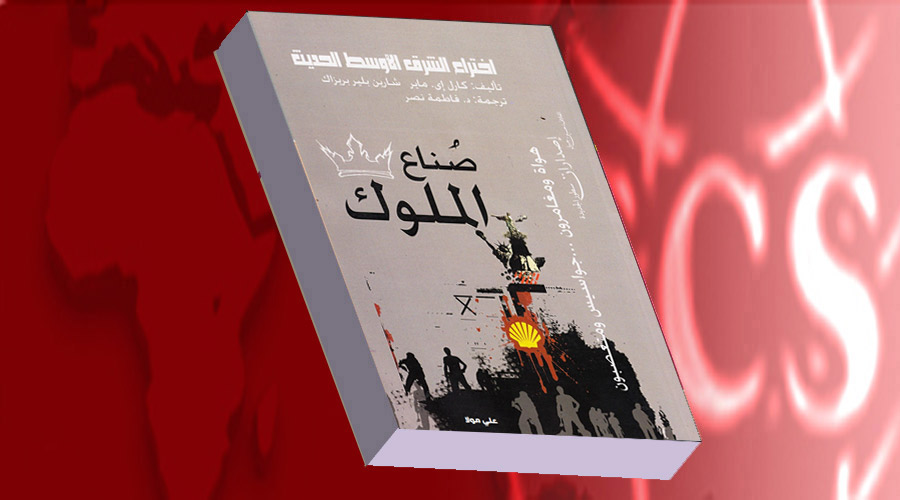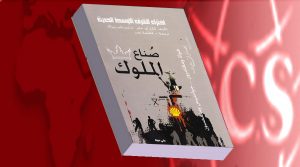(الجزء الثَّالث).
لقراءة الجزء الأوَّل، اضغط هنا.
ولقراءة الجزء الثَّاني، اضغط هنا.
عندما كان وزير المستعمرات البريطاني، تشرشل، في القاهرة عام 1921 يترأس بصورة فنية ومباشرة لجان حكومته المتخصصة بوضع اللمسات النهائية في عملية تشكيل منطقة المشرق العربي، ورسم خطوط على سطح المنطقة بهدف تفريقها وتشتيتها عن بعضها، تهيئة لمرحلة فرض سيادة غربية عليها بعد تثبيت حدود يفترض بها البقاء طالما تلبي حاجات الإمبريالية الغربية، فإذا انقضت هذه الحاجات، كما هو حال اليوم، يصبح الحديث ممكنا لإعادة التشكيل ورسم المنطقة من جديد. في تلك الأثناء كان تشرشل مصممًا على تعيين فيصل بن حسين ملكا على عرش العراق. غير أن مشكلة أخرى برزت أمامه في تلك الأثناء، وتحديدًا عندما أتى الحديث حول مستقبل الأخ الأكبر لفيصل، الأمير عبدالله، وصفته السياسية، خصوصا وأنه كان يتوقع أن يتولى هو حكم العراق وليس شقيقه. أما الآن وقد ذهبت بلاد الرافدين إلى فيصل، والفرنسيون اخذوا سوريا، والبريطانيون لن يفرطوا بفلسطين إرضاء للأمير عبد الله، ولم يتبق شيء يمكن منحه لهذا الأمير الغاضب إلا من خلال عملية اجتزاء أو اقتطاع مساحة ما من أحد الكيانات التي تشكلت حديثا، وهذه مسألة وفقا لوجهة نظر وزير المستعمرات تستحق بعض العناء، فالرجل – الأمير عبد الله – أثبت على نحو لا التباس فيه مدى إخلاصه وتفانيه في خدمة التاج البريطاني، وكانت له إسهامات في الثورة على الدولة التركية، مع أن التقييم البريطاني لهذا الدور وفي أكثر من مرة لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه في النهاية حقق عددا من النتائج الإيجابية التي يستحق لأجلها أن ينال مكافأته.
جال تشرشل بشكل خاطف على خريطة المنطقة، ووجد حلا يرضي كافة الأطراف، نوعا ما، وأشار بعصاه إلى منطقة شرق الأردن التي كانت وفقا للتقسيمات الإمبريالية تابعة للمندوب السامي في فلسطين، وأعلن هذه المنطقة كيانا سياسيا وعين عليه الأمير عبدالله، الذي أصبح منذ هذه اللحظة، وبدعم مالي بريطاني، حاكما على شرق الأردن التي أصبحت إمارة ومن ثم مملكة. وكان الأمير عبدالله، وفقا لأحد اشتراطات استمراريته في الحكم، ملزما بوجود طبقة من المستشارين والموظفين والعسكريين البريطانيين حوله. وفي فترة لاحقة من تاريخ تسميته أميرًا على البلاد التحق به ضابط بريطاني، إيرلندي الأصل، جاء إلى المنطقة العربية ضمن من جاء من البريطانيين المستكشفين لأحوالها وطرق عيش سكانها، وأسس أول أجهزة الاستخبارات فيها.
لم يكن هذا الضابط سوى السير جون بايجوت جلوب، عرفه البدو بـ “أبو حنيك”، لإصابته بشظية في حنكه أثناء الحرب الأولى، أصدقاؤه يسمونه جاك، أما الاسم الذي عرف من خلاله على نطاق واسع فهو “جلوب باشا”. إنه نموذج للجندي المحترف الذي أولع بالبدو الرحل، وهم بدورهم كانوا صادقين إلى أقصى درجات الصدق في ولائهم ومحبتهم له. يمكن القول وبدون أدنى مبالغة، إنه كان أسطورة متجذرة في قلوب البدو. أسس وقاد ما كان يعرف بـ “الفيلق العربي”، الذي كان العمود الفقري لجيش الأردن لمدة تزيد عن ربع قرن.
تطوع عام 1920 للخدمة في بلاد الرافدين”العراق”، وكان المبدأ العسكري الذي أقره الإستراتيجيون البريطانيون في تلك الفترة يتلخص بفكرة فرض الأمن من خلال الجو، وكانت هذه أول تجربة في التحكم وبث الرعب في قلوب السكان وأفراد المقاومة دونما احتلال مباشر. وساهم جلوب بدور مهم في تحديد المواقع والقبائل التي ينبغي أن توجه لها الضربات الجوية.
وعندما عين في عام 1928 مفتشا إداريا للصحراء الجنوبية، كان يراقب المذابح التي يمارسها أنصار الحركة الوهابية، الذين باتوا معروفين باسم “الإخوان”، وشاهد عيانا نتائج حملات الغزو والتطهير التي نفذها هؤلاء في سبيل تمكين ابن سعود من بسط حكمه على أنحاء واسعة من أرض الجزيرة العربية، التي عرفت لاحقا باسم “المملكة العربية السعودية”. قرابة نصف مليون إنسان، ذهبوا ضحية هذه الحملات الدموية، وكان السبب في ارتفاع أعداد الضحايا، أن “الإخوان” لم يكونوا يحتفظون بأسرى، وكل ما كانوا يفعلونه ببساطة هو قتل المهزومين. شاهد جلوب قبائل حجازية كبرى مثل شُمّر وهي تفر مذعورة باتجاه العراق. وفي الفترة ذاتها أخذ جيش الوهابية بالتقدم نحو عمّان، ولم ينقذ عاصمة شرقي الأردن من مذبحة مؤكدة سوى عربات مصفحة تابعة لبريطانيا، ونتيجة لبروز هذا الخطر جرى تكليف جلوب للالتحاق بفيلق الأردن، برتبة فريق/ جنرال، كانت مهمته الأساسية الحفاظ على أمن الحدود بالدرجة الأولى كان ذلك عام 1930.
وعلى سبيل المكافأة لولائها ونصرتها لبريطانيا أثناء الحرب الثانية، منحت الأردن استقلالها الرسمي عام 1946. ومع سروره وفرحه لحصول بلاده على الاستقلال، إلا أن هذا الإعلان بعثر بصورة عملية ما بقي من ظلال خيال في نفس الملك عبدالله بأن يغدو ملكا على سورية العظمى الموحدة. فيض من التلميحات وأحيانا التصريحات البريطانية المباشرة لملك الأردن بأن يبعد هذه الفكرة عن ذهنه، وأن يقلع عن حلمه التوسعي بالمنطقة، لأنه ببساطة حلم غير قابل للتحقيق. لم يكن الأمر يقتصر على عدم قابلية تحقيق حلم الملك الهاشمي، وإنما كان البديل الذي صرح به تشرشل أكثر من مرة، باعتباره يفضل ابن سعود لزعامة كيان عربي موحد يضم الجزيرة العربية والهلال الخصيب، كانت هذه الصيغة بمثابة كابوس حقيقي بالنسبة لعبد الله، لذا آثر القبول بما قُسم له، مرحليا على الأقل. وبالفعل فقد توّج عبد الله بن الحسين ملكا على “المملكة الأردنية الهاشمية” وإلى جانب الملك وقف جلوب باشا. لم يلاحظ سوى عدد قليل أن السلام الوطني الذي أعد سريعا لحفل التتويج كان يبدو شبيها بالسلام الوطني الإنجليزي.
بديلا عن حكم سورية الكبرى توجه الملك عبدالله بنظره إلى فلسطين، وأخذ يتطلع إلى توسيع حدود مملكته عبر ضم أجزاء من فلسطين المجاورة، ووافق هذا الطموح هوى المنظمة الصهيونية التي كانت تفضل مملكة مجاورة، موسعة وصديقة، خير من وجود كيان فلسطيني معاند. وفي فبراير 1948 زار وفد سياسي من الأردن العاصمة لندن، لتوضيح ترتيبات معاهدة الصداقة البريطانية – الأردنية لمرحلة ما بعد الاستقلال. كان هذا هو العنوان المعلن للزيارة، أما مبررها الخفي فكان بحث مسألة سيطرة “الفيلق العربي” على فلسطين، وحماية المناطق المخصصة لليهود. هذه المسألة اقتصر بحثها في لقاء مغلق ضم رئيس وزراء الأردن – توفيق أبو الهدى- ووزير خارجية بريطانية – إرنست بيفن –، وقائد “الفيلق العربي” جلوب باشا. وبعد فترة وجيزة من هذا الاجتماع، عبَرَ رتل من “الفيلق العربي” الجسر الواصل بين الضفتين، ويحتل الضفة الغربية الفلسطينية. بعدها بثلاثة أشهر أعلنت حكومة إسرائيلية مؤقتة قيام دولة إسرائيل التي احتلت كامل الساحل الفلسطيني، إضافة إلى عمق وصل إلى الجزء الغربي من القدس، فيما استولى الفيلق العربي على الجزء الشرقي منها، إضافة إلى ما تبقى من فلسطين ضمن ما بات يعرف بـ “الضفة الغربية”. وكانت وظيفة ” الفيلق العربي ” الأساسية في تلك المرحلة حفظ الأمن ومنع المقاومين العرب من التسلل إلى عمق الكيان الصهيوني، حديث النشأة.
لم يبق من حلم الملك عبدالله في ضم مزيد من المساحات إلى مملكته الصغيرة سوى الجزء المتبقي من فلسطين، “الضفة الغربية”، وتلاشت بذلك أحلامه بالكامل بأن يغدو ملكا على إقليم المشرق العربي أو حتى على فلسطين وضمها إلى مملكته. ورغم لقاءاته السرية مع اليهود إلا أنهم لم يكونوا يثقون به، وغالبية الزعماء العرب كانوا يبغضونه، وعدد كبير من شعوب المنطقة كانوا يحمّلونه وقائد جيشه، جلوب، جزءا غير قليل من مسؤولية هزيمة عام 1948. كان حظه من الأعداء أكبر بكثير من الأصدقاء، لتنتهي هذه التفاعلات باغتياله في يوليو 1951، نتيجة تخطيط التيار القومي، وأشرف على العملية واحد من أبرز قادة الفيلق العربي السابقين، والحاكم العسكري للقدس، ومن الذين استبسلوا في قتالهم لليهود على أسوار المدية المقدسة، واسمه عبدالله التل، الذي لجأ وبعض المشتركين معه في عملية الاغتيال إلى مصر، فيما أعدم الباقون.
بعد سنوات قليلة من مقتل الملك عبدالله، وفي زمن حفيده الملك حسين، توسع جلوب بهيكلة “الفيلق العربي”، ليخرج من رحمه الجيش الأردني، الذي عرف رسميا باسم ” الجيش العربي”. وكان جلوب دائما يفضل ضم أبناء البدو والتحاقهم بالجيش، ولم يكن متحمسا كثيرا لانضمام أبناء المتعلمين، الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم مسيسين ولهم توجهات سياسية تتعارض مع الثوابت العسكرية، كان دائم الخشية أن تتسرب المبادئ القومية داخل صفوف الجيش. وقد وجدت الصحافة العالمية في شخصيته ودوره مادة مغرية للنشر والتناول، وأطلقت عليه بعض العناوين “ملك الأردن غير المتوّج” و”لورانس الحديث”، وقد أثارت هذه المعالجات بلا شك حفيظة الملك حسين آنئذ، الذي كان يعتبر القائد البريطاني إنسانا متعاليا ولا صلة له بالواقع.
ولتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، دعت بريطانيا ملك الأردن للانضمام إلى ما كان يعرف آنذاك بـ”حلف بغداد”، الذي شمل: تركيا، العراق، باكستان، إيران، والأردن. ونتيجة انضمامه للحلف، تعرض الملك حسين إلى حملة شرسة من الدول المحيطة:سوريا، مصر السعودية، واتهم بالخيانة ومعاداة القومية، فلم يكن أمامه ليس فقط الانسحاب من الحلف، بل اتخاذ إجراء يعزز صورته كقائد قومي، لا يقل إحساسه بعروبته عن هؤلاء الذين يوجهون له الاتهامات صبح مساء، فقام وبصورة مفاجئة بطرد جلوب من الخدمة، وكان الأخير آنئذ قد أمضى ثلاثين عاما في خدمة ثلاثة أجيال من الهاشميين، وارتفعت شعبية حسين على المستوى المحلي والعربي على نحو لافت بسبب هذه الخطوة.
كان عمر جلوب عندما رجع إلى بلاده قرابة ستين عاما، الحكومة الأردنية لم تصرف له تقاعد جنرال، ولا حكومته، فلم يجد من سبيل لإعالة نفسه وعائلته سوى إلقاء المحاضرات وتأليف الكتب التي تنوعت بين التاريخ والسيرة الذاتية. توفي عام 1986 وعمره 89 عاما، وحضر الملك حسين جنازته. وإلى اليوم ما زال البدو في الأردن يذكرون جلوب الذي عاش بينهم كأنه واحد منهم، وكان متعاطفا معهم، متآلفا معهم إلى أبعد مدى، فيما يختصره السياسيون هنا بحادثة الطرد.
للشخصية التالية نمط مختلف في الصناعة السياسية، نمط خاص يختلف على نحو جذري مع نمط الحرفة البريطانية في الصناعة والتآمر، وهذه الشخصية ساهمت بدرجة كبيرة في ترسيخ إستراتيجية بنكهة أمريكية في التآمر، وبدلا من صناعة حكام وإمدادهم بالدعم وعناصر الاستقرار والبقاء، وفقا للمدرسة البريطانية، اعتمدت المدرسة الأمريكية أسلوبا مغايرا من خلال زراعة ضباط في الجيوش، وإعدادهم للانقضاض على الحكم في أي لحظة، إنها النسخة الهوليودية في الجاسوسية والتحطم بالآخر.
ومع أن صاحب الشخصية عرف واشتهر باعتباره مؤلف كتب سياسية بطابعها الاستخباري والبوليسي، وفي مقدمتها كتاب كان يعد ضمن كتب الأكثر رواجا في العالم لفترة طويلة، وعنوانه ” لعبة الأمم”، إلا أن مايلز كوبلاند أو”الصبي الساحر” كما كان يطلق عليه، يبقى مضرب المثل في الجاسوسية واحترافه في صناعة الأحداث السياسية بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
لفت كوبلاند الأنظار إليه منذ التحاقه بالحرس الوطني الأمريكي عام 1940، يذكر أنه حصل في امتحان القبول على 160 درجة وفق مقاييس الذكاء، وهي أعلى درجة حصل عليها مرشح للجيش الأمريكي لسنوات طويلة. يقال إن مستوى الذكاء لديه يقارب مستوى أينشتاين وجوته، وكذا عيسى المسيح، وفقا لتكهنات علماء النفس. جرى تعيينه في فرقة استخبارية بالجيش، وأدّى عددا من المهام في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان هنري كيسنجر من المشاركين معه بنفس الفرقة. وفي عام 1945 ألغيت الفرق الاستخبارية العسكرية لتتشكل وحدة تسمى “ssu”، وهي الجنين الذي تطورت منه عام 1947 وكالة الاستخبارات المركزية ” cia”. وكان مايلز من أوائل الذين التحقوا بالجهاز الوليد، وأكثر العملاء بروزا على الإطلاق، وجرى تعيينه في دمشق بصفة ديبلوماسي. وفي الواقع كان أول رئيس عملياتي للمخابرات الأمريكية في سوريا.
بعد قراءة سريعة لواقع السياسة العربية تبنى مايلز تفسيرا مغايرا لما كان سائدا آنذاك حول العلاقة الأمريكية – العربية، مؤداه أن الصراع القائم بين دول عربية والولايات المتحدة غير ضروري، وأن علة هذا الصراع تكمن في القيادات العربية سيئة النية، المضللة لشعوبها، وأن الإطاحة بالقيادات المترهلة قضية ملحة، ولاحقا ستظهر انعكاسات هذا التغيير لصالح الدول العربية وشعوبها أكثر من غيرها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي ممثلا بتقديم ضمانات لأية تسوية تتعلق بالقضية الفلسطينية. ووفقا لهذه الافتراضات والتوصيات السياسية التي أقرتها وكالة المخابرات المركزية، فقد وقع الاختيار على سوريا لتكون حالة اختبار لمقترحات مايلز والإتيان بحكومة عاقلة منطقية.
لم يكن الأمر بالسبة لـ “الصبي الساحر” يتطلب أكثر من قائمة تشمل أسماء المسؤولين السوريين العاجزين عن تسديد ديونهم، التي حصل عليها من أكبر مراب في دمشق. ولم تكد تمضي أربعة أشهر من حصوله على هذه القائمة حتى حدث انقلاب مارس/ 1949 بقيادة حسني الزعيم، (من أصول كردية) الذي شرع لحظة توليه السلطة إلى تبني الخطوات التي طالما حلمت واشنطن بتحقيقها منذ سنوات طويلة: محادثات هدنة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشيوعية، والأهم من ذلك كله المصادقة على مرور خط التابلاين عبر سوريا. ورغم المكاسب الخاطفة التي جنتها أمريكا من هذا الانقلاب، إلا أنها تحملت في السنوات التالية تكلفة باهظة نتيجة انطلاق شهية العسكر في ممارسة لعبة الانقلابات التي مكنت الجيوش من التحكم في الشؤون السياسية للمنطقة لفترات طويلة. وعليه فإن حكم الرئيس الزعيم لم يستمر أكثر من خمسة أشهر؛ إذ أطيح به بانقلاب مضاد، مدعوم هذه المرة من المخابرات البريطانية لصالح ضابط سوري آخر، هو سامي الحناوي، الذي نفذ حكم الإعدام بسلفه. غير أن المخابرات الأمريكية استعادت زمام المبادرة من خلال إعداد انقلاب ثالث بغضون عام، وتزعم الانقلاب العقيد أديب الشيشكلي، الذي قدر له البقاء في منصبه حتى عام 1954 ليطاح به في انقلاب رابع.
بعد دعمه لانقلابين ناجحين في سوريا، استقال كوبلاند من الـ” سي آي إيه” وغادر سوريا إلى القاهرة عام 1953 ليلتحق بمجموعة ” بووز، آلان وهيملتون” للاستشارات الإدارية. وأيدت المخابرات الأمريكية المنصب الجديد لمايلز. وفي القاهرة ترأس كوبلاند فريقا اقتصاديا مهمته إجراء دراسات إدارية لصالح بنك مصر الآخذ بالتوسع فترة ما بعد الحكم الملكي، حيث كانت المخابرات الأمريكية تبحث عن “أصدقاء” لها في أوساط الضباط الأحرار الذين انقلبوا على الملك. كان الوجه العام للحركة هو الجنرال محمد نجيب، إلا أن الشخصية المهيمنة في مجلس قيادة الثورة كانت جمال عبد الناصر، الذي ما لبث أن تولى الرئاسة وحل مكان نجيب.
كانت التوجهات الأولية لدى المخابرات المركزية تسعى إلى مغازلة ناصر والتقرب منه، وهو بدوره سعى بداية إلى بناء علاقات أمنية راسخة مع واشنطن، وكان الاختبار الأول لهذه العلاقة صفقة أسلحة قدرت قيمتها بأربعمائة مليون دولار، خفضت فيما بعد إلى 200 مليون، لتتقلص في النهاية إلى ما قيمته 3 ملايين دولار مخصصة لأسلحة استعراضات عسكرية: خوذ، مسدسات، تجهيزات تزيين الاستعراضات العسكرية، لم تكن أميركا مستعدة بعد لتزويد مصر بالطائرات والدبابات والأسلحة المتقدمة، ما دفع ناصر للتوجه إلى السوفييت.
يسهب الكتاب في تفصيل دور كوبلاند ومحاولاته لكي يتبنى جمال عبد الناصر سياسات مغايرة لتلك التي يعتمدها، مثل الانضمام إلى منظمة معادية للاتحاد السوفيتي، وفي الوقت نفسه يشير المؤلف إلى دور كوبلاند ومساعدته لجمال عبد الناصر في سبيل اكتساب السلطة، ثم يتم إبقاؤه فيها أطول فترة ممكنة، وكانت الحجة التي اعتمد عليها أنه لا يوجد بديل منظور. ومقابل سرد التفاصيل التي يذكرها الكتاب اعتمادا على ما كتب مايلز نفسه، ووفقا لكتابات محمد حسنين هيكل وأحاديثه يتضح أن كلام كوبلاد عن فترة وجوده في القاهرة تحتوي على كم كبير من الخيال، وأن دور كوبلاند بعد استقالته من المخابرات الأمريكية، وفقا لتوضيحات هيكل، اقتصرت على أعمال مرتزقة، وأنه حاول ابتزاز النقود من مسؤولين مصريين وبعض الأمراء العرب عبر ترويجه لمشاريع علاقات عامة واستخباراتية وتجارية.
آخر محترفي الصناعة التي تناولها الكتاب وبحث مستفيضا في تبيان دورها بالمنطقة، هي شخصية معاصرة، من المفترض أن كافة متابعي أحداث الخليج الثانية لا بد وأن يسترجعوا بعض لحظات أخباره التي كانت تتناقلها الفضائيات العالمية بين فترة وأخرى، إنه الرجل الذي كان يعرف أكثر مما ينبغي. وبالنظر إلى خلفيته الأكاديمية العلمية البحتة، كان متوقعا حين سنحت له الفرصة أن يتصرف ويباشر العمل بالسياسة، أن يتصرف كملاك، ولكن تصرفه وفقا لما أظهرت نتائج سياساته، أظهر وحشا ألحق دمارا وخرابا بواحدة من أهم حواضر العالم العربي، لن يزول أثره مهما طال الزمن وتتابعت الأحداث. إنه نائب وزير الدفاع الأمريكي زمن رئاسة بوش الابن، واسمه بول وولفوفيتز، الذي يعدّ مهندس الحرب على العراق بامتياز، ويعد من أبرز اليهود النشطين في الإدارة الأمريكية.
إنه نموذج لرجل الظل بامتياز، الذي يكون عادة حاد الذكاء، لا يعرف الكلل، وعادة ما يكون مجهولا، بعيدا عن الأضواء، يعد القرارات والخطط فيما يعلنها الرجل رقم واحد ويوجه بتنفيذها. وصفه الصحافي الأمريكي المعروف، بوب وودورد، في كتابه “خطة الهجوم”، باعتباره رجلا عليما ببواطن الأمور، ” كان العرّاب الفكري للإطاحة بصدام حسين”. وحينما سارت الأمور على نحو سيئ بعد عملية الإطاحة، بدأ الناس يسمعون باسم وولفوفيتز الذي نجا من محاولة اغتيال في بغداد منتصف شهر أكتوبر 2003. لم يكن وضع العراق في تلك الفترة هو الذي تخيله بول في فترة سابقة، بحسب رأيه، لكنه كان يواسي نفسه وإدارته، ويبرر حالة الفوضى التي عمت العراق بأن العراقيين على الأقل تخلصوا من حاكم مستبد، وأن معظمهم أصبحوا علمانيين، وأن حكومة منتخبة ستصبح منارة ليبرالية يهتدي بها الجيران.
قبل الحرب، شكل بول فرقة من المؤيدين لأفكاره: لويس ليبي، ريتشارد بيرل، اليوت أبرامز… والقائمة تطول من الأصدقاء والمعاونين المتخصصين في كبرى الجامعات الأمريكية ومعاهد الأبحاث ومراكز التفكير، إنها المجموعة التي أُطلق عليها اصطلاحا آنذاك “المحافظون الجدد”. يذكر مؤلف الكتاب أن عملية “حرية العراق” التي أطلقتها هذه المجموعة انقلبت رأسا على عقب، ليس بسبب فشل الإدارة، بل بسبب فشل الخيال والتصور، وأن وولفوفيتز هو رمز هذا الفشل. ويبدو أن الكاتب، وفي أكثر من مناسبة، يحاول تمرير صفة النية الطيبة على الحرب الأمريكية على العراق، باعتبار أن الدافع كان نبيلا، ولكن المسعى والفعل لم يكونا مدروسين على نحو دقيق. الغريب في المسألة أن كافة تدخلات الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عاما كانت هذه صفتها، نية سليمة، لكن خللا ما حدث في التطبيق، وفي النهاية ننظر إلى المنطقة فلا نجد سوى فوضى وكوارث بصناعة أمريكية.
نعرف جميعا كيف انتهى سيناريو “اليوم التالي” الذي أطلقته الإدارة الأمريكية، الذي يصور الوضع الافتراضي للعراق بعد سقوط صدام حسين ونظامه، كان التصور مفرطا في تفاؤله، ببساطة كان الواقع نقيضا لهذه النسخة الافتراضية بالكامل، إذ لم تستطع القوة الغازية من الحفاظ على النظام، وبدلا من الإجراء الطبيعي والاعتيادي في مثل هذه الحالات حيث تلجأ القوة الغازية، وبدرجة ما، إلى القوات المحلية وتعتمد عليها في التوجيه لحفظ الأمن والنظام. غير أن الذي حدث كان مغايرا لذلك تماما، حيث حُلّ الجيش العراقي وسُرحت كافة قطاعاته فجأة، وبذا أطلقت عملية “اجتثاث البعث” جيشا كاملا من الساخطين على الوضع الجديد، فالتحق معظمهم بالمقاومة العراقية. حتى الانطباع الذي حاول الإعلام تمريره على الناس باعتبار أن مخلّصا سيتقدم قافلة عسكرية، هو أحمد الجلبي، سينقذ العراق، ولدى وصوله بدا أن قليلين في العراق يعرفونه، وقوبل بفتور وعدم اهتمام، فتراجعت القوات الغازية عن تتويجه. يقول الجلبي عن هذه اللحظة:” كنا مسؤولين ولم تكن لدينا أية سلطة. ألقيت علينا المسؤولية عن كل ما فعله الأمريكيون، لكن لم يكن بوسعنا تغيير أي شيء… كان المذنب المسؤول عن كل هذا هو وولفوفيتز”.
لم يتعاط بول بجدية مع تبعات الحرب التي كان هو عنصرا أساسًا فيها، والأصح أنه لم يرد هذا التعاطي، وأن وصول العراق إلى ما وصل إليه منذ عام 2003 والى يوما هذا، وكافة آثار التخريب والتدمير التي ستشهدها هذه الدولة في المستقبل، كل هذا لم يكن نتيجة سوء تخطيط، وإنما كان أمرا مقصودًا ومتعمدًا على نحو لا مجال لإنكاره أو التعامي عنه.