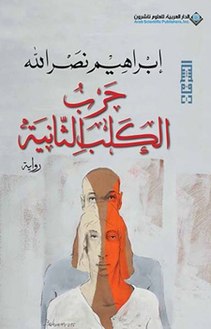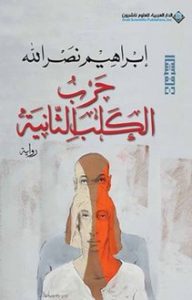ثمة كتاباتٌ تُخدّر قارئها وأخرى تزعجه، بينما ثمة صنفٌ ثالثٌ يجعلك تجلس القرفصاء مفكّرًا، يجعلك تعيد حساباتك مع كل شيء، خائفًا من تحولات الزمن وما يمكن أن تتركه على نفسك، ما بين حسنٍ وما هو دون ذلك، إنه الأدب المسكون بالفلسفة على حد تعبير “جان فرانسوا ماركيه”، الذي يقلب رأسك ولا يدعك كما كنت قبل قراءته. تأتي رواية “حرب الكلب الثانية” للكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله من بين هذه الروايات المنتمية للصنف الثالث، ربما يحلو للبعض أن يصنّفها من بين روايات الخيال العلمي، أو ما شابه ذلك، وذلك لكون أحداثها تدور في المستقبل، إلا أنها أكثر عمقًا من تصنيفها إلى زمنٍ دون آخر، أو صقع دون غيره، فدوران الأحداث في المستقبل ليس أكثر من استحضار للنتيجة التي تكشف الحاضر الإنساني وتعرّي ماضيه.
أحاول عبر هذا المقال أن أتطرق للأفكار التي طرحتها الرواية، تاركًا الأحداث جانبًا إلا إذا استدعت الضرورة ذكر بعضها، ولا أهدف إطلاقًا أن أسبح في إطار النقد الأدبي للعمل، بقدر ما أريد أن أسير مع الكاتب في رسالته الفلسفية، فهي شاغلي في هذا العمل، بل هي أبرز ما يحمله من وجهة نظري. كان المشهد الأول في الرواية لشابٍ معارضٍ في دولة ديكتاتورية، ساعدتها التكنولوجيا الحديثة في المستقبل كي تغزو رؤوس مواطنيها وتعرف فيم يفكرون، مما سهّل استبدادها وحوّل المواطنين إلى شبه آلات. كان هذا الشاب يحاول مشاهدة فيلم وثائقي عبر حاسوبه يعرض التاريخ الذي سعت السلطة جاهدةً لإخفائه. وأول ما صنعه النظام هو محو الماضي، خوفًا من تكرار أحداثٍ داميةٍ خارجةٍ عن السيطرة، كما حدث – وفقًا لأحداث الرواية – في حرب الكلب الأولى، التي قامت بسبب كلب؛ ظنًا من هذه الأنظمة أن ذاكرة الإنسان الدموية تحثه نحو مزيد من الدماء، أو ربما تعمل على إحياء ثأر قديم يكون فتيل حرب جديدة، كما أن الكاتب يُعرّض هنا أيضًا بعمليات تزييف التاريخ التي تمارسها الأنظمة على مدار التاريخ، فالتزييف لا يختلف عن المحو حين يتعلق الأمر بإخفاء الحقائق.
لكن السؤال الفلسفي المطروح هنا، وحاولت الرواية أن تجيب عليه عبر أحداثها: هل الإنسان متوحشٌ بطبعه، أم أن الأمر متعلقٌ بالذاكرة البشرية؟ كأن “نصر الله” يعرض بشكل أو بآخر لفكرة الفيلسوف الإنجليزي “توماس هوبز” الذي يقول إن الإنسان “ذئبٌ لأخيه الإنسان”، فالتوحش كامنٌ فيه. قلنا منذ قليل إن المشهد الأول في الرواية كان لشابٍ يحاول التلصص على الماضي عبر حاسوبه، وبالطبع تم القبض عليه، وبعد هذه الحادثة بدأت عملية التحول، التحول من شخص معارضٍ للنظام إلى شخصٍ آخر ينافس النظام في فساده ويتفوق عليه، وهو بطل الرواية “راشد”، الذي وصلت به الوحشية للمتاجرة بأمراض الناس. وكان سياق الرواية في مجمله إجابةً عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة التي سوف نعرض لها عبر هذا المقال.
الطرح الفلسفي الآخر الذي تعرضت له الرواية بعمق هو ثنائية (الأنا / الآخر) فقد اعتدنا على أن الصراع ينشأ من الاختلاف، ومحاولة فرض وجهة واحدة لتكون هي السائدة وتقليم أظافر التوجهات الأخرى، هذا إن لم نتطرف ونقص أصابعها كلها وربما يدها. وكانت الفكرة المركزية هل لو تخلصنا من الاختلافات القائمة بين البشر سوف نصل للسلام المأمول؟ السلام ذو الوجه الواحد حين يغيب المخالفون عن أعيننا؟ وقد عرض الكاتب لفكرة نفي الآخر من خلال فكرة “الاستنساخ”، فطالما الرواية تدور في المستقبل حيث الطفرة التكنولوجية الهائلة، فكان من اليسير على الكاتب أن يعرض للفكرة الفلسفية “الأنا / الآخر” عبر إجراء علمي وهو “الاستنساخ”، إذ تم التوصل لآلية تساعد الإنسان أن يتحول أو يحوّل أي شخص آخر لشبيه، لا يتفق فقط في الشكل ولكن في الطبائع كلها، وبدأها البطل بتحويل سكرتيرته بشكل متقنٍ للغاية عبر عملية في الخارج لتشبه زوجته التي يحبها كثيرً، التي أراد منها مائة نسخةٍ كما ذكر لأمه بعد زواجه منها.
إلا أن الأمر لم يقتصر على إجراء عمليات جراحية لإحداث هذا التماهي، فقد أصبح الالتقاء بشخص آخر يُحوّل أحد الشخصين إلى شبيه للآخر، وقد بدأت الظاهرة ضعيفة في البداية، ثم استشرت لدرجة أن رأس السلطة ظهر له أشباه كثيرون، مما استدعى تدخل السلطة للقضاء على هؤلاء الأشباه. وبعيدًا عن الأحداث نعود لسؤالنا: هل الاختلاف هو أساس الصراع البشري، وهل حُلت المشكلة بتحول الناس لنسخٍ مكررةٍ من بعضهم بعضا؟ أعتقد أن هذه هي قمة العبقرية في هذا العمل، فكرة تُسلّط الضوء على أن صراع الإنسان ليس مع المختلف معه، وليست رفضًا له بقدر ما هي رفض الإنسان لذاته عبر رفض الآخر، بل الآخر المختلف أخفُّ وطأة على الإنسان من نفسه، فلم يستطع بطل الرواية أن يرى أشباهه، ولم يستطع أي شخص آخر في الرواية أن يستسيغ فكرة أن يكون منه نسخٌ كثيرة، بل جرّت المثلية الشكلية كوارث أضعافًا مما جرّه الاختلاف، كأن الإنسان يصارع ذاته في صراعه مع الآخر. وإن لم يقبل العيش مع المختلفين معه، لن يستطيع العيش مع مجتمع متشابه حتى لو كان هو الذي صنعه بيديه.
عرض “إبراهيم نصر الله” أيضًا لفكرة تكشف مدى عبثية الفعل الإنساني وكارثيته، حين بدأت الحيوانات عبر الرواية تتصف بصفات الإنسان، فلم يعد الكلب على وفائه، ولا أيٍ من الكائنات الأخرى على طبيعتها، وأخذوا يتشبهون بالبشر؛ مما ألقى مزيدًا من الضوء على التشويه الذي يخلقه البشر في هذا الكوكب، وأن صنيعهم إن قام به غيرهم من الحيوانات فلن يجني هذا الكوكب إلا الخراب، وربما الزوال السريع. كأن الإنسان لا يكفيه تدمير ذاته بل يدمّر الكوكب من حوله، ويُخلّ بتوازنه. ومن الواضح عبر الرواية أنها تميل للتأكيد على شرّية الإنسان أكثر من خيريته، فقد انتصر الجانب الشرير في البطل بعد أول مواجهة له مع السلطة أو قوى الشر، للدرجة التي جعلته يفوقهم شرًا وتوحشًا، وهذه نظرة لن أقول تشاؤمية بقدر ما هي صرخة تحذيرية، تضع الإنسان أمام ذاته، عمل مرآوي – إن جاز التعبير – يكشف كل شيء للإنسان، ويعرض عليه الحقائق بعيدًا عن أي تزييف أو تجميل، الحقيقة عارية إلا من ذاتها، فإما أن يتعظ الإنسان أو سيدمر نفسه قبل تدمير أي شيء آخر.
الإنسان عدو نفسه الأول، إن لم ينقذ ذاته فلن يستطيع شيءٌ إنقاذه، وحين تكون الجوانب الشرية كامنةً في الإنسان متغلغلةً فيه بهذا الشكل، فلن تفيده تكنولوجيا ولا علم، بل سوف تتحول كل إنجازاته العلمية إلى وبالٍ عليه، إلى حبلٍ يخنق به ذاته وهو في رحلة خنقه للآخر، وحين لا يجد سوى نفسه في أشباهه الذين صنعهم بيديه، وقتها سوف يدرك أنه قتل ذاته بالقضاء على الاختلافات، وأن عملية التماهي التي مارسها كانت السُمَّ الذي وضعه في كأسه بنفسه. الرواية تحمل رسائل تحذيرية كثيرة وشديدة العمق، لا يعاني من أخطارها الإنسان في الشرق فقط أو الغرب وحده؛ بل الإنسان في كل مكان، إن لم يعِ جيدًا وقبل فوات الأوان أن الآخر يُكْمله لا يناقضه، إن لم يفهم أن الآخر هو طوبة تسنده في جدار واحد، إن لم يستوعب ذلك مبكرًا سوف يفيق على هشاشته التي ستضربها الريح بكل سهولة وتقضي عليه.