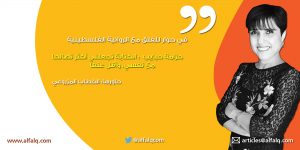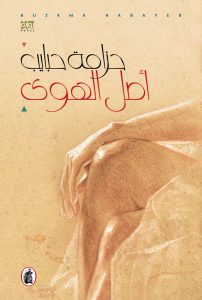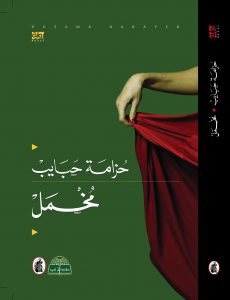حُزامة حبايب روائية وقاصة فلسطينية. ولدت ونشأت في الكويت ودرست فيها، في العام 1990، مع اندلاع حرب الخليج الأولى، غادرت حزامة حبايب الكويت إلى الأردن، لتكتسب شهرتها هناك ككاتبة قصة قصيرة، مع صدور أول مجموعة قصصية لها بعنوان “الرجل الذي يتكرر” (1992)، التي نالت عنها جائزة مهرجان القدس للإبداع الشبابي. عام 1994م نالت حبايب جائزة رابطة الكتاب التقديرية عن مجمل أعمالها القصصية.
صدرت روايتها الأولى “أصل الهوى” عام 2007م، وهي رواية حظيت باهتمام نقدي كبير،وفي العام 2011، أصدرت حبايب روايتها الثانية “قبل أن تنام الملكة”، التي وصفها بعضهم بأنها ملحمة روائية تتناول اللجوء الفلسطيني، إذ تقدم رحلة حياة، يتقاطع فيها الأمل واليأس ضمن سرد موزاييكي بالغ الثراء والتلوّن. واختارتها صحيفة “الغارديان” البريطانية في قائمة أفضل قراءات العام 2012. في 2016، وأصدرت روايتها الثالثة بعنوان “مخمل”، التي اعتبرها بعض النقاد علامة فارقة في مسيرة حبايب الروائية. وقد نالت عنها جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2017م.
مؤلفات حزامة حبايب:
1- “مــخـــــــمل”، (رواية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (2016)
2- “قبل أن تنام الملكة”، (رواية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، (2011)
3- “أصل الهوى”، (رواية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (طبعة أولى – 2007)، (طبعة ثانية – 2009)
4- “ليل أحلى”، (قصص) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (2001).
5- “شكل للغياب”، (قصص) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (1997).
6- “التفاحات البعيدة”، (قصص) دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان (1994).
7- “الرجل الذي يتكرر”، (قصص) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (1992).
8- “من وراء النوافذ”، (مختارات قصصية)، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام الله (2010)
9- “استجداء”، (نصوص شعرية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (2009)
حزامة حبايب: ما بين مدن العيش ومدن السفر ومدن اللقاءات العابرة، اكتشفتُ نفسي حينًا وضعتُ عن نفسي أحيانًا.
1- من هي حزامة حبايب؟ هل هي نفسها في الكويت والزرقاء وعمّان وأبوظبي ودبي؟
يا له من سؤال! هل نَعرف أنفسنا حقاً من خلال المدن؟ أو أترانا نستطيع أن نعرِّف أنفسنا بها أو بمقدار ما تتركه فينا؟ أعتقد أنه من المنصف القول إن لي مع المدينة علاقة عضوية، بمعنى التورّط التام فيها، كمنظومة إنسانية وعاطفية وثقافية وفكرية وتاريخية، وهو تورُّط يُمليه مزاج المدينة وتحولاتها وقابليّتها لأن تبوح لي بحالها وأحوالها، تماماً كما يُمليه مزاجي الشخصي و”أحوالي” العاطفية والنفسية. أنا ابنة المدينة، ولا أتخيّلني لحظة أعيش على هامشها، أو قاطنة متوجّسة، أو زائرة عابرة. بعض المدن تفتح بواباتها من الطرقات الأولى، تراها تُشرع عواطفها بحبور وبلا توجس؛ وأخرى تميل إلى أن تكون متحفظة أو متمنّعة، أو صعبة المنال. بعض المدن تظل تملك احتمالات متجددة لأن تفاجئك وتأسرك أو تأخذك في طرقات جوانية وخفية وأخرى تستنفد صلاحيتها في الحب والكشف وسرعان ما تفرغ طرقاتها من أي مفاجآت. وكما تحفر المدينة نقوشاً في روحي، فإنني أترك نقشًا لي، شخصياً، في كل مدينة. وبطريقة ما أحوّل المدينة في جانب منها إلى “مدينتي”.
لي مع “مدني” حكايات وحكايات.. قد تصنع المدينة هي ذاتها الحكايات، أو قد أُودع المدينة حكاياتي. وُلدتُ في الكويت وعشتُ في مدنها وضواحيها، ودرستُ فيها، وعرفتُ فيها أول الأشياء كلها: أول الحرف – قراءةً وكتابةً –وأول الحب وأول الهجر وأول معنى للهوية بتجلياتها واستحقاقاتها، كفلسطينية. ومع اندلاع حرب الخليج الأولى، نزحتُ إلى الأردن (وهو مسار حتمًا لم أختره). عشتُ في مدينة الزرقاء قريبًا من المخيم الفلسطيني الذي عاش فيه والدي طفلًا (والزرقاء مدينة ذات بيئة “قاسية” عاطفيًا بأكثر من معنى، وهي قسوة تبدت في الكثير من قصصي)، علمًا بأنني لم أنقطع عن المخيم ونواحيه طيلة سني طفولتي ومراهقتي، من خلال ما يشبه “الحج” العائلي السنوي له (من الكويت إلى الأردن)، وهي رحلات انحفرت تجاربها “المثيرة” و”المجنونة” و”الإنسانية” بطريقة عجيبة في تكويني. ثم انتقلتُ إلى عمّان، كمدينة ذات مشاعر “هجين”. عليّ ربما أن أعترف أنني لم أتصالح معها تمامًا، وإن تفهمتُ تناقضاتها. عشتُ في عمّان سبع سنوات، قبل أن أغادرها لأبوظبي. وإذا كان لكل مدينة نصيب في كتاباتي، بمعنى كتابة المكان نفسه أو إنتاج الكتابة في المكان، يمكن القول إن أبوظبي كانت مأوى للمنجز السردي الأكبر الخاص بي؛ ففي هدأة المدينة، وضمن عزلة فرضتُها على نفسي، استعدتُ حكايات المدن الأخرى على مدى تاريخي، من خلال معايشة تجربة سردية جديدةً تمامًا عليّ حين اقتحمت عالم الرواية. أنجزتُ ثلاث روايات، كل واحدة منها “ملحمة” عاطفية بطريقتها. وحتى أبوظبي أعطتني حكايات خاصة بها، كفضاء لوجود إنساني متشابك.
واليوم أقيم في دبي التي انتقلت إليها حديثًا، كمدينة تَعِد بتجربة خاصة لا تزال بالنسبة لي في مرحلة الكشف والتكشّف، أبحث فيها عن مكان يصبح “مكاني”، وحدي أعرف ما قد يعنيه أو احتمالاته، شأنه في ذلك شأن أماكن عدة في المدن التي سطّرتُ فيها فصول حياتي.
وما بين مدن العيش ومدن السفر ومدن اللقاءات العابرة، اكتشفتُ نفسي حينًا وضعتُ عن نفسي أحيانًا. والأرجح أنني بعد كل هذه السنوات ما زلت أحاول أن أعرف من هي حزامة حبايب. ولا أحسبني أني سأعرف نفسي .. أحب أن أعتقد أنني أشبه المدن، أتوه في “طرقاتي”، وعلى استعداد دوماً لترقب مفاجأة “مدائني” الداخلية وتحولاتها.
2- رغم تنقلاتك العديدة بين مدن عربية، تحملين هم الإنسان الفلسطيني أينما ذهبتِ. كيف استطعتِ أن تقبضي على كل تلك التفاصيل اليومية للإنسان الفلسطيني رغم البعد الجغرافي والاجتماعي والنفسي والعاطفي المعاش؟
يصحّ القول إن كل المدن التي عشتُ فيها ساهمت، كل بطريقتها، في صوغ “فلسطينيتي”. شئت أم أبيت، أنا في كل مدينة، سواء كانت تشبهني أو لا تشبهني، أكون قريبة من فلسطين. بل كل مدن العالم تأخذني إلى فلسطين، حتى وإن كانت بعيدة تماماً عنها أو لا تتقاطع معها بأي صورة. ربما المسألة لها علاقة بوعي خاص شحذتُه من تربيتي، في كنف أسرة تمسكت بكل مكونات الهوية الفلسطينية في الشتات، بحيث تحولت هذه المكونات إلى ما يشبه “الحصانة” أو الشعور بالخوف أو التهديد أو حتى التيه، وانضفر هذا الوعي ضمن معطيات المجتمع الفلسطيني الأكبر من حولي، قبل أن يتعزَّز بالتجربة الفردية والثقافة والاحتكاك بالآخر. كل هذه المكونات والتفاصيل، الصغيرة منها قبل الكبيرة، صنعت – ولا تزال – معطيات السردية الفلسطينية. والغريب أن هذه السردية، بالنسبة لي أنا شخصيًا، تأخذ بعدًا أكثر فلسطينية في “الأقاليم” البعيدة عن فلسطين كشكل من أشكال حماية الذاكرة ربما وصونها ولملمة جزئياتها، كي لا تضيع. أعتقد أن جزءًا من مشروعي ككاتبة هو “القبض” على الذاكرة واستعادة الصور الزائلة في قوالب حكائية تصمد أكثر، بالمعنى العاطفي والإنساني. ومع الوقت، تطورت حساسيتي في رصد “التفاصيل اليومية للإنسان الفلسطيني” كما تصفها، رغم البعد الجغرافي والعاطفي عن فلسطين. وقد تكون العملية معكوسة، بمعنى أن البعد الجغرافي والعاطفي عن فلسطين أسهم بطريقة ما في “بناء” حساسيتي وحشد حواسي وتطوير ملكتي على الرصد والالتقاط وجمع مخزون وفير من المشاعر والأفكار التي تصوغ نسيج السرد، كل ذلك كجزء من الآليات التي نميل إلى تطويرها لحماية ما نراه ملحًا لوجودنا.
3- كيف تتعاملين وجوديًا مع قضية وطنك المحتل؟
فلسطين تقيمُ في نفسي؛ تتغلغلُ عميقًا في وعيي كوطنٍ معنوي وعاطفي بموازاة كونه وطنًا مادياً وبالتقاطع معه. وإذا كان المنطق يُملي علينا – أحياناً – أن نتفَّهم صعوبة الحصول على الوطن المادي أو استعادته، فإنّ يقيني بعكس ذلك يجعل فلسطين خاصتي أقرب إليّ مما قد يعتقد الآخرون. أعلنها صراحةً: لولا فلسطين كحقيقة ثابتة، متجذِّرة في كياني، مستحكمة في داخلي، لما كنتُ أنا ما أنا عليه. ثم كيف يمكن تجاهل أن الشقَّ الأعظم من تجربتي السردية إنما هي تعبير عن فلسطينيّتي أو انعكاس لها أو نتيجة لها بصورة من الصور؟! أنا أحمل فلسطين تاريخًا ومعنًى وإرثًا إنسانيًا وثقافيًا.
4- ألا تستهلكك ككاتبة، مشقات الحياة اليومية والسعي لتأمين متطلبات الحياة، العادية؟
بكل تأكيد. “السعي وراء الرزق” ومشقات العمل اليومي تسرقني من رغبات كثيرة، وتحرمني من شرط حيوي: توفر الطاقة البدنية والاستعداد النفسي للكتابة، بمعنى التفرغ التام بعيدًا عن أي مخاوف لها علاقة بتأمين “لقمة العيش”. وكثيرًا ما يحدث أن أعود مستنزفةً من عملي، وأحياناً “أعمالي” (إذ مررتُ بظروف اضطرتني إلى مكابدة أكثر من عمل في اليوم الواحد للإيفاء بمتطلبات أسرتي الممتدة). لكنني مع ذلك أحرص على أن يظل فعل الكتابة – مشتعلاً في قلبي. وحين تلحُّ عليّ فكرة ما، فإنه لا شيء يوقفني. وكثيرًا ما يحدث وأن “أتورط” في تجربة تستغرقني بالكامل، وغالبًا ما أدفع استحقاقها لاحقًا من جسدي، ومن عملي. في روايتي “قبل أن تنام الملكة” و”مخمل“، تحديدًا، وخلال فترة الكتابة المتواصلة على مدى شهور لكل منهما، كنتُ تقريبًا “عاطلة” عن العمل أو “معطّلة”، معتمدة على بعض الكتابات المتفرقة في الصحف والمجلات أجني من ورائها القليل الذي “يمشّي الحال” كما نقول. وكان فعل الكتابة يقتضي مني الجلوس لساعات طويلة، وفي وضعية، متحفزة، وسط هجمة من المشاعر والأفكار التي تسبِّب تشنُّجات بدنية وعصبية لي، تبقى آثارها قائمة حتى بعد انتهاء فعل الكتابة.
وفي النهاية، لعل مشقّة الحياة التي عشتها ووعورة الطرقات التي قطعتها لم تكن بالأمر الذي أعاقني تمامًا؛ فهذه المشقّة تظهر في مناخاتي السردية، وقد تغلب عليها؛ والطرقات الوعرة التي مشيتها في طريقي للعمل وأحيانًا لانتزاع لقمة العيش بأي ثمن، هي ذاتها – بشكل أو بآخر – التي قطعها عدد كبير من أناس حكاياتي. وفي النهاية أيضًا، لعلّني لم أكن لأكتب كل هذه الحيوات، وكل هذا الدفق من المشاعر والعلاقات لولا الحياة الصعبة. (والصعبة جدًا أحيانًا) التي عشتُها.
5- تجربتك القصصية، محكمة وموزونة ولن أبالغ إذا قلتُ هناك انسجام وحِرفة متقنة بين اللغة والشخصيات. هل سننتظر أعمالاً قصصية جديدة لحزامة؟
أعتز بتجربتي القصصية، فهي بوابتي “الحقيقية” إلى الكتابة الإبداعية بمعنى الجِدّة، وهي التي قدمتني للمشهد السردي الذي تسيّدت فيه القصة القصيرة، في الأردن وفلسطين في تسعينات القرن الماضي. ووسط عدد كبير من الأصوات القصصية في تلك الفترة، “سُمِع” صوتي بوضوح، و”قُرِئتُ”، واستطعتُ أن أبرز منذ مجموعتي القصصية الأولى “الرجل الذي يتكرر“، التي تناولها عدد كبير من النقاد بالإشادة. أعتقد أنني من البداية كنتُ خارج تصنيفات الأدب “النسائي” بمعناه الضيق أو المحاصَر. كما شكلت تجربتي مفاجأة للبعض، وصدمة للبعض الآخر، كوني مارستُ جرأةً غير مسبوقة في حينه، ودون أية تحفظات زائفة، لجهة التعاطي مع اللغة ومقاربة موضوعات يميل كثير من الكتاب والكاتبات إلى تحاشيها إلى جانب تسمية الأشياء بأسمائها، بعيدًا عن التمترس وراء “أخلاقيات” ذات بُعد ظاهري أو ادّعائي أكثر منه حقيقي. ولعل سؤالك يذكرني بما ذكره أحد النقاد ذات مرّة بأن تجربتي القصصية وُلدت ناضجة، متخطيةً عثرات البداية، من حيث البنية القصصية المشيَّدة بأناة ورسم شخصيات مركبة. وجاءت مجموعتي الثانية “التفاحات البعيدة” لترسّخ حضوري في المحيط الأدبي آنذاك وسط زحمة لافتة في النشر القصصي. لقد دخلتُ عالم القصة عاشقةً مخلصة، حريصةً على أن أترك بصمةً من خلال نتاج نوعي لا كمّي. وبعد أربع مجموعات قصصية، حفرت لي مكانًا في السردية العربية، ما زلتُ عاشقةً ووفية لهذه المنظومة الحكائية فائقة الحساسية، ذات القابلية المذهلة للإدهاش، حتى وإن أشعرت القارئ بسهولتها. على أنني أشعرُ اليوم بمسؤولية أعظم من أي وقت مضى إزاء كتابة القصة القصيرة، بعد أن قطعتُ شوطاً كبيراً في تكريس مشروعي الروائي عربياً. بالتأكيد، يشدّني الشوق للقصة القصيرة، وثمة عودة مؤكدة لها، وهي عودةٌ سأحرص على أن أضيف من خلالها إلى مشروعي السردي ككل، بمعنى التجديد والخلق والحفر في فضاء مختلف، لا أريد أن أقدم عملاً قصيصًا يبدو كأنه امتداد أفقي لتجربتي؛ ما يهمني هو خوض مغامرة جديدة، وأنا تفتنني المغامرات، التي تنطوي على مجازفة، دون أن أحسب عواقبها.
حزامة حبايب: معظم “ناس” السرد لدي يسيرون بثقل، كأنهم منهكون ومستنزفون، يتبعهم ظل قاتم ويخلفون أثراً وراءهم.
6- ذكرتِ في برنامج بُث في عام 2004 (قناة الجزيرة)، بأن جميع الشخصيات النسائية في إحدى مجموعاتك القصصية “قد تكون الشخص ذاته”. هل هذه الرؤية تنسحب على شخصيات رواياتك (أصل الهوى، قبل أن تنام الملكة، مخمل)؟
في الحقيقة هذه المقاربة كانت تخص تحديدًا مجموعتي القصصية الثالثة بعنوان “شكل للغياب“، التي تتألف من اثنتي عشرة قصة قصيرة محورها النساء، بكل تحولاتهن وأمزجتهن، واستقصاء جوانيّتهن. ومن مقاربة “مشروعة” للقراءة، قد نجد أن كل نساء “شكل للغياب” إنما اثنا عشر وجهًا وحياة لامرأة واحدة. هذه المقاربة قد لا تستقيم في أعمالي القصصية الأخرى أو رواياتي.. ولكن على الأرجح أن ثمة خيطًا رفيعًا جامعًا بين شخوص السرد لدي، قصصيًا وروائيًا، يتمثل في المناخ العام الذي يتسلل إليه شعور بالقهر والانسحاق والهزيمة الجمعية.. توقفت عند ما كتبه أكثر من ناقد عن شخصيات أعمالي بأنها تسير على الأرض، بمعنى أرض الواقع الحقيقي، بكل خشونته وقسوته ومراراته المتراكمة، وأن معظم “ناس” السرد لدي يسيرون بثقل، كأنهم منهكون ومستنزفون، يتبعهم ظل قاتم ويخلفون أثراً وراءهم.. لربما هذا نتيجة الحياة، حياتي أنا، ومشاهداتي وخلاصة تجربة عيش بالغة التعقيد والثراء، بالمعنى النفسي والعاطفي.. ربما!
7- أثارت روايتك الأولى “أصل الهوى” عاصفة من الجدل في الأردن (إبان صدورها) مما حدا بدائرة المطبوعات والنشر آنذاك بمنعها. لماذا الحكومات العربية تستمع إلى لغة الشارع، إذا كان في مسألة قمع الكاتب فقط؟
برأيي هذه “العاصفة” كانت مفتعلة من دائرة المطبوعات والنشر، التي تمارس “الرقابة” ضمن معايير مربكة ومضحكة أحيانًا، تنطلق من مفهوم “الوصاية” على المجتمع وعلى الفكر ولعب دور “القيّم الأخلاقي”! والمضحك في الأمر أن المنع الذي يتكئ على مسألة “توظيف الجنس” في العمل غالبًا ما يكون ذريعة أو وسيلة للتعمية على أسباب أخرى، لها علاقة بكشف عفن مجتمعي وفكري متغلغل، يُراد لنا، نحن الكتّاب، التغاضي عنه أو السكوت أو مقاربته على استحياء أو بـ”وقار” مصطنع. اللافت في أزمة “أصل الهوى” أن الجهة التي أقرت المنع لم تستمزج لغة الشارع أصلاً كي تستجيب له، وهذا يعني أن المنع أصلاً ينطلق من فرضيات سابقة، أو بالأحرى من “موقف” مُحدَّد سلفًا. لا أدافع هنا عن الشارع أو المجتمع، وبالتأكيد أنا آخر من يحاول تجميله، فثمة تواطؤ غير معلن بين المؤسسات القمعية وبين المجتمع، ضحية هذه المؤسسات في أغلب الأحيان، حين يتعلق الأمر بتابوهات بعينها، في مقدمتها الجنس والدين. ولطالما كان اللعب على هذين التابوهين وسيلة للتلاعب بالفكر الجمعي وتسييره.
8- في “أصل الهوى” طرحتِ بشكل جريء الرغبة الحقيقية للشخصيات وبوحها الإنساني رغم ما شاب تلك الرغبات من خوف مكنوناتها. ألم تكرري الثيمات وعوالم الرواية في مخمل؟ ما الذي يجعل “مخمل” تختلف عن “أصل الهوى”؟
ما يجمع بين الروايتين هما الشأن الفلسطيني أو “الهم” الفلسطيني العام، ومسألة الهوية في المنفى؛ وفيما عدا ذلك، فإن لكل رواية عالمها الخاص، لجهة البيئة والحبكة والحبكات الفرعية والشخصيات، بمعنى البناء المتفرد الذي يحيل العمل إلى حياة وفيض هائل من الطيف البشري ذي المشاعر المركبة. كل عمل أكتبه هو وليد معطيات خاصة به، وإن كان يندرج ضمن خصوصية تجربتي السردية ككل. والحديث عن الجرأة في “أصل الهوى” يدخل في إطار المفارقة المضحكة والمبكية في آن، فرواية “مخمل” لا تقل جرأة، لجهة تعرية المخيم الفلسطيني واستبطان العفونة المتفشية خلف طبقات من الصمود الهش، وتجريده من كل أشكال البطولة الكرتونية ونزع هالة القداسة المفتعلة عنه، وهو أمر للحق أغضب كثيرين ممن يعتقدون أن المخيم كيان سياسي بمعنى الصمود والنضال فيما هو في واقع الأمر كيان اجتماعي واقتصادي بائس ومتردٍ، تعرضت – ولا تزال – “الهوية” من خلاله، بوصفها حائط صد معنوياً وثقافياً وتاريخياً كما يُفترض، إلى امتحان قاس. لم تتعرض “مخمل” للمنع بسبب جرأتها، حد الضراوة، في تصويرها اللاذع للحياة في المخيم الفلسطيني، هذا التصوير المغلف بمحكية سردية شاعرية؛ وهو ما يعني أن “الرقيب” الذي منع “أصل الهوى” لم يجد في “مخمل” ما يجرح الذائقة العامة أو يمس “المقدّسات” المزعومة، وهو ما يعكس بالضرورة المنهجية التي تتبعها الرقابة، كآلية حكم تنطلق من مبدأ الافتئات والتجريم الذي ينطلق من قراءة تعسفية أو سطحية في أفضل الأحوال.
9- حسب الموقع العالمي (goodreads) رواية ” قبل أن تنام الملكة” لاقت رواجًا ونجاحًا شعبيًا؛ هل تعتقدين أن الضجة التي أحدثتها روايتك الأولى كان له دور في تسويق الرواية؟ مع أن الرواية قد وصفها الناقد صبري حافظ (أهم رواية فلسطينية صدرت عن الجيل الثاني لكتّاب فلسطين).
لا أعرف ما إذا كانت رواية “أصل الهوى” لها دور في خلق توقعات حول روايتي الثانية “قبل أن تنام الملكة“. في جميع الأحوال، “قبل أن تنام الملكة” رواية مختلفة تمامًا، وعند صدورها في 2011 تم استقبالها بحفاوة كبيرة، من النقاد والقراء على حد سواء. فالرواية، التي تناولت المجتمع الفلسطيني في الكويت ما قبل تسعينات القرن الماضي (وتحديدًا عند الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990) من خلال عائلة فلسطينية محسوبة على “الطبقة المستورة” اقتصاديًا، شكّلت نقطة فارقة ليست في تجربتي السردية فقط وإنما في السردية الفلسطينية بالمجمل، على حد وصف الناقد صبري حافظ، الذي كتب دراسة نقدية ضافية عنها، معتبرًا إيّاها ربما “أهم رواية فلسطينية صدرت عن الجيل الثاني لكتاب فلسطين بعد الروايات الفلسطينية الكبرى لغسان كنفاني وإيميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا“، وأنها “حققت إنجازًا فريدًا في الرواية العربية وهو المزاوجة بين كتابة رواية المتخيل الوطني الجمعي الفلسطيني وهو يصارع في الشتات والمنفى للإبقاء على هويته من ناحية، وكتابة رواية (تكوين) المرأة الفلسطينية من الجيل الذي ولد ونشأ في الشتات والمنفى، بهواجسها الفردية ومعاناته الفريدة لتجربة النفي والهزيمة من ناحية أخرى.” وإلى جانب صبري حافظ، العديد من النقاد والكتاب تناولوا الرواية ضمن مقاربات نقدية عدة أجمعت على الجانب الملحمي فيها، مصنّفينها ضمن سرديات الشتات الفلسطيني بمعناه الإنساني والعاطفي العريض. كل من يقرأ “قبل أن تنام الملكة” يكتشف أنها تجربة مغايرة ومختلفة ضمن مخزون تجربتي السردية ككل، وحتى ضمن السردية العربية، وهذا هو التميز الذي أسعى إلى أن أحققه، بمعنى أن أسعى إلى أن يكون أي عمل أو نص أكتبه تجربة نوعية ومختلفة، تضيف لي، وتكون جزءًا من إرثي.
حزامة حبايب: “مخمل” قصة حب بالدرجة الأولى، بل أعظم وأجل وأنقى ما يمكن أن يكون عليه الحب.
10- أشادت لجنة جائزة نجيب محفوظ، بلغة رواية “مخمل” هل تختبئ حزامة الشاعرة في لغة “مخمل” وهذا ينسحب حتى على أعمالك القصصية، خاصة إذا عرفنا أن لك كتابًا شعريًا وهو “استجداء”؟
ربما.. من يدري! في البدايات قاربتُ الشعر. ولخشيتي من التصنيف لم أكن أشير لما أكتب بأنه “شعر” أو “أشعار” وإنما نصوص شعرية، كما لو أني أردتُ أن أخلق مسافة ما بيني وبين التصنيف “الفعلي”. في العام 1990، أصدرت مجلة “الناقد”، أحد أهم المجلات الأدبية التي كانت تصدر في حينه، عددًا خاصًا عن الشعر في الوطن العربي، وتم اختياري من بين 80 صوتا شعريًا راهن القائمون على الملف يومها على هذه الأصوات في صياغة المشهد الشعري عربيًا. يومها “جفلت”، إذ لم أنظر إلى نفسي شاعرة، فتواريت خلف القصص، وعُرفت عربيًا كقاصة ثم كروائية، قبل أن أستجيب لإلحاح تجربة شعرية مغايرة من خلال “استجداء” التي صدرت في العام 2009، وحققت صدى لافتًا. ومع ذلك، أحرص على أن أكون “منطوية” شعريًا، فلا ألبي دعوات لإلقاء الشعر أو لنشره إلا نادرًا. ويقينًا هذا الحس الشعري الذي يغمرني يتسرب بوضوح في تضاعيف كتابتي السردية، ليس فقط بمعنى صياغة التعبيرات وإنما خلق الإحساس العام للنص. نعم أعترف أن بعض الشعر يتلصص في حكاياتي.. وهو أمر لا أعتذر عنه أبدًا ولا أتنكّر له.
اللغة الشعرية أو الشاعرية في “مخمل” هي المقابل الموضوعي لمفردات البيئة، الجغرافية والإنسانية، بالغة الفجاجة والقسوة والعنف والانتهاك بكل أنواعه، حد الوحشية أحياناً. وبقدر ما قد يبدو هذا الأمر، أي توظيف اللغة الشاعرية، نافرًا وشاذًا أحيانًا بقدر ما يبدو منطقيًا بطريقته، كشكل من أشكال “المقابلة” بوصفها آلية تعبيرية تروم البحث عن مقابل موضوعي للبؤس والقبح المستشري في بيئة المخيم، وهذا المقابل يتجسد في أحد صوره في اللغة. وفي النهاية اللغة تعبير عن أجمل ما يجعل “مخمل” قصة حب بالدرجة الأولى، بل أعظم وأجل وأنقى ما يمكن أن يكون عليه الحب.
11- كروائية عربية، على من تراهنين في نجاح عملك الروائي، على القاعدة الشعبية للقراء، أو الناقد الحذق صاحب المنهج العلمي، أو أن الأمر لا يعنيك برمته؟
أعتقد شيء من هذا وذاك.. وهذا يقودنا للسؤال الذي قُتل بحثًا: لمن نكتب؟ في العادة أكون مدفوعة بحاجة ما ملحة، حتى وإن كنتُ لا أستطيع أن أشرح هذه الحاجة أو دوافعها. في النهاية، لستُ مضطرة لتبرير دوافعي أثناء الكتابة، وتراني لا أسائل نفسي. وحين يظهر العمل للملأ، فإنه يخرج من “سلطتي” وسيطرتي للآخر، ويكون متاحًا للقراءة وإعادة القراءة بل والتشريح. هل يعنيني القارئ؟ أو الناقد؟ بالطبع. ما دام أنني جعلت الرواية مشرعة أو متاحة للآخر، هذا يعني أنني أتوقع ردود فعل. ويكذب من يقول إنه لا يهتم برأي القارئ أو الناقد. لكن السؤال هو: من هو القارئ الذي نبحث عنه؟ وكذلك من هو الناقد الذي نتوقع أن يقرأنا ؟ هناك فرق بين قارئ وقارئ متمرس، وبين ناقد وناقد حاذق. شخصيًا أعتز برسائل القراء الشغوفين التي تصلني، والتي يشاركونني من خلالها آراءهم ومشاعرهم والتأثير الذي تتركه قصة أو رواية من رواياتي عليهم. وكذلك.. أتوقف مليًا عند العديد من القراءات النقدية التي تتناول أعمالي بالتشريح. بعضها تضيء لي أشياء أنا نفسي لم أكن مدركة لها.. وهذا هو دور النقد أن يجوب مناطق اللاوعي في الكتابة فيرينا ما لا نراه حتى نحن الكتّاب. وإذن، هل أجبت عن سؤالك؟
حزامة حبايب: السخرية في الكتابة محاكاة صادقة للجانب العبثي والتهكمي في الحياة
12- تحفل جل أعمالك بهاجس الفقد والسخرية، هل تستعينين بالسخرية نتيجة الفقد على مستوى الإنسان/الفرد والوطن المحتل (فلسطين)؟
السخرية شرط حيوي في كتابة الفقد والخسارات، إذ تضفي أنسنة حيوية على النص، وتمنح بعض التوازن المطلوب، وتجعل الحياة أو ما تبقى منها محتملة وقابلة لأن نناضل من أجلها. فالسخرية في الكتابة محاكاة صادقة للجانب العبثي والتهكمي في الحياة الواقعية خارج الكتابة. لعل السخرية كحس عام، طغت بجلاء في رواية “قبل أن تنام الملكة“. وهي رواية تنهض فعليًا على الفقد، بل هي تجسيد للخسارات. ومع ذلك، تبدو السخرية نتاجا طبيعيًا للفقد، كأنه “ينتشله” أو يجعله قابلاً لأن يُعاش، وأحيانًا مفهومًا ومبررًا. السخرية هي الوجه الآخر للحكمة. مع فرق أن الحكمة ذات طابع استعلائي متعنت. وإذا كان الحزن يهدّنا ويقهرنا، ويجعلنا نتضعضع قلبًا وروحًا وجسدًا، فإن السخرية وقاء من الانهيار التام، بل هي التي تعطي الخسارات معناها العميق.
13- “حوا” في مخمل، التي طحنتها الحياة والمجتمع بكل ما تحمله الكلمة من قسوة، وما عانته من اضطهاد جسدي ونفسي؛ كانت تبحث عن ومضات من الحياة ولحظات من الفرح؛ مع كل ذلك. هل أردت طرح مسألة صلابة المرأة الفلسطينية؟
ليس فقط صلابة المرأة الفلسطينية، وإنما صلابة المرأة، صلابة العاشقة، صلابة كل العاشقات.. “مخمل” هي رواية النساء المحبّات، المولّهات، المتيمّات، الذائبات في العشق الخالص؛ “مخمل” هي رواية النساء اللاتي يشتققن الصبر والبقاء والجمال من وسط القبح والموت المحتم؛ “مخمل” هي رواية النساء اللاتي يرفضن أن يُكسرن، مرممات جراحهن في سبيل حياة مشتهاة تليق بهن. رغم كل ما تواجهه حواء من قهر، فإنها تظل صلدة، متجاوزة عذاباتها المادية بقوة الخيال الساطع الذي يسند وجودها.. ومع كل ما تتعرض له من انتهاك جسدي سافر، فإن روحها لا تُمس.. لا تُهزم، ولا تتحطّم. أسوأ شيء يمكن أن يلحق بالإنسان، رجلاً كان أم امرأة، هو أن تُكسر روحه. لا شيء يمكن أن يعوض انكسار الروح.. لا شيء.
14- شخصية “حوا” في مخمل تنتمي إلى جيل ما بعد النكسة (1967م)، ما الذي اختلف في شخصية الفلسطيني على مستوى الأجيال نفسيًا وسيكولوجيًا وحتى فكريًا وسياسيًا ؟
لقد اختلف الكثير بلا شك. الفلسطيني بعد نكسة 67، كأنه صحا على هزيمة ثانية فادحة، بعد نكبة 1948؛ هذه الهزيمة الثانية – أي النكسة –موجعة أكثر، بل ومذلّة، ذلك أنها أسست فعليًا لمرحلة حاسمة في الشرط الوجودي الفلسطيني عنوانها “الاحتلال” التام، وقضم فلسطين التاريخية بالكامل والقضاء على أي احتمال – في المدى المنظور – لتغيير مسار التاريخ، السائر نحو المزيد من الانحدار. ولا ننسى أن هذه الهزيمة حطمت الذات الفلسطينية والعربية، بالنظر إلى أنها نتجت بعد أمنيات “مضخَّمة” بالنصر لتكشف عن زيف أكثر إيلامًا من أي وقت مضى، ضمن منظومة تواطؤ متعددة الأطراف، وما تمخض عن ذلك من انكسار متعاظم، الأمر الذي أسس لبداية الحلول السياسية المجحفة، ونهاية مشروع الدولة فعليًا على الأرض. نحن لم نخسر معركة، بل خسرنا فعليًا الحرب. من هنا، أضاف الفلسطيني لرصيده من الخسارة خسارة مضاعفة، ضمن إرث متواتر من الشعور بالنفي، النفي عن ذاته وعن وطنه وعن وجوده، أو الأسباب الموجبة لوجوده الذي بات يُمتحن يوميًا. وعلى الأرجح أننا في تلك الفترة كنا عرضة لـ”الاندثار” كشعب بالمعنى المادي والقيمي، وما عناه ذلك من تعزيز المناخ العام بالانحطاط، وزعزعة مفهوم الأرض كجغرافيا، والأخطر من الجغرافيا، زعزعة مفهوم الحق التاريخي في فلسطين. ضمن هذا السياق، فإن شخصيات “مخمل” هي نتاج استحقاق الهزيمة بكل معنى من المعاني؛ الهزيمة التي تستقر مع الوقت في النفس كحجارة ثقيلة. وقطعا، أسهمت بيئة المخيم المشوهة في “مخمل“، عاطفيًا وإنسانيًا ونفسيًا، في تعميق الشعور بالضآلة والخسارة واللاقيمة والانحدار، لتتحول الهوية الفلسطينية إلى استحقاق مؤجل، ولتصبح تداعياتها عبئًا يرزح على كاهل الفرد وكاهل الشعور الجمعي.
15- رغم سيميائية العنوان “مخمل” ودلالته اللغوية والرمزية نحو النعمة والجمال والنعومة، إلا أن “مخمل الرواية” تحمل القهر والظلم والسحق واستلاب الإنسانية؟
يبدو العنوان خادعًا لجهة توقع مناخات الرواية، والإحالات المحتملة، لكن على الأرجح أن “مخمل” كحكاية لا تخلو من (مخمل) كقماشة. فوسط مناخ يطغى فيه الظلم والانسحاق واستلاب الإنسانية، كما تصفها، ثمة فسحة – وإن كانت محدودة – كي نتخيل الجمال، ونطلبه، ونعيشه أحيانًا. إن “مخمل“، كعنوان وكقماشة، هي رمز لكل ما تشتهيه نساء “مخمل” ويرغبنه ويتُقنَ له بشدة: الحب والجمال والحياة والآخر البعيد والسعادة شبه المستحيلة، والمذاق الشهي، والجسد الذي يبوح برغباته بحرية، والجسد الذي يستحق المخمل الغالي، والجسد أيضًا الذي لا يُنتهك، والقلب الذي لا يُسحق.
16- هل الكتابة خيار؟
لم تكن الكتابة يومًا خيار. الكتابة بالنسبة لي جزء عضوي من تجربة العيش ككل. أعتقد أنها تجعلني أكثر تصالحًا مع نفسي، أقل عنفًا. ومع الوقت، ومن خلال الكتابة، بدأت أكوّن ما يشبه الرؤية البانورامية للحياة، واستشفاف أعماق الناس والأشياء والوجود من حولي، على نحو يجعلني أتقبل التناقضات وأقدر الاختلافات، والأهم أتقبل ذاتي بكل صراعاتها وتناقضاتها وتشوشاتها وحيرتها المتأصلة. الكتابة حياة، ويوم أتوقف عن الكتابة سأتوقف عن الحياة.
17- هل الجوائز مهمة في حياة الكاتب؛ خاصة في ظل تجاهل تام من المؤسسات الثقافية العربية لمواطنيها الأدباء والكتاب والمفكرين؟
لا يمكن أن ننكر دور الجوائز في الاحتفاء بالكتب والكتّاب و”تلميع” أسماء وإبرازها. على أنه أيًّا كانت الجائزة الأدبية، فهي لا تشكل مقياسًا موضوعيًا لتقييم منجز الكاتب أو عمله، دون أن يعني ذلك أن الكاتب أو العمل لا يستحق الجائزة. وعلى أهمية الجوائز ودورها في إثارة نقاش وجدل لا ينقطع، وهي ظاهرة محمودة بالنظر إلى الركود الثقافي العام، إلا أنه علينا أن نعترف بأن ثمة شبهة “فساد” تسللت إلى عدد كبير من الجوائز، سواء من خلال “المحاباة” أو “التقسيم الفئوي أو المناطقي”، أو ببساطة من خلال “سوء الاختيار”، الأمر الذي أسهم في إقصاء أعمال مهمة والاحتفاء بأعمال تفتقر إلى الشرط الإبداعي أو الحد المعقول منه. وهذا الأمر لا يقتصر على الجوائز الأدبية في الوطن العربي، التي تكاثرت في السنوات الأخيرة، والمقتصرة في الغالب على الاحتفاء بالجنس الروائي؛ فحتى الجوائز العالمية ليست محصنة أو “نقية” تماماً حيث تتدخل فيها عوامل عدة في الاختيار. غير أن الجوائز العربية تظل تحت الأنظار لحداثتها نسبيًا ولغياب معايير نقدية واضحة وارتهانها لأحكام اعتباطية في معظم الأحوال، حتى إننا بتنا نتوقع أسماء بعينها فيها لا لشيء إلا بسبب التراخي والكسل العام للجان التحكيم وعدم اجتهادها في البحث عن التميز. هذا الأمر، وإن يُفترض ألا يؤثر على الكتّاب الأصلاء ذوي السوية الإبداعية، فإنه لا يعدم أن يخلق حالةً عامة من الإحباط، ناهيك عن الإسهام في الترويج لذائقة قرائية ونقدية مختلّة، ضمن مناخ طاغ من “الميديوكراسي” (أي حالة عامة من الرّداءة”).
أتفهم سعي العديد من الكتاب العرب، حد الهوس أحيانًا، وراء الجوائز، لأسباب عدة في مقدمتها الظهور الإعلامي و”الشهرة” وتحقيق “العالمية” الموعودة، إلى جانب التقدير المادي (وهو السبب الأكثر شرعية برأيي بالنظر إلى أن الإبداع لا يُطعم خبزًا في معظم الأحوال)، لكن في النهاية علينا أن نتذكر أن الجائزة، أيًا كانت، لا تصنع الكاتب وليست مخولة بمنح الفائز صك إبداع!
على المستوى الشخصي لا أشغل بالي بالجوائز الأدبية ولا أنتظرها أو لا أسعى وراءها. هناك جوائز ذات قيمة اعتبارية، مثل “جائزة نجيب محفوظ للأدب” التي نلتها عن روايتي “مخمل”، وأجمل ما فيها بالنسبة لي، أنها جاءتني دون أن أنتظرها أو أطلبها. فهي التي سعت إليّ لا العكس.
18- هل لديك طقوس معينة للكتابة؛ حيث صرحتِ في إحدى اللقاءات معكِ، أنكِ من أجل “مخمل” قمتِ بتهيئة مكان خاص لذلك، بعناصر ومكونات شبيهة بمكونات المخيمات الفلسطينية؟
كل عمل يفرض مكانه ومزاجه الخاص به. في العادة، حين أبدأ عملًا أدبيًا ما، فإنني أخلق له “بيئة” كتابة بعينها، وهذه البيئة تشمل حيز الكتابة، الموسيقى التي أسمعها أثناء الكتابة، إلى جانب أوراق الملاحظات الصغيرة المتناثرة حولي، وغيرها من تفاصيل ومفردات تضفي عليه حسًا بالألفة بالنسبة لي طبعًا. حين أكتب، أؤوب إلى هذا الفضاء لوحدي، ولا أسمح لكائن من كان أن يشاركني فيه أو يحاول أن يغير مفرداته. في “مخمل” تحديدًا، صنعتُ فضاء كتابيًا استثنائيًا، إذ قمتُ بإعادة بناء بيئة المخيم في غرفة خاصة في بيتي، بما في ذلك مقطع من سوق المخيم ومن طرقات المخيم وطرقات أخرى من وإلى المخيم، هي الطرقات التي تقطعها حوا (بطلة الرواية) في جزء كبير من السردية، مستعينة في هذا البناء التخييلي بمئات الصور التي جمعتها من زياراتي الاستقصائية لمخيم البقعة، حيث تدور معظم أحداث الرواية. كما، خصصتُ زاوية من هذا الفضاء الاستثنائي لبناء غرفة خياطة بالأقمشة والخيوط والأزرار وطاولة القص (التي كانت طاولة الكتابة فعليًا). حيث كتبت الرواية على هذه الطاولة ووسط أدوات الخياطة. كذلك اقتنيت كميات كبيرة من مختلف الأقمشة، من خلال زيارات مكثفة لأسواق الأقمشة، مع التركيز على المخمل بأنواع وألوان عدة، رافقتني طيلة شهور الكتابة، وساهمت بطريقتها في صوغ ذاك الدفق الهائل من الحواس في النص. ولم أقم بتفكيك هذا الفضاء إلا بعد فترة من الانتهاء من كتابة الرواية، وهي لحظة عاطفية كانت غامرة بالنسبة لي.
19- هل كنتِ متعاطفة مع الشخصيات-شخصياً تعاطفتُ معهن-؛ (حوا، قمر، درة العين) بمعنى تقصدتِ أن تذهبي بالقارئ إلى ذلك؟
لا أعتقد أن شخصيات “مخمل” تنتظر عطفي أو تعاطفي أو تحتاج إليه. فالشخصيات من السوية وزخم الصورة الحية وزخم المشاعر بحيث إنها قادرة على أن تستدرج القارئ إليها، وأن تدفعه إلى تشكيل رأي خاص به دون تدخل من جانبي. حوا استحقّت أن تُحبّ لدفء روحها وصفاء قلبها، وكذلك قمر ودرة العين. هؤلاء نساء يقدسن الحب ويعرفن كيف يقدمنه.
هذا ربما يقودني إلى عملية “الخلق”.. دائمًا ما يُطرح علي السؤال الآتي: إلى أي مدى يتدخل الكاتب في خلق شخوصه وجعلها على ما هي عليه؟ وهو سؤال صعب وشائك، لأن عملية الخلق الإبداعية تتدخل فيها عوامل عدة. لكن ما أعرفه وما عايشته من تجربتي هو أن نفخ روح الإحساس في الشخصية، كما اشتقاق الشحم واللحم من الخيال، لا يخولنا التحكم بها. صحيح أننا نلد الأبناء لكن هناك مرحلة ما يخرجون فيها من أسرنا، ومن حكمنا. وهذا بالضبط هو الخلق السردي للشخوص.
وعودة لسؤالك مرة أخرى: هل تعاطفتُ مع حوا وغيرها من نساء الرواية؟ بالطبع، فأنا لست قاسية القلب تمامًا، بل إنني تعاطفتُ مع النساء العاتيات الجبارات القاهرات، في لحظات هزيمتهن وانحطاطهن، لكن أحرص بأن أترك خيار التعاطف من عدمه للقارئ.
20- هل يعنيك أن يكون لديك التزامات سياسية عضوية؛ فيما يخص القضية الفلسطينية، أم أنك تراهنين على ما تقدمينه أدبيًّا؟
أراهن دومًا على ما أكتب.. أنا هو ما أكتب.. أنا تمثيل حي فعليًا لما أكتب. وعليه، أحرص بألا أخون ذاتي أو أتنكر لها، وأن أكتب ما أريد أن أقوله لا ما يُراد لي قوله، وأن أقارب فلسطينيتي، منتصرةً أولاً وأخيرًا للشرط الإنساني. التزامي فيما يخص فلسطين و”القضية الفلسطينية” هو التزام إنساني وهو التزام فكري وعاطفي ووجودي قبل أي شيء آخر، وهو التزام تعزز مع الوعي المتعاظم بتنكُّر الآخر لإنسانية الفلسطيني. في كل ما أكتب، أحاول أن أذكِّر نفسي كما أذكِّر الآخر بإنسانيتنا، وما يعتريها من هشاشة وضعف وتداع وشوائب ونواقص وخلل بيِّن لا تزيدنا إلا إنسانية.
21- هل تخططين وتحضرين لعملك، قبل البدء في كتابته؟
أكيد. أي عمل قد يولد من فكرة أو خاطر أو إحساس ما.. (“مخمل” مثلًا لاحت من صورة حلمية غائمة لامرأة تقف تحت المطر وقدماها مغروستان في الطين.. أعتقد أنني كنت بين الصحو والنوم، ومن هذا الصورة خُلقت “حوا”.) لكن قطعًا الفكرة أو الخاطر أو الصور الحلمية تظل قاصرة، ولا تقيم معمار العمل الروائي. غالبًا ما تلعب الفكرة دورًا “كاتليستياً” (بالمعنى التحفيزي) لاستيلاد أفكار وخيالات أخرى. بموازاة ذلك، أبدأ عملية تخيل وتخطيط العمارة السردية، وما يستتبع ذلك من عملية بحث واستقصاء، خاصة إذا كانت طبيعة العمل ملحمية، كما في معظم رواياتي، ذات امتداد تاريخي وجغرافي. وهذه العملية، أي البحث، مضنية وفي الوقت نفسه ممتعة. بعد البحث، تبدأ عملية الكتابة التي لا تتكئ بالمطلق على مخطط العمارة المبدئي؛ فالكتابة عملية خلق فريدة من نوعها، لا تتبع قاعدة، ولا تنتظم وفق شروط، وتتداخل فيها عوامل وعواطف ومسارات عدة، وغالبًا ما تفاجئني هذه المسارات والتحولات، لأجد نفسي وقد ولجتُ عوالم لم أخطط لها أو لم أكن أتصورها. فأترك نفسي لها، في إطار ما يثري النص ويضيف له، ذلك أنه حتى الخيال له منطقيته الخاصة به ضمن لا منطقيته.
22- نشكركِ في “مجلة الفلق” على إتاحة الفرصة للحوار معكِ.
الشكر لكم لمنحي هذه المساحة للبوح.