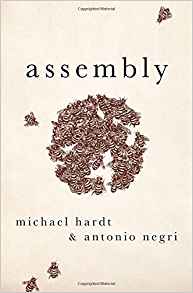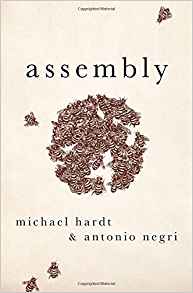المؤلف: مايكل هاردت وانطونيو نيغري
الناشر: Oxford university Press, 2017
عدد الصفحات: 370
لغة الكتاب: الإنجليزية
في هذا العمل وعلى مدى 4 أقسام و16 فصلا يتطرق هاردت ونيغري، وهما اللذان كتبا الكثير من الأعمال المشتركة بينهما والمؤثرة منذ فترة طويلة تتجاوز العقدين من الزمان، وربما أشهرها وأهمها تلك الثلاثية : الإمبراطورية في عام 2000م، والجمهور في عام 2004م، والخير العام أو الصالح العام في عام 2009م. وهما يسعيان في كل الأعمال السابقة وهذا العمل أيضًا إلى وضع طريقة جديدة للتغيير في العالم، وذلك من خلال رصد التحولات التي تطرأ على كل ما من شأنه التأثير في طرق التغيير وأساليبها؛ ذلك أنه وفي الفترة الأخيرة نجد أن الأحداث التغييرية التي حدثت في الكثير من مناطق العالم المختلفة، لم تصل إلى نتيجة مرضية كما يقولان؛ مما لزم وضع خارطة جديدة لجعل هذه الأحداث مؤثرة ومُغيرة بشكلٍ إيجابي. لعل في البداية من الضروري الحديث عن أن عنوان الكتاب بالمعنى الحرفي ينتمي إلى علوم الحاسوب، فهي تعدّ لغة من لغات البرمجة الكثيرة والمختلفة، غير أن هذا العمل يهدف إلى نقل المصطلح من هذا المعنى الحرفي إلى معنى جديد، يقوم على وضع خطة جديدة للتغيير الفاعل، التي أثبتت الأحداث العالمية الأخيرة أنها ليست ناجحة، وهو سؤال يبحث الكثير من الأشخاص عن إجابة واضحة ومقنعة له.
في الفصل الأول(ص4)، المعنون بـ”أين ذهب القادة؟” يتطرق الكاتبان إلى أن الثورات السابقة، أو الحركات الاجتماعية كانت تتم بوجود قيادات لها، وذلك عن طريق أسماء أصبحت شهيرة، ومؤثرة، وبمثابة نماذج انتشرت صورها، ومقولاتها، وطرق حياتها في كل مكان، لدى الكثير من شعوب العالم المختلفة؛ غير أنه لفهم هذه الفكرة ينبغي العودة بهذا الموضوع إلى فترات زمنية سابقة عن الوقت الحالي؛ فإذا كانت الحركات الاجتماعية في الماضي تقوم على وجود قيادات، تقود هذه الحركات الاجتماعية، رافعة شعارات كثيرة، شعوبًا تستمع أو تنقاد لهذه الأفكار؛ فإنها من الجانب الآخر تجسد فكرة بأن للجميع الحق في اتخاذ القرارات العامة، والمشاركة فيها، وبأن لها وزنها وثقلها في هذا الجانب.
في الجانب الآخر، نجد أن العلاقة بين الديمقراطية والقيادة وجدت نفسها في مأزق جذري، عانى من خلاله قادة الثورات، وعلماء الاجتماع وغيرهم في فهم هذه العلاقة وتفسيرها، وهو ما نجده في مفهوم ” التمثيل” بالمعنى السياسي والديمقراطي المتعارف عليه، إذ من الممكن وضعه كمدخل لقراءة الإشكاليات السياسية المعاصرة، فالعلاقة بين فعل التمثيل كما يحدث في البرلمانات المختلفة، وإرادة الناخبين او المُمثلين أصبحت موضع سؤال عميق، ومتشابك، فالإجابة هنا من الممكن أن تأخذ اتجاهين رئيسين ولكنهما متقابلين، إذ نجد أن الأولى تؤكد بأن صلابة هذه القوة تتجسد في الأرضية الشعبية التي تؤسس لما يشبه القوة الدستورية؛ في حين إن الثانية تتعلق بالسيادة وتحديدًا بالسيادة الشعبية، التي من الضروري أن تكون محمية، ومنفصلة، عن الدستور، وذلك من خلال وجود آليات واضحة، ومحددة تتبعها. وهو ما يضع هذا المفهوم أمام وضع متقابل، ومتناقض.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن عدم وجود قادة لهذه الثورات أو الحركات الاجتماعية يعدّ نقلة أو أعراض نقلة تاريخية كبيرة (ص8)، وهي تعود بشكل ٍ أساسي إلى أن البنية الهرمية أو البطريركية لها قد تفككت، أو انقلبت على وظائف هذه الحركات، فهي تعود إلى وجود أزمة تمثيل كما تم التوضيح سابقًا، أو وجود أزمة عميقة تتمثل في عدم وجود طموحات أو تطلعات في الديمقراطية المعاصرة.
وربما الإجابة البسيطة هنا للسؤال السابق عن أسباب غياب القادة يمكن تلخيصه في أنهم اختبأوا أو تواروا خلف التشريعات والقوانين المختلفة والمستجدة من جهة، أو تم القضاء عليهم من قبل السلطات المحلية المختلفة، كما هو الحال لدى روزا لكسمبورغ، وأنطونيو جرامشي، والتركي إبراهيم كابكايباكايا…وغيرهم، غير أنه في المقابل من الضروري القول بأن هذا القمع والاستهداف لهذه القيادات ليس جديدًا، فهذه الإجابة تقع في النطاق التقليدي، ولا تعبر عن الوضع بشكل ٍ دقيق. من الممكن القول هنا، بأن هذه القيادات قد تم انتقاداها وإزالتها من أماكنها الطليعية، بسبب احتكارها للسلطة والتمثيل من جهة، وعدم التزامها بمنح الأعضاء الحق في الكلام والتعبير عن الرأي، الأمر الذي أصبح عائقًا أمام جوهر الديمقراطية، وروحها، ليصبح السؤال هنا: هل من الممكن بناء مؤسسة بدون نظام تراتبي؟ أو منظمة بدون مركز؟ (ص14)، وهو ما يحيلنا على التساؤل حول سيادة هذه المؤسسات أو المنظمات في الفكر السياسي المعاصر؛ إذ إن هذه السيادة ليست مطلوبة أو إلزامية لمثل هذه المؤسسات في الوقت الحاضر، إذا أخذنا في الحسبان بأن هذا الموضوع قد طُرح منذ فترة طويلة من قبل الكثير من المفكرين والفلاسفة الأوروبيين.
في الفصل الثاني من هذا العمل (ص15)، يناقش المؤلفان مسألة الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة لأساليب التغيير؛ ذلك أنه أصبح من المألوف الحديث عن أن التغيير يمر بالكثير من الآليات والطرق السلمية المعترف بها والمتعارف عليها، مثلما هو الحال في الانتخابات السياسية، والإجراءات البيروقراطية، غير أنها لا تقتصر على ذلك فقط، بل تشمل أيضًا على ضرورة وجود استراتيجيات محددة، تلك التي تتضمن وجود إمكانية لدى القادة على القيام بتحليل نقاط الضعف والقوة للقوى التي تقف ضد هذا التغيير، كما تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تأقلم وجهات النظر المتداولة والسعي لموازنتها مع الظروف المختلفة، كما تهدف الاستراتيجيات في الجانب الثالث إلى التحلي ببعد النظر لدى القادة، وتعقلهم للظواهر المختلفة، والتخطيط بعيد المدى، وخلق استمرارية لهذه الأنشطة والفعاليات. في حين إن التكتيكات تأخذ بعدًا آخر، فهي تركز على ترتيب القوى المسيطرة على الجمهور، التي تعد محدودة بطبعها، وذلك نتيجة تركيزها على مجالات محددة، واهتمامات معينة لدى هذه الجماعات البشرية المختلفة.
ومع ذلك؛ نجد أن هناك إدراكا تاما لدى أصحاب النظريات السياسية المعاصرة، بوجود تداخل أو اشتباك بين هذه الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة من جهة، وبين المشاكل التي تعاني منها القيادات المختلفة –التي سبق الحديث عنها – من الجهة الأخرى؛ إذ إن هذه الحلول وقعت بين مجموعتين متجاذبتين، لا ينفصلان عن بعضهما بعضا، وهي: العفوية والسلطة. ففي الجانب الأول: يذهب بعضهم إلى ضرورة وجود تلازم بين الجانبين، فمعاناة الأشخاص، وتمرد العُمال يعدان المحرك الأول الذي يقود التغيير السياسي، غير أنه في المقابل نجد أن هذه الإرادة الشعبية ليست كافية، دون وجود حكمة، وتجربة، ومعرفة. من الضروري على القادة هنا تمثيل الأشخاص بشكل يحميهم، إذ من الممكن التوقف عن بعض طرق التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك؛ ذلك أن الموازنة بين التكتم والشفافية، والسرية والعمومية تعد من الأمور الضرورية، وهو ما جعل المؤلفين يستدعيان حيوان القنطور الخرافي، الذي ينتمي للأساطير الإغريقية، والذي يتكون من جسد حصان وجذع ورأس إنسان، وذلك في إشارة واضحة إلى ضرورة الموازنة والجمع بين الجانبين المتناقضين. في هذا السياق نجد أن ليون تروتسكي الزعيم الماركسي البارز وأحد زعماء ثورة أكتوبر 1917م الروسية، يذهب إلى أن الرغبة في تفوق الطبقة العاملة يحتاج إلى أكثر من التمرد العفوي، إنها تحتاج إلى منظمات مهيأة، وخطط، ومؤامرات.
في حين يذهب الجانب الثاني إلى أن هذه الحركات تحتاج بشكل أساسي وأولي إلى عفوية وإرادة صادقة من قبل الناس، وهذا يستلزم بأن التغيير يأتي ضمن أولوياتهم، بعيدًا عن السلطة ورغبة القيادة. وهذا يشمل آراء الكثير من الأسماء الأساسية في تراث الحركات الاجتماعية التي تدعو إلى التغيير.
من الممكن في هذا السياق الذهاب إلى أطروحة الماركسي البارز أنطونيو جرامشي حول العلاقة بين القادة والشعب من جهة، والسلطة والديمقراطية من جهة أخرى (ص18)، التي تمثل ما يمكن التعبير عنه بـ” مركزية الديمقراطية” حيث يواصل جرامشي شرح هذه المسألة التي تعد بمثابة أطروحة تجمع بين الضد ونقيضه؛ ذلك أنها تعد مركزية في الحركات الاجتماعية للتعبير، ولمواصلة عمل هذه المنظمات بشكل ٍ واقعي، تضمن من خلاله الدفع بهذه النقائض إلى الأمام، من الأسفل إلى الأعلى والعكس، كما أنها تعد جامعة، أو مؤلفة للنقائض. بكلام آخر، من الممكن القول إن هذه العلاقة بين الديمقراطية والقيادة المركزية ليست بين طرفي نقيض بقدر ما هي اختلاف بين القوانين، وتباين بين الاستراتيجيات والتكتيكات التي تدعو إلى التخطيط والعفوية وكيفية الجمع بينهما في شبكة واقعية فاعلة.
في الفصل الثالث من هذا العمل (ص25) والمعنون “ضد روسو: وضع حد للسيادة”، يتعلق النقاش هنا بطرح تساؤلات حول السيادة، وبشكلٍ خاص مع انخفاض الحس القيادي لجانب القوانين والخطط التكتيكية من جهة، ومع تزايد وارتفاع حضور الجمهور والمستويات الاستراتيجية، تبقى مسألة السيادة في هذا السياق في موضع تساؤل أكثر من قبل، إذا اخذنا بالاعتبار بأن السيادة هي من يقرر كما قال كارل شميدت، في حين إن القادة من الممكن أن يتخذوا قرارات في مناسبات معينة، وهذا لا يعني بأنه يجب النواح والندب على فقدان السيادة، بل على العكس من ذلك؛ ذلك إنها ملتبسة وغير واضحة بشكلٍ كبير وجلي للكثيرين، فهي مختلطة مع الاستقلالية والإرادة الذاتية، غير أنها في المقابل تشير للكثيرين إلى علاقات القوة والسيطرة، ذلك أنها تعني ذلك الحق الحصري لاستخدام القوة السياسية، كما أنها تقع دائمًا في علاقة مباشرة مع الذوات البشرية. وبعيدًا عن التوصيفات المختلفة للسيادة، نجد أنها قد ولدت في أوروبا، وذلك بعد انتقال السلطة الإمبريالية من روما إلى القسطنطينية، ذلك أنه منذ ذلك الوقت أخذ مبدأ السيادة يقترب من سمات الاستبداد، غير أنه لاحقًا ومع انحلال الإمبراطورية وتفككها، ومع مولد الدولة- لقومية تم إعادة استخدامها كمفهوم أساسي في الدولة المعاصرة. من الضروري القول هنا إن السيادة تشكلت بشكل وظيفي فعال، وواقعي بعد اتفاقية وستفاليا، ووضع القانون الدولي لبناء السيادة القومية لكل بلد على حدة.
يستتبع الحديث عن السيادة – أي وضع قوانين عن الأشخاص الذين لا يستطيعون سن قوانين لأنفسهم- بالضرورة الحديث عن مفهوم التمثيل بالمعنى السياسي، ونقد هذا المفهوم الذي يعد مشابهًا لمفهوم السيادة من حيث وجود علاقة غير متساوية في صناعة القرار السياسي، فالمواطنون عندما يسعون لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم فإنهم بذلك يقوضون مفهومي السيادة والتمثيل.
يقودنا الحديث عن مفهوم التمثيل إلى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وموقفه منه؛ ذلك أنه يعرف جيدًا باستحالة التمثيل السياسي(ص27)، فهو يعرف جيدًا بأن الإرادة الشعبية والجماعية معقدة جدًا، وربما متناقضة في كثير من الأحيان؛ إذ تعود هذه الأفكار إلى تلك الأوضاع المعقدة والمتضاربة التي كانت سائدة آنذاك في عصره.
في الجزء الثاني من هذا العمل (ص77)، يتطرق الكاتبان لمسألة غاية في الأهمية، وهي مسألة الإنتاج الاجتماعي، إذ يسعى هذا الجزء إلى استكشاف طبيعة الإشكاليات السياسية من خلال الهيمنة الاجتماعية، وتحديدًا عن طريق الحكومات النيوليبرالية، والسلطة المالية في عالم اليوم، تلك التي تتوسع وتحول أنماط استغلالها وسيطرتها الرأسمالية؛ ذلك أن بعض هذه الأدوات ثابتة في مسار التطور الرأسمالي لهذه المجتمعات، إذا عرفنا كيفية استخدامها بشكل ٍ جيد. فهي تنتج بشكلٍ مستمر آليات وحشية، وجامدة لكيفية السيطرة والاقتناص، وتنتج في المقابل أيضًا معاني وأساليب جديدة للمقاومة والتحويل (بالمعنى النفسي). من خلال هذا الاستكشاف للأساليب المعاصرة في الهيمنة، نستطيع كشف ومعرفة القوى المُنتجة وإمكانياتها المختلفة للتحكم في الجماهير، وحيازة حياتها اليومية. تبدأ الواقعية السياسية مع القوة التي تقلب المفاهيم وتصورها رأسًا على عقب؛ ذلك أن هذه البداية ستنتهي بالضرورة برؤية المسار نفس. فمن الضروري في هذا السياق معرفة أن الليبرالية الجديدة والهيمنة المالية تأتي كرد فعل على قيم الحرية والليبرالية ومشاريعهما؛ إذ تأتي المقاومة بوصفها وضعا طبيعيا لهذه القوة، وما يستتبعها، لذلك نجد أن من ضمن المفاهيم المركزية في الواقعية السياسية تبدأ مع الجمهور (هنا إشارة الى كتاب المؤلفين في عام 2004م بالعنوان نفسه)، كما قال مكيافيلي وسبينوزا بعد ذلك، فهذه الواقعية السياسية لا تستوجب فقط معرفة الناس كما كانوا، بل كيف هم هنا والآن، وكيفية معيشتهم، وطرق إدارتهم لحياتهم، مما يعني ضرورة رؤية العالم من الأسفل، من حيث يعيش البشر ويتفاعلون مع بعضهم بعضا.
وربما السؤال هنا: ما الذي من الممكن أن يفعله الجمهور؟ وماذا يفعل هذا الجمهور بشكٍل فعلي وواقعي؟ ذلك أننا في حاجة لتتبع التحليل المادي لهذا الشغف الذي يتمتع به الجمهور.
للإجابة عن هذا السؤال من الضروري معرفة وفهم كيفية تصاعد طبيعة الإنتاج الاجتماعي من خلال مسارين حول كيف ولماذا يتم إنتاج الجمهور، وهو ما يتطرقان إليه في الفصل 6 من هذا العمل تحت عنوان: ” كيف نضع الملكية الخاصة للعموم؟”(ص85). ففي ما يخص الملكية الخاصة نجد أنه منذ عقود تم سن قوانين تحافظ على الملكية الخاصة، وتعدها مقدسة، فهي من الحقوق التي لا يمكن مصادرتها، فهي الحصن المنيع الذي تتحصن به المجتمعات من الفوضى، ذلك أنه بدون ملكية خاصة لا تنعدم العدالة، والحرية، والتنمية الاقتصادية فقط؛ بل أيضًا لا نجد معنى للذوات من حولنا، أو لا حياة اجتماعية كما نراها ونعرفها. فالحق في الملكية منصوص عليه في الدساتير، ومتجسدة في النسيج الاجتماعي الذي يحدد الحس المشترك بين الأشخاص في المجتمع الواحد. فالمليكة الخاصة لم تكن معروفة قبل العصر الحديث، التي كانت ممهدة لعصر جديد، فبدون الملكية الخاصة كان من المستحيل فهم أنفسنا، وعالمنا أيضًا.
لفهم أهمية الملكية الخاصة من الضروري معرفة أنها ليست مقدمة للعدالة، والحرية والتنمية الاقتصادية، بل على العكس من ذلك، فهي تعد عائقًا للحياة الاقتصادية، وأساسًا رئيسًا لسيطرة اجتماعية غير عادلة، وسببًا رئيسًا لخلق التراتبية الاجتماعية واللامساواة بين الأفراد.
في الفصل السابع (ص107) بعنوان “نحن مواضيع ميكانيكية أو آلية”، يتطرق الكاتبان بعد تحليل الملكية الخاصة كنوع من أنواع الإنتاج الاجتماعي وأسلوب من أساليب السيطرة، إلى العلاقة بين الإنسان والآلة أو التقنية، فقبل الحديث عن هذه العلاقة يسعيان لتبديد الكثير من وجهات النظر السابقة حول هذه العلاقة بين الطرفين، وذلك التعارض أو التقابل بينهما، من خلال عملين مهمين وأساسيين في هذا السياق، الأول لماكس هوركايمر وثيودرو أدورنو المعنون بجدلية التنوير(1947م)، إذ كُتب هذا العمل تحت تأثير جرائم النظام النازي، وتلك التأثيرات الكبيرة والمختلفة على القرن الحادي والعشرين، وطرح تساؤلات جذرية عن شعارات التنوير كالحرية، والتقدم، في ظل التقدم التكنولوجي وما رافقته من شعارات طوباوية انقلبت لاحقًا وتحولت إلى النقيض بشكلٍ وحشي وعنيف.
العمل الثاني لمارتن هايدغر بعنوان: سؤال التقنية، الذي صدر أيضًا بعد فترة قصيرة، والذي يتفق بشكل أساسي مع أطروحة جدلية التنوير، من حيث إن العلم والتقنية ليسا محايدين؛ فجوهر التقنية – يقول هايدغر- هي كشف إطار الحقيقة، غير أنه اليوم لم تعد العلاقة كذلك؛ بل أصبح يتم استخدام التقنية كأداة. وهذا ما نجده واضحًا في علاقة الإنسان بالطبيعة بشكلٍ عام، إذ إن التقنية قد أثرت في الإنسان في جوهره بشكل كبير، وهو ما أثر في الأمل البشري في الحرية، والوجود البشري (وهي الأطروحة المركزية لدى هايدغر).
ربما السؤال هنا: هل التقنية المعاصرة مسؤولة بشكل كبير وأساسي عن الدمار والمصير البشري؟
ففي وجهة النظر الأولى نجد أنه من غير الممكن تجاهل التأثير التكنولوجي على المجتمعات والكوارث البيئية، التي أنتجت كثيرًا من الأمراض، والمآسي، ولكنها أيضًا وضعت التاريخ البشري والنظام البيئي للأرض في طريق الدمار بشكل يبدو نهائي. في هذا السياق لا يمكننا أن ننسى أو نتجاهل بأن الإنسان والحضارة الإنسانية على حدٍ سواء يلفهما الغموض بدون التقنية، فالآلات والتفكير الميكانيكي قاما بتهيئة عوالمنا وذواتنا بشكل كبير، وجوهري.
وجدت وجهة النظر هذه العديد من الردود والاعتراض التي من الممكن تلخيصها بأنها تنتمي لما قبل العصر الصناعي، أو قبل الرأسمالي (ص109).
إذا كان الجزء الثاني قد تطرق إلى الإنتاج الاجتماعي؛ فإن الجزء الثالث (ص155)، من هذا العمل الكثيف والغني، يتطرق لمسألة لا تقل أهمية عنه، وهي الإنتاج المالي والاقتصادي والليبرالية الجديدة التي تحكم وتتحكم بالجمهور (حسب مفهومهما الموضح في كتابهما “الجمهور”)، فالليبرالية الجديدة تعد ردة فعل على الحركات الاجتماعية، والتنوير، ومقاومتها للشيوعية العالمية، وذلك من خلال الاستخدام الرئيس للأيدولوجيا والأفعال الاقتصادية بالإضافة إلى الأطروحات الفلسفية والتنظير السياسي. فهي بهذا المعنى أصبحت “علم” عوضًا عن العقيدة، تدوير أو تنقل رأس المال عوضًا عن سلطة الكنيسة، قوة السوق بدلا من الهوية القومية. تُظهر الليبرالية الجديدة الوجه الاقتصادي؛ ولكن بقلب سياسي، فهي لا تستعيد حرية السوق؛ بل تعيد تعريف الدولة واختراعها، وذلك بتخليصها أو تحريرها من صراع الطبقات أو المطالب الاجتماعية، فهي تضع التطورات الرأسمالية النظرية والتطبيقية بعيدًا عن مخاطر الصراع الاجتماعي والمخاض الديمقراطي.
لفهم هذا السياق بشكل أفضل ينبغي رؤية الاقتصاد أو الجانب المالي من الجانبين: العلوي والسفلي، وتأثير ذلك على القيم الاجتماعية؛ ذلك أنه عندما ظهر الاقتصاد بشكل مهم، وكعنصر مؤثر في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، أعطى قوة كبيرة لرأس المال الصناعي، الذي أبقي السيطرة الكبيرة للاقتصاد على التشكيلات الاجتماعية الداخلية في المجتمعات، وهو ما تجلى بشكلٍ كبير ما بعد عام 1970م، إذ إن الرؤية من الجانب الشعبي أو الأسفل تقوم على تأثير الجانب المالي على المقاومة، وعلى الإنتاج الاجتماعي على حد ٍ سواء، وهو ما يعني ضرورة تحليل الجانب الاقتصادي المصغر(مايكرو)، فتزامن صعود الهيمنة المالية مع تزايد قوانين اقتصاد السوق، وردود الأفعال على تراجع الاقتصادات الوطنية المنظمة، إذ انتقلت مراكز القرار والرقابة من الدولة القومية إلى المعايير الدولية التي تسيطر على الديون الاجتماعية، الأمر الذي انتزعت معها بشكل ٍ تدريجي السيادة الوطنية، وسلمتها للقيم التي تُحكم بواسطة الأسواق المعولمة، التي تدار بدورها عن طريق الرأسمال المالي.
في الفصل الحادي عشر (ص183)، يتحدث هذا العمل عن النقود بوصفها مؤسسة للعلاقات الاجتماعية، فالنقود في عصرنا أصبحت الأكثر انتشارًا في وجودنا المعاصر، إذ نجد أنه ليس من الصعوبة فهم دورها فقط؛ بل أيضًا كيف تتحكم في حياتنا وتؤثر في سن الكثير من القوانين. فالكثير من النظريات تذهب إلى النقود تساهم في تسهيل حياتنا المعاصرة، عن طريق شراء السلع واعتبارها أداة محايدة؛ غير أنها في الجانب الآخر، تعد أداة من أدوات السلطة وتعبيرًا عن النفوذ لبعض المؤسسات والأفراد. ولفهم هذه العلاقة بين النقود و المؤسسات الاجتماعية، يتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وهي على الشكل الآتي: التراكم الأولي الذي يقوم على مجموعة عناصر مترابطة منها الإنتاج المؤقت الذي يشمل وقت العمل والمهام وحيادية الإيقاع أو التأثير، في حين أن شكل القيمة في هذا النمط يقوم على فائض القيمة بشكل كامل، فهي يتم استخلاصها من الغزو والسلب. في حين أن الجانب الثاني حيث التصنيع وأنماط التصنيع الكبرى يعتمدان على الوقت المحدد وتقسيم أوقات العمل، وعلى جزئية فائض القيمة، كما يتم الحصول عليها من الاستغلال الصناعي والاستعماري. أما الجانب الثالث فهو الإنتاج الاجتماعي الذي يقوم على تقسيم أسبوع العمل إلى 24 ساعة في 7 أيام في نظام معولم لا يتوقف عن العمل، معتمدًا في ذلك على السياسة الحيوية وما تنتجه من فائض القيمة، كما أن مصادرها تقوم على الاستيلاء على العموم، وهي المرحلة الحالية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة.
من المهم القول هنا بأن النقود عندما تنتج هذه العلاقات المختلفة فهي لا تنتجها بحد ذاتها، بل تقوم بذلك عن طريق مؤسسات تديرها وتتحكم بها الليبرالية الجديدة المنتشرة في كل ثنايا المجتمع المختلفة (ص207)، فالسردية المعيارية أو المتداولة تذهب إلى أن الليبرالية الجديدة ظهرت من أزمة البيروقراطية المعاصرة، حيث تزايدت مع خفوت سيادة الدولة القومية، وعدم استقرار أو ضعف هذه المؤسسات مع إجراءات الخصخصة وقوة المؤسسات المالية العالمية.
في خاتمة هذا العمل الغني والمشتبك مع الكثير من الأعمال والنصوص والاستراتيجيات والنقد لكل شيء تقريبًا، يطرح الكتاب نقاطًا مهمة عن الواقعية السياسية (ص231)، فالقوة تأتي في المرتبة الثانية، في حين أن الأشياء والمواضيع والاهتمامات العامة تأتي في المرتبة الأولى في سياق الحركات الاجتماعية الجدية التي تسعى إلى التغيير والثورة على الأوضاع السائدة؛ ذلك أن هذه الحركات لا تمتلك القوة في عصر الإمبراطورية، بل تستطيع اللعب على التحركات الاجتماعية والاهتمامات التي من الممكن أن تصاغ بهذه الطريقة التي تأخذ في الحسبان الجمهور بتعدده، واختلافه، وفي الوقت نفسه بذلك الاجماع المشترك حول الأهداف وطريقة الوصول إليها.