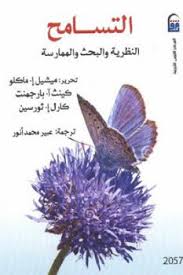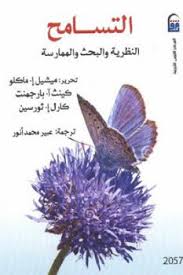للكتب الرائدة ميزة تفرقها عن سواها من الإصدارات في مجالها، فهي التي تأخذ على عاتقها فتح آفاق وخوض غمار بحث في مسائل لم تبلغ بعد مرحلة التناول العلمي المتخصص، إنها المعالجة التي تتميز عن سابقاتها من خلال هذه الإفاضة البحثية، والشرح التفصيلي، والتدقيق في المسائل الفرعية المهملة. والكتاب الذي بين أيدينا واحد من هذه التجارب، أخذ فريق إعداده من العلماء والباحثين المتخصصين، ومن ورائهم فريق من المحررين، كل هؤلاء أخذوا على عاتقهم مهمة تزويدنا بخلاصة وافية لموضوع بزغ مجال بحثه في فترات قريبة؛ إذ تزايد الاهتمام بحثا ودراسة في قيمة “التسامح”، وغدا هذا الموضوع واحدا من مجالات البحث والتدقيق لدى علماء النفس والفلسفة والتاريخ، الذين أسهم كل في مجاله في إثراء هذا المفهوم وبشكل علمي متخصص.
وجاء هذا الاهتمام في التناول وعلى هذا المستوى من البحث، نتيجة انتباه التربويين وعلماء الفلسفة والتاريخ، إلى هذه الحالة المتزايدة – ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي- في معدلات الأحداث المؤلمة والمفجعة في التعامل الإنساني، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي محاولة لبحث حالة التصدع في البنيان الاجتماعي والسياسي، ومع تعالي الأصوات المنادية بضرورة إعادة بناء الثقة بين طرفي – أطراف – العلاقة، بغض النظر عن مستوى تمثيل هذه العلاقة، جرت هذه الالتفاتة وهذا الاستحضار المتأخر لقيمة إنسانية، أما الغاية فهي لا تعدو أكثر من تحقيق مستويات أعلى من التناغم بين البشر.
ولأننا نشهد تحولا متأخرًا في تناول موضوع هذه القيمة الإنسانية، وما رافقه من إثارة أسئلة نوعية بدرجة أكبر؛ فإن أبرز ما يريد هذا الكتاب قوله على نحو غير مباشر، أنه من غير المحتمل الكشف عن الأسس النفسية – العصبية المرتبطة بالتسامح، ثم عرضها على نحو تبسيطي واعتمادها بوصفها أداة قياس مكونة من بند واحد كما كان في السابق، أو من خلال إقرار الأفكار النمطية السائدة التي عايشتها البشرية عبر ترديدها عبارات مفرطة في بساطتها من قبيل: أدر خدك، سامح وانسَ؛ إن هذه النظرة التبسيطية لا تستطيع في الواقع أن تقدم كثير مساعدة بهدف مقاومة المشاعر التي تعيق على نحو عميق حدوث التسامح بصورة حقيقيّة. وللوصول إلى هذه الغاية، فإن هذا الكتاب لا ينفك عن طرح الأسئلة والمزيد منها، والذين انخرطوا في إعداده ونشر بحوثهم عبر صفحاته تتملكهم جميعا قناعة واحدة، مفادها: إن الأسئلة المتعلقة بالتسامح ما زالت تفوق الإجابات، وإن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى المزيد من البحث والتأمل.
كتاب “التسامح: النظرية والبحث والممارسة”، هو بالأصل مجموعة أوراق بحثية، قدمها عدد من ذوي الاختصاص على مستوى عالمي في لقاء علمي مشترك ضم علماء وباحثين في مجالات التربية وعلم النفس والفلسفة والتاريخ، ولاحقا جمعت أوراق العمل المقدمة لتصدر بين دفتي هذا الكتاب بعد تحريرها وتبويبها، إضافة إلى تصنيفها وفقا لعناوينها والمواضيع التي تناولوها. ونتيجة هذا التقسيم توزعت الأبحاث على أربعة أجزاء تفرع منها أربعة عشر فصلا، كل فصل يتناول موضوع “التسامح” إما على مستوى بيني، بالاعتماد على جداول وأرقام مسحية، أفرغت لاحقا في بيانات ذات معنى ودلالة على فكرة ما، أو أن التناول اقتصر على البعد النظري. وكانت النتيجة العملية لهذا النمط من التأليف أن العمل بمجمله وقع في فخ التكرار، فالفكرة الواحدة أو الاستخلاص الواحد نجده موزعًا في أكثر من مكان، وهذه نتيجة طبيعية في حال اشتراك عدد من العلماء في عملية بحث لموضوع واحد، وإن تشعبت طرق التناول ووسائله. وبالنظر إلى تداخل الأفكار والاستخلاصات مع بعضها في أكثر من موقع، وتكثيفا للفائدة المرجوة من هذا العرض، فإن التركيز سيكون منصبًا في هذه القراءة على الأفكار الرئيسة، إضافة إلى أهم الاستخلاصات دونما التزام بالنسق التقليدي للعرض من خلال تناول كل فصل بشكل منفرد.
ومن خلال نظرة خاطفة لمواضيع الأجزاء الأربعة التي حواها الكتاب، نجد أن الجزء الأول تناول القضايا المتعلقة بصياغة مفهوم تقريبي لمعنى التسامح والقضايا المنهجية الخاصة بدراسته النفسية. فيما الجزء الثاني للجهود التنظيرية الجديدة الخاصة بالدراسة النفسية للتسامح، وهي مستمدة من أربعة مجالات في أسس البحث النفسي. والجزء الثالث يركز على التقييم النقدي للكيفية التي تم من خلالها دراسة هذا الموضوع وتطبيقه في سياق الإرشاد والعلاج النفسي. أما الفصل الرابع فيعالج الموضوعات التي أثارها الكتاب بصورة عامة، ويعرض أهم التوجهات الحديثة في التسامح، التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في البحث والتنظير المستقبلي.
إشكالية التعريف والماهية
إذا أردنا في هذا العرض تجاوز التفصيل الدقيق في تعريف “التسامح”، وتكثيف التباينات التعريفية في عبارة واحدة، لغايات تحقيق أكبر قدر من النفع المعرفي عبر هذه القراءة، يمكننا القول إن التسامح يعني نبذ المشاعر والأفكار والسلوكيات السلبية تجاه من أساءوا إلينا، واستبدال المشاعر والأفكار والسلوكيات السلبية بأخرى إيجابية. ووفقا لهذا التعريف فإن الترجمة العملية والمباشرة لهذا المعنى، تستلزم بالضرورة إتاحة الفرصة، وأن نكون عونا لبعضنا كي نعايش مشاعر التعاطف والرحمة لمن أساء إلينا. وبذا يمكن اعتبار هذا المجال السلوكي واحدا من الطرق والوسائل النفسية التي تخلص بنا إلى الشعور بالسلام الداخلي والسعادة، وهو السبيل إلى الطمأنينة رغم الشعور بالألم، والاستمرار في الحياة بعد تعرضنا للإيذاء من الآخرين.
الملاحظة الأساسية في هذا المحدد بالذات، أن هناك تنوعا في هذه القيمة بين مختلف الجماعات البشرية على اختلافاتها العقائدية، وذلك مع أن الديانات الكبرى تعطي لهذا المعنى قيمة بالغة الأهمية، إلا أن لكل مجموعة دينية فكرتها الخاصة وتعريفها الذاتي. وعلى سبيل المثال، وجد الباحثون عددا من الاختلافات في تعريف “التسامح” بين المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، والكيفية التي ينظر بها أتباع أي من هذه الأديان إلى المعنى ذاته. فالمسيحية تصف التسامح من خلال التعبير عن الحب والشفقة والرحمة، فيما تتميز نظرة كل من الإسلام واليهودية الى هذا المعنى من خلال رسم خط فاصل بين التسامح والتصالح عبر عملية تبدأ بإبداء التوبة من قبل المسيء، يعقبها التسامح من قبل الضحية. فيما وصفت ذات الفكرة باعتبارها الانصراف عن كل ما هو سلبي في المعتقد الهندوسي. هذه التباينات والاختلافات على مستوى العقائد في تعريف قيمة أخلاقية يحرص كل منها على إبرازها باعتبارها قيمة أصيلة ضمن محتواه العام؛ تستدعي بالضرورة سؤالا بالغ الأهمية فيما إذا كانت الفروق بين أنساق هذه المعتقدات تتحول بالضرورة إلى فروق بين الأفراد الموالين أو التابعين لكل دين؟ وهل يعرف كل فريق التسامح فعلا على نحو مختلف عما هو عليه لديه الفريق الآخر؟ وإلى أي حد يجسد أعضاء هذه الأديان تعاليم دياناتهم فيما يتعلق بالتسامح ويلتزمون بها ؟
إذا انتقلنا من البعد الديني إلى المنظور النفسي، فإننا نجد اختلافا بين علماء النفس في تحديد ماهية هذا المعنى: فريق يرى فيه تخلي المُساء إليه عن حقه في الانتقام ممن أساء إليه، والتغلب على مشاعر الاستياء والغضب، والانصراف الذهني عن الأفكار والسلوكيات السلبية تجاه المسيء. فيما يذهب أنصار فريق ثان إلى أبعد من ذلك من خلال تعريفهم للتسامح باعتباره تغيرًا يحدث لدى المُساء إليه تجاه المسيء، وتخلي الأول عن حقه في الغضب وإصدار الأحكام السلبية، وإبدائه كل أشكال الحنو والشفقة نحو المسيء، وينتج عن هذه العملية عادة انخفاض في دافعية المساء إليه للثأر. وفي حال أردنا استخلاص مضمون التسامح وفقا للتعريفين السابقين يمكن القول إن المظهر الأول يكمن في تخلي المساء إليه عن المشاعر والأفكار والسلوكيات السلبية، والمظهر الثاني يكمن في نمو الانفعالات والأفكار والسلوكيات الإيجابية تجاه المسيء وإبداء السلوك الخيري تجاهه.
أنماط التسامح:
هناك عدة أنماط من التسامح: التسامح المعرفي، هو قرار يتخذه المساء إليه للتحكم في سلوك المسيء لغاية خفض السلوك السلبي أو السلوك الإيجابي لدى هذا الأخير، وهذا النمط لا يرتبط بالضرورة بتغيير المشاعر تجاه المسيء، وإنما الهدف يكون معرفيًا بحتًا، وينظر إليه بعين التفهم فقط. هناك التسامح الوجداني ويبلغ منتهاه عندما يصل المساء إليه إلى مرحلة العلاقة الوجدانية المحايدة مع المسيء، ويحدث هذا في سياق العلاقة مع الغرباء أو مع أشخاص لا يكون لدى المساء إليه رغبة في توطيد علاقة مستقبلية مع من أساء إليه. وهناك التسامح الحقيقي، الذي يتضمن المكونين المعرفي والوجداني، وفيه يتعامل المتسامح مع الإساءة بعين التفهم من جهة، إضافة إلى قراره بالتخلي عن حقه في الثأر، وهي مرحلة تحدث تحولا جوهريا في علاقة كل من المسيء والمساء إليه. وهناك التسامح الزائف، الذي يتم التعبير عنه سلوكيا فقط، فتصدر عن الفرد سلوكيات تنم عن التسامح استجابة للضغوط الواقعة عليه من قبل الآخرين، ومجاراة للأعراف الاجتماعية، وفي هذه الحالة لا يعايش العمليات المعرفية والوجدانية التي تستثير حدوث التسامح الحقيقي لديه. وهناك التسامح الأحادي حينما يختار الفرد أن يسامح من أساء إليه. وهناك التسامح المتبادل ويشير إلى مجموعة من السلوكيات الأخلاقية التي يقوم بها كل من المسيء والمساء إليه. إلا أن التسامح لا تتوقف أنماطه باقتصاره على أنماط التعامل مع الآخرين، فهناك أيضا التسامح مع الذات الذي يعرف بأنه الميل لتجنب اللوم الذاتي المفرط، بمعنى أن الفرد المتسامح مع ذاته يعترف بأخطائه ويبدي توبته وندمه، ثم يتوقف عن الاستياء والنقد الذاتيين على نحو مؤلم.
من المتوقع إلى غير المتوقع
لعل من أغرب الاستخلاصات التي خرج بها الباحثون خلال مناقشاتهم ومجهودهم الفكري في استنباط المزيد من المعاني حول هذه المسألة، أنهم لاحظوا وجود جانب سلبي لبعض نماذج السلوك المقترن بالتسامح، خصوصا تلك المرتبطة بأكثر أشكالها سطحية وزيفا، عندئذ تكون عواقب التسامح مؤذية وتلحق أضرارًا بكلا الطرفين. وهذه المسألة مرتبطة أساسا بالدافع من وراء التسامح: فالتسامح الذي يستخدم سلاحا للانتقام من الآخرين، أو لجعل المتسامح يوظف سلوكه كسلاح ينتقم به من الآخرين، أو لجعل المتسامح يشعر بأنه أفضل أخلاقيا من الآخرين، فإن هذه النماذج ترتبط عادة بالانفعالات والاتجاهات السلبية، وذلك بخلاف ارتباط التسامح الذي يُمنح للآخرين لقيمته الجوهرية، فإن هذا النموذج يرتبط دائما بالانفعالات والاتجاهات الأكثر إيجابية.
كما يفترض باحثون بعض الخسائر المحتملة لأكثر أشكال التسامح صدقا، فربما تنتج عن هذا المستوى العفوي والصادق، نتائج مغايرة يعبر عنها من خلال مشاعر الضعف والجرح لدى الشخص المتسامح، الذي من المحتمل أن يُترك فريسة لمشاعر عدم العدل والظلم، وربما يفقد الفوائد التي تتحقق له في علاقاته مع الآخرين من خلال وضعه كضحية، وزيادة على ذلك ربما تجعله مبادرته في التسامح عرضة للاستهداف والإيذاء بدرجة أكبر في المستقبل. وبناء على هذه المشاهد التي تتكرر بنسب غير قليلة، تغدو الإجابة على أسئلة ملحة مطلبا عادلا ومنطقيا، مثل: هل يشجع التسامح على تغير المسيء وعلى الحل البنّاء للمشكلات، وعلى التواصل الحميم وجدانيا بين الشخص المتسامح والمسيء ؟ أم أنه في الأساس يكافئ المسيء على سلوكه، وبناء على ذلك إما يؤيد نمط العلاقات المتبادلة الهدامة، أو يفاقم من خطورتها؟ والإجابة عن هذه الأسئلة قد لا يكون بالضرورة سهلا، فالتسامح قد يكون مفيدًا في أوقات محددة وفي مواقف محددة ومع أناس محددين، وقد يكون غير ملائم أو حتى مؤذيا في مواقف وأوقات أخرى، ويقدم بعض الباحثين تحذيرات من التسامح فيما يتعلق بهذا البعد على وجه الخصوص.
من جملة الأسئلة المعرفية المرتبطة بهذا البعد تحديدا، يبرز السؤال الآتي: هل يعني التسامح التجاوز عن أخطاء الآخرين؟ وتأتي الإجابة الفاحصة والمدققة بـ “لا” كبيرة، والسبب أن التسامح عملية إيجابية هدفها تعديل موقف الإساءة أو إعادة تصحيحه بما يعود بالخير على كل من المساء إليه والمسيء، أو على الأقل إعفاء المسيء من تهديد المساء اليه أو عقابه.
ومن جملة الملاحظات التي توصل إليها الباحثون في العلاقة بين من أسيء إليه بالمسيء، هذا الربط المثير الذي أظهروه بين التسامح والموروث الشامل المتعلق بسمات الشخصية الأخرى، سواء بأبعادها النرجسية أو من خلال السلوك المتفهم والمميز، ووجدوا أن السمات المميزة للشخصية النرجسية، كالشعور بالجدارة والتكلف والتيه الذاتي والحساسية المرتفعة للنقد ونقص التفهم، كلها خصال تؤهل صاحبها لأن يكون أقلّ تسامحًا، فيما يكون التسامح متفهما ومقبولا، بل وحتى مرحبًا به، لدى الشخصية ذات الرتبة الأعلى التي تضبطها عدد من الخصال الخاصة، كالحساسية الشديدة للظروف الملطفة للغضب والمهارات الخاصة بالتحكم في الانفعالات والتفهم والتواضع والامتنان.
كل من تتاح له فرصة قراءة هذا الكتاب سيخرج بجملة من الانطباعات الرئيسة، أهمها أن لـ “التسامح” أكثر من بعد، وأنه أكثر تعقيدًا مما تخيلناه في البداية، وأن ثراء الظاهرة يستلزم بالضرورة أساليب فهم وأدوات قياس ومناهج بحث أكثر تنقيحا وأكثر تنوعا بالمقارنة مع هذه التعميمات التبسيطية حول المفهوم. وهذا يستدعي بالضرورة أن يبقى الباحثون والممارسون منفتحين على الجوانب غير المتوقعة للتسامح، ولإمكانية أن يكون لهذه القيمة السلوكية بعض العواقب المدهشة على المساء إليه والمسيء في آن واحد، إضافة إلى تأثيراته على مستوى النسق الاجتماعي الأكبر. ولتحقيق منافع إنسانية أكبر من هذه القيمة الأخلاقية، فإن عمليات مثل أساليب التدخل ذات الصلة مثل تعليم مبادئ التسامح وتعميمها على نطاق واسع، من شأنها أن تمنع حدوث ألم طويل المدى أو على الأقل التخفيف من حدته، واذا لم يقدم التسامح كبرنامج تدريبي، فيمكن أن يصبح موضوعا للمناقشة في المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد التعليمية العليا في السياقات المؤسسية.
بقي أن نذكر أن كتاب ” التسامح: النظرية والبحث والممارسة” تحرير: ميشيل إ. ماكلو/ كينث آ. بارجمنت/ كارل إ. ثورسين. ترجمة: عبير محمد أنور. صادر عن المركز القومي للترجمة في القاهرة والكتاب موجود بصيغة pdf على محرك البحث غوغل.