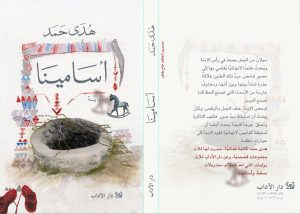بلغنا السنتين أنا وأخي، وليس لأحدٍ منا اسم. عندما يُقال يا بنت ألتفتُ، وعندما يقال يا ولد يلتفتُ أخي. وعلى نحو غريب تجنبنا الجميع، لم تفكر أي من النسوة بحملنا، وأي من الرجال لم يضحك في وجهينا، كأن نحسا ما يحيطُ بنا. وكلما أصرّ أبي على أن يُطلق علينا الأسماء ذرفت أمّي الدموع. “سيأكلهما السحرة ما إن نسميهما”. فيقول لها أبي: “سوف نذهب إلى مسقط سنبدأ حياة أخرى هناك، سيكون لهما مدرسة وحياة أخرى. سيح الحيول بلا مدرسة بلا مستشفى. ينبغي أن يكون لهما شهادتا ميلاد. إنّ مستقبلهما غامض على هذا النحو. أريد لهما حياة أخرى”. كان أبي قلقا من هلعها المضاعف من الأسماء. “الولد ضعيف، لو أنّي سميته فربما يموت. إنه منسي الآن. إنّه بلا اسم. انتظر حتى يشتد عوده”. كان تعلقها يتضاعف كل يوم بالولد، تحبه وتدلله وتشفق على ضعفه.
بعد مرور سنة من ولادتنا، قررت أمّي أن تدخر حليب ثدييها معا لابنها المريض. كنتُ كلّما اقتربتُ منها أبعدتني عن حجرها. أمسكُ بطرف غدفتها وأبكي، وأتوسل إليها أن تتركني لأرضع منها، لكنها تنكبُ في محاولات مستمرة لإشباع الولد. كنتُ أشاهدها تلوح بيديها وتتحدث بكلمات لا أعرفها. لكني أستشعر غضبها فأبتعد.
بدأتُ بشرب حليب البقرة والماعز، أجلسُ فوق طابوقة بجوار العمّة صاحبة الفص وهي تخبز باكرا. أنقلُ الخبزة الساخنة من يد لأخرى، لأتفادى حرارتها. بينما تزيح العمّة شعري المبعثر على جانبي وجهي، أغمسُ الخبز في الحليب الدافئ لتسكت قرقرة معدتي. تنظرُ أمّي إلى العمّة بحنق وتقول: “انظري. لقد امتصت عافية الولد.كانت تمتص عافيته منذ أن كان في بطني. انظري لا أحد يصدق أنّهما توأم. الولد يتهالك كل يوم”. كنتُ لا أفهم ما تقول على وجه الدقة، ولكني أعرف أنّها غاضبة مني، دون أن أدرك أسباب غضبها.
في تلك النهارات البعيدة، كانت كلماتي قليلة وبالكاد تعدُّ على اليد الوحدة، إلا أنّي امتلكتُ جملة، جملة أكبر مني بكثير، أضمرتها بيني وبين نفسي:”سأتجنبُ أمّي”.
تعودتُ على تجنبها والالتصاق بالعمّة، العمّة التي تُعطيني كل شيء، الطعام وبعض الابتسامات، بل إنّها عندما ذبحت بقرتها في العيد، أخذت الحبل الذي لطالما ربطت به البقرة، وعلقته في شجرة الغاف التي تتوسط البيت وأصبح لي أرجوحة. أجلستني على اللوح الذي شبكت به الحبل لكيلا تتأذى مؤخرتي، وبدأت في دفعي، وتهيأ لي أني أطير. تذكرتُ الشقلبات في رحم أمّي، ثم نفضتُ رأسي، عندما ساورني شعور غامض بأنّي كنتُ أركل أخي الضئيل، أوقفت الأرجوحة وملأني الحزن: “ماذا لو كانت أمّي تعرف أني ركلته حقا. هل يعقل أن يكون هذا هو سبب هياجها؟”.
أصرّ أبي على أخذنا أنا وأخي وأمّي إلى مسقط. كنا قد أكملنا سنتنا الثانية. قال إنّه سيعرض الولد على طبيب جيد، وأنّ هنالك استوديو يمكن أن نلتقط فيه صورة للعائلة قبل أن يكبر الصغيران. وافقت أمّي على مضض، فانطلقنا إلى مسقط بسيارة أبي الـ”جي تي” التي كان قد اشتراها مُستعملة. لم يقل الطبيب شيئا أكثر من أنّ أمور توأمي طبيعية وأن أمّي تُبالغ في توهم المخاطر المُحدقة به. طلب منها الطبيب ألا تقارن بينه وبيني، فلكل منا بنيته الجسدية. طمأنها الطبيب بما استطاع من قوة أنّ الولد سيكبر وستصبح له بنية قوية وأنّ شهيته ستنفتح في قادم الأيام، ووصف لها بعض المُشهيات.
تناولنا غداءنا لأول مرة في حياتي كلها في مطعم صغير، وكان الطعام لذيذا. أكلتُ بيديّ، وظلت أمّي تضع الطعام في فم الولد وهو يتقيأه. سمعتُ أبي يردد كلمة استديو التصوير وكنتُ لا أملك أي تصور عن هذه الكلمة!.
لأول مرّة أرى رجلا بقميص وبنطال، الأمر الذي دفعني للالتصاق بأبي، ولأول مرّة أرى ورقا ملصقا بطول وعرض الحائط. كانت صورة لأشجار النخيل وشلالات ماء تحيطُ بنا من كل اتجاه. قال أبي: “إنّها الهند”، ثم وقفنا جميعا. وضع أبي يده على كتف أمّي واحتضنتْ أمّي الولد بين يديها، وكنتُ أنا بين سيقانهم، لا أعرف ما الذي ينبغي أن أفعله، فهبطت يدُ أبي الأخرى على كتفي فشعرتُ بالاطمئنان، وظهرت صورتي مطمئنة، بينما وجه أمّي يميل نحو أخي تماما.
دشداشة أمّي القصيرة حمراء اللون تكشفُ عن سروال أخضر تحتها، فرقت شعرها في جديلتين وتركتهما يتدليان على جانبي رأسها، بينما غطى الليسو المزركش نصف مفرقها، ولم يكن لأحد أن يتبين عينيها في الصورة، حيث كانت تضعهما برفق في عيني الولد. ظهر أبي بدشداشته البيضاء ومِصَرٍ على رأسه، وأخي بوجه مريض، وأنا بفستان مُكشكش يميلُ إلى الزرقة يصل إلى تحت ركبتيّ. لكن الصورة أخفت ألواننا جميعا، فخرجنا بالأبيض والأسود.
علّق أبي الصورة في بيتنا الصغير، وكانت تلك أول صورة عائلية تعلق في كل سيح الحيول. قالت العمّة صاحبة الفص: “أنت تفعل دائما الأشياء للمرّة الأولى”. تبسم لها أبي: “قريبا سوف أشتري كاميرا صغيرة، ومن يدري قد ألتقط لكِ صورة يا عمتي”. تدفقتْ ضحكة صغيرة من فم العمّة الذي قلما يضحك، وبدا وكأنها تتمنع، لكنها في حقيقة الأمر وما إن صدق أبي الوعد حتى وقفت كما قد يفعل جنديٌ يتأهب لمعركة. لقد حاول لمرات عديدة أن يُخفف من تلك الجدية والصرامة القاتمة في ملامحها إلا أنّها لم تكن لتتصور أن ثمّة وضعية أخرى للوقوف أمام الكاميرات. علّق أبي صورتها على الجدار المقابل لصورتنا قال لها: “سيبدو وكأننا ننظرُ لبعضنا دوما”.
يمكن أن نقول إن العمّة لم تمتلك يوما شيئا ذا قيمة كما هو حال تلك الصورة التي تظهر فيها بغدفة سوداء على رأسها ومفرق شعرها الذي خالطه البياض، ودشداشتها بنفسجية اللون القصيرة التي تكشف عن سروال ممتلئ بحيوية الألوان كانت قد سهرت ليالي كثيرة لإنجازه. كانت كاميرا والدي التي أحضرها من أسفاره الكثيرة تخرجُ الصور بالألوان، وليس بالأبيض والأسود.
لم تقل العمّة شيئا ولم تجد كلمات لتشكر أبي كل ما قالته: “إنّها أكثر وضوحا من أي مرآة رأيتُ فيها نفسي”.
أثارت الكاميرا التي تقف على ثلاثة أقدام انتباه الجيران وفضولهم ، عندما أخرجها والدي من علبتها الكرتونية، كما يُخرجُ الساحر الماهرُ أرانب وفئران من قبعته. كان رأس أبي يندسُ تحت الملاءة السوداء تماما، بينما يقفُ أحد رجال القرية أو أطفالهم في مواجهته، مبتسما أو متجهما، فاردا جسده أو جالسا على صخرة أو ممسكا بغصن شجرة، كان أبي يرشدهم طوال الوقت لتبدو الصورة أفضل ما يمكن.
اقتطع والدي جزءًا من غرفة المعيشة، سوّره بالأخشاب، وفرش فوقه ملاءة سوداء، ومنعنا جميعا من الاقتراب، علّق حبلا رفيعا أشبه بحبل الغسيل، وترك المشابك لتتدلى منه. وضع صحونا معدنية واسعة، وسكب فيها سوائل عجيبة، وأكثر ما أتذكر الآن هو تلك الرائحة الحادة التي تنتشر في أرجاء البيت. قال لي مرارا: “الأحماضُ خطرة، ينبغي أن لا تقتربي”. ولم اقترب يوما إلا من مسافة تجعلني أنظر للجيران وأطفالهم وهم معلقين في حبل المشابك. كان مُدهشا حقا أن يتحول ضجيجهم وحيواتهم الصاخبة إلى شيء بذلك الجمود. قلّة من النساء وافقن على التقاط الصور، فقد خاف الرجال كثيرا من أبي ومنعوا زوجاتهم من الانجرار خلف الأشياء التي يُفاجئهم بها من أسفاره الكثيرة. كان أبي مصدر قلق وفضول في آن.
عكف ليالٍ كثيرة حابسا نفسه في زاويته المظلمة تلك، تحول إلى كائن ليلي قليل الكلام، قليل المواساة، لا يأوي إلى فراشه إلا في ساعات الفجر الأولى، الأمر الذي دفع أمّي للشكوى المستمرة، “كانت تريده لها وحدها، وحدها وحسب، لكن أبي بقلبٍ مسروق”.
ينظر أهل القرية إلى صورهم، يمسكونها بين أياديهم غير مُصدقين، قال بعضهم: “من علّم هذا الرجل السحر؟”. فيبتسم أبي ويتأمل دهشة وجوههم ويتركهم لتخمينات لا نهائية. يحفظ الأهالي الصور في الأماكن الأكثر سرية كمن يخفي ثروة، ولكن ما أن يموت أحدهم حتى تحرق الصور، “الصور تعذب الموتى” هكذا يقولون. لقد حاول أبي مرارا أن يمنعهم عن فعل ذلك، لكنهم لم يرتدعوا.
حدثني والدي عن رجل البانيان الذي ابتاع منه الكاميرا وعلّمه السحر. رجل البانيان الذي يقطن في سوق مطرح، ويحضر بضاعته من الهند، فيتجشم أبي المسافات الطويلة توقا ليعرف شيئا جديدا عن العالم .
أعرف أين يختفي والدي ما إن يتشاجرا هو وأمّي لأسباب تتعلقُ بانشغاله عنها، أجده دوما حيث أخمن، تحت سدرته البعيدة والمعزولة عن القرية، يجلسُ وينظر إلى الجبال التي تُحدقُ بنا من كل اتجاه، كالجنود الذين لا يفارقون جبهاتهم، ويصوبون أسلحتهم لأي حركة مهما بدت صغيرة. أجلس جواره مُلتصقة به، لكنه لا يمد ذراعه ليطوقني كما يفعل عادة، بل يعكفُ على شرب شيء ما، شيء يبدو حارقا كتلك الأحماض التي يخشى عليّ منها، فما إن يصل جوفه قطرات منه حتى تطفر عيناه بالدمع. أبقى جواره لا أتحدث، أعدُّ الحمير القليلة التي تمرقُ جوارنا، وأنصتُ لكل الجُمل التي تعتمل في رأسه.
في الوقت الذي انفرجت فيه أسارير العمّة انغلقت أمّي على نفسها، وتكبدت مشقة هائلة. كانت ستجن لو أنّ مكروها يصيب الولد. قالت مرارا وبصيغ مختلفة، “البنت لا تمرض، البنت لا تشتكي من علّة والولد عليل!”، وكان أبي يغضب منها ويحملني على أكتافه، سائرا بي نحو المزرعة التي بذر فيها الذرة والقمح والقت والمسيبلو. حتى إنّ المانجو أوشك أن يثمر، والنخلات ممتلئة بالأعذاق الثقيلة. ماء البئر يتفجر كينبوع في الحوض الذي تركني أبي فيه لأسبح. كان ذلك بعد أن اشترى دينمو صغيراً يعمل على الكهرباء المؤقتة التي وصلت إلى القرية.
ظنت أمّي بأن أبي مسروق القلب، وأنّي أنا من سرق قلبه، ولكنها لم تقل له شيئا من هذا. أخبرت العمّة بالأمر فضحكت ضحكة مجلجلة أخرجتها من جديتها المعتادة، “تغارين من بنت صغيرة.. إنها ابنتكِ!”، ثم ناولتها كمّة وطلبت منها أن تزينها بالنجوم لتُشعر أبي بأنّها تحفل بأمره. لكن أمّي أهملت الكمّة والخيوط في صندوق فضي لعدّة أشهر، ولم تشعر برغبة في ذلك. لقد بدأت تقيم بعض العلاقات مع الجارات. تريد أن تعرف أكثر عنهن وعن أطفالهن. تريد أن تخرج من الحزن الذي ألمّ بها بسبب شقاء أخي في علله المتلاحقة. العمّة كانت تقدم لهن المساعدة دوما لكنها يوما لم تفتح معهن الأحاديث ولم تشرب بصحبتهن القهوة، كانت متنائية وقليلة الكلام.
لكن أمّي بدأت تخرج لجاراتها حقا لتقلل ضجيج الوساوس التي تعصف بها، لا سيما أنّ أبي منغمسٌ في أشغاله وأسفاره التي لا تهدأ. تذهب إليهن ساعة الظهيرة والولد في حجرها، فيما أبقى أنا مع العمّة لأراقب الماعز فوق تلك السهول التي اخضرت في ذلك العام لكثرة السيول التي هطلت.