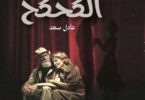أحب الكتب التي توسّع وجهات نظرنا إلى العالم وتدفعنا لطرح الأسئلة وللتفكير
أحترم القارئ وأسعى دائما إلى مخاطبة ذكائه.
فاتحة مرشيد، شاعرة وروائية مغربية، وطبيبة أطفال، عضوة باتحاد كتاب المغرب، وحاصلة على جائزة المغرب للشعر سنة 2010. شاركت بقراءات شعرية في عدة ملتقيات ثقافية داخل المغرب وخارجه، وتُرجمت بعض أعمالها إلى عدة لغات: الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية، والتركية، والصينية.
أشرفت على إعداد وتقديم برنامج يهتم بالتربية الصحية في القناة الثانية المغربية لعدة سنوات، كما أشرفت على فقرة “لحظة شعر” في البرنامج الثقافي “ديوان” بالقناة نفسها.
تتراوح إصدارتها بين الشعر والرواية والقصة وطب الأطفال، بصفتها طبيبة متخصصة في هذا المجال.
وقد صدر لها في الشعر: إيماءات”(2002)،”ورق عاشق”(2003)،”تعال نُمطر”(2006)، “أي سواد تخفي يا قوس قزح”(2006)،”آخر الطريق أوّله”(2009)، “ما لم يُقل بيننا” (2010)، “انزع عني الخطى” (2015).
كما صدر لها في الرواية: “لحظات لا غير”(2007)،”مخالب المتعة”(2009) ،الملهمات”(2011)، ”الحق في الرحيل”(2013)، “التوأم” (2016). وفي القصة صدر لها: “لأن الحب لا يكفي” (2017).
كما صدر لها كتابان فنيان مع فنانين تشكيليين مغاربة: “ورق عاشق” و”حروف وألوان”. وكتاب مشترك من إبداع ثلاث نساء مغربيات وثلاث أمريكيات صدر بثلاث لغات، العربية، الانجليزية والإسبانية يحمل عنوان “مشكال، نساء بين الثقافات”. أمّا في مجال الطب فلها مرجع مهم في ميدان التربية الصحية وهو “الإسعافات الأولية للطفل”.
- كتبت خمس روايات في مواضيع مختلفة وفي وقت وجيز، من أين تأتي الفكرة عند فاتحة مرشيد ؟
الزمن نسبي على العموم، ونسبي بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالكتابة. كل رواية جديدة هي مغامرة جديدة تنطوي على صعوبات جديدة.
لا أعلم من أين تأتي الفكرة بالتحديد، يقول فارغاس يوسا بأن “الحياة هي التي تفرضها علينا”. على العموم ليس المهم من أين تأتي الفكرة ولكن كيف الإمساك بها؟ أنا في حالة تأهب دائم للإمساك بأفكار جديدة ألتقطها بفرح طفل وقلق مبدع. فرح لأنها بمثابة هدية. وقلق من ألا أكون في مستوى تطلعاتي الخاصة أثناء بلورتها فنيا.
- – تطرقت في روايتك الأخيرة “التوأم” لموضوع علمي مهم، كيف يمكننا أن نتناول هذا النوع من المواضيع العلمية في عمل أدبي، دون السقوط في التقريرية أو الغموض الذي قد يشتكي منه القارئ؟
رمزية التوأم في الرواية تذهب أبعد من الجانب العلمي وفكرة جنينين يتقاسمان الرحم نفسه. ولو أنها تطرقت إلى نفسانية التوأم وإلى هذا الارتباط الذي يجمع بين توأمين والوجع القاهر الذي يخلفه فقدان أحدهما.
الرواية في جوهرها رواية البحث عن توأمنا على اعتبار أن “لكل توأمه “ البحث عن الآخر فينا، ومن ثم عن أنفسنا.
هي تبدأ بسؤال “من أنا؟ وتنتهي بسؤال/ جواب هو: “ولم لا؟
وبينهما يقودنا السارد في سفر تأملي، سفر البحث عن ملاذه، هذا الملاذ الذي يوجد في أعماق كل منا.
الرواية، هي كذلك، حول الثنائيات التي لا توجد الواحدة منها دون الأخرى: ثنائية الواقع والخيال وسؤال الحدود بينهما. ثنائية الممكن والمستحيل في الحب وفي الحياة.
العمل الروائي عملٌ فنيٌّ قبل كل شيء، ما يهم ليس بالأساس الموضوع وإنما الطريقة الفنية التي عولج بها وقدرتها على تشويق القارئ وإمتاعه موازاة مع تمرير بعض مفاتيح المعرفة.
- إلى جانب موضوع “التوأم”، أشرت أيضا إلى مواضيع أخرى من بينها السنيما، والمهاجرين المغاربيين المتقاعدين بفرنسا من جهة، ومواضيع أخرى علمية كالحمل من جهة أخرى، ما جعل الرواية بمثابة موسوعة شاملة، ما السر في هذه الشمولية العلمية الأدبية؟
الجميل في العمل الروائي هو كونه فضاء يستوعب كل أنواع المواضيع وأشكال الكتابة.
ورواية التوأم اتخذت الفن والإبداع بكل أنواعه خلفية لها. تحضر السينما بقدرتها على ابتكار الأحلام والمعجزات، ويحضر الأدب بأساطيره وبنسجه الرفيع لحيوات مختلفة، والتشكيل بولعه حد الجنون.
نحن نكتب الروايات التي تعجبنا قراءتها. وأنا أحب الروايات التي تجعلني أستمتع وأستفيد في الوقت نفسه. أحب هذا الإحساس بالامتلاء الروحي والمعرفي الذي تمنحه بعض الروايات.. أحب الكتب التي توسّع وجهات نظرنا إلى العالم وتدفعنا إلى طرح الأسئلة وإلى التفكير. أنا أحترم القارئ وأسعى دائما إلى مخاطبة ذكائه.
- الجديد في رواية “التوأم” مقارنة بسابقاتها، هو توظيف الحوارات الصحافية، وهناك ثلاثة حوارات: حوار الصحافي الفرنسي مع سارق اللوحة، حوار الصحافية الإيطالية المختصة في السينما، ثم حوار الصحافية مع الشيباني في بداية الفيلم.
الرواية تتسع لكل أشكال الكتابة بما في ذلك الحوارات. وأنا أحب الحوارات العميقة التي ينجزها الصحافيون بذكاء يجعل المحاوَر يروي قصته في غفلة منه، من خلال أجوبة قد تبدو بسيطة أو متقطعة.. لكن على المتلقّي أن يفكّ شفرتها وأن يربط بعضها ببعض ليصل إلى حكاية هي حكاية المحاوَر.
- وظفت الميثولوجيا في الرواية، ما الذي يستهويك في الميثولوجيا؟
أحب الميثولوجيا لأنها تزخر بكل ما يمكن استنتاجه عن السلوك البشري وعلاقة الإنسان بأخيه. تجد الغيرة والحب والانتقام والحقد والنبل.
نحن لا نخلق حكايات جديدة، نحن نعيد صياغة القديم فقط.
نحن نغير النظارات لرؤية بانوراما الإنسان نفسه. الإنسان هو من خلق آلهة الميثولوجيا ونسبت لها حكايا وقصص. تجد إله الحب، وآلهة الخصوبة وإله الشر والخير.
إنها إسقاطات الإنسان في محاولة منه لسبر أسرار الكون من خلال تفسيرات مريحة قد تصبح عند بعضهم اعتقادات راسخة.
- تقولين في أحد الحوارات: “كل حالة أعيشها هي ذريعة للكتابة”. إلى أي حد تساهم الدكتورة في مد الروائية بالمواضيع والشخوص المناسبة لعمل روائي ما؟ أعني هل عملك بالطب أثر فيك أدبيا؟
أنا إنسان تمتهن الطب وتستبدل – من حين لآخر- سماعتها بالقلم لتشخيص علل المجتمع، إيمانا منها بقدرة الكلمة على ترميم شروخ أرواحنا وعلى أن الإبداع إكسير الحياة.
هل عملي بالطب أثر فيّ أدبيا؟ كل ما نفعله وكل ما نقدم عليه يؤثر فينا بصفتنا مبدعين ويترك بصماته على إبداعاتنا. ممارسة الطب بالنسبة لي أكثر من مجرد مهنة إنها تجربة حياة غنية جعلتني أقترب أكثر من جوهر الكائن من معاناته وهشاشته ومواجهته الحتمية للموت.
الطب يكسر الأوهام، والإبداع يرممها وأنا أحتاج إلى أوهامي كي أتحمل الحياة. يتهيأ لي أنني أفهم الأشياء أكثر حين أكتبها.
والطبيبة تُسهم في مد الكاتبة بمواضيع وشخوص إلى حدّ كبير، لأنهما ذات واحدة وأنا لا أفرق بينهما.
وكل حالة أعيشها، إن بشكل شخصي وإن بالنيابة عن آخرين، هي بالفعل ذريعة للكتابة أكانت مرتبطة بمهنتي أم بتجارب الحياة الخاصة والعامة.
- في دراسة نقدية حول الرواية نشرها الكاتب إبراهيم الكراوي بجريدة القدس العربي، جاء في جزء منها أن “شكل الرواية يذوب في بوتقة العلائق المتشابكة بين الشخوص كأننا أمام شكل جديد للحبكة المعروفة في الأدبيات السردية الكلاسيكية، وهو الشكل القريب المستلهم من أسلوب كتابة السيناريو”. هل هذا الأمر يمكن أن يجعلنا نرى “التوأم” فيلما سينمائيا يوما ما؟
كون السارد مخرجًا سينمائيًا جعل الرواية تتخذ شكل فيلم، “إنها الرواية/الفيلم” كما قال عنها الناقد الدكتور وليد جاسم الزبيدي. السارد يستدعي القارئ/المشاهد إلى قاعة العرض المعتمة ليشاهدا معا شريطا سينمائيا من إخراجه، الذي هو بالنهاية شريط حياته.
أنا عاشقة للسينما ومدمنة أفلام. أشاهد الأفلام ربما أكثر مما أقرأ الروايات. أحتاج هذا السفر في عوالم الصورة، أعيشها بكل جوارحي، أبكي وأضحك وأنفعل وأموت أحيانا أمام شريط سينمائي. وهذا ينعكس بالطبع على رواياتي. وهي على حد قول بعض النقاد والمخرجين السينمائيين تصلح جميعها أن تحول إلى أفلام سينمائية.
- نقرأ على ظهر الغلاف: “هناك مكان بداخلي، بعمق أعماق ذاتي لا يستطيع أحد الوصول إليه، مكان مُحصّن، أهرب إليه كلما شنّت الحياة حربها عليّ ولفتني بالضياع المضاجع.. “
قلت بأن “التوأم” هي رواية البحث عن هذا المكان/ الملاذ الذي يوجد في أعماق كل منا.
هل يمكن أن تقربي القارئ من هذا الملاذ؟
هناك فعلا “ملاذ” يوجد في أعماق كل منا، هو ذاك الذي يسعى إليه الحكماء والمتصوفة الذين يقضون حياة بأكملها في البحث عنه. لكن يمكن لكل منا الاقتراب منه ما استطاع.
بواسطة التأمل والإنصات إلى الذات. الثرثرة تفرغنا من ذواتنا وعلينا أن نعيد الاعتبار إلى الصمت في زمن التواصل المفرط. أتعلم؟ مشكلة الإنسان تكمن في رغبته اللامتناهية في غواية الآخر. مرهقة هذه الطاقة التي نبددها في محاولة اقتناص نظرة إعجاب أو كلمة رضا مع أن الأجدر هو أن نستعملها في الوصول إلى الرضا عن أنفسنا.. وحبها أكثر.
كيف نمر من حب إعجاب الآخر بنا إلى الحب اللا مشروط لذواتنا؟
بتفادي المقارنة التي هي سمّ العصر، والتي تنبني عليها وتتغذى منها وسائل التواصل الحديثة.
لو استطاع الإنسان الوصول إلى استيعاب كون الاختلاف هو الأصل، فهو سيتقبل الآخر ويتقبل نفسه. وربما يصل إلى نوع من السكينة التي يصبو إليها الجميع.
- تطرقت في الرواية إلى ظاهرة “متلازمة ستاندال” وعلى أن من الفن ما قتل. كيف ذلك؟
أجل من الفن، كما من الحب، ما قتل.
الفن بكل أنواعه يؤثر فينا انفعاليًا؛ لأنه يخاطب النصف الأيمن من الدماغ. ولأن كل أنواع الفن تحكي حكاية فهي تخاطب بالضرورة البعد الكوني لانفعالاتنا، وتخلق بينها وبين المتلقي روابط انفعالية وتواصلا عاطفيا.
لكن ما جعل أعراض “متلازمة ستاندال” أو “متلازمة فلورنسا، التي تعرض لها الكاتب الفرنسي “ستندال” وكتب عنها لأول مرة سنة 1817، أكثر حدة هو تعرض المتلقي لكم كبير من الأعمال الفنية الباذخة الجمال. فلورنسا هي المدينة المتحف التي تحتوي على روائع من الفن قد تثير في السائح، الذي يتمتع بحساسية مرهفة، انفعالات قوية ومشاعر حادة قد لا يقوى الجسد على استيعابها كلها دفعة واحدة فيصاب بدوار وارتفاع دقات القلب والغيبوبة أحيانا.*