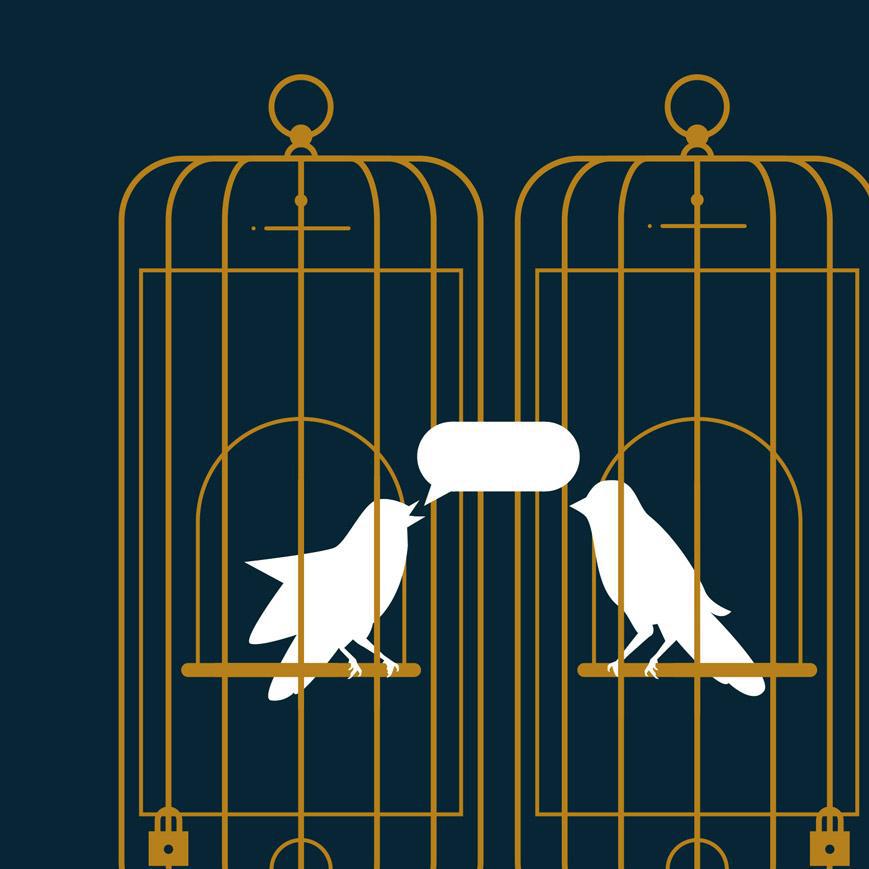إلقاء اللًّوْم على الآخرين نسخة متطرفة من الميول نحملها جميعًا، اللًّوْم دافع نفسي عميق الجذور لحماية الذات، يجعلنا نملك فاعلية أكبر لحماية الذات، ونتجنب الاعتراف بالمسؤولية الشخصية. هكذا حاول المحلل النفسي، ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ أن يفسر ظاهرة نفسية تبدو كمتلازمة إنسانية في أوقات الكوارث خصوصًا وهي ” توجه الإنسان نحو الخارج ومحاولته إلقاء اللوم على الآخر”.
ضرب اللوم بجذوره عميقًا شؤوننا اليومية، وصارت ممارسة هذا السلوك أمرًا اعتياديا مفروغا منه؛ تحصيل حاصل. ولا يعني ذلك إنكار روعة “اللوم” في تشكيل حياتنا، فهو غالبًا ما يعد وسيلة حميدة تظهر بوصفها مزاحا لطيفا بين أفراد العائلة، والأصدقاء، والأحباب، والأزواج. لكن الجانب الآخر لسلوك “اللوم” مروع؛ ذلك أنه سام ومؤذٍ، يدمر كل ما يقع تحت وطأته، فهو قادر على الإطاحة بأقوى العلاقات الإنسانية، وتعطيل الحس الإخلاقي، ويعلن إطلاق الحروب، ويعطي المبررات للإبادات الجماعية.
اكتسب اللوم قدرة استثنائية على تفسير بعض الأمور، ويتميز التفسير المنبثق عن اللوم بالمرونة، إذ يقدم الأجوبة المطلوبة التي يمكن استغلالها سياسيًا واجتماعيًا، مثلًا: لماذا هناك بطالة؟ – العمالة الوافدة السبب، لماذا ختان المرأة؟ – لشهوة المرأة الجنسية، لماذا ترتفع معدلات التسريب من التعليم؟ – الطلبة مهملون، لماذا انتشر وباء كورونا؟ الصين تأكل الخفافيش.
كيف تمكن سلوك “اللوم” بهذا القدر من حياتنا، وصار يشكل العديد من طبيعة العلاقات، والتفاعلات الاجتماعية؟ ما عواقبه، خيرًا كانت أم شرًا؟ هذه التساؤلات يحاول الباحث البريطاني ستيفن فاينمان أن يقف على إجابة لها في كتابه “صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام”، وهذا انطلاقاً من رحلة علم نفسية، وتاريخية للبحث جذور اللوم ومظاهره، بدءاً من ممارسات “كبش الفداء” و”حالات الوصم” وتحولات هذه الممارسات التي ما زلت قائمة حتى يومنا هذا.
آلية نفسية
يلجأ ستيفن فاينمان إلى علم النفس وخصوصًا إلى كارل يونغ الذي عمِلَ على كتابه الأحمر بين عام 1915 وحوالي 1930، بالتزامن مع بداية الحرب العالمية الأولى، وفي ذروة تطور البشرية نحو التقدم العلمي والصناعي وما تلاها من حروب واستبداد وتملك وسيطرة، وفي ذروة توجه الإنسانية نحو الحياة الاستهلاكية والصراعات الطبقية، وتوصل لوجود جانب قابع في الظل من شخصية الإنسان تُقيم فيه العيوب وسمات الضعف وانعدام الأمن، والعدوانية والكراهية والدوافع الجنسية، ولكي نطرد هذا الجانب من الوعي الإنساني، نقوم بدون بوعي بتشكيل سلوكنا لإدانة الآخرين على أخطاء لا نستطيع الاعتراف بوجودها في أنفسنا.
لكي نُعبر عن مشاعر إحباطنا وأوجه القصور التي نواجهها، نتبع نوعًا من الإغراق أو الغَمْر النفسي Psychological dumping : وهذه الآلية النفسية تعمل خلال عملية إلقاء اللوم على الآخرين والانتقاص منهم لرفع مكانتنا، حينها نشعر أننا تجاوزنا القصور والإحباط، وقمنا بتفريغ أعبائنا، ويمكنا الاستراحة بعض الوقت.
يشير يونغ إلى وجود منطقة ظلًّية في عقولنا تعمل على مستويين فردي وجماعي. على المستوى الفردي تكمن بداخل هذا الظل كل السمات والصفات السيئة والشريرة في الشخصية، التي يرفض الوعي الاعتراف بوجودها بوصفها جزءا من الشخصية وليس دخيلة عليها. وهذه الصفات الشريرة هي التي تظهر باعتبارها مكونا فعالا على المستوى الجمعي، حيث الجماعات تسقط ظلها الجماعي مِن لوم وانحياز ومخاوف على ما تراه كبش فداء مُناسب، لتكن أمة أو طائفة أخرى مثلًا. يونغ كان صاحب مزاج سوداوي، ولم ير مفرًا للإنسان مِن هذه المنطقة الظلية، ولا يمكن لأي قوة أن تخلصه منها. ولهذا يستمر الإنسان في أختراع أو خلق أهداف جديدة ليسقط لومه عليهم، ليحولهم إلى كباش فداء، وكلما تختفي، يظهر غيرها لتعلو الأمة أو الجماعة ذات القدرة على ممارسة اللوم على حساب الضحايا البائسين.
كبش الفداء
تعد فكرة إيجاد كبش فداء نقطة محورية في نجاح “إلقاء اللوم” وتبعاته، فبواسطة كبش الفداء يحرر الناس أنفسهم من الذنب، ويلقون اللوم على هدف بريء (إنسان، جماعة، دولة…)، ربما، لذا يرى عالم الأنثروبولوجيا جيمس جورج فريزر إن إيجاد كبش فداء يمكننا من تحميل شخص آخر جريرة المشاكل التي نحجم عن تحملها بأنفسنا. فمثلًا الأمم تتهم أممًا أخرى أنها سبب مشاكلها، والحكومات تتهم النقابات، والنقابات تتهم الإدارات، وحتى أفراد الأسرة يتهمون بعضهم بعضًا. إن الآباء والأمهات الذين تنشب بينهم خلافات يلقون المسؤولية على أطفالهم، والمراهقون يمارسون السطوة والنفوذ على زملائهم الأضعف، ويضعون اللوم على ضعفهم، وكبار الموظفين يتهمون صغار الموظفين بدلًا من تحمل تبعات سوء الإدارة، كما يوضح ستيفن فاينمان. الحكومات والأمم والشعوب والأفراد؛ الجميع يبحث عن كبش فداء ليتحمل اللوم بدلًا من البحث عن المشكلات والعيوب والأخطاء ومعالجتها أو دفع تكلفة الإصلاح.
قديمًا، وخلال فترات الأوبئة والمجاعات وانتشار الآفات والطاعون، كان يجب إيجاد كبش فداء بصفتها شعيرة للتطهر، والتضرع لرفع البلاء، وكان غالبًا ما يتم التضحية بإنسان، شخص من الطبقات الدُنيا في المجتمع، قد يكون مجرما، أو شخصا صادف حظه العسير أن يولد بإعاقة أو بعيب خلقي أو قبيح جدًا بمعايير عصره.
حديثًا، ومع ظهور فيروس كورونا المستجد، وجد العالم ضالته في إلقاء اللوم على أمة وعرق قارة آسيا، ثم ضيق إلقاء اللوم على دولة الصين، ليكون اللوم أشد وطأة، ليحمل العالم كل تبعات انتشار الفيروس على المواطن الصيني؛ بدايةً حكومته، ثم سلوك الفرد وطعامه وحتى طريقة نومه وقيامه. ولم تنظر الغالبية العظمى من المتحفزين لإلقاء اللوم على سياسات بلدانهم التي تهاونت في التعامل مع انتشار المرض، ولم تأخذ أي احتياطات طبية ولا إجراءات احترازية، لم ينظر أحد قبل أن يقوم بالسخرية أو بالسب واللعن في حق المواطن الصيني إلى ميزانية دولته الاقتصادية وكيف تُهدر على حروب عبثية وشراء سلع ومنتجات غير ضرورية عوضًا عن إنفاقها في إصلاح القطاع الصحي وتدعيمه. الصين شعبًا وحكومة صاروا كبش الفداء الجديد لمعظم دول العالم.
الوصم
يأخذ اللوم أشكال عدة، كما يشير ستيفن فاينمان، فمن كبش الفداء، إلى عملية الوصم، والوصم هو ممارسة يونانية قديمة، تهدف إلى هدم هيبة الإنسان، والنبذ، وجعله في أدنى مكانة بالتراتبية الاجتماعية، والوصم أخذ عدة مراحل تطورية عبر الزمن فبدأ عبر حرق أجزاء من الجسم، وشج رؤوس الخونة والعبيد. ثم أخذ شكل علامات تزينية خاصة ظهرت في معسكرات الإعتقال النازية، حيث عُرفت النجمة كوصم ل “ملوث العرق”، والمثلث الأحمر كان للخصوم السياسيين، والمثلث الأخضر للمجرمين واللصوص، والمثلث البني للغجر، والمثلث الوردي لمثليي الجنس..إلخ. صارت هذه الشارات هي النموذج الجديد للوصم، وتعبير جديد للأمة الألمانية آنذاك لإلقاء اللوم على هذه الفئات بوصفهم سببا للنكبات التي حلت بالأمة الآرية بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى. لا يتوقف الوصم عند الوضع السياسي، يمتد للحقل الطبي، حيث يتم إلقاء اللوم على المرضى ووصمهم بالمرض مثل : مكتئب أو فصامي أو حتى مشلول؛ مما يكرس هذا الأمر لعزلهم اجتماعيًا بشكل أكبر عوضًا عن تقديم يد العون لهم.
وهذا تقريبًا ما يتم مع الآسيويين عمومًا الآن، والصينيين خصوصًا، فعلى سبيل المثال شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا ولاية كاليفورنيا توزيع منشورات مزيفة تحذر من تناول الطعام فى المطاعم الآسيوية بسبب فيروس كورونا. وشهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية واقعة تنمر بحق طالب آسيوي، بعد أن اتهمه بعض الأشخاص بأنه يحمل المرض وضربوه بشدة[i]. وفي فرنسا، ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملات مكثفة للسخرية من الآسيويين ودعوات لطردهم مِن البلاد. وقد كتب الآسيويون، خاصة الصينيين في فرنسا، حكايات مروعة عن التمييز والتنمر والشتم واللعن الذي يتعرضون له عبر هذا الوصم “#JeNeSuisPasUnVirus، أنا لست فيروسًا”.[ii]
النهاية
شكل اللوم والثناء على الأغلب وسيلتين مفيديتن لأسلافنا قبل نحو 2.6 مليون سنة. وقد توصل تشارلز داروين إلى أن الخوف من اللوم وحب الثناء لعبا دورًا حاسمًا في السلوك التعاوني الذي ساعد على بقاء الوحدات الاجتماعية. فمن خلال قدرتهم على التلقيد، تعلم البشر مبكرًا أن تقديم المساعدة للآخرين قد ينطوي على مكافأة، من خلال تقليد مساعدة مقابلة. وكتب داروين أن الإنسان انطلاقًا من هذا الدافع الصغير اكتسب عادة مساعدة رفاقه، وأن عادة أعمال الخير تُعزز بالتأكيد مشاعر التعاطف التي تمثل الدافع الأول لأعمال الخير.
اليوم، لم يعد الثناء يلعب دورًا كبيرًا، وتنحى لصالح اللوم، فحضارة العصر الحديث ضاغطة، مُثقلة بالقوانين، بالأوامر والسرعة، يتهرب الجميع من الاعتراف بالمسؤولية خوفًا مِن اللوم، والنبذ المجتمعي، والوصم. الحياة المعاصرة أفقدت الإنسان ثقته في الأواصر الاجتماعية، وأنه سوف يتحصل على تقدير لذاته إن أقدم على فعل الصواب، وتحمل المصاعب، والبحث وراء حلول للمشكلات.
يشير ستيفن فاينمان إلى أن ظاهرة إلقاء اللوم على أسباب خارجية من أقدم الظواهر التي درسها علماء النفسي الاجتماعي، منذ الخمسينيات من القرن العشرين، لفت الطبيب النفسي النمساوي فريتز هايدر الانتباه إلى ما أسماه “أخطاء الإسناد الأساسي” التي نرتكبها حين نتحدث عن الأسباب، لأننا نعمد في لاشعورنا إلى ضبط تصوراتنا بحيث نضمن احترامنا لذاتنا، ونحمي قيمنا وتحيزاتنا. وبناء على ذلك فإننا كثيرًا ما نلوم بصوتين: الأول، عندما نكون نحن الجناة فنقلل من تداعيات فعلنا على الضحايا، والثاني عندما نكون نحن الضحايا فنشكو من جور وظلم شخصي لا يزول. ثمة تفسير هنا لاستفحال بعض المظالم الدولية واستمرارها لأجيال مثل المعاناة العربية من الهجمات الصليبية، ومرارة الفلسطينين بعد النكبة، واستمرار استياء ولايات الجنوب من الحرب الأهلية الأمريكية.
من السهل جدًا أن نلجأ إلى لغة اللوم. فلوم شخص أو جماعة يبسط الأمور، وتتجاوز التعقيدات التي يتعين الخوض فيها للتوصل إلى حل للمشكلة. ومع ذلك، يفقد اللوم القدرة على التمييز عندما ينتشر بحرية في شؤوننا اليومية، يرمي المسؤولية على الآخرين ويخلق حالة دفاعية، فنبرئ أنفسنا ونغلق الباب أمام فرص التغيير أو التحول وعندما يلوم الجميع الجميع تغدو الخيارات محدودة، وتتجاوز مجرد استمرار الحقد والصراع.
مغرٍ الحديثُ عن رؤية عالم لا يلعب اللوم فيه أي دور. يقول ستيفن فاينمان، لكن ذلك نوع من الخيال الجذاب، إلا أنه سيجعلنا نغفل عن الحقيقة: فليس اللوم دائمًا أمرًا سيئًا. قد يكون بداية رفع ظلم، أو قد يقرع ناقوس الخطر بشأن مسائل يجب عدم تجاوزها، أو قد يضع الأقوياء من الشركات والحكومات والمسيئين تحت طائلة المساءلة. اللوم مدير يتمتع بمناقب أخلاقية، من دونه يضيع جوهر القانون والمواطنة الملتزمة. وإذا كنا لا نستطيع أن نلوم أو نلام، فلن يكون للشرعية معنى ثقافي. لهذا، فإن اللوم لن يخفي ولا ينبغي أن يختفي.
[i] https://www.falsoo.com/news/4/97605/هل-تحول-فيروس-كورونا-إلى-حملة-تنمر-ضد-الصينيين-فى-أمريكا
[ii] https://al-ain.com/article/coronavirus-france-je-suis-pas-virus