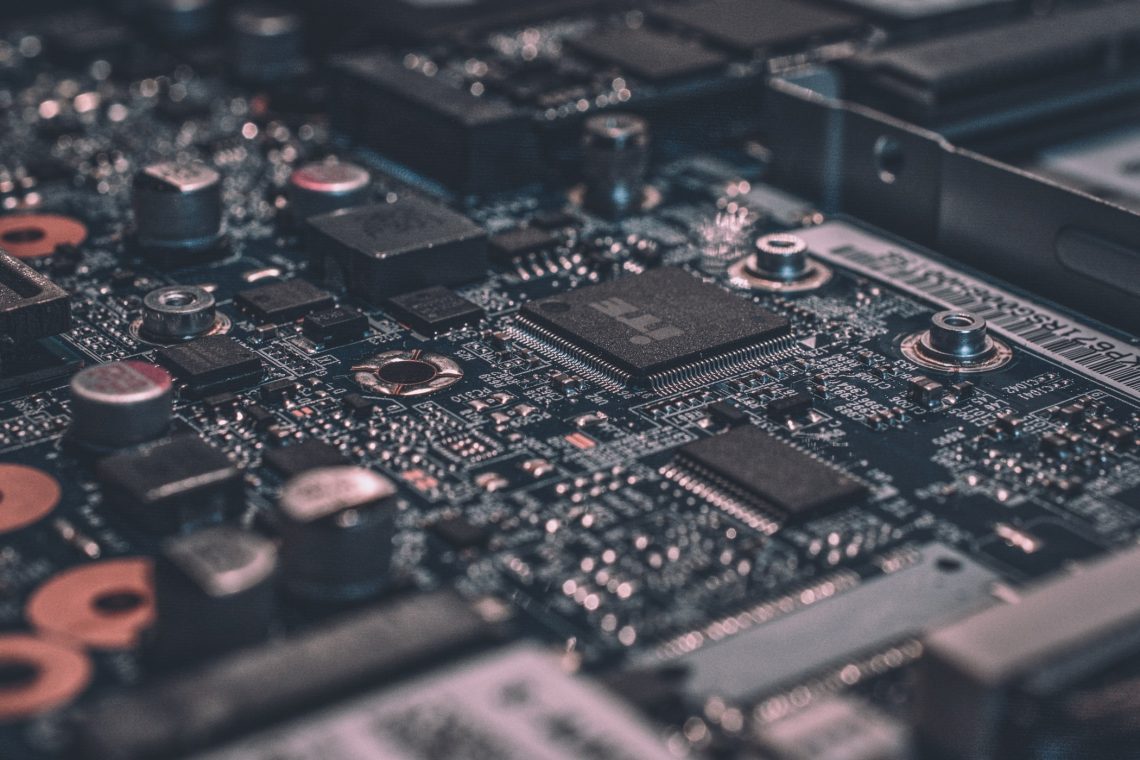في 2018 اعتذر مارك زوكربيرج مؤسس ومالك فيس بوك عن تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لصالح شركة كامبردج أناليتيكا التي كانت تدير حملات الانتخاب لكلٍ من دونالد ترامب والسيناتور تيد كروز وحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بالبريسكت. جُمعت هذه البيانات عبر استخدام التطبيقات التي تعمل وفق نظام الطرف الثالث – وهي تطبيقات طوّرها أفراد أو شركات خارجية تستخدم بيانات التطبيق، إما عن طريق تنزيلها وربطها بالتطبيقات، كتطبيقيْ بيتموجي وسناب شات، وتطبيق كويزز في فيس بوك، وإما عن طريق استخدامها داخل التطبيق. تتيح هذه التطبيقات الوصول لبيانات أكثر حساسيّة مما يشكل خطراً أمنياً على المستخدم. وكان الاعتذار يتمحور حول عدم وجود الأدوات والخصائص الكافية التي يوفرها فيس بوك والتطبيقات التي تملكها الشركة (واتساب وأنستجرام) لحماية المستخدم وضمان خصوصيته. وشكل استحواذ فيس بوك على إنستجرام وواتس أب قفزةً هائلةً في حجم البيانات وقدرتها على الوصول لمعلومات أكثر دقة، وتتبع وتحليل بيانات المستخدم الذي يستخدم أكثر من تطبيق تابع للشركة نفسها، ورصد بياناته عبر خصائص كل تطبيق وربط هذه التطبيقات معا. هذه ليست الفضيحة الأولى المتعلقة باختراق الخصوصية لتطبيق فيس بوك، فالسابقة كانت في قضية موظف وكالة الأمن القومي الأميركي السابق إدوارد سنودن، الذي صرح أن الفيس بوك يستخدم ويجمع البيانات الخاصة بمستخدميه ويسيء استخدامها. والمعقد في الأمر هو شرعنة جمع هذه المعلومات والبيانات دون قيود أو حماية للمتلقي؛ ببساطة لأن الأمر يسهِّل وصول الحكومات والكيانات التجارية الكبرى لها واستخدامها لحماية هذه المؤسسات. ولا تعد فيس بوك المتهمَ الوحيد في مسألة اختراق الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية، فهنالك على المستوى العالمي جوجل التي أثارت قضية تتبع مواقع مستخدمي خرائط جوجل، حتى حين يكون التطبيق مغلقاً جدلًا حول أحقية الشركات بالوصول للبيانات الخاصة بالمستخدمين، علاوةً على أهمية صياغة الشروط والأحكام بصيغة أكثر وضوحاً. ويشهد العالم اليوم، وتحديدا بعد جائحة كرونا، تناميًا في الطلب العالمي على الخدمات الإلكترونية كتطبيقات التعليم والعمل عن بعد، التي ارتفع معدل استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها إلى 300%، بالإضافة إلى الخدمات والاستشارات الصحية، وتطبيقات التسوق، والتوصيل والخدمات اللوجستية التي يقدر حجم زيادة الطلب عليها إلى 250% وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقلص التعاملات المباشرة، والتي أصبحت فرضًا لا خيارًا كما كانت في السابق. فبحسب تقرير اليونسيف فإن قرابة 500 مليون طالب حول العالم توقفوا عن الدراسة بسبب إغلاق المدارس، وتوجهوا نحو تطبيقات التعليم الإلكتروني. والأمر ذاته في العمل، مما ينبئ بثروة هائلة في المعلومات الأساسية والثانوية عن مليارات البشر حول العالم، بشكل يسهّل التنبؤ بسلوكياتهم، وتوجيههم نحو سلوكيات معينة، والتجسس على تفاصيل حياتهم إن لزم الأمر.
كيف يتم ذلك؟ تطلب هذه التطبيقات البيانات الأولية كالعنوان، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعمر عند التسجيل، ثم تمرر لك قائمة طويلة جدًا وبلغة معقدة حول الشروط والأحكام التي تتيح للتطبيق استخدام البيانات الشخصية والدخول لجهازك بما فيه الوصول للكاميرا والمايكرفون. بعدها تقوم بقياس فترات الاستخدام، والخدمات والمنتجات التي تقوم بتجربتها أو شرائها أو الاطلاع عليها، بعدها تقوم بفرز هذه البيانات وتحليلها، ثم وباستخدام الخوارزميات تقوم بعرض خدمات ومنتجات شبيهة أو ذات صلة بما بحثتَ عنه، بحيث تقوم هذه الخوارزميات بربط المنتجات والخدمات والمواضيع التي بحثت عنها لتعرض لك منتجات شبيهة وتربط خيارات الأفراد الذين بحثوا في الموضوع ذاته، أو قاموا بشراء المنتج ذاته وعرضها عليك، بحيث يتم عرض حزمة خيارات مشابهة لمجموعة من الأفراد الذين قاموا بالبحث عن خيار واحد متشابه. وبالطبع يتساءل الكثير منّا حول ظهور إعلانات لفنادق ومواقع لحجز السكن بعد انتهائه من شراء تذكرة سفر عبر الإنترنت، وهذا هو التأثير الذي تراه وتشعر به، ولكن التأثير الذي لا تراه، هو ذلك الذي يحلل بياناتك للأدق، كالأماكن التي ترتادها (عبر خرائط جوجل، أو طلبات التوصيل في تطبيقات التوصيل كأوبر)، قوتك الشرائية (عبر استخدامات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس)، مطاعم وجباتك المفضلة ( تطبيقات التوصيل كديليفرو، أوبر إيت وطلبات )، وغيرها من سلوكياتك وعاداتك التي تشكل أساسًا استثماريًا وتجعل منك عميلاً مستهدفًا لأية مؤسسة تجارية كما تسهِّل التنبؤ بردود أفعالك لأي قرار مستقبلي تريد الشركات أو الحكومات اتخاذه. والأمر لا يقتصر على المنتجات أو الخدمات أو حتى البحث الاستهلاكي؛ بل يتعدى ذلك ليصل إلى توقع وصياغة اتجاهات المستخدمين الفكرية والسياسية، وتحليل بياناتهم عبر خاصية الإعجاب أو المشاركة، ومن ثم عرض المزيد من الخيارات المتشابهة، أو ظهور منشورات لحملات سياسية وثقافية يمكن أن تثير اهتمامك. وهنا تكمن قوة هذه التطبيقات التي تستطيع عرض محتوى مختلف لكل مشارك حسب بياناته ومعلوماته التي يتم تحليلها بناءً على تفاعله اليومي والعفوي في استخدام هذه التطبيقات. وبالطبع فإنَّ الوصول لا يشمل بياناتك وحدها، فالأمر ينطبق على كل المضافين في قائمتك، والمضافين لدى الأصدقاء، ومن ثمّ الوصول لأكبر قدر من الأفراد.
وخلال العقدين الماضيين شكّل النمو التقني ثورةً معلوماتيةً هائلةً، ساهمت بشكل كبير في تكشِّفِ ومعرفةِ جوانبَ سلوكيةٍ شخصيةٍ لمليارات البشر حول العالم، وساهمت في تغيير كياناتٍ سياسيةً واقتصاديةً عملاقة. كما ساهمت بشكل كبير أيضًا في حسم مسائلَ سياسيةٍ واتخاذ خطوات استباقية نتيجة سهولة الاختراق والحصول على المعلومات بشقيها القانوني وغير القانوني. ومع ذلك ظلت الكثير من البيانات محدودةً رغم حجمها الهائل، وتتراوح النسب العالمية بين40 إلى 60% من إجمالي المعلومات الشخصية للمتلقي. لذا هل ستظل هذه النسبة كما هي بعد أن وجد ملايين البشر حول العالم أنفسهم حبيسيْ المنازل، ولا يستطيعون ممارسة أعمالهم إلا خلف الشاشات؟
وحين تذكر عبارةُ أن العالم بعد وباء كورونا لن يعود كما كان قبله فهي ليست عبارة مبالغة. فبالدخول في الشهر السادس من بداية هذه الأزمة منذ ظهورها في ديسمبر 2019 في الصين يتجه العالم إلى تحويل كل ما أمكن من تعاملاته إلى تعاملات إلكترونية، وبالنتيجة المزيد من البيانات عبر المزيد من التطبيقات مما يعني قدرةً أكبر على الوصول لمعلومات المستخدم، الذي يضطر للثقة والإدلاء بياناته في ظل محدودية الخيارات خلال فترة الأزمة، والتي أدّت القوانينُ الجديدةُ لاستحداث عاداتٍ وسلوكياتٍ لم تكن موجودةً من قبل، بالإضافة إلى تطورٍ في عاداتٍ وممارساتٍ سابقةٍ لتكتسب مرونةً وشكلاً آخرَ يحاول فيها الفردُ الحفاظَ على كيانه من التغيير الذي يفرضه العالم عليه اليوم، وتصعب مقاومته لمحدودية خيارات الفرد نحو موجة التغيير التي تفرضها الأنظمة الاقتصادية والسياسية.