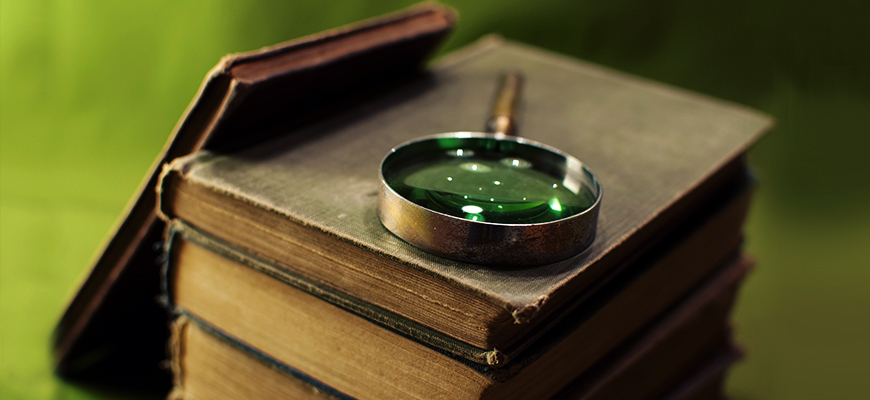ليس ثمّة مجالٌ يخصّ الإنسان إلّا وكانت الثقافة طرفًا فيه بوجه من الوجوه؛ فأيّ دراسة في العلوم الإنسانيّة من تاريخ وسياسة واقتصاد وغير ذلك تعدّ في نهاية المطاف دراسة للثقافة؛ بل لنا أن نقول إنّ العلوم الطبيعيّة فيها جانب ثقافيّ أيضًا، فهي تنطلق من فروض مسبقة بشأن العلم، مادّةً ومنهجًا؛ وإذا كان الأمر كذلك فماذا نعني، إذن، بـ”دراسات ثقافيّة”؟
الملاحظ هنا أنّنا لا نتحدّث عن دراسة الثقافات وإنّما عن دراسات ثقافيّة، والفارق بينهما أظهر من أن نقف عنده طويلًا، حسبنا أن نقول إنّ الأول يحيلنا إلى مجال الدراسة، وهو بذا أقرب إلى الأنثروبولوجيا، الميدان الأكاديميّ الذي يأخذ الثقافة- قيمًا وقوانين، عاداتٍ وتقاليدَ، فنونًا وآدابًا، علومًا ومعارفَ- مادّة دراسته؛ أمّا الثاني فيحيلنا إلى صفة الدراسة، وهو بذا أقرب إلى المنظور أو المنهج الذي يسير عليه الدراس في معالجة مادّته، فأنت بإمكانك أن تعالج أيّ موضوع في الاقتصاد، مثلًا، من منظور ثقافي، كما أنه بإمكانك أن تعالج أيّ موضوع في الثقافة من منظور اقتصادي؛ على أنّ هذا التمييز فيه من التعميم ما يثير تساؤلًا آخر: ماذا يعني أن نتناول موضوعًا ما من منظور ثقافي؟
لعلّ عرض نبذة تاريخيّة يمدّنا بفهم أدقّ وأوضح؛ فمصطلح “الدراسات الثقافيّة” يعود بنا، إذا وضعناه في السياق الأنجلو-الأمريكي، إلى عام 1964، فقد أنشئ في هذا العام “مركز الدراسات الثقافيّة المعاصرة” في جامعة برمنغهام البريطانيّة؛ تميّز المركز منذ نشأته بمجال ومنهج خاصّين به، فقد درس موضوعات كانت تعدّ فيما مضى غير جديرة بالبحث أو ثانويّة في أحسن تقدير، مثل التقاليد الشعبيّة وعادات وقيم الفئات الأقلّ تمثيلًا كالنساء والشبّان والطبقات العاملة؛ منهجيًّا، تعامل المركز مع العوامّ من منطلق المؤمن بأهمّيّة الدور الذي يؤدّونه في التغيّر الاجتماعي والثقافي، ومن المنطلق ذاته حلّل كاشفًا تورّط الخطابات التربويّة المختلفة ووسائل الإعلام الجماهيريّة من تلفاز ومذياع وصحف يوميّة وإعلانات تجاريّة، في إبقاء الهيمنة الذكوريّة والتفاوتات الطبقيّة والعرقيّة غير العادلة في المجتمع.
لعلّنا نرى هذا المنزع الديموقراطي النقدي أوضح وأجلى إذا ما قابلنا بينه وبين التوجّه النخبويّ للكتّاب الذين تطرّقوا إلى الثقافة في القرن التاسع عشر، فالشاعر والناقد ماثيو آرنولد (1822-1888)، مثلًا، عرّف الثقافة بأنّها أمثل ما قيل وفُكِّر فيه وأفضل ما ينبغي أن يُعرَف، وكان يهاجم بشدّة كلّ من هبط بها إلى مستوى أدنى من ذلك، سواء أتى ذلك من الطبقات الدنيا أم من الطبقات العليا؛ وكانت نخبويّة بعضهم ممزوجة بالعنصريّة، فالمؤرّخ توماس كارلايل (1795-1881) كان رأيه في التاريخ أنّه السيرة الذاتيّة للعظماء، سجلٌ لمآثرهم دون العوامّ من الناس، وكان من أشدّ المتحمّسين لتفوّق الأنجلو-سكسون على غيرهم من الأجناس، إذ لم يجد بأسًا في استخدام السود عبيدًا لهم؛ والناقد المفكّر جون رسكن (1819-1900) كان يصنّف الناس إلى خاصّة وعامّة، صفوة وسوقة، رائيًا أنّ للأوّل الحقّ في فرض رؤاه على الثاني بل إخضاعه بالقوّة إذا ما اقتضت الحاجة.
يمكن القول إنّ لمنزع المركز الديموقراطيّ بعدين، يتجسّد الأوّل منهما في خلفيّات مؤسّسي المركز الشخصيّة الاجتماعيّة: ريتشارد هوغارت، مدير المركز منذ تأسيسه حتّى عام 1968، وريموند ويليامز، الروائيّ والناقد الذي أعاد قراءة الفكر الماركسي، كما سنرى لاحقًا، وستيوارت هول، مدير المركز من عام 1968 حتّى عام 1979؛ فالأوّل تربّى في أسرة من الطبقة العاملة، وكان معجبًا بطبقته وثقافتها إعجابًا يوازيه نفوره من الثقافة الجماهيريّة الإعلاميّة، فقد كان يرى هذه الأخيرة إفرازًا رأسماليًّا مضرًّا بالثقافة الشعبيّة؛ أمّا الثاني فقد كان ويلزيًّا من الطبقة العاملة، وكان أبوه عاملًا في خطوط السكك الحديديّة في قرية صغيرة؛ أمّا الثالث فقد ولد في جامايكا من أصول أفريقيّة وأوروبّيّة، وتربّى في أسرة من الطبقة الوسطى، انتقل في عام 1951 إلى جامعة أكسفورد لإكمال تعليمه العالي في بريطانيا، وأسّس هناك في عام 1960 مجلّة New Left Review اليساريّة، وكان أوّل من أدار تحريرها.
البعد الثاني لهذا المنزع الديموقراطي هو السياق التاريخي، فقد تميّزت عشرينيّات وستّينيّات القرن العشرين بديناميّة كانت فيها أوجه عدّة من الاضطراب والتقلّب والتغيّر في كلّ من أوروبّا الغربيّة وأمريكا؛ فقد عرفت العشرينيّات بـ”العقد الهادر”، فالمدن الرئيسة كانت تنام وتستيقظ من جهة على هدير موسيقا الجاز والرقص الصاخب والأفلام الملوّنة والمركبات والهواتف وغيرها من الأجهزة الحديثة ومن جهة أخرى على تغيّر سريع وكبير لأنماط الحياة القديمة،[1] من أوجه ذلك بروز المرأة والأمريكيّين السود بروزًا لافتًا في ميادين الاقتصاد والإعلام والفنّ؛ ومع أنّ هذا “الهدير” قد خفت قليلًا في الثلاثينيّات بسبب ما يعرف تاريخيًّا بـ”الكساد الكبير” وفي أثناء الحرب العالميّة الثانية، فإنّ دولًا مثل بريطانيا وفرنسا شهدت تعافيًا ملحوظًا من آثار الحرب، فعاد من جديد في الستّينيّات ظهور حركات شبابيّة وعمّاليّة مناهضة للرأسماليّة من جهة ومطالبة بقدر أكبر من التمثيل السياسي والحرّيّة الفرديّة من جهة أخرى، وقد تتوّج كلّ ذلك بانتفاضات الطلبة والعمّال في مايو 1968 في فرنسا؛ كما شهدت أمريكا في العقد ذاته ظهور أصوات تسعى إلى مقاومة مركزيّة “الرجل الأوروبّي الأبيض” وإلى تمكين النساء والأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقيّة واللاتينيّة والآسيويّة.
تغذّت هذه الأصوات من طرفي المحيط الأطلسي بتنظير ميشيل فوكو للخطاب وبالكتّاب الذين يصنّفون في أدبيّات السياسة والفكر بـ”الماركسيّين الغربيّين” من أمثال روّاد مدرسة فرانكفورت ووالتر بنيامين ولوسيان غولدمان وأنطونيو غرامشي؛ شأنها في ذلك شأن مؤسّسي المركز، فهؤلاء أقرّوا بتأثير الأوضاع المادّيّة في المعتقدات والأفكار والآداب والفنون، ولكنّهم لم يهتمّوا بالبنى الاجتماعيّة والصراع بينها بقدر ما اهتمّوا بعوامّ الناس في تفاعلاتهم واحتكاكاتهم وممارساتهم اليوميّة؛ فكان ذلك إفرازًا لتبلور فكر يساريّ محلّيّ في بريطانيا في منتصف الخمسينيّات وأوائل الستّينيّات، فكر يتعاطف مع الطبقة الكادحة وينظّر للثقافة “العليا” على أنّها أيديولوجيا الرأسماليّة؛ وقد تجسّد ذلك أكثر ما تجسّد في مؤلّفات مثل “استعمالات معرفة القراءة والكتابة” لريتشارد هوغارت[2] و”صنع طبقة العمّال الإنجليزيّة” للمؤرّخ إي بي تومبسون[3]و”الثقافة والمجتمع” و”الثورة الطويلة” لريموند ويليامز. [4]
وكان لرؤى الأخير أثرٌ كبير فيما سمّي لاحقًا “الدراسات الثقافيّة البريطانيّة”؛ فإن كانت الماركسيّة الكلاسيكيّة ترى أنّ الثقافة، علاقاتٍ اجتماعيّةً، وبنًى سياسيّةً وطرائقَ للتفكير، تحدّدها المادّة، إنتاجًا واستهلاكًا وتملّكًا واستثمارًا وتبادلًا، فإنّ ويليامز قدّم تصوّرًا فيه حراكٌ وتفاعلٌ وأثرٌ وتأثيرٌ متبادلان بين المادّة والمعنى؛ وإن كانت هيمنة الطبقات الحاكمة تكمن -حسب أنطونيو غرامشي- في زرع فكرة ما المألوف وما الطبيعي في أذهان الناس، وإن كانت هيمنة الدولة تكمن- حسب لويس ألتوسير- في أجهزتها القمعيّة من جيش وشرطة ومحكمة وقضاء وفي أجهزتها الأيديولوجيّة من مسكن ومدرسة ومعبد ومختبر ومعمل ومصنع فإنّ الهيمنة -في رأي ويليامز- ليس منتجًا شأنه شأن صخرة صمّاء، وإنّما هي عمليّة ديناميكيّة داخليّة تتفاعل مع بعضها في درجات متفاوتة من القوّة.
ففي أيّ مجتمع وفي أيّ فترة من التاريخ هنالك معانٍ تسود على غيرها، معانٍ تشكّل واقعًا له من القوّة في أذهان المؤمنين بها ما يقف حائلًا بينهم وبين تصوّر واقع بديل آخر؛ ولكنّ هذه السيادة ليست مطلقة، فالمعاني تُقبَل بدرجات مختلفة، ومنها ما يعاد تأويله حتّى يتوافق مع السائد، ومنها ما يُهمَل ويُنسَى، والمهمل والمنسيّ تبقى منه خبرات وقيم عالقة في أذهان بعض الأفراد وربّما تعدّ مقبولة لديهم في وجوه منها، وهو ما يسمّيه “الثقافة المتبقّية”؛ وقد يمهّد المهمل والمنسيّ والمعاد تأويله الطريق لظهور معانٍ وخبرات جديدة، وهو ما يسمّيه “الثقافة الناشئة”؛ لعلّنا نلمس هنا أنّ ويليامز يقدّم بهذا التنظير الثقافة قوّة فاعلة منتجة لا انعكاسًا خاملًا لبنية تحتيّة.
انطلاقًا من ذلك لنا أن نقول إنّ معالجة نصّ ما من منظور الدراسات الثقافيّة يعني أن نتساءل باحثين: هل يأتي النصّ معزّزًا للسّائد أم مقوّضًا له أم متأرجحًا بين هذا وهذا؟ وما تأثّره بالمعاني المتبقّية أو بالمعاني الناشئة وما أثره فيهما؟ وما الأوضاع التي أُنتِج وقُرِئ فيها النّصّ؟ لعلّه واضحٌ أنّ هذه ليست أسئلة أكاديميّة تقليديّة غايتها الوصول إلى القراءة الأكثر تماسكًا، وإنّما هي أسئلة سياسيّة غايتها فضح الواقع هيكلًا هرميًّا؛[5] الدراسات الثقافيّة، إذن، ليست تخصّصًا أكاديميًّا وإنّما هي نقطة تتقاطع عبرها توجّهات فلسفيّة مختلفة، من هذه الماركسيّة والتفكيكيّة ونظريّات التلقّي والتاريخانيّة الجديدة؛[6] جلّ هذه الاتّجاهات تأتي في السياق الفكري للـ”مـا بعديّات”: ما بعد الحداثة، وما بعد البنيويّة، وما بعد الكولونياليّة؛ والجامع بين هذه الما-بعديّات والدراسات الثقافيّة هو سعيها إلى زعزعة المركزيّات والمرويّات الكبرى.
ربّما اتّضح لنا الآن أمر “الثقافي” من العنوان، مجالًا ومنهجًا، ولكن ماذا عن الكلمتين اللتين تصل “أم” المتّصلة إحداهما بالأخرى: “دراسات” و”نقد”؟ إن كانت الدراسات الثقافيّة سياسة تبغي كشف الواقع، سياسة متفاعلة مع المادّة المدروسة مشتبكة معها لنا أن نتساءل: هل “الدراسات” معبّرة بحقّ عن خطورة خلخلة المنظومة السّائدة وما يتطلّب ذلك من جرأة وجسارة؟ فـ”الدراسة” لها إيحاءات تذهب بها إلى سياق بحثيّ وضعيّ يتبنّى الحذر والتأنّي والموضوعيّة ويهدف إلى فهم مبنيّ على التحليل والاستقصاء والجدوى؛ وهذه مبادئ قد تكسبك من صرامة المنهج ما تستطيع به تمييز الجزء من الكلّ والمقدّمة من الخاتمة والجدوى من اللاجدوى، ولكنّها قد تحول بينك وبين اتّخاذ موقف صريح صارم أخلاقًا تجاه ما تدرس، فأن تكون موضوعيًّا يعني أن تنأى بنفسك شخصًا ذا شعور وإحساس وخبرة وخلفيّة عن مادّة دراستك، فتقبل عليها كما يقبل المتخصّص بالرياضيّات على أرقامه أو الكهربائيّ على أسلاكه.[7]
أمّا “النقد” فمعناه تمييز الحَسَن الجيّد من السّيّئ الرديء؛ وهذا ينطوي، بالضرورة، على افتراضات مسبقة ننطلق منها، فنؤوّل بها ما الحُسْن والجودة وما السوء والرداءة؛ ولما كنّا قد دخلنا مجال التأويل لم يعد لنا ما ندّعي به الحياد، فنحن منخرطون عندئذ لا محالة؛ وإن استندنا إلى ذلك وربطناه بما قلته تعريفًا للدراسات الثقافيّة ربّما كان لنا أن نعرّف “النقد”- وظيفيًّا- بأنّه يحلّل ويستقصي لا ليكتشف قوانين علميّة؛ وإنّما ليبين ما تنطوي عليه المنظومة من تراتبيّة، يحلّل ويستقصي لا ليحدّد الجدوى العمليّة؛ وإنّما ليهتدي إلى مساءلة مؤطّرة لما قرّ ورسخ في أذهاننا؛ فنحن، إذن أمام نهج تأويليّ نقدي؛ من هنا إن طُلِب منّا التعيين، كما يوحي بذلك استخدام حرف “أم” وعلامة الاستفهام في العنوان، فأنا أراني أميلَ إلى “النقد الثقافي” منّي إلى “الدراسات الثقافيّة”؛ والواقع أنّ هذا النهج يضعنا في إطار خطّ بحثيّ راسخ ظهر في سبعينيّات وثمانينيّات القرن المنصرم، خطّ يذهب مذهب الدراسات الثقافيّة من حيث ربط الكلمة بسياقها الاجتماعي وكشف ما بها من ميول أيديولوجيّة، فهناك تحليل الخطاب النقدي واللسانيّات التطبيقيّة النقديّة والأسلوبيّة النقديّة.
على أنّ الأهمّ عندي من هذا السند النظري والترابط الأكاديمي هو الجانب الإنساني للنقد، الجانب المتمثّل بإيمان وأمل، بإيمان بأنّ التغيير ممكن، بأمل في أنّ المستقبل سيكون أدفأ حبًّا، وأكثر عدلًا، وأوفر كرامة؛ فالبنى والأنساق- مهما تكن قوّتها وسطوتها- لا تستطيع أن تقول بدوامها إلّا على خلفيّة زوالها، أو ببقائها إلّا على خلفيّة فنائها، أو بقوّتها إلّا على خلفيّة مقاومة تلك القوّة؛ فالحال أنّه “أينما توجد القوة توجد المقاومة”؛[8] هذا التلازم يعني أنّ البنى والأنساق ليست حصنًا حصينًا، فهي ممكنٌ تحدّيها وخرقها، كما أنّه يعني أنّنا لسنا إفرازًا آليًّا لها أو ترسًا في دولابها؛ فالفرد منّا- عالمًا كان أم جاهلًا، حاكمًا كان أم محكومًا، رئيسًا أم مرؤوسًا، رشيدًا أم سفيهًا- ليست حالا نفسيّة ثابتة ولا كيانًا مكتمل البنيان مستقلًّا عن محيطه، وإنّما هو ساحة تلتقي فيها الأضداد من وعي وغير وعي، من شعور ولاشعور، من واقع وخيال، من ظاهر وكامن؛ إنّه، بكلمات أخرى، عمليّة بناءٍ متواصلة متغيّرة فيها شيءٌ من تأثّرنا بالبنى والأنساق وشيءٌ من أثرنا فيها.
هنا، بين التأثّر والتأثير، مساحةٌ بل أملٌ لنا لخلق عالم بديل.
[1] لعلّنا نرى تمثيلًا أدبيًّا لهذا “الهدير” في أعمال مثل رواية The Great Gatsby (1925) وقصّة Babylon Revisited (1931) لإف سكوت فيتزجيرالد ورواية The Sun also Rises (1926) لأيرنست هيمنغواي.
[2] Richard Hoggart. (1957) The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life. (London: Penguin).
[3] E. P. Thompson. (1963) The Making of the English Working Class (London: Victor Gollancz Ltd.).
[4] Raymond Williams. (1958) Culture and Society (London: Chatto & Windus) and The Long Revolution (1961) London: Chatto & Windus).
[5] لمزيد من التفصيل انظر: “تأطير: النقد الثقافي، مبدأً ومرتكزًا” (ص 25 حتى ص 54) من كتابي “الرواية العمانيّة في ميزان النقد الثقافي، تفريق المنضود وتفكيك المفروض” المنشور في عام 2018 عن دار مسعى، المنامة.
[6] انظر:
Robert Con Davis and Ronald Schleifer. (1998) Contemporary Literary Criticism, Literary and Cultural Studies (New York: Pearson)
يتضمّن هذا الكتاب أطروحات ذات منزع نقديّ ثقافيّ ألّفها على فترات متباعدة كتّابٌ ذوو خلفيّات فكريّة مختلفة، من أمثال إعجاز أحمد وريموند ويليامز وإدوارد سعيد وجاك دريدا وستانلي فيش وجاك لاكان وسلافو جيجاك ورونالد باث وستيفن جرينبلاث وناسي آرمسترونج كورنيل ويست وبيل هوكز وجوري فيشواناثن.
[7] يمكننا أن نرى أثر “الدراسة” بإيحاءاتها الأكاديميّة في مجلّة New Left Review؛ فصفحة الغلاف والتصميم الداخليّ للمجلّة كانت في أعدادها الأولى مزدانة، انطلاقًا من ميولها اليساريّة، بصور ورسومات تحدّت بروتوكولات الوقار والرزانة، ولكنّ المجلّة تراجعت لاحقًا عن ذلك متبنّيةً نهجًا أكثر “أكاديميّةً”.
[8] Michel Foucault. (1980) The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction (New York: Vintage). P.95.