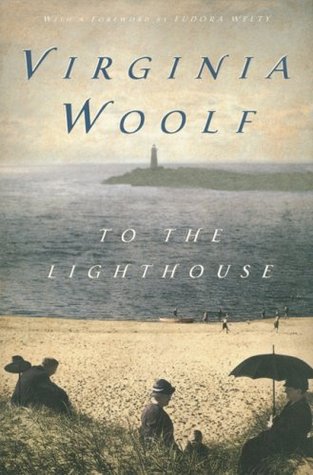قراءةٌ في رواية “إلى المنارة” لفرجينيا وولف
عملٌ لا يقول الكثير، لكنهُ سيربككَ بعادية الأشياء والأحداث، عادية كل شيء يحدث، مرور الزمنِ، تساقطُ الأماكنِ والأشخاص، وهذه المسافة الطويلة القاسيةُ بيننا وبين الآخرين، ما يمكن أن يقال وما لم يقلهُ أحد، وصولًا إلى منارة لا تُعرف، بعيدة قصية لكنها وحدها من ستبقى تاركةً ظلالًا من النورٍ في الشالِ القديمِ المهترئ لميتٍ لن يعود لترميمِ مكانه.
وولف في هذا العمل، تكتبُ بخفة، بدءًا بفصل الحكايةِ الأول “النافذة”، ثم “ويمر الزمن” وأخيرًا “المنارة”، وفي النافذة تقفُ محدقًا في المكانِ والزمان، لا شيء يفاجئكَ لكن وولف تجلسُ تحت مائدةِ الطعام، ترى وتسمع كل شيء، تسجلُ أدق رعشات علاقاتنا البشرية المهتزة، ما يريدهُ الرجل وما يظهره، ما تقوله المرأة وما لم تقله في انتظار شيءٍ ما، انتظار، هي هذه الكلمة التي تجسُ وولف نبضها وهي تكتبُ تحت مائدة الإنسان، متسائلةً حولَ السر العادي الذي يمنعنا دومًا من أن نمد اليد في الوقت المناسب، من أن نقول “أحبكَ” لمن نحب بكل بساطة، دون تفكيرٍ في ما سيكون، ودون انتظارِ كلمةٍ ما من الآخرِ حتى ننطقَ، هذهِ اللحظات المربكة بيننا وبين الآخرين التي تتصيدها وولف وتحولها إلى ملحمة، دون أطلال أو بكائيات أو أبطال، مركزةً على المأزق الوجودي الذي وجدنا أنفسنا فيه، خائفين نحدق وننتظر، دون حوارات إلا تلك الحوارات اللانهائية المتخيلة في أعماقنا، دون كلماتٍ تحاول اقتحام المسافات بيننا، مأزقٌ يزعجك وأنت تقرأ جُبن الناس من الحديث إلى بعضهم، من قول شيءٍ بيده ِ كسر الزمن، قول شيء يجعلك تمتطي الزمن وتقودهُ وحدة دون أن يكسرك هو، أن تعانده وتقول كلمتك
لكن لا أحد في هذه العائلة العادية البسيطة التي تشبه عوائل الدنيا كلها يتجرأ ليقول شيئا في وجه هذا الصمت اللانهائي الذي يسكن كل شيء، صمت يجعل الزمن يأخذ مكانه القوي، تاركا خلفه الناس والأشياء تتهاوى.
تخرج وولف من “النافذة”، وهنا يمر الزمنُ سريعًا حاملا التفاصيل كلها التي جعلت الزمن الروائي يتمدد في الفصل الأولِ، يمر الزمن، سريعًا لا يغيرُ الكثير، رغم القذيفة التي اصطادت الابن والموت الغريب الذي أخذ الأمَّ بعيدًا، لا شيء تغير حقًا، تُرك البيت وحيدًا تزورهُ ظلال المنارة، عادوا، رفعوا شال الأم القديم ولموا خرابهم، وفي يومٍ آخر يشبهُ يوم “النافذة” ركبوا القارب واتجهوا إلى المنارةِ أخيرًا كما كانوا يخططون منذ زمنٍ بعيد لكن الزمن ما زال خفيفًا وما زال السؤال الأول يطنُّ في رأسك “لماذا لا يقولون شيئًا الآن!”، سؤال عادي طبيعي لكنهُ مصيري لا يختلفُ كثيرًا عن سؤال كنفاني: “لماذا لم يطرقوا باب الخزان”، وهو ما ستقر به وولف: “كيف للمرء إذن، سألت نفسها، أن يعرف شيئًا أو آخر عن الآخرين، مع كل انغلاقهم على أنفسهم؟”.
يغيبُ الحوار في النص، وتحضرُ أحيانًا سونيتة لشكسبير أو أبيات لشعراء مغمورين، عندما ينطقها أحدهم يحدث شرخًا في الصمت اللانهائي وفي الجمل المقتضبة التي يمررون بها الوقت بينهم، شعرٌ يورطهم في متاهاتهم الخاصة، ويفضح هشاشة الهواء بينهم، يجبرهم على أن يرددوا أبياتًا قصيرةً بسيطة لكنها تثقب أعماقهم جميعًا:
“تعالي خارجًا ولنصعد درب الفردوس، لوريانا لورلي، ها هي الخطمية الحمراء مزدهرة تضج بطنين النحلة الصفراء أتراكِ ترين، لوريانا لورلي،”
شعر عادي، ولا جدوى من التساؤل حول الدوافع التي تدعو وولف إلى اختياره دون غيره، ما يهم أنه شعر، كلمات، لكنها تخفي وتبطن أكثر مما تظهر، يهرب إليه من لا يريد أن يصرح حقيقة بما يسكنه، شعرٌ يحرجهم، لكنه وحده من يوحدهم في هذا الصمت الموجع المسكونِ بالترقبِ ومحاولة سبر أعماق الآخرين، لكن الزمن يمر سريعًا، يرحلون إلى المنارةِ، منارةٌ تغري القارئ المهووس بالتأويل المتشوق إلى نقد النص أكثر من قراءته، متشوقٌ لإظهار عمق نظرتهِ وتشريحه للرموز والدوال التي تقفُ هناك مشرعة أبوابها للنقد والتفكيكِ، مغرية القرّاء الفضوليين الثرثارين لهتكِ عذريتها من المعنى، “المنارة” فيضٌ من المدلولات، قد تكون مثل “جزيرة اليوم السابق” عند إيكو، عصية بعيدة وقريبة في آن، بها تبدأ الحكايات وبها تنتهي دون أن يبلغها أحد يلهث القارئ يتعثرُ بمراوغات الكاتب الكثيرة، وخدعه اللانهائية التي تتربص به في كل صفحة، يرقب المنارة بعيدًا، يقول: “حتمًا سيصلون الآن”، لكن لا هو ولا الحكاية ومن فيها سيصلون إلى المنارة، ربما سيقول في النهاية محاولًا إخفاء خيبته من غياب النهايات المدهشة: “قد يكون الكنز المفقود، الفردوس، الجزيرة، المنارة، شيءٌ هنا قريب يسكنُ اللحظة “التي تتدلى عالقة””، ثم يتنهد في نهاية الحكاية، تاركًا هذا الخواء الذي يهزهُ بعد حكايةٍ “خفتها لا تحتمل” تتسكع في روحهِ دون أن يورط نفسه بألاعيب اللغة وفخاخِ التأويل، متسائلًا مع اكتمال اللوحة التي لم تعد تحلم مثل أي فنٍ بالخلود، لم يعد يعنيها إلى أن تنتهي حتى يستريح الفنان إلى “رؤياه” التي بلغها، رؤياه التي هي رؤيا صوفي، سرٌ لا يقال، وإلى حقيقة وحيدة: “وهكذا فنينا كلٌ وحده”، “وبذا تغدو الحياة صدى لا ينفك يتردد”.