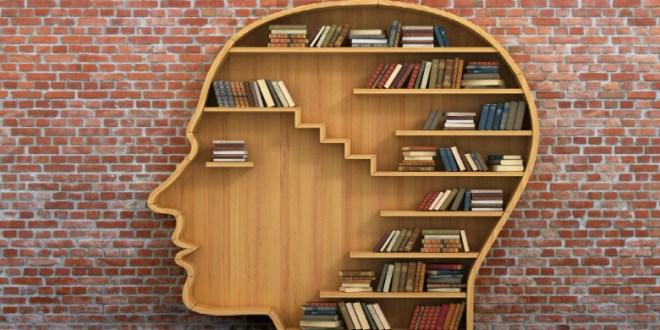بين ضرورة التأصيل وآليات المراجعة
تُعد النَّظرية نشاطاً فكرياً وإنسانياً، وعادةً ما تتسم كلُّ النظريات بطابعِ التنقل والارتحال تبعاً لدورة الأفكار وحاجة الحياة الثقافية والفكرية والإنسانية إلى تحريك المياه الراكدة، وتجريب قنوات جديدة لتصريف تلك الحركية في إنتاج الفكر الإنساني. النظرية إذن، قابلة للتغير والتحول على غرار الإنسان، ووفق مقاصد وغايات مُحدَّدة، وعن طريق مختلف الوسائط التي تُعدُّ شرطاً أساسياً لتوجيه النشاط الفكري.
ولقد حظيت النظرية باهتمام المشهد النقدي المعاصر ومختلف المؤسسات الثقافية، وازداد الوعي بقيمة فتوحاتها، منذ صدور كتاب “نظرية الأدب” لرينيه ويليك وأوستن وارين نهاية الأربعينيات، ولو أنه من الصعب بمكان، اعتبار النظرية نهائية وقادرة على الإجابة عن كل الأسئلة، فـ”المدافع الحقيقي عن أهمية النظرية يجب أن يبدأ من الاعتراف بمحدودية ما يعد به، وأنه ما من نظرية يمكن أن تتسم بالكمال، أو تزعم القدرة على تفسير كل جوانب التباين في التجارب الأدبية”، ومردُّ ذلك إلى حالة الإدهاش التي يُخلِّفها العمل الأدبي، وإلا ستصبح النظرية الأدبية خاضعةً للنسق وغير قابلة للتحول والاندفاع نحو الأمام، فهي تركيبة تستنطق النص الأدبي بشكل نسبي، وتستمد سيرورتها من فعل ممارساتها الآنية، وهذا ما يَمنحها قيمة السقوط في مفارقات حادة: الالتزام بحدود النسق التي ترسمها كل نظرية، وما يطرحه ذلك من قدرة على استيعاب الأسس العامة للشرح والتفسير والتأويل، ثم استبعاد كل ما يخالفها، تحقيقاً لمفهوم المفارقة في تحديد مسوغات النظرية الأدبية.
“إن منطق الإنجازات البشرية برمتها، يفترض وجود أشكال عديدة من الاتصال، إذا لم نقل الامتداد بينها، وذلك أن وجود الأفكار الجديدة يكون بمقابل أفكار أخرى موجودة كأرضية لكل تحديث فرضته سياقات معينة”، ولا يُمكن أن نتصور وجود أفكار جديدة بدون خلخلة جديدة. ثمة ارتباط وثيق بين مفاصل الاشتغال في الحقل النقدي، بمعنى أن هناك أشياء تتغيَّر، وأشياء أخرى تُضاف، من منطق الحركية التي يعرفها التفكير الإنساني، واتساع النشاط الذهني المنتج للمعرفة حقاً، نحن لا ننكر أن الدرس النقدي العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وصولاً إلى وقتنا الراهن، بدأ من إثارة الكثير الإشكاليات في علاقتها بالثقافة العربية، ومدى قدرتها على الانخراط في نشاط التفكير الإنساني، رغم ما يعتور ذلك من صعوبات خصوصاً على المستوى الإجرائي، فلا يُمكن مثلاً “أن نحكم على النقد الذي أنجبهُ الفكر العربي الوسيط من منظور حديث أو تصورات معاصرة، بل الأولى أن نضعه ضمن سياقه التاريخي ونُقوِّمَه وفقَ مقاييس المرحلة الزمنية التي ظهر فيها”، تبعاً لذلك، تبقى الغاية في التأسيس لنظرية أو نظريات نقدية حاجة ملحَّةً، تراعي ما أمكن اجتراحات وقيم الثقافة العربية، لأن ذلك، يساهم في بلورة مشروع نقدي عربي مؤسس على حدود معرفية وعلمية واضحة من جهة، ويُعيد للذات العربية أفقها كذات مفكرة ومنخرطة في أسئلة الحداثة ونظريات ما بعد الحداثة، “ولتحقيق هذه الغاية أي المساهمة في تأصيل نقد عربي، وجدتنا نبحر في عوالم الفكر النقدي دون أن تكون لنا ضوابط علمية متعارف عليها تسمح لنا برسم خطوط العرض والطول، وكشف الاتجاهات، وحساب التوقعات. فارتأينا أنه لا يمكن للأداة النقدية أن تستجيب للطموحات ما لم تكن بدورها خاضعة لبوصلة واضحة ولصرامة نظرية تضع الاستراتيجيات وتحدد الثوابت والمنطلقات”، صحيح، أن معيارية الممارسات النقدية العربية لم تتحرر بعد من حالة الانبهار بالنظريات الغربية، لكن، علينا أن نُقِّرَ بفضل نُقادنا وإسهاماتهم في التأصيل لنظريات نقدية، “بيد أن التراث النقدي العربي يسجل وباعتزاز الجهود النقدية العربية ويضعها في مصاف الأعمال المبجلة”، شريطة النظر إلى هذا التراث كـ“نظام”، قابلللتغير والتحول، كما أنه لا يمكن إلغاؤه من الإنتاج المعرفي الإنساني، لأنه ببساطة “فعل تأسيس“، ومكتسب يفرض كينونته وشخصيته، كما أن هذا التراث ليس “مقدسا“، وإمكانية تطوره وامتداده في جسد الحداثة وما بعد الحداثة ممكنة ومتاحة، ما لم يتسرب إلينا تعسف الإسقاط ووهم الثورة على الأشكال القديمة، ثم إن السيرورة المعرفية تقتضي نوعاً من التواؤم بين الحداثة والتراث، لا باعتبارها جدليةً قائمة على أساس الريادة والسبق، بل لكونها امتداداً مؤسساً لوجودهما معاً، صحيح، أن هذه الجدلية خلقت أشكالاً شتى من “الهدم” و”البناء على الأنقاض”، لكن هذا لا يعني البتة “موت التراث“، لأن الحداثة، ستبقى مفاصلها معطوبة ما لم يكن الماضي كائنا فيها، تستند عليه، وتسترشد به في استشراف الأفق وتحقيق السيرورة.
غير أن مسألة التأصيل ممارسة نقدية عربية، لها كيان خاص بها، يبدو أمرا صعب التحقق، وإن كان هناك توجه منذ مطلع القرن الماضي نحو استشراف آفاق جديدة للخطابات النقدية العربية عبر المثاقفة، والانخراط في عجلة النقد العالمي، إلا أن الملاحظ أن شروط تشكل هذه النظريات النقدية، ظلت حاجزا يحول دون استنبات هذه النظريات بالشكل الذي يسمح ببلورة ممارسة نقدية عربية خالصة، وفي اعتقادنا، أن هذا الانخراط في مسيرة النقد، من شأنه إثراء المناهج العربية ونظريات الأدب، إذا ما تعاملنا مع المثاقفة بروح علمية تقويمية، ولا نكتفي فقط بذاك الانبهار الخادع. إننا نقدر جهود نقادنا العرب من الرفد من الثقافة الغربية، ونسجل باعتزاز محاولاتهم الحثيثة في تجديد الرؤى والتصورات بشأن الممارسة النقدية، في ظل استحالة تأصيل نظرية نقدية عربية، لسبب بسيط هو أنها تشكلت في إطار المثاقفة، فضلا عن حمأة الصراع الدائر بين أنصار النقد التراثي والحداثيين. لقد حان الوقت للانخراط في دينامية المثاقفة، والبحث عن طرق نسهم من خلالها في الدفع بتصوراتنا ورؤانا ومفاهيمنا الثقافية نحو صميم الإشكاليات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم.
يؤكد الباحث رسول محمد رسول على أهمية “إعادة التفكير في رؤيتنا إلى التاريخ الثقافي، سواء تاريخنا نحن أو تاريخ غيرنا، ذات أهمية فائقة في ظل التغيرات الجذرية وشبه الجذرية التي تدور رحاها في عالمنا المعاصر، خصوصاً في ظل نزوع البشرية صوب الكونية المتعالقة التي تتسع كلما حققت ثورة الاتصالات مزيداً من التقدم في جعل العالم يرى ذاته بكل أطرافه وتخومه وهوامشه في لحظة متزامنة واحدة”، وبذلك لا يمكن النظر إلى الحداثة إلا بوصفها أفكاراً تتوالى فوق “أنقاض” أفكار أخرى، مؤَسِّسَة، ومتجاوبة مع مقتضيات العصر ورهاناته، “وخير وسيلة للجمع بين محاسن القديم والحديث، أن يتصف أصحاب الحديث بالأصالة والعراقة والقوة والابتكار، وأن يتخلى أصحاب القديم عن كل ما لا يوافق روح العصر من التقاليد البالية والأساليب الجامدة”.
بيد أن هناك اختلاف بين “القدامة” و”الحداثة” في الرؤى والمفاهيم والتصورات، “فالحداثة في الأدب مصطلح بالغ العراقة والجدة معاً، فهو يشير تراثيا إلى الصراع بين القدماء والمحدثين، كما يشير مجددا إلى صراع جديد في الوقت الراهن بين قدماء ومحدثين حول التغييرات الجذرية التي وقعت أو لا تزال تقع في القصيدة العربية المعاصرة.. فهي وعي بواقع متحول من ناحية إلى حوار مع تراث آخر يعاد إنتاجه لصالح هذا الوعي من ناحية ثانية”. إننا لا نزعم امتلاكنا لحلول منهجية وعلمية لكل معضلات النقد العربي، بقدر ما نحاول البحث في راهن النقد من أجل نقاش مثرٍ وخصب.
مصدر الصورة: https://2u.pw/M7ahQ