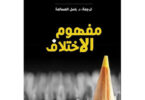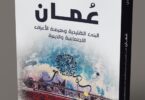لم تكن علاقة الإنسان بالزراعة علاقة برجماتية في كل الأحوال، بأن يختار الإنسان أرضًا خصبة يودع فيها البذور ويستمر في رعايتها في مراحل حياتها، إلى أن تصبح يانعة وتؤتي ثمارها. بل كانت هذه العلاقة في بعض الأحيان علاقة ترابط وتكامل وتعاون وسمة أساسية في حياة الإنسان، كزراعة النخيل التي عبر وجودها وانتشارها في بعض المناطق عن سمات إنسانية وثقافة فريدة، فرعاية النخيل والدأب على متابعته ليس أمرًا سهلًا أو ترفًا، بل يحمل كثيرًا من المشقّة.
لذلك فإن علاقة الإنسان مع النخيل علاقة وطيدة تبدأ في مرحلة الطفولة والصبا بأكل الثمار واللعب بسعف النخيل، وتستمر بالعمل والمسؤولية في مرحلة الشباب والمتابعة والحثّ على العمل في الكِبر، لذلك وجد الإنسان ذاته في النخيل، فاكتسب من الدأب على رعايته الصبر وتحمّل المشقات. وهناك من يقول أن بين الإنسان والنخيل في المناطق التي يكثر بها؛ سمات مشتركة أهمها العزّة والشموخ والصبر.
بدأت علاقة الإنسان العربي بالنخيل منذ مئات بل آلاف السنين، نظرا للبيئة الصالحة لانتشاره في شبه الجزيرة العربية بما فيها اليمن وجنوب العراق، وأيضا في بعض المناطق بمصر، خاصة سيناء والواحات، حيث النخلة جزء أساسي من أساسيات الحياة ورعايتها جزء من الحياة اليومية للإنسان في هذه البقاع، ويعوّل عليها في كثير من شؤون الحياة، فيعيش على ثمارها، ويستفيد من مكوناتها في أغراضه اليومية.
أصبحت النخلة رمز الشموخ والسمو والعطاء، لذلك وُظفت في الأمثال الشعبية والمقولات المأثورة وفي ضرب المثل على العطاء وإنكار الذات، فمن التشبيهات السائدة “كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعاً، يرمى بالحجر فيلقي أطيب الثمر” فالنخلة إذا رميتها بحجرٍ؛ رمتك بالتمر، وأيضًا كُنْ شامخًا مثل النخل، وازرع في كل مكان نخلة… إلخ.
تغنى الشعراء العرب بالنخيل في قصائدهم في مختلف المراحل الزمنية منذ العصر الجاهلي وحتى الشعر الحديث، واستلهمت الثقافة الشعبية في منطقة الخليج دور النخيل وأثره في حياة الإنسان، فأبدعت عديدًا من الأمثال الشعبية المعبرة، على نحو ما سنبين آنفًا.
النخلة.. عصب الحياة
أثّر النخيل والتمور في الثقافة الشعبية بمنطقة الخليج العربي، بسبب العلاقة المترابطة والمتجذرة منذ أزمان غابرة، فشكلت النخلة عصب الحياة ودخلت مكوناتها في صناعات عديدة واستخدامات شتّى، مثل صناعة الحبال التي يكثر استخدامها في ربط السفن، وفي أعمال البناء، فهذه الحبال مصدرها الأساسي ليف النخيل، حيث جرى صناعتها وتفضيلها على الألياف الصناعية، وكانت تستخدم قديمًا في ربط جذوع النخيل بعضها إلى بعض في عملية البناء داخل القرى القديمة، لكن مهنة فتل الحبال التي احترفها الأجداد في الماضي كإحدى الحرف اليدوية التي تعتمد على الخبرة والمهارة قد اندثرت في العصر الحديث، ويدخل الخوص في صناعة مساحات وأشكال مختلفة كالحصر للجلسات، وسفرة الطعام، والقفف، والمراوح اليدوية، وأغطية الطعام… وغيرها من الأدوات. وتتميز هذه الأدوات بأنها معمرة، حيث تتم صناعتها من السعف في مرحلة الاخضرار، وتعالج بعد نهاية صناعتها بالغمر في الماء والتجفيف وقد يتم تلوينها في بعض الأحيان للزينة. هكذا اعتاد الإنسان في الماضي السحيق بمنطقة الخليج أن يستفيد مما توفره الطبيعة الإلهية، فبحث عن اللؤلؤ وحصل عليه، ورعى النخيل واستفاد من مكوناته، ووفرت له التمور الغذاء الجيد طول العام، واستفاد من مختلف المعطيات التي تتوفر له، ليتجاوز صعوبة البيئة الصحراوية وحرارتها الملتهبة.
وتعدّ صناعة التمور في منطقة الخليج من الصناعات اليدوية الهامة، خاصة المناطق القديمة حيث توفر المؤن للبيت طوال العام، فما أن يأتي موسم الرطب إلا وتجد كل بيت يقوم بتجهيز وصناعة التمور. ومن أنواع الرطب المنتشرة في الأحساء (شرق السعودية): الخلاص، والرزيز، والشيشي، والغر، والخنيزي، والزاملي، والهلالي، وأم رحيم، وشهل، وعذابي.. وغيرها. وتنتشر في بعض المدن العربية أسواق للتمور، من بينها مدينة الهفوف يالأحساء، حيث تضم سوقًا خاصًا للتمور يقام على مدار العام.
البيئة والألعاب الشعبية
في بعض البيئات الزراعية بمنطقة الخليج كواحة الأحساء؛ ارتبط الأطفال ببيئتهم ارتباطًا حميميًا، فراحوا يلهون في الطرقات بين المزارع، وكعادة الناس في الواحات هناك ارتباط وثيق وتناغم دائم مع النخيل. وأهالي الأحساء اعتادوا زراعة النخيل والاهتمام برعايته، على الرغم من انه يحتاج إلى خدمة شاقة، ومثلما منحوا النخيل الحب والرعاية، فإن النخيل أكرمهم ووهبهم أنواعًا عديدة من التمر الذي يذكر في الأحساء باسم الـ”رطب”، ومنه تتم صناعة التمور التي يطلق عليها في القاهرة “عجْوة” وتُعدّ من الصناعات التقليدية في البيئة الصحراوية وفي مقدمتها سيناء.
استفاد الأطفال في منطقة الخليج من تطويع أجزاء من النخيل لألعابهم الشعبية، وتصميم ألعاب تناسب أعمار مختلفة، فقد اشتهرت الجزيرة العربية بالكثير من الألعاب التي أصبحت الآن من التراث، وقد شكلت تلك الألعاب طبيعة هذا المجتمع من حدود الخليج العربي حيث ضفاف الخليج إلى قلب الجزيرة العربية ذي الطابع الصحراوي, لتكون تلك الألعاب ممثلة لجانب مهم من حياة وتاريخ ذلك المجتمع. وأصبحت لكل منطقة ألعاب شعبية يرتبط بها الصغار، ومازالت بعض المناطق تحتفظ بكثير من هذه الألعاب ويمارسها الصغار، بينما انقرض بعضها ولم يعد له وجود. والغريب في هذا الأمر غياب الدراسات الشعبية والاجتماعية والتأريخية عن هذا الجانب الذي يعطي انطباعا وتوثيقا عن جزء مهم لطبيعة الحياة في مجتمع الخليج قديمًا.
يقول الباحث في الثقافة الشعبية د. علي الدرورة لقد اعتمد الأطفال في ألعابهم الشعبية على النخيل بشكل كبير، واستثمروا ما في بيئتهم بما يتناسب مع طفولتهم وطوّعوه ليكون لهم ألعاباً يلهون بها، فتنمو قدراتهم بتلك التسالي والألعاب. لقد كانت لهم طرقات المزارع وظلال النخيل عالما فسيحًا يمرحون فيه. وقد اعتمدوا في ألعابهم على النخيل، فوظفوا مكوناته حسب حاجة كل لعبة، مثلا لعبة الخيالة أو “خيل جريد” التي تعود تسميتها إلى أن الأداة المستخدمة في اللعب تسمى خيلاً، أي حصانا يمتطى، فيأخذ كل صبي جريدة ويلهو بها بطريقة الفارس الذي يمتطي حصاناً أو فرساً، وتسمى هذه اللعبة في بعض مناطق الخليج كما في القطيف والأحساء والبحرين (جحش) أو (جحيشة)، وقد يسميها البعض حصاناً، وتكون من جريدة كاملة، تجرد من الخوص ويبقى قليل منه عند القمة ويلعب الأطفال هذه اللعبة بجوار منازلهم أو بين المزارع. وكذلك لعبة (قلة إخلاص كلوها) وتعتمد كليًا على النخيل فتركز عصا قوية من جريدة النخل في الأرض ويربط بها حبل من ليف النخيل، ويجلس من تقع عليه القرعة بجانب العصا، والأطفال يضعون أيديهم على كتف اللاعب الجالس. وهذه اللعبة غير مدونة في كتب التراث وأخبر الرواة أنهم كانوا يلعبونها عندما كانوا يافعين.
هناك عديد من الألعاب الأخرى، التي تعتمد على مكونات النخيل مثل لعبة (الهشت) التي تعرف في دولة الإمارات العربية بالاسم والمضمون نفسه، وتتطلب مشاركة أربعة من الصبيان يأتون بأربع من جريد النخيل، يبلغ طول كل واحدة منها نحو خمسة عشر سنتيمتراً، وترتكز اللعبة على ألوان الجريد، ولعبة (القرقعانة) المعروفة في جميع دول الخليج بهذه التسمية، بينما في بعض مناطق السعودية تعرف باسم طرطيعة وتعتمد على جزء من العذق أو العرجون الحامل لعدد من الشماريخ، وهي الأغصان الحاملة للبلح، وتسمى عند أهل الإمارات باسم (لِعسِكة) بفتح العين، أو (إِلْعَسَكة). ولعبة (الفرّارة) ويتخذها الأطفال من ورق أغصان النخيل وهي ما زالت خضراء (الخوص) ويشكلونها بطريقة معينة على هيئة مروحة السفينة (البروانة) ثم يقوم كل صبي بتثبيت الدوامة على شوكة النخل، ثم يجرون بها، وأثناء الجري يحدث لها الدوران، وفي اللهجة الشعبية يقال: (تِفْتَر) أي تدور ومن هذه المفردة أخذت التسمية فُرَّارة. وقد أوردها المرهون وقال: تصنعها النساء من خوص النخيل الأخضر، يتداخل بعضها في بعض، وتكون لها أربع شفرات بطول عشرة سنتمترات، ولها ثقب في وسطها، فيضع الطفل فيه شوكة من شوك النخيل، ويعدو بها مسرعاً في الطريق، فتدور حول نفسها بسرعة فائقة.
وهناك ألعاب أخرى لا تعتمد على النخيل مثل لعبة (عظيم ساري) المشتهرة في منطقة نجد، و(شد الحبل)، و (تحدي كسر البيض) ولعبة (طاق طاق طاقية) المعروفة في منطقة الخليج. وكل هذه الألعاب انما تنمي حب التنافس والتعاون والاعتماد على النفس، بالاضافة إلى الجانب الرياضي البدني الذي يتحقق من ممارسة هذه الألعاب.
الشعراء يتغنون بالنخيل
تغنى الشعراء بالنخيل قديما وحديثا، مثل أمرؤ القيس، وأبو تمام، وابن سهل الأندلسي، وجرير، وابن الرومي، وأبي العلاء المعري، والحسن بن هانئ، وصفي الدين الحلي، ووضاح اليمن، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وبدر شاكر السياب، عبد الله البردوني، والشاعر مظفر النواب الذي أنشد قائلًا:
“وصرت كأني صفر في الريح
وصلت إلى باب النخل .. دخلت على النخل
أعطتني إحدى النخلات نسيجًا عربيًا
فعرفت بأن النخلة عرفتني”
والشاعر العربي محمد مهدي الجواهري الذي كتب قصيدة بعنوان “تحت ظل النخيل” قال فيها:
“يا حبذا هذبانُ العاشقين بكم
لا شيءَ أفصحُ عندي منه تبيانا
وحبذا تحت النخل مُصْبَحُنا
بدجلةٍ وعلى الأجرافِ مُمْسانا”
وفي استلهام المثل الشعبي قيل “لاهو فوق عذوق ولا هو تحت عروق” ويقال لمن لا يستفاد منه مهما حاولت، وهو عكس النخلة التي عذوقها من التمر في أعلاها ولها جذور، مع العلم بأن الجذر الرئيسي للنخلة كان يعتمد عليه في حرق الطَفلة لتكوين الجص. ويقال أيضًا “الخلاص لازم فيه شيص” بمعنى انه لا يوجد شيء مكتمل حتى تمر الخلاص الذي هو الأفضل فيكون به جزء غير ملقح (شيص) ويقال “لو حصلت تمرة ما أكلت جمرة” وهو وصف معنوي عن ركوب الصعاب ومحاولة نفي اللوم عن نفسه وإقدامه على فعل اضطراري. ومن الأمثال الشعبية القديمة في منطقة الأحساء : “أخذ المرحلة بعراها” أي الرغبة في الحصول على شيء وعدم اجتزاء الأشياء، والمرحلة هي سلة مصنوعة من جريد النخل يوضع بها التمر لنقله وتسويقه، وعراها أي مماسكها.
ومن الأقوال المأثورة حول النخيل: شباب الوطن مثل النخل، لا ينحني رأسه، ولا ينثني لأحد أبداً، ويبقى جذع النخلة صلب، لا ينحني للفلاّح، وكن مثل النخل صبوراً لا تهزك الرياح، قد تميل قليلاً، لكنك تصمد في مكانك. و”مثل المؤمن كمثل شجرة النخل، فهي شجرة لا تسقط أوراقها، وثابتة الشكل الظاهري، وثابتة الأصل، وتتصف بسمو الفرع، والنفع الدائم”، والنخلة كريمة بعطائها، حتى لو قطعت أطرافها. وأيضًا ثلاثة مظاهر تذهب الحزن عن المرء: القمر في ليلة بدر، والماء الجاري، وسعف النخل حين يعانق السماء، وكن كالنخل كريماً يكثر من الصدقة للطيور، والعصافير، وألا ترى أن النخلَ ينمو في الفلا سمقاً، والورد يزهر في منتصف الحجر.
مصدر الصورة: https://2u.pw/xJ2G3