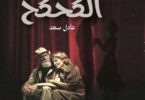(نُشر الحوار على صفحات مجلة PHILOMAGAZIN سنة 2018)
المحاور:
أنتَ روائي ومؤرخ للعصور الوسطى، وناقد ثقافي وسيميائي وكاتب مقالات، مفكّر متنوع الاهتمامات، لكنكَ بدأتَ حياتك بدراسة بالفلسفة. هل كانت الفلسفة مهنتك الأولى؟
إيكو:
دائمًا ما يرغب الإنسان في فعل أشياء عديدة في حياته، لما كنتُ في الثالثة رغبتُ في العمل كسائق قطارات وفي المرحلة الثانوية ظهرت ميولي الأولى نحو دراسة الفلسفة. وكان الفضل في ذلك لأستاذ ممتاز. كان لدي صديقان أكبر مني يَــدْرُســان الفلسفة، حاولا أن يرياني كم أنا أحمق، وهو ما أذكي بداخلي شعورًا بالفخر. رغم ذلك اضطررت لخوض صراع لأتمكن من دراسة الفلسفة، فأبي ينحدر من أسرة مكونة من ثلاثة عشر فردًا وكانت رغبته الأساسية أن أكون محاميًا. كان يرى أن دراسة الفلسفة معناها مكابدة الجوع وكان يراني أستقل كل يوم قطارًا ينطلق بي في الخامسة صباحاً يوم لأُلقي دروسًا في قرية نائية في “بيدمونت”، لكنني دحضتُ وجهة نظره في النهاية.
المحاور:
أي الفلاسفة أثروا فيك تأثيرًا قويًا؟
إيكو:
القديس توماس الأكويني بوصفه نموذجـًا للحِجاج. ربما لم يبقَ اليوم من أطروحات توما الأكويني شيئًا لكنه ابتكر طريقة مذهلة في تنظيم أفكاره داخل نسق. وفي مرحلة الدراسة الجامعية تأثرتُ بكتابيْن: الأول “محاولة في العقل البشري” لجون لوك والثاني كتاب” الأخلاق” لسبينوزا.
المحاور: تياران متناقضان للتفكير الإنساني!
إيكو:
ألم يسبق وأن وقعتَ في غرام امرأتين مختلفتيْن تمام الاختلاف؟ أليس في وسعنا تقدير موهبة لاعب الملاكمة مثلما نُــثـمّن موهبة راقصة؟
المحاور:
ألا تخشى من خوض غمار مجالات خارج حقل الفلسفة، كالرياضة أو الكوميكس أو التليفزيون؟
إيكو:
كان ديكارت عالم رياضيات وباسكال عالم فيزياء ولايبنتس أمين مكتبة. قبل ابتكار فكرة الجامعات كان الفلاسفة أناسًا يمتهنون مهنًا أخرى غير تدريس الفلسفة وقد حاولت المحافظة على شيء من هذه التقاليد.
المحاور: أنت متخصص في علم السيمياء أي علم العلامات، ما تعريفك لكلمة العلامة؟
إيكو:
حسبي ما قاله القديس أوغسطينوس. العلامة هي ذلك الشيء الذي ينقلُ ما في رأسي إلى رؤوس الآخرين، وهذا التعريف البليغ لا يحتاج إلى إثباته عبر واقع، لأنه صحيح بالفعل حتى لو لم يكن العالم موجودًا.
المحاور: وما أهمية علم السيمياء بالنسبة للتفكير الراهن في عالم اليوم؟
إيكو:
ترجع أهمية “علم السيمياء” إلى أنه يمثل الشكل الحديث للفلسفة. فعلم السيمياء هو أفضل طريقة للتعامل مع المتغيّر الذي احتلّ مكانة مركزية في قلب فلسفة القرن العشرين، وهو ما أطلِقَ عليه لفظ “الانعطاف اللغوي”[1]. لتبسيط ذلك بكلمات واضحة أقول: كيف يُمكنني ربط معنى “الزجاج” بمفردة “زجاج”؟ حاول الفلاسفة التحليليون الذين سيطروا بأفكارهم على العالم الأنجلوسكسوني الإجابة عن السؤال بالسعي إلى صقل اللغة وشحذها، أي بضرورة أن تقتصر اللغة على المفاهيم/الأفكار المتطابقة بحذافيرها مع الأشياء الخارجية أو المواقف التي تصفها هذه اللغة، كما لو كانت اللغة مجرد ملصقات تُلصق على سطح الأشياء. بيد أن علم السيمياء يقارب هذه الإشكالية مقاربة مُختلفة فعلم السيمياء لا يعير اهتمامًا إلى العلاقة بالعالم بقدر ما يولي اهتمامه بكيفية توليد المعنى/الدلالة أو ما نُطلق عليه في علم السيمياء “عملية خلق الإشارة” ولنضرب مثلًا بوحيد القرن. فالفيلسوف التحليلي المنطقي لن يهتم مطلقًا بتأمل حيوان وحيد القرن، لأنه بالنسبة إليه غير موجود، أما بالنسبة للسميوطيقي فلحيوان وحيد القرن أهمية جوهرية لأنه عنصر من عناصر عالمنا الذهني. فقدرتي على التفكير في حيوانٍ كوحيد القرن وقدرتي في التفكير في الله أو في هاري بوتر مثلًا هو جانب أساسي من جوانب حياتنا العقلية، بل ومن جوانب حضارتنا ومبادئنا الأخلاقية وسلوكنا، وهو جانب لا يمكن التغاضي عنه بأي حال.
المحاور:
بهذا المعنى فنحن عالقون في شِباك اللغة من دون أن نتمّكن من بلوغ الواقع بلوغًاس مباشرًا مثلما ذهب رولان بارت الذي كنتَ تعرفه معرفة وطيدة.
إيكو:
أكِــنُّ كل تقدير إلى رولان بارت كونه مؤلف وصديق. لكنه ارتكب حماقة بالغة لما زعم في إحدى محاضراته في “الكوليج دي فرانس” أن اللغة فاشية اللهم إلا إذا كان المقصود أننا داخل نظام فاشي يسهل جدًا معه القيام بثورة والانتقال إلى موقع المعارضة. اللغة ليست سـجنًا بل ثورة متجددة.
المحاور:
لديك اهتمام بمسألة الثورات في مضمار الفن. في كتابك “العمل المفتوح” تعقد مقارنة بين الأعمال الأدبية الكلاسيكية المقـترنة بفكرة الكمال والخاضعة للقواعد والأسس الفنية وبين الأعمال الأدبية الحديثة القائمة على انفتاح المعنى ولا نهائية التأويلات، لكنها في الوقت ذاته ترفض إساءة تأويلها.
إيكو:
أنا لا أعدل عن مواقفي البتة. ولكن تعدد التأويلات مـردّه وجود حقائق أو أحداث أو نصوص أدبية يحاول الإنسان تأويلها. وسط ذلك تظل الحقيقة الثابتة هي ما أسمّه “ركيزة الوجود الأساسية”، وهي ليست أطروحة ميتافيزيقية، وإنما نظرية علمية. هو نفسه مبدأ “قابلية دحض النظريات”بالمعنى الذي ذهب إليه كارل بوبر[2]. ربما تـظن أن حياتنا ما هي إلا سلسلة من التأويلات، إلا أن حياتنا لا تخلو من تأويلات لا تعمل بكفاءةٍ في بعض الأحيان.
المحاور:
في كتابك “البحث عن لغة مثالية” وقفت مناصرًا لمبدأ التعدد اللغوي وعن أمثولة برج بابل، ومناهضًا لأسطورة اللغة الأصلية للبشرية. هلا شرحتَ لنا بعض التفاصيل؟
إيكو:
اللغة هي محاولة بشرية للتكيف مع أوضاع معينة، ومن هنا جاءت أطروحات أبيقور أن اللغة لم تنشأ من مصدر واحد بل من مصادر متعددة وأنها ما تنفكّ تتطّور في مواقف معينة، وهو سبب تعدد اللغات البشرية. وهذا هو الحل الأنثروبولجي الأفضل لحسم عضلة أصل اللغة. وفقًا لنظرية تشومسكي فثمة بنيات ذهنية متشابهة في جميع لغات العالم. وربما أتفق مع رأيه من ناحية المبدأ، وإلا كيف نفسّر كيف يشرع الطفل في تعلم اللغة. إلا أن خطأ تومشكي الوحيد أنه عَـمّم هذا المبدأ انطلاقًا من لغة بعينها، وتحديدًا من اللغة التي ينطق بها لسانه. فهو يذهب مثلًا إلى أن تصّور الرسم مقرون دائمًا برسم الأشياء من الخارج، حيث يقول: I paint my house، قاصدًا بذلك طلاء منزلي من الخارج. ربما ينطبق المثل داخل أميركا حيث يعيش الناس في بيوت مستقلة، بينما لا يسري الأمر بالمثل على أوروبا، حيث نقوم بطلاء جدران شقتنا، أي طلائها من الداخل، ومن ثم فالأمر مُختلف.
المحاور:
ومن هنا فلا وجود لقواعد عامة تجمع لغات العالم في بوتقة واحدة؟
إيكو:
جرَت محاولات للعثور على لغة إنسانية مشتركة. ففي لغات عديدة يُضاف الحرف s لتشكيل صيغة الجمع، لكن الحال ليس هكذا في اللغة الإيطالية. فأي مفردة تنتهي بالحرف o في الإيطالية تكون صيغة الجمع لها مُنتهية بالحرف i. سأروي لك تجربة فريدة مررتُ بها مع ابني. حينما كان ابني طفلًا طلب منا الحصول على “بونبون”، فأجبناه: Solamente un، أي بونبونة واحدة فقط، ولما كان ابني يريد المزيد قال: أعطوني بونبونات (unos) أي أكثر من واحدة، مُلحِــقًا الحرف s بنهاية اللفظة لتشكيل صيغة الجمع. مستحيل! مـن أين جاء بهذا التصريف؟ يظل هذا لغزًا غامضًا.
تمنح كل لغة إلى العالم شكلًا مختلفًا، ولكن في كل بقعة في الكون ثمّة حبّات تحوي الكون بأكمله داخلها. فبحسب عالم اللسانيات جاك ليرو هناك ظواهر محايدة كأن نقرأ: it rains//إنها تمطر، أو أنها تؤلمني it hurts، في الروسية كما في اللغة الإنجليزية. ثمة قواسم وجودية مشتركة كالأكل والنوم وارتداء الملابس والسقوط على الأرض الذهاب والإياب، هناك بعض الحضارات تُعلي من شأن الحياة الأبدية، والبعض الآخر يحطّ من قدرها، وكل لغة تتوائم مع هذه الظروف. هنا مجددًا نرى ما أطلِقُ عليه “النواة الصلبة للوجود”. ثمة صورة جميلة للمخترع الإنجليزي جون ويلكينز[3]، وهو مبتكر أول لغة اصطناعية في القرن السابع عشر، في الصورة تحوي دائرةً وشخصًا ما تحيطه نحو أربعين مصطلحًا: up, down, o, in، وهكذا إن لم تكن تتكلّم الإنلجليزية فستتمكّن من فهم المقصود بهذه المصطلحات: هي نحو أربعين وضعًا للجسد البشري في الكون، مُـكوَّنـة بذلك اللغة الكونية للجسد البشري.
المُحاور:
تطرح أحد أطروحاتك إمكانية إعادة كتابة علم الأخلاق انطلاقًا من مبدأ احترام الجسد…
إيكو:
في مراسلاتي مع الكاردينال مارتيني (1927-2012)[4] سألني هل بالإمكان تأسيس علم أخلاق من دون الحاجة إلى الله، فأجبته أنه بالإمكان فعل ذلك لو أسّسنا علم الأخلاق على الجسد. يحتاج الجسد إلى تلبية احتياجاته من استيقاظ ونوم وأكل وشرب إلخ. لكن احترام رغبات الجسد مقرون كذلك بضوابط أخلاقية. لأنك لو علقّت شخصًا من قدمَيه، أو أجبرته على الاستلقاء فوق الأرض ومنعته من الوقوف، أو قطعتَ لسانه ولم تسمح له بالكلام فإنك بذلك تورّط نفسكَ في موقف لا أخلاقي. ومن ثم فالمباديء الأخلاقية الأساسية تتكأ على احترام احتياجات الجسد، فإذا اتبعتَ هذه الأخلاق صِرتَ مسيحيًا مثاليًا.
المحاور:
نَـبّهتَ على مفارقة زوال الجمال عن الفن في اللحظة التي يتحول فيها إلى هــوس يومي..
إيكو:
كانت الحداثة هي أول من وضع الفن والجمال على قدم المساواة. كان الجمال بالنسبة إلى الإغريق هو الطبيعة أي الشمس والعالَم، بينما المقصود بالفنّ اصطلاحًا هو إتقان صُنع الأشياء. لم يُـمـيّز الإغريق بين ما نسميّه نحن الفنون الجميلة والحِرَف اليدوية، لكن في ثقافتنا المعاصرة صِــرنا نضع الفن والجمال على قدم المساواة كما قلتُ. ثم جاءت بعض التيارات الطليعية المختلفة التي وضعت حدًا فاصلًا بين الفن والجمال. في السابق كان بإمكانك الوقوع في هوى امرأة رسمها آنغر[5] لأنها امرأة فاتنة، بينما لا يُمكنك أن تقع في هوى امرأة رسمها بيكاسو مثلًا، وبعد حدوث تينك التفرقة مضى الفن في طريقه الخاصة، وتحوّل الإحساس بالجمال إلى ضباب هارب من قبضة الفلاسفة ليقع في أسر وسائل الإعلام. رغم ذلك فينبغي للمرء أن يواصل تأمّل مفهوم الجمال بعيدًا عن مفهوم الفن، لأن بإمكانك إعطاء إجابات عامة إذا ما سُئلتَ عن ماهية الجمال. أعتقد أن أفضل الإجابات هي إجابة “كانط” القائلة بعدم الاهتمام الماديّ بالأشياء التي تجلب اللذّة. فجمال نيكول كيدمان مثلًا لا علاقة له ب”علم الجمال”، لأنكَ تشتهي جمالها بطريقة تختلف عن اشتهائك الجمالي للوحة الموناليزا مثلًا. يكمن جوهر الجمال في تحصيلك لذّة/متعة لحظة أن تتأمل شيئًا أو تسمعه، ولا تراودك الرغبة في امتلاكه.
المحاور: في ثقافة اليوم يتعاظم حضور فكرة نهاية العالَم، ألا تعد هذه الفكرة إشارةً على العودة إلى القرون الوسطى؟
إيكو:
لم يسبق إطلاقًا وأن ساد هذا التصور عن التاريخ فكر القرون الوسطى، إذ لم تمثّل فكرة “أبوكاليبسو” لحظة نهاية العالم، بل مجرد لحظة تراجيدية، هي معركة هيرمجدون السابقة ليوم القيامة ودخول الفردوس، ولما كنا اليوم مضطرين إلى الاستغناء عن فكرة الخَلاص [المسيحي]، فلدينا ما يكفينا من أسباب لنكون أكثر تشككًا عما كان عليه أهل القرون الوسطى، ولكن بيت القصيد هنا ليس فكرة الشعور بحلول الكارثة، بل فكرة اللايقين حول مغزى التاريخ.
لقد تـعثـرتْ خطوات التاريخ. ونحن لا ننفكّ نتأرجح دائمًا وأبدًا بين سلسلة من التقدّم والتقهقر. في أواخر القرن التاسع عشر اخترع ماركوني الهاتف اللاسيلكي وحين ظهر الإنترنت عُدنا إلى فكرة التواصل السِلكي، ومع ظهور الواي فاي والهواتف المحمولة نتحرك أخيرًا إلى شبكة لا تحدّها حدود. لقد حلَّ التليفزيون محل الراديو، ثم عاد الـ IPod مُعلنًا عودة الراديو مجددًا. صرنا لا ندري إن كانت الخطوة التي نخطوها هي خطوة إلى الأمام أم نكوصًا إلى الخلف.
المحاور: معنى هذا ألا نحلُم بثورة، بل بحالة اضطراب متواصل؟
إيكو:
انــظُـــرْ اليوم إلى حزب القراصنة [6] وحركة أنونيموس[7] وويكي ليكس. حتى الإرهابيون لم يصبحوا ثوريين بل أفرادًا مزعزعي الاستقرار.
المحاور:
ناقَـــشـــتْ روايتيك الناجحتيْن اسم الوردة وبندول فوكو موضوع الهرمسية ومستقبل الكِتاب والإيمان بالحقيقة، إلخ. كيف يُـعبّر فنيًا عن العلاقة بين الفكر الذهني والخيال؟
إيكو:
لم أسعَ عبر رواياتي إلى إثبات أي شيء، فقد كتبتها بدافع من المتعة الخالصة. طالما آمنتُ أنّ الفكر والخيال شيئان منفصلان، وأن أحدهما سلّـة تحمل أوراق للآخر. وبما أني غير مُصاب بالفصام فقد يحدث أن أكتب قصة وأُعــبَّرُ عن أفكاري داخلها. أما بالنسبة إليَّ كفيلسوف فكان ضربًا من المستحيل تقريبًا أن أسرد قصصًا دون أن أضمنّها بأمثولات، وكان ذلك يجري من دون قصدٍ مني ومن دون أن ألاحظه، لكن القارئ- الذي يكون عادةً أذكى من المؤلف- سرعان ما يعقد الصلة بين الموضوعيْن.
بعد إنهاء كتابة رواية “بندول فوكو” وضعتُ نفسي مكان القاريء، مُفكرًا: في رواية تدور عن هذا الأحمق. في العالم بعض الأفكار الفلسفية المثيرة للاهتمام، كفكرة العبث مثلًا. فكل عبث جائز الحدوث. الروايات بالنسبة إليَّ مضمار للتجريب، حيث أبتكر الشخصية الروائية أولًا ثم أشرع في كتابة معالجة نفسية لها، لكني لا أبدأ إطلاقًا من معالجة نفسية بغرض ابتكار شخصية.
المحاور:
تتردّد كثيرًا إلى زيارة متحف اللوفر، ما الذي يثير اهتمامك في هذا المكان؟
إيكو:
تجذب انتباهي الأعمال الفنية وسلوك الزائرين. التصوير الفوتوغرافي هو أكـثـر الظواهر التي وضعتْ حواجز فاصلة بين العين البشرية وتأمل الأشياء. لقد فقدتْ أعيننا وظيفتها في تمثّل الواقع، لا في تمثّل الأعمال الفنية وحدها. فعبر شاشة الكاميرا تؤكد لنفسك ما تراه ماثلًا أمام عينيكَ، ولأجل ذلك توقّفتُ عن التصوير الفوتوغرافي. سأحكي لك شيئًا. ذات يوم عُدت من جولة لتفقّد معالم المدينة بعد أن التقطتُ صورًا كثيرة، وحينما رجعتُ إلى بلدي اكتشفتُ أنني التقطتُ صورًا رديئة وصرتُ لا أدري ما الذي رأيته حقًا، لذلك ألقيتُ بالكاميرا جانبًا، عاقدًا العزم على ألا أعود إلى التصوير الفوتوغرافي مجددًا، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لكي أرى الأشياء وأحتفظ بها في ذاكرتي. أما إذا أردتُ الاحتفاظ بدليل مادي على زيارتي فأكتفي بشراء بطاقة بريدية. ما يزعجني حقًا في سوّاح متحف اللوفر ورغبتهم في مشاهدة كل شيء. أعتقد أنه ينبغي للمرء زيارة المتحف لمشاهدة لوحة واحدة فقط. ينبغي للمتحف إعادة تنظيم المعروض كل ستة أشهر والتركيز على عرض عمل فني واحد ليتصدّر المشهد، على أن يكون باقي المتحف مجرد تحضير وإخبار الناس حول الفرجة على هذا العمل. وهذا صعب، لكن سبق وأن قام المتحف الملكي للفنون الجميلة في بروكسل بفعل ذلك قبل عشر سنوات مع لوحة “فينوس أوربينو” لتيتيان.
المحاور:
كمفكر أوروبي ينظر بعين الاهتمام إلى مشروع أوروبا كيف تفسّر أن أوروبا مُهددة بالتخلف عن اللحاق برَكب العولمة؟
إيكو:
مصدر الخطر في أوروبا هو التعددية اللغوية، ولكن لا فائدة تُرجى من تبني لغة واحدة. فاللغة الإنجليزية التي يتحدثها الأوروبيون لا تساعدهم على فهم بعضهم بعضًا بشكل أفضل. بل على العكس، خلقتْ ألوانًا قاسية من سوء التفاهم. تملك أوروبا القدرة على التعدد اللغوي والفكري. ويكمن التعددّ الفكري/اللغوي في محاولة فهم كيف تفكر الثقافات الأخرى. بهذه الطريقة يمكن لأوروبا أن تساهم في مسألة العولمة.
المحاور:
تقول إن إحدى المهام الرئيسية للأدب هي اعتياد فكرة اللا رجعة. ألا ينطبق ذلك أيضًا على الفلسفة؟
إيكو:
أعتقد أن الفلسفة هي أجمل طريقة لمواجهة الموت. تتفلسف لأنك تريد الدخول في مواجهة ضد الموت.
المحاور: وهل واجهتَ الموت بما يكفي؟
إيكو:
بشكل أو بآخر. لدي نماذج بعينها. سُئلَ ألفريد جاري وهو على فراش الموت عما إذا كان بحاجة إلى أي شيء آخر فأجاب: “أريد خِلّة أسنان”، فجلبوا إليه واحدة ليُسلم الروح بعدها. هذه هي الطريقة التي أريد أن أموت بها. كتب هوبز على شاهد قبره العبارة التالية: “هذا هو حجر الفيلسوف”.
أوعزتُ أن يُكتَب على شاهد قبري الجملة الأخيرة المأخوذة من كتاب “مدينة الشمس” لكامبانيلا (1602)[8]: “انتظرْ، انتظر لحظة واحدة فقط.. ولكن مستحيل..مستحيل”.
[1] الانعطاف اللغوي: مصطلح شائع في الدراسات الفلسفية وهو عبارة وردت في الكتاب الذي أشرف على تحريره الفيلسوف الأميركي ريتشارد رورتي سنة 1967، وكان الفيلسوف النمساوي لودفيج فيتجنشتاين، أحد المؤسسين لمفهوم الانعطاف اللغوي القائل بأن المشكلات الفلسفية تنشأ عن سوء فهم منطق اللغة (المترجم).
[2] قابلية الدحض كما عرَّفها الفيلسوف كارل بوبر تعني قابلية الاختبار المتأصلة لأي فرضيّة علمية، ولكي تمتلك أية نظرية درجـة من المصداقية عليها أن تكون قابلية الدحض متأصِّلة فيها قبل أنْ تصبح مقبولة كفرضية أو نظرية علمية، بمعنى أنه لايوجد هنالك نظرية صحيحة بالكامل (المترجم).
[3] جون ويلكينز قسيس وعالم طبيعيات إنجليزي، ألّف كتابًا بعنوان مقال نحو طابع حقيقي ولغة فلسفية دعا فيه إلى إنشاء لغة عالمية مشتركة للبشر (المترجم).
[4] – يقصد إيكو كتاب (الإيمان بماذا؟ – أومبرتو إيكو وكارلو ماريا مارتيني)، وللكتاب ترجمة عربية أنجزتها د. عواطف نصيف جاسم عن دار أبكالو (المترجم)
[5] – جان أوغست دومينيك آنغر، رسّام كلاسيكي فرنسي، كان متأثرًا بالتقاليد الفنية الكلاسيكية القديمة واشتُــهر برسم البورتريهات (المترجم)
[6] حزب القراصنة: حركة تتبناها بعض الأحزاب السياسية في دول مختلفة تطالب بحياد شبكات المعلومات وإتاحة كافة المعلومات والبيانات بلا حجب (المترجم).
[7] حركة أنونيموس: كيان من أشخاص مجهولين يعملون في مجالات الاختراق البرمجي لا يجمعهم مكان ولا رابطة تنظيمية. أفرادها مجهولون ولا يمتلكون أي تنظيم هرمي أو أهداف مُتفق عليها (المترجم).
[8] توماسو كامبانيلا: راهب دومينيكاني وفيلسوف وشاعر إيطالي، وإشارة إيكو هنا إلى كتاب “مدينة الشمس” الذي كتب فيه أفكاره حول المدينة الفاضلة القائمة على حب الله (المترجم).