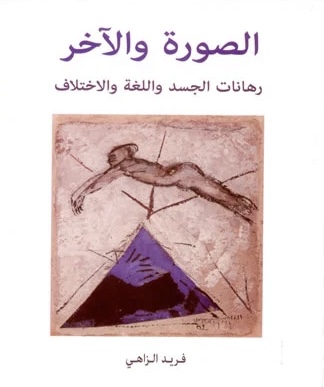كتاب الصورة والآخر: رهانات الجسد واللغة والاختلاف، تأليف فريد الزاهي، دار الحوار للنشر والتوزيع- سورية، الطبعة الأولى 2013، عدد الصفحات 275 صفحة من الحجم المتوسط.
في مقدمة كتابه يؤكد الكاتب على أنه لا يخفى أن قضية الجسد الأنثوي منه والذكوري بكل متعلقاته الأنثروبولوجية والثقافة، الواقعية منها والمتخيلة، هي أولا وقبل شيء قضية الذات بكل حمولاتها النفسانية والفلسفية والاجتماعية. من ثم فإن توجه الكاتب العربي إلى طرق قضايا الجسد والصورة أصبحت اليوم من التحولات التي تعرفها المجتمعات العربية، تأخذ إضافة إلى الطابع الاستراتيجي طابعا سياسيا، إذ هي تمس مسائل عويصة من قبيل المظاهر الاجتماعية كالحجاب والمظاهر الحميمية كالجنس والحدود بين الأجناس والممارسات الغوائية، والخطابات حول الجسد. كما أنها من ناحية أخرى صارت تجد موقعا أكيدًا لها في الممارسات الفنية المعاصرة التي صارت النساء- الفنانات فيها بالأخص- يعبرن بها عن مسعاهن النقّاد تجاه الردات التي عرفتها المجتمعات العربية في العقود الأخيرة.
الذكورة والأنوثة في الثقافة العربية والإسلامية:
يرى الكاتب أن الثقافة العربية الإسلامية لم تتطرق للذكورة والأنوثة إلا في علاقتها بالقضايا الشرعية كالعورة والنكاح، ومرد ذلك في نظره كون الإسلام والثقافة العربية التي تطورت في تاريخ البلدان العربية، ثم الثقافة العربية الحديثة لم تواجه أبدا مشكلة الجنس إلا في صيغته النكاحية، اعتبارا بأن مصطلح النكاح يجمع بين النكاح الشرعي والجماع.
ويذكر الكاتب، أن التصور الإسلامي للكائن الإنساني، يقوم على مبدأين: وحدة الجنس البشري في عمومته في علاقتها المباشرة مع الله، والثنائية القاضية بالتفرقة الجازمة بين الذكورة، والأنوثة، والشهادة، وغيرها. فالذات الإنسانية لا توجد في وحدتها إلا باعتبار ارتباطها بواجباتها الدينية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ومن ثم فقيمتها الأحادية هذه تكتسبها بالأساس بمدى قدرتها على تمثل هذا الارتباط وتحويله إلى قيمة عملية، يعلق هنا الكاتب قائلا: “تخترق ثنائية الذكورة والأنوثة كل ماهر الحياة الإسلامية كما قعّد لها النص الديني. والجنسان يشتركان في كل ماهر العبادات من صلاة وصيام، غير أن المرأة نظرا لاختلافها الجسدي وطبيعتها المختلفة تحظى في النص الديني بمجموعة من الاعتبارات الاستثنائية التي تخصها، فالمرأة الحائض والنفيس مثلا غير طاهرة”. هذه المعطيات إذن تقسم فضاءات الذكورة والأنوثة وتمس أيضا طبيعة التعامل مع الجسد من الناحية القيمة والمظهرية.
الحب الإلهي والمرأة والغيرية:
لقد اعتبر الكاتب أن الانفصام والاغتراب هما اللذان يحددان العلاقة بالمرأة ويؤسسانها؛ فالجسد الأصلي الآدمي حسب ابن عربي انفصم لتنجم عنه الذكورة والأنوثة. والمفاضلة الأصلية بين الذكر والأنثى عَرضية لا جوهرية، ذلك أن آدم فرد وحواء واحد في الفرد مبطون فيه. من ثم فقوة المرأة حسب ابن عربي من أجل الوحدانية أقوى من قوة الفردانية. ولهذا فالمرأة أقوى في ستر المحبة من الرجل ولهذا كانت أقرب إلى الإجابة وأصفى، محل كل ذلك من أجل الوحدانية. وانطلاقا من هذا الاختلاف في الفردانية والوحدانية والقوة، يفسر الشيخ الأكبر أن المرأة في الإرث تُخص بقسم لأنها الأقوى ويُخص الرجل بقسمين لأنه الأضعف.
هكذا تبدو العلاقة الجنسية رغبة في استعادة الجسد الأندروجيني الآدمي الأصل الفرداني المُبطن للوحدانية، فيغدو النكاح صورة أصلية لحركة الوجود. يقول ابن عربي بهذا الصدد: “فما كمُل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم، ولا ظهر العالم إلا عن هذا التوجه الإلهي عن شيئية أعيان الممكنات بطريق المحبة للكمال الوجودي في الأعيان والمعارف، وهي حالة تشبه النكاح للتوالد فكان النكاح أصلا في الأشياء كلها، فله الإحاطة والفضل والتقدم”؛ لهذا كان النكاح ظاهرة كونية تتم بين الحروف والليل والنهار والمساء والأرض وهو بذلك عبادة للسر الإلهي.
جينالوجيا اللوحة الاستشراقية أو وساطات الغيرية:
تنبني الرؤية الاستشراقيية على مجموعة من الوسائط المادية والمتخيلة التي تسعى إلى حل مفارقات الذات الرومانسية ومأساوية وضعيتها. هذه الوسائط تمكن دائما من التجاوز المتخيل للمفارقات عبر تمكين الذات من إسقاط كامل أوهامها على الآخر. من ثم فإن الرحلة سواء منها المتخيلة أو الواقعية، هي أساس وقوام ما يمكن أن نسميه المختبر الاستشراقي الذي فيه يتمكن الفنان من اختزال عالمه بكامله في مشرق متخيل، من جهة، وتركيز موضوعات الفن المتعددة في موضوعتين أو ثلاثة: المرأة، الأسطورة الدينية، الحروب، على سبيل المثال.
بناء على ذلك، يرى الكاتب أن الفنان الاستشراقي كان يرتدي قناعه ليبتكر شرقا خاصا به، من غير أن يكون لعينه أية علاقة مباشرة به، أو في أحسن الأحوال من خلال وساطة ما خلّفه بعض الفنانين الذين عاينوا تلك البلدان. وفي هذه العلاقة يبدو أن هذا الفضاء الغامض وشبه الأسطوري كان يحيل إلى مجال بدائي طالما تاق له الفنانون الرومانسيون. إنه فضاء يمكّنهم من استكشاف هذه البدائية الخالصة التي يمثلها الماضي الذي فات. لهذا تزاوجت لدى هؤلاء استعادة العديد من المشاهد الإنجيلية في فضاء الصحراء مع ابتكار الجسد الشرقي في حلته الاستيهامية.
مفارقات الصورة والتصور:
ليس من قبيل الصدفة، أن يكون الفن عند تجاوز التشخيص بشكل راديكالي قد اكتشف الطابع الروحاني للمعنى التصويري. ويرى الكاتب أنه لا يخفى هنا أن التجريدية في الفن تلك التي سادت بشكل أو بآخر في الفن المعاصر قد أصبحت في إحدى تطبيقاتها المبدعة، مع التعبيرية التجريدية، تلامس إنكار الصورة. إنه الأمر الذي يجعلنا– بتعبير الكاتب- نتساءل مرة أخرى عن تلك العلاقة الملتبسة بين المرئي واللامرئي، وبين المادة والمعنى في الممارسة الفنية. من ناحية أخرى فإن استخدام الجسد في المنجزة الفنية، والمادة الفضائية قد فتح المجال واضحًا أمام تجربة تجريبية فنية سوف يغدو فيها كل شيء سياقيا، أي داخلا في لعبة مسْرَحة يغدو فيها الجسد مكونا أساسا والزمن ابتكارا دائما والفضاء خدعة ليس إلا.
هكذا، يمكن القول، إن موقف الفن السياقي هو باختصار: إبعاد التمثيلات إبعادا (الفن الكلاسي)، والمداورة (الفن الدوشاني)، والمنظور النقدي الذاتي حيث يتأمل الفن ذاته ويتشرح بنفسه بتحصيل الحاصل (الفن التصوري). أما رهانه، فيتمثل في إبراز الممكنات النقدية والجمالية للممارسات التشكيلية المقترحة في صيغة تدخلات، هنا والآن. هكذا فإن السمة التي تطبع مسير الفن المعاصر لا تخضع فقط لتملُّك الواقع من خلال عرض المرئي من حيث هو كذلك، وإنما بشكل مماثل في جذريته وتبعا للتخوم التي حاذاها التعبيريون: إنكار الصورة نفسها.