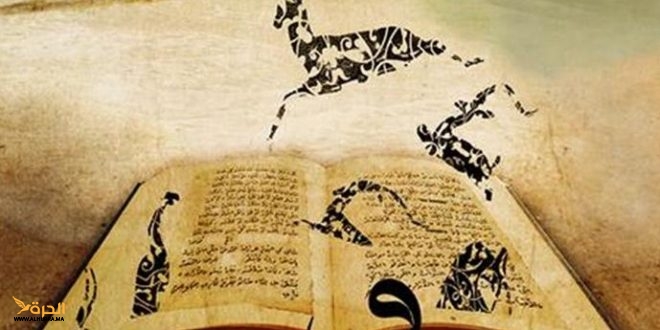لاشك أن الفضل في نشأة اللغة يرجع إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان نفسه. فلولا اجتماع الأفراد بعضهم إلى بعض وحاجتهم إلى التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عما يجول بالخواطر من معانٍ ومدركات ما وجدت لغة ولا تعبير إرادي. ولاشك كذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية تنشأ كما ينشأ غيرها من الظواهر الاجتماعية، فتخلقها في صور تلقائية وتنبعث عن الحياة الجمعية وما تقتضيه هذه الحياة من شؤون. هناك بالطبع عوامل دعت إلى ظهور اللغة في شكل أصوات مركبة ذات مقاطع متميزة الكلمات، والكشف عن الصورة الأولى التي ظهرت بها هذه الأصوات، أي الأسلوب الذي سار عليه الإنسان في مبدأ الأمر في وضع أصوات معينة لمسميات خاصة، وتوضيح الأسباب التي وجهته إلى هذا الأسلوب دون غيره.
نظريات نشوء اللغة
ترجع نشأة اللغة إلى أربع نظريات، تقرر الأولى أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى إلهام إلهي هبط على الإنسان فعلمه النطق وأسماء الأشياء، والمؤيدون لهذا الرأي من الباحثين العرب يعتمدون على قوله تعالى: “وعلم آدم الأسماء كلها” (سورة البقرة – 31) وقد اتفق مع هذا الرأي في العصور القديمة الفيلسوف اليوناني هيرا كليت Heraclite وفي العصور الوسطى بعض الباحثين في فقه اللغة العربية كابن فارس في كتابه الصاحبي، وفي العصور الحديثة طائفة من العلماء على رأسها الأب لامي Lami في كتابه “فن الكلام” والفيلسوف دوبونالد Vicomte de Bonald في كتابه “التشريع القديم”. وتذهب الثانية إلى أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق وارتجال ألفاظها ارتجالا. وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور القديمة الفيلسوف اليوناني ديمو كريت Democrite (من فلاسفة القرن الخامس ق . م) وفي العصور الوسطى كثير من الباحثين في فقه اللغة العربية، وفي العصور الحديثة الفلاسفة الإنجليز آدم سميث، وريد، ودجلد ستيوارت. وليس لهذه النظرية أي سند عقلي أو نقلي أو تاريخي. أما النظرية الثالثة فتكشف أن الفضل في نشأة اللغة يرجع إلى غريزة خاصة زُوِّد بها في الأصل جميع أفراد النوع الإنساني، وأن هذه الغريزة كانت تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة به. وبفضل ذلك اتحدت المفردات وتشابهت طرق التعبير عند الجماعات الإنسانية الأولى فاستطاع الأفراد التفاهم فيما بينهم.
تقرر النظرية الرابعة أن اللغة الإنسانية نشأت من الأصوات الطبيعية (التعبير الطبيعي عن الانفعالات) وسارت في سبل الرقي شيئا فشيئا تبعا لارتقاء العقلية الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان. وقد ذهب إلى هذا الرأي معظم المحدثين من علماء اللغة وكثير من فلاسفة العصور القديمة ومن مؤلفي العرب بالعصور الوسطى. وقد مرت اللغة الإنسانية بمراحل عديدة من الإشارات والألفاظ الدالة على معان كلية، ثم تشعبت عن هذه الألفاظ الكلمات الدالة على المعاني الجزئية. بعد المراحل الأولى التي اجتازتها اللغة بعد نشأتها، فإن اللغات الإنسانية انتهى بها الأمر في تطورها وانشعابها أن انقسمت إلى فصائل، وانقسمت كل فصيلة منها إلى عدة شعب وكل شعبة إلى عدة لغات، وكل لغة إلى عدة لهجات. وترجع نظرية مكس مولر جميع اللغات الإنسانية إلى ثلاث فصائل: الفصيلة الهندية الأوروبية، والفصيلة السامية الحامية، والفصيلة الطورانية. واللغة العربية هي إحدى اللغات الثلاث للفصيلة السامية الجنوبية التي تضم إلى جانب اللغة العربية كلا من اللغة اليمنية القديمة، واللغات الحبشية السامية.
طرائق انتقال اللغة وكيفية انتشارها
اختلفت اللغات الإنسانية في انتشارها اختلافًا كبيرًا، فمنها ما تتاح له فرص مواتية فينتشر في مناطق واسعة من الأرض، ويتكلم به عدد كبير من الأمم الإنسانية، كما حدث للغة العربية في العصور القديمة والوسطى، والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والألمانية في العصور الحديثة. ومنها ما تسد أمامه المسالك فيقضى عليه أن يظل حبيسًا في منطقة ضيقة من الأرض وفئة قليلة من الناس، كما حدث للأينو (يتكلم بها نحو عشرين ألفًا من سكان جزر هوكادو وساخالين وشيكوتو) والبسكية (يتكلم بها نحو مليون ونصف من الباسكيين الذين يقطنون جبال البرانس الغربية)، والليتونية (يتكلم بها سكان ليتونيا الذين يبلغ عددهم نحو مليونين) ومنها ما يكون حاله وسطًا بين هذا وذاك.(1) كما أن اللغة تعكس سمات الشعوب الناطقة بها.
يشكل الاستعمار بكل أشكاله البدائية والحديثة وما يمثله من توطين للغة على حساب لغة أخرى، أو الانتقال باللغة إلى مناطق أخرى والتوسع في انتشارها. وبما أن الاستعمار قديما قدم الإنسان، وأن التاريخ القديم هو فصول متلاحقة أو متداخلة من الهجرات والغزوات التي كانت أقرب إلى التحركات غير الهادفة، بل البدائية أو “الغريزية” منها إلى الحركات المقننة المخططة، فقد ساهم ذلك كثيرا في إقامة مجتمعات وحضارات في أراض أخرى مما ساعد على اندماج المجتمعات ونقل مفردات لغوية جديدة بل ونقل لغة ما إلى أماكن غريبة، فقد كانت البشرية لا تزال في حالة هلامية رجراجة، أو هي كانت غلافًا زئبقيا بعيدا عن الاستقرار والتوطن والارتباط الوثيق المحدد بأرض محددة. ونحن أقرب إلى الصواب إذا اعتبرناها أدخل في عداد ما يسميه “والتر باجهوت” بفترة تكوين الأجناس Race-Making Period منها في فترة تكوين الأمم Nation-Making ومن ثم أقرب إلى الأنثروبولوجيا منها إلى السياسة. ولا شك أن الاستعمار ساهم في فترات وعصور لاحقة في توطين اللغة، لاسيما مع تطور المجتمع والحضارة وزيادة الارتباط الايكولوجي عضويا ومجتمعيا بين الجماعات والأقاليم، ومع إطراد نمو الدولة كشكل سياسي، حيث أخذت الحركات البشرية بالتدريج اتجاها أوضح نحو الاستعمار، الاستعمار بمعنى سيطرة منظمة لجماعة على جماعة أخرى.(2)
إن النظر إلى جغرافيا العالم القديم واسترجاع التاريخ في مراحله المفصلية سيكشف كيف انتقلت اللغات وعاشت ونمت في مجتمعات غريبة عنها بسبب الاستعمار، فيمكننا عبر تلسكوب التاريخ أن نرى العالم القديم يتألف من سلاسل مرصعة كالموزايكو من الصراعات المحلية الصغيرة أو الضيقة في مداها وحدودها الجغرافية. ويوضح جمال حمدان في تفسيره لآلية الاستعمار، الذي انهكس تأثيره في انتقال اللغة وانتشارها، بأن بدايات نشاط الإنسان، وأغلبها لا تخرج عن معادلة بعينها هي “صراع بين الرعاه والزراع” وعادة ما تتشكل هذه المعادلة بشكل بيئتها الجغرافية فتأخذ لونًا محليًا خاصًا. فهو إما صراع بين “الرمل والطين”، وإما بين “الجبل والسهل”. وقد تتداخل هذه الصراعات كلها أو بعضها في حالات أو تتعاقب في حالات أخرى.
أما معادلة الرمل والطين فهي تلخص عند “برستد” تاريخ الشرق القديم، حيث نجد هجرات الرعاة وغزواتهم – ابتداء من الآراميين إلى الكنعانيين والفلسطينيين والعبرانيين والفينيقيين.. إلخ. – تتواتر خارجة من قلب الجزيرة العربية خاصة إلى كل المناطق الزراعية المجاورة في الهلال الخصيب ووادي النيل، ومثلها إلى حد كبير هجمات المور من الصحراء الكبرى الغربية على اقليم المغرب. ومعادلة الصراع بين السهل والجبل فهي بحكم طبيعتها محلية أساسا، ولذا تنتشر في تضاعيف العالم القديم كدوامات موضعية. فنرى رعاة الجبال المحاربين يهبطون على السهول وينقضون عليها غزاة أو مخربين: من جبال ارمينيا وكردستان إلى سهول الرافدين التي هبط عليها من قبل الكاسيونفي الشمال والعيلاميون في الجنوب، ومن بعد الآشوريون الذين سيطروا عليها جميعا. كذلك من مرتفعات الأناضول توالى هجوم ونزول الميتاني والميديين والحيثيين على الهلال الخصيب شرقا وغربا. وفي أوروبا من قلاع البلقان إلى أحواضها، ومن كتلة الألب إلى سهول البو ولومبارديا.(3)
وتحت تأثير البيئة الرعوية الفقيرة وما قد يعتريها من نوبات جفاف، مع إغراء المناطق الغنية، كانت جحافل الرعاة تخرج كالطوفان لتنتشر في كل مكان. ومع الانتخاب الطبيعي القاسي الذي تفرضه البيئة وقسوة النمط البشري الناتج، وبفضل حركة الخيل الكاسحة، كانت هذه الموجات تزحف آلاف الأميال لتهوى عاتية على مناطق الاستقرار المحيطة. أثناء كل ذلك وبينما تتحرك عجلة الاستعمار بقوة بما تمتلكه من قدرات تجعلها قادرة على تنفيذ مخططاتها. وتتحرك آلية الاستعمار نشاطا وتوسعا، وصعودا وهبوطا، واستقواء جماعات أو دول وضعف جماعات ودول أخرى؛ فإن اللغة في كل ذلك تتأثر بلغة النازحين والمستعمرين، أو تكتسب غرسًا جديدًا في أماكن خالية. واللغة تتحرك وتنمو هي الأخرى أو قد تتبدل مع المستعمرين والغزاة، فقد تنمو لغة وتتوسع بينما تندثر أخرى وتنقرض تماما.
إذا نظرنا إلى الفتوحات الإسلامية وراقبنا كيف انتشرت اللغة العربية مع الموجة العربية الكاسحة في العصور الوسطى وما أحدثته هذه الفتوحات من انقلاب جذري في انتشار الإسلام في انحاء الدولة الإسلامية، ومن ثم انتشار اللغة العربية في أغلب البلدان التي دخلها الإسلام. فقد خرج عرب الإسلام من قلب الجزيرة ليبنوا دولة لم تسبقها من قبل دولة في الامتداد والرقعة ولم تلحقها من بعد إلا امبراطوريات العصر الحديث وحدها. بل هي في نظر “ماكيندر” الامبراطورية العالمية World Empire الأولى في التاريخ، تقلد الإسكندر وتستبق نابليون. فمن ضمن أطراف الصين إلى أبواب فرنسا، ضمت دولة العرب والإسلام شمال الهند ووسط آسيا وكل هضبة إيران (سجستان وخراسان وفارس) إلى جانب العالم العربي بتحديده الحديث، مضافا إلى ذلك جميعا شبه الجزيرة الأيبيرية إلا قليلا أو المغرب الأوروبي أو المغرب الثاني كما كان يسمى. بل لقد طغت هذه الموجة على شطر كبير من شرقي هضبة الأناضول (أرض الروم)، حيث كانت التخوم الشهيرة (الثغور والعواصم) بين الخلافة وبيزنطة.
القبائل العربية أول من تكلم العربية
لم تكن الدولة العربية امبراطورية استعمارية؛ لكنها كانت امبراطورية تحريرية، فهي التي حررت كل هذه المناطق من ربقة الاستعمار الروماني أو الفارسي واضطهاده الوثني وابتزازه المادي، وبعدها لم تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزا لونيا، بل كانت وحدة مفتوحة من الاختلاط والتزاوج الحر، وما عرفت قط شعوبية أو حاجزا حضاريا حيث كانت وسطًا حضاريًا متجانسًا مشاعًا للجميع، ولم تخلق نواة متروبولوتية سائدة تتميز على سائر المقاطعات والأقاليم في شيء، بل ان نواة جغرافية ما لم تحتكر السلطة السياسية قط. على العكس كانت السلطة “دولة بين الجميع” بلا استثناء إن صح التعبير. فقد هاجر مركز الحكم السياسي بانتظام فلم يلبث بعد قليل أن ترك “النواة” في جزيرة العرب التي أصبحت في النهاية وهي جزيرة الإسلام بقدر ما أصبحت دار الإسلام دار العرب الكبرى Greater Arabia فانتقل إلى الشام الأموية ثم غادرها إلى العراق العباسي حتى تركه في وقت ما إلى مصر الفاطمية، وكان المغرب مركزا آخر للقوة، ومثله كانت الأندلس. إن اخوّة الدّين كان يقابلها اخوّة الأقاليم، وسواسية الناس كانت تترجم سياسيًا إلى سواسية الولايات والمقاطعات.
الحقيقة أن الدولة العربية الإسلامية كانت شركة مساهمة بين كل اعضائها وأطرافها، ولعلنا لا ندفع بالتشبيه إلى أبعد من حدوده السليمة إذا قلنا أنها كانت أول “كومنولث” في التاريخ بالمعنى الحديث، مع هذا الفارق المهم جدا وهي أنها لم تمر بالمرحلة الاستعمارية المشينة التي مر بها كومنولث اليوم. والحقيقة ان دولة العرب الإسلامية هي فصل – أول فصل – في جغرافية التحرير، وأبعد شيئ عن جغرافية الاستعمار.(4) كل ذلك ساهم بشكل كبير في سرعة انتشار اللغة العربية وزيادة كبيرة في أعداد المتكلمين بها من ناحية، وحدوث تحول جذري في جغرافيا اللغات إن جاز التعبير من ناحية أخرى.
الحضارة الإسلامية تجاوزت بسعة آفاقها العرقيات، واللغويات بل والطبقات، حيث التقت في ساحتها أجناس عديدة، فتمازجت وتلاحمت، بل وانصهرت ونمتْ في حضن هذه الحضارة، فأنبتت زرعًا مزدهرًا جديدًا – تمثل في عدد يعجز عنه الحصر – يتمثل في أئمة كانت لغتهم الأم هي “لغة القرآن العظيم” برغم عروقهم غير العربية، سواء كانت: فارسية أو تركية أو هندية. وعلى سبيل المثال: ماذا كانت اللغة الأم للإمام البخاري- التركستاني الأرض، أو الأوزبكي المكان حسب التسمية الحالية – وهو الذي لم يكتب كتابًا بغير اللغة العربية، وعلى رأسها: الجامع الصحيح، وثلاثة كتب كبيرة تحت عنوان: التاريخ الكبير، والأوسط، والصغير. وقرينه وتلميذه “الإمام مسلم”، النيسابوري، صاحب “صحيح مسلم”. ومانعرف له مؤلفًا أو رسالة بغير العربية، ولا أريد أن أتحدث عن أئمة التفسير ومنهم “الطبري” صاحب أوسع تفسير معروف بين الناس. أو عن المفسرين اللغويين والبلاغيين من أمثال النسفي، والزمخشري، وغيرهم ممن يمثلون الأعلام البارزة في تأصيل الفكر العربي واللغة العربية. هل أذكر “سيبويه” صاحب “الكتاب” الذي حاول بكفاءة نادرة تأصيل قواعد العربية ومازال كتابه مرجعًا “أُمَّا” حتى الآن.
هناك عشرات اللغات التي تنقسم إليها فصائل اللغات ما بين قديم وحديث، ومستعمل ومهمل، ولغات حية وغير حية ومتحجرة ونامية وواسعة الانتشار ومحدودة، وأشهرها وهي: الهندية الأوروبية التي تنتمي إليها السنسكريتية، واللاتينية، واليونانية والفارسية القديمة، والتي تنتمي إليها الآن أو تتصل بها، بأي صلة من الصلات: الفرنسية والإسبانية والفارسية الحديثة والأردية.. وغيرها كثير. أما الفصيلة السامية التي منها لغتنا العربية وإلى جانبها الحبشية بتفريعاتها، والعبرية قديمها وحديثها بصرف النظر عما اندثر أو انزوى أو تقوقع من أخواتها : الآرامية والكلدانية ، والكنعانية، وانه كانت للجميع لغة أم؛ يرجح أنها العربية القديمة، مع اختلاف الآراء. اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم وهي اللغة التى احتفى بها الله تعالى وتعهد بحفظها قال تعالى:(وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًاعَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا)، وقوله: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، وقوله:( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، وقوله:( إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وقوله:( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فهى لغة السموات الحية التى لاتعرف الموت أوالفناء .
وبالبحث فى تاريخ اللغة العربية نجد أن أول من تكلم بها من القبائل العربية القديمة قبيلة جرهم ويعرب بن قحطان من العرب المتعربة من قبائل اليمن، وقد أخذ عنهم إسماعيل عليه السلام، ولم يأخذها عن أبيه إبراهيم عليه السلام الذي كان يتحدث الكلدانية، ولا عن أمه هاجر المصرية، مما يعنى أن اللغة العربية وافدة من اليمن.
انتشرت هذه القبائل فى الجزيرة العربية وتفرقت إلى فروع وبيئات مختلفة فى اللسان وطريقة النطق حتى طرأت لهجات متعددة ومتباينة امتدت حتى وقتنا هذا كالذى نراه فى الأقطار العربية من حيث اختلاف المعانى للفظة الواحدة، ومن حيث تعدد الأغراض والأنواع فى اللهجات المتقاربة، ويمكن ملاحظة ذلك فيما يحدث بين أبناء القطر الواحد، وفى اللهجة الواحدة كتمايز أبناء الوجه البحرى والقبلى فى مصر فيما بينهم فى استعمال المترادفات. بل إن التفاوت يمتد ويبدو ظاهرا عند أبناء الجيل الواحد، مما يدل على أن اللهجات تتعدد وتتفاوت وظيفتها اللغوية تبعًا لتفاوت العمران الحضارى والاعتزاز بالهويّة اللغوية، والقدرة على التأثير فى الآخرين وبث ثقافة التعبير فى النفوس من خلال الفنون والآداب والعلوم. وفى العصور المتعاقبة تباينت اللغة قوةً وضعفًا تبعا لضعف الأمة وعدم استقرار أمرها، وارتبط ذلك بعوامل عديدة منها المتغيرات السياسية والاقتصادية والتخلف الحضاري عن ركب التقدم. (5)
المصادر:
- علي عبد الواحد وافي، “نشأة اللغة عند الإنسان والطفل” – دار نهضة مصر – القاهرة (بتصرف)
- جمال حمدان، “استراتيجية الاستعمار والتحرير”، الأعمال الفكرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999. (بتصرف)
- المرجع السابق.
- المرجع السابق
- المرجع السابق