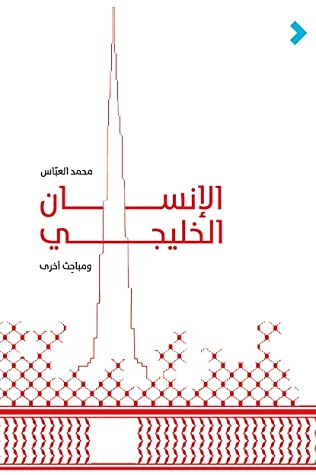قراءة كتاب الإنسان الخليجي
للناقد محمد العباس
دار روايات، ط١ ٢٠٢١م الشارقة
“ليس الإنسان فقط إمكانية استئناف، إمكانية نفي، فالإنسان هو كلمة نعم رنانة بفعل نغماتها الكونية”.
فرانز فانون
ت. خليل أحمد خليل
ص١٠، بشرة سوداء أقنعة بيضاء
هل الشكلانية، مجتمع الاستعراض والفرجة، بتعبيرات جي ديبور، والمتحقق بكثير من مفرداته وعلاماته في المجتمع الخليجي المعاصر، المديني بخاصة، نتيجة خيار ثقافي واعٍ لدى النخب، أم هو تحقيق لشكلانية مفروضة من أعلى، لإضفاء مظهر متمدن، على من يدعوهم الخطاب الغربي “الأصدقاء والحلفاء”؟ وبصيغة أخرى ما مدى تجذر الحداثة، وما بعد الحداثة خاصة في نقد الاستعمار الجديد، كممارسة ثقافية وفكرية جمالية وطريقة معاصرة لتعاطي تجربة الحياة في الثقافة الخليجية المعاصرة؟ أم نميل مع الفرضية القائلة بأن كل المظاهر الحداثية البرّانية ورق توت ومظاهر “شكلية”، وفاترينات عرض بتمويل ودعاية ورعاية سلطوية، وكلها مهددة بالزوال مع أول تغير في اتجاه هبوب الرياح، أو الموضة السائدة؟
يجيب ولا يجيب صراحة هذا الكتاب على مثل هذه الأسئلة، ولعله غير معني حصرًا بها، وله كل الحق، بقدر عنايته بنقد معطيات وصيرورة التجربة الإنسانية، العربية المعاصرة ككل، والخليجية خاصة.
الصورة الأيقونية:
يقرأ الكتاب في مبحثه الأول الصورة بوصفها وسيطًا حديثًا طاغيًا، عبر مراجعة استخداماتها الإعلامية بداية هذا القرن في منطقة الخليج، في الصور المنشورة لشخصيات رمزية مثل صدام حسين، خالد شيخ، رمزي الشيبة، ليقرأ المحمولات والدلالات المضمرة لتلك الصور، التي قد تمر على المشاهد العادي، بوصفها مجرد صورة مقرونة بالخبر، في حين يحمل الناقد تلك الصور محمل الجد، مما يعيد للذهن، مثلًا، ذلك الاستخدام الرمزي، الذي شاع بين الشباب في فترة ما، لملصقات تشي غيفارا وصدام حسين على السيارات، لصالح دلالة ثورية ضد الرأسمالية واضحة للعيان، في حين يشرّح الناقد في كتابه هذا أيقونية مثل تلك الصور ودلالاتها ليخلص إلى نتائج حاسمة حول استخدامات الصورة:
الصورة تندرج في سياق عملية كولونيالية بإسقاطات أيدلوجية تزعم التعبير الفني الحداثي عن نوايا تغيير الواقع، من خلال إفساح المجال لصراحة الكاميرا، لكنها في حقيقة الأمر تحاول تحقيق أهداف جيوسياسية من خلال تغيير معادلات السلطة وإنتاج معرفة ملفقة ومجتزأة عن مكان أو ذوات متخيلة تحت عنوان توثيق الحدث في أبعاده الزمانية والمكانية. ص١٨
يكشف الناقد، بعدة نقدية بارعة، ليس عن مضمرات مثل تلك الصور وحسب، بل وعما يقف وراءها من اشتغالات مدبرة، مما يدعوه النص مختبرات:
لا تنحصر مهمة إدراك الشيء المصوّر في غائية تعيينه، بل يتجاوز تأثيرها ما وراء المرئي. ولكن رهان المختبر الموكل إليه تدبير تلك المتوالية من الصور يراهن على آراء التلقي الانطباعية المتأتية من إدمان التعاطي البصري مع سيل “الصور الذهنية” وثيقة الصلة بوسائل الإعلام، واكتفاء الجمهور الذي لم يكتسب أدوات فك شفراتها كنص بمطالعتها من خلال ما يعرف بالقراءة المرتبطة عضويًا بالجملة العصيّة، التي تنتهي بالموافقة على إملاءات السلطة التاريخية والأطر المرجعية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين رأي مغلوط. ص٢٠
لا شك أن قراءة الصور، إحدى هواجس الناقد الحديث، منذ رولان بارت وسوزان سونتاج، لكن الناقد هنا معني كذلك بالكشف عن عمل نظام العلامات، اللغة المعاصرة:
كل نظام علاميّ يفترض وجود دال ومدلول، تراهن من خلاله الهجمة السيميائية المحمولة بالآلة الإعلامية على إبراز الطابع الشكلي، وطمس فاعلية المضامين، وهي خدعة جمالية يتم بموجبها تحويل الإنتاج الفني إلى إبداع أيدلوجي، ينهض في المقام الأول على “الحشو الفارغ”. ص٢٠
وكل ذلك يكشف عن تصور مسبق ما يزال يعمل بمفاعلاته منذ زمن الاستشراق:
تتكدس العلامات في نظام مدبّر من الصور، وتتناسل المعاني من أيقونغرافياته، لترسم الحدود الفاصلة بين الشرق والغرب، الأمر الذي يكرس صورة نمطية عن الإنسان الشرقي في الوعي الإنساني، فهو كائن عنيف بدئي إرهابي. ص٢١
وهذا يذكرنا بكتّاب كثر، فضلًا عن إدوارد سعيد وهومي ك بابا في كتابه موقع الثقافة، لكن لنواكب هذه الكلمات بداية القرن بكلمات أقدم من ذلك عند عبد الكبير الخطيبي الذي كان يكتب منذ ١٩٦٨، أي أكثر من نصف قرن، كاشفًا الخيط نفسه، أو بالأحرى حفريات هذا الخط لدى يسار الثقافة الفرنسية:
الرؤية المبتسرة للإنسان العربي المتهدم بعض الشيء، المتجمد عند حتمياته، والمفسّر “أساسًا” بسلوكه الديني.
ص١٠، الكتابة والتجرية، ت. محمد برادة
العقال الخليجي:
“الصراع بين المؤسساتي والجماهيري هو الوجه الأبرز لمعوقات التنمية الثقافية للإنسان الخليجي” ص٤٢
يستخلص الكتاب عبر تحليله لتواريخ الفعل الثقافي للمثقف الخليجي وسعيه لإطار جامع خارج إطار المؤسسة الرسمية المشغولة أكثر بفعلها الحكومي، في الأقطار المعروفة، يصل الكاتب لنتائج واضحة ومبسطة، فيما يخص تطور الفعل الثقافي في الخليج ومصائره الحالية، وبذلك يكشف عن أزمات الفعل الثقافي الخليجي وانسداداته وتاريخ ممارساته، في خلاصات غنية عن كل تعليق زائد:
لقد نجحت المؤسسة، بمؤازرة من بعض النخب الثقافية المنتجة ضمن مختبراتها، في إبعاد الإنسان الخليجي عن المؤثرات، وتجريد الخطاب الثقافي من روح الصراع والتعدد والاختلاف، والاستغناء عن فكرة إعداد كوادر ثقافية أصيلة بإعداد عقول واستجلاب أخرى تملك من الاستعداد لتحريف الثقافة، واستئجار وعيها ورمزيتها للتحدث بما هو أقرب لتزوير الوعي بالنيابة عن المثقف الخليجي.
وكل هذا التمويه يحدث على إيقاع العولمة حيث الكرنفالات والجوائز العابرة للقارات والثقافات التي لا تلامس واقع وضرورات وشروط الانسان الخليجي، بقدر ما تسهم في إرساء قيم جديدة لتعزيز اغترابه عن ذاته وموروثه، أي فصل منتجه الإبداعي عما يجري على أرض الواقع، حيث أصبحت الثقافة في المجتمع الخليجي مسألة عارضة على هامش الاحتياجات الاجتماعية، ولم تعد مسألة تتعلق بوجوده.
ص١٩، ٢٠
لا شك أن الاختناقات الثقافية متشابهة في كل الاقطار الخليجية، ولا يختلف اضطراب التيار الثقافي بين دولة وأخرى، وما يواجهه مثقفوها من تعارض وحالة انفصام جلية واحد في المجمل:
كل من يفكر من المثقفين في إنتاج خطاب ثقافي مستقل يكون بشكل تلقائي عرضة للإقالة أو الاستقالة، أو يدفع دفعًا لليأس والتعفف عن ممارسة أي دور ثقافي. ص٥٢
وذلك واضح لكل مستقرئ وقارئ، بل إنه منشور خليجي يومي قديم، معتاد ومكرس بالبنط العريض:
يمكن تلمس معالم ذلك المآل البائس وبعض الآثار المترتبة عليه في كثافة المادة الخبرية التي تبرزها الصفحات الثقافية بوتيرة شبه يومية وبشكل استعراضي في ظل غياب فاضح للقضايا والسجالات التي يمكن أن تضفي على المشهد شيئًا من الحيوية، في ظل موت معلن للنص الأدبي، كما يمكن التقاط إشارات الغياب -مثلًا- في مجمل المجلات والدوريات الأدبية التي لم تفرد في صفحاتها الشاسعة والملونة هامشًا ولو ضئيلًا لمحاججة القضية الحقوقية للمثقفين، أو أي قضية ذات معنى، بقدر ما أمعنت في التعيش على نفايات الانترنت، أو استنساخ البائت في المواقع الإلكترونية إهدارا للميزانيات الكفيلة بتعزيز ممكنات الخطاب الثقافي المفترض التشارك في إنتاجه. ص٥٥
هذه الأزمات الثقافية تدلل عن طريقة عمل العقل الخليجي المعاصر، عن شخصيته وانعكاساته، وكذلك على طريقة عمله في انعكاس لدور بطولة احتكاري، احتكرته المؤسسة الرسمية لصالحها، منذ عقود، وهي من حيث تعلم، أو لا تعلم بافتراض حسن الطوية، ترغم الثقافة على حالة من العقم الإجباري، والضمور، لصالح اجترار أنماطا قديمة تقليدية وماضوية من صور الثقافة، لأنها أنماط أليفة داجنة، غير فاكرة، وتفصح المؤسسة الرسمية بذلك أن لم يكن عن بنية جهل مركب، فعن بنية مفاهيمية خاطئة، بالحداثة نفسها وبالزمن المعاصر والتجربة الإنسانية ودور الثقافة الحاسم، وتتزامن هذه القراءة مع رفض هابرماس لجائزة ثقافية خليجية، وسواء اتفقنا أم اختلفنا حول هابرماس فإن لحدث نفسه دلالة خاصة.
ولعل الأهم من ذلك، وهو الملمح البارز مؤخرًا في الخليج، ذلك العداء الافتراضي بين الثقافة الحديثة والدين والمجتمع، في معارك تشغل الأطراف بلا أدنى طائل:
يكرر أغلب المثقفين مقولات السلطة المؤكدة على تزمت المجتمع ورجعيته مقابل تقدمية الطروحات المؤسساتية وطليعيتها، رغم تعنتها المعلن وتسويفاتها. ص٥٦
مثل تلك المعارك التي تجعل القوى الاجتماعية بمواجهة بعضها، كما في مثال المثقف بمواجهة السلطة الدينية، هو مجرد استنزاف قوى وهدر للطاقات، يدلل على عدم تفاهم البنى والمكونات الاجتماعية المختلفة مع ذاتها، وانعدام التصالح، والإبقاء على فتيل خلاف يجري استغلاله كل مرة لصالح الإطاحة بكل الأطراف، بما في ذلك الطرف المنتصر، وكما يخلص العباس في كتابه هذا:
“تحميل المجتمع الأهلي ممثلًا في مثقفيه وزر التخلف الاجتماعي والإبقاء على تخثر اللحظة المدنية وتبرئة المؤسسة من تعطيل أو إبطاء حركة التاريخ هي معركة تستحق أن تخاض حقوقيًا لإيقاف حالة الموت البطيء للتجربة الجمالية التي يشكل الإنسان عصبها ومبتغاها. ص٥٦
مباحث أخرى:
هذان مجرد مبحثان من المباحث الستة التي يتطرق لها هذا الكتاب السابر، وهو في جملته تشكيلة جمالية وحصة قرائية مستحقة لكل قارئ، خاصة الخليجي، لا يخفي سعيه الجمالي مثلما في قراءته النقدية لفترينة العرض، كواجهة جمالية وفنية، ولوحة فنية متسعة على واجهة المحلات، ولا راهنيته ومعاصرته كما في قراءته المليئة بالحماس الجمالي لكرة القدم المعاصرة ومآلاتها ونظرة اسماء فكرية وثقافية شهيرة إليها كتعبير إنساني معاصر يجتمع حوله الناس في كل مكان من عالمنا، ولا انشغالها بقضايا أصيلة وحاضرة كما في مبحثه عن الإنسان واللغة والأعلمة (من الإعلام) حيث الانطلاقة من الأثر اللغوي على الإنسان، ومفصل اللغة في التجربة الإنسانية ليس كوسيلة اتصال وحسب بل كنهج تفكير ومادة بناء إنسانية، أو كما يستخلص الكتاب:
الإنسان هو اللغة إذًا. ص١١٢
واستقراء مدى تلاعب الإعلام المعاصر بتلك اللغة والإنسان من وراءها لصالح رعاته ومموليه، خاصة الإعلام الجديد والمعاصر، فتكنولوجيا الإعلام حسب الكتاب:
لم تعد أداة تدفق المعلومات وتبادلها تبادلًا حرًا، بل تحولت إلى أداة لتطويع الإنسان ومراقبة حميمياته وقهره. ص١١٩
وأخيرًا يختم الكتاب في مبحث أدبي فني حول قصيدة النثر العربية بعنوان تعقيدات الكون الشعري ويبحث فيه محاولات الشاعر العربي لتوطين قصيدة النثر، ويخلص لعدة خلاصات حاسمة بنفس الصدق النقدي غير المجامل فيما يخص هذا الفن الشعري الحديث:
كل ما أبداه الشاعر العربي من آراء ليس تنظيرًا لرعاية مولود يعرف ملامحه. بل مجرد حالة من التطواف الحذر حول مولود يقيم في حضانة الآخر الذي استولده وسماه. بمعنى أنه حاول تبني ما لا يملك مقومات رعايته. وبالتالي استنفذ كل مرئياته وأدواته التقليدية حول الشعر ليقيم سياجًا بينه وبين شكل المولود الجديد. وهذه أعراض خوف ضامر. ص١٣٧
رغم حجم الكتاب الصغير وال١٤٠ صفحة من القطع المتوسط التي تشكل جسده فإنه يحوي آفاقًا فكرية ويقدم قضايا نقدية مهمة، يستعرضها بطريقة خصبة، معززة باقتباسات تزاحم النص أحيانًا كثيرة، والعمل ككل هو أقرب دليل وتأكيد على ما يقوله الكتاب ص٩٢، إذا استعدنا إعلان مارتن هيدجر موت الفلسفة من قبل:
الناقد هو الوريث الشرعي للفيلسوف.