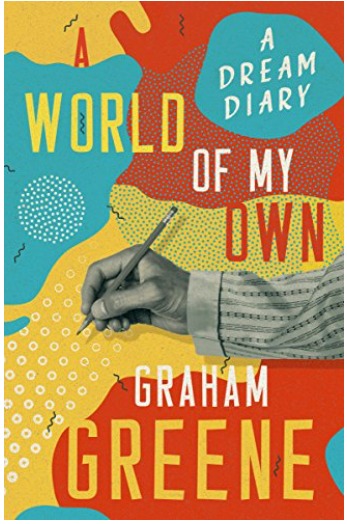مقال بقلم عبد الرزاق قرنح
التاريخ 2004
منشور إلكترونيا بتاريخ 2008
مكان النشر: مجلة Wasafiri البريطانية 1
ترجمة: دينا البرديني
وُلد عبد الرزاق قرنح في 1948 في زنجبار الكائنة على سواحل شرق افريقيا. وصفت روايته الأولى “ذكرى الرحيل” (1987) تجربة الرحيل عن الوطن، وهي التيمة التي احتفظ بها أيضا في رواية “طريق الحج” (1988)، رواية “دوتي/ Dottie” (1990) ورواية “الإعجاب بالصمت” (1996). في روايته “عن طريق البحر” (2001)، يعود بنا قرنح إلى فكرة الهجرة المعاصرة من خلال “صالح عمر “، طالب اللجوء المسن الذي يعيش في إحدى المدن الساحلية الإنجليزية، والذي لجأ إلى استرجاع ماضيه في زنجبار سعياً منه إلى الوصول إلى السلام والسكينة. عبد الرزاق قرنح ناقد أدبي أيضاً، له مؤلفات في العمل النقدي مثل: “مقالات حول الكتابة الأفريقية: إعادة تقييم (1993)” و “مقالات حول الكتابة الأفريقية: الأدب المعاصر” (1995). كما أنه أستاذ اللغة الإنجليزية وأدب ما بعد الاستعمارية في جامعة كينت/Kent في كانتربيري/ Canterbury. في المقال التالي، يصف لنا قرنح تطور عملية نموه ككاتب أثناء وبعد هروبه من الفوضى والعنف اللذين مُنيت بهما زنجبار في أعقاب انتهاء الحكم الاستعماري بها، كما أنه يستكشف تلك الحيل والألاعيب التي يمكن أن تلعبها ذاكرة المهاجر النازح من وطنه.
بدأت الكتابة خلال السنوات الأولى من حياتي في إنجلترا، تحديداً عندما كنت في الحادي والعشرين من عمري. بشكل ما، كان الأمر أشبه بشيء تعثرت فيه أكثر منه تحقيقاً لهدف أو خطة ما. كنت قد كتبت سلفاً عندما كنت تلميذاً مدرسياً في زنجبار، ولكنها كانت محاولات عابثة غير جادة لتسلية الأصدقاء أو للمساهمة في المجلات المدرسية، كان الأمر أشبه بنزوة عابرة، أو محاولة لملء الفراغ أو للتباهي، لم أنظر لتلك المحاولات أبدًا باعتبارها إعداداً لشيء ما، كما لم أر في نفسي طموحاً لأن أصبح كاتباً في يوم ما.
اللغة السواحيلية هي لغتي الأولى، وهي-على عكس العديد من اللغات الأفريقية- لغة مكتوبة ومقروءة قبل مجيء الاستعمار الأوروبي، ومع ذلك، لا يمكننا القول بأن العلم والثقافة كانتا السمتان السائدتان. يعود تاريخ الأمثلة الأولى للكتابة الاستطرادية باللغة السواحيلية إلى أواخر القرن السابع عشر. عندما كنت مراهقاً، كان لتلك الكتابات معنى وفائدة على صعيد الكتابة في حد ذاتها وكذلك على صعيد التداول الشفهي للغة. ولكن كانت القصائد القصيرة هي الكتابات الوحيدة المعاصرة التي وعيت لها وكان يتم نشرها في الصحف وإذاعتها في الراديو من خلال برامج القصص ذات الشعبية الكبيرة أو وضعها في كتب قصصية. كانت معظم تلك الكتابات تحمل الطابع الوعظي أو الهزلي وكان هدفها الأساسي هو الاستهلاك الشعبي. كان لهؤلاء الذين يكتبون تلك الكتابات مهن أخرى غير الكتابة، فكان أغلبهم مدرسين أو موظفين مدنيين. في ذلك الوقت، لم أكن أرى الكتابة كأمر يمكنني أو يجب عليّ فعله. حدثت تطورات في الكتابة السواحيلية منذ ذلك الحين، ولكنني أتحدث هنا عن مفهومي عنها في ذلك الوقت. كنت أرى الكتابة كنشاط عقيم، مُبهم وعَرَضيّ، ولم يخطر ببالي أبداً أن أمارسه سوى في ذلك الإطار العابث الذي وصفته.
في كل الأحوال، في الوقت الذي تركت فيه وطني، كانت أحلامي بسيطة. فقد كانت أوقات عصيبة لإرهاب الدولة والإذلال الممنهج، وفي عمر الثمانية عشر، كان كل ما أردته هو الرحيل للبحث عن الأمان وتحقيق الذات في مكان آخر. كانت فكرة الكتابة بعيدة عني تماماً. بدأت في التفكير بشكل مختلف بعد مرور سنوات على وجودي في إنجلترا وكنت قد أصبحت أكبر سناً، وبدأت أفكر وأقلق بشأن أمور بدت في السابق أقل تعقيداً، ولكنها -في القسم الأكبر منها- تتعلق بالشعور الطاغي بالاغتراب والاختلاف الذي اجتاحني. كان هناك شعور بالتردد وتلمس الطريق خلال هذه العملية برمتها. لم يكن الأمر كأنني كنت مدركاً بشكل كامل لما يحدث لي وبناء عليه قررت أن أكتب عنه، ولكنني كنت أكتب بشكل عابر يشوبه الإحساس بالقلق والمعاناة، من دون أي تخطيط، فقط مدفوعاً بالرغبة في قول المزيد. بمرور الوقت، بدأت أتساءل عن ماهية هذا الذي أفعله، لذا كان لزاماً على أن أتمهل لوهلة لوزن الأمور، والتفكير في هذا الذي كنت أفعله من خلال الكتابة. عندها أدركت أنني أكتب من الذاكرة، ويا لها من ذاكرة تلك، حية وغامرة وبعيدة بشكل غريب عن ذلك الوجود الخاوي عديم الوزن الذي عشته في إنجلترا خلال أولى سنوات حياتي بها. تلك الغرابة عززت من إحساسي بوجود حياة كاملة تركتها خلفي، وأناس هجرتهم غير مبالٍ، ومكان ووجود فقدتهما إلى الأبد. عندما بدأت في الكتابة، كتبت عن تلك الحياة التي فقدتها وذلك المكان وما كنت أتذكر عنه. بشكل ما، كنت أيضا أكتب عن وجودي في إنجلترا، أو على الأقل، عن وجودي في مكان ما مختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي يسكن ذاكرتي وكياني، هو مكان آمن وبعيد كل البعد عن كل ما تركته خلفي، للدرجة التي ملأتني بمشاعر غير مفهومة من الذنب والندم. وبينما أنا أكتب، غمرتني لأول مرة أحاسيس ملؤها المرارة والشعور بعقامة وعبثية تلك الآونة الأخيرة التي عشتها، كما داهمني كل الذي فعلته لأستجلب ذلك على نفسي، وأثقلني ما بدا لي وقتها حياة غريبة لا واقعية في إنجلترا.
يوجد منطقاً مألوفاً في ذلك التحول في الأحداث، يمنحك الرحيل عن الوطن بُعداً ومنظوراً كما يمنحك مساحة من التحرر والسِعة. فهو يعزز من ذاكرة الكاتب التي هي في الأساس مساحته الخاصة. كما يمنح البُعد الكاتب فرصة للتوحد مع ذاته الداخلية دون تشويش، مما يؤدي إلى تحرر خياله بشكل أكبر. ذلك المنظور يرى الكاتب ككون مكتفٍ بذاته من الأفضل تركه للعمل في عزلة. قد تظن أنها فكرة قديمة الطراز، أو ربما منظوراً رومانسياً يعود إلى القرن التاسع عشر يدور حول فكرة الدراما الذاتية، ولكنه منظور ما زال يتمتع بوجاهته ويصلح في أكثر من موضع.
كما أن هناك منظوراً يرى أهمية البُعد للكاتب بصفته عالماً منغلقاً على ذاته، هناك منظور آخر يرى البُعد عاملاً مساعداً على تحرر الخيال النقدي للكاتب. ويرى الأخير أن تلك الإزاحة ضرورية، وأن الكاتب يمكنه أن يُنتج عملاً قيماً من خلال العزلة لأنه حينها يكون محرَّرَاً من مسؤولياته وأموره الحياتية الحميمية التي تقيد وتميع حقيقة ما يجب أن يُقال، وتُبهت حقيقته كبطل ورائي للحقيقة. إذا ما كان للمنظور الأول، الخاص بعلاقة الكاتب بالمكان، أبعاداً منتمية للمدرسة الرومانسية في القرن التاسع عشر، فإن المنظور الثاني يستدعي في أذهاننا مدرسة الحداثة في بداية القرن العشرين ومنتصفه. لجأ عدد من أهم كتاب مدرسة الحداثة الإنجليزية إلى الكتابة أثناء البُعد عن وطنهم ليكونوا أكثر تعبيراً عن الحقيقة كما يرونها، ليهربوا من مناخ ثقافي رأوه مميت.
توجد أيضاً وجهة نظر أخرى ترى أن الكاتب، في عزلته وسط غرباء، يفقد إحساسه بالتوازن والناس، بل وإحساسه بأهمية إدراكه لهذه الأشياء. ويُقال إن ذلك المنظور حقيقي بشكل كبير في أوقات ما بعد الأمبريالية، وفي حالة الكُتاب المنتمين إلى مستعمرات أوروبية سابقة. أعطى الاستعمار نفسه الشرعية من خلال التسلسل الهرمي للعرق والدونية والذي تجسد في الكثير مما تم سرده حول الثقافة، المعرفة والتقدم. كما بذل الاستعمار كل ما في وسعه لإقناع المستَعمَرين بالإذعان لتلك الرواية. خطورة ذلك على كاتب ما بعد الاستعمارية تكمن في أنه يؤدي إلى تعميق إحساس العزلة والاغتراب لديه كمغترب في أوروبا. في الأغلب، يتحول ذلك الكاتب الى مهاجر يعاني من إحساس عميق بالمرارة، ساخر من هؤلاء الذين تركهم خلفه، محتفى به من قِبل ناشرون وقراء لم يتخلوا عن عداء غير مفهوم، ويسعدون للغاية بمكافأة ومدح كل من يقسو على العالم غير الأوروبي. من هذا المنطلق، فإن الكتابة وسط الغرباء تعني وجوب الكتابة بقسوة لتحقيق القبول والمصداقية، وتبني احتقار الذات كصوت للحقيقة، وإلا يتم استبعادك وتجاهلك لشاعرية تفاؤلك.
كلا المنظورين -البعد كأداة للتحرر والبُعد كأداة للتشويه- يتسمان بالتبسيط، ولكن مع ذلك، لا يمكننا القول بأنهما لا يحويان ملامحاً من الحقيقة. لقد عشت حياتي كبالغ بأكملها بعيداً عن موطني الأصلي واستقررت وسط غرباء، ولا يمكنني الآن أن أتخيل كيف كان يمكنني العيش خلافاً لذلك. أحياناً أحاول أن أتخيل ذلك، ولكن تهزمني استحالة التصالح مع الخيارات الافتراضية التي أقدمها لنفسي. لذا، فإن الكتابة من قلب ثقافتي وتاريخي لم تكن ممكنة، وربما كانت أمراً غير ممكن أيضاً لأي كاتب بشكل حقيقي. أعلم أنني لجأت إلى الكتابة في إنجلترا بدافع من إحساسي بالاغتراب، وأُدرك الآن أن تلك الحالة من الانتماء إلى مكان ما والحياة في مكان آخر كانت موضوعي عبر السنون، ليس لأنها تجربة فريدة خضتها، ولكن لأنها إحدى قصص العصر الذي نعيشه.
في إنجلترا، سنحت لي أيضاً الفرصة للقراءة بشكل أكثر توسعاً. كانت الكتب في زنجبار باهظة الزمن ومحلات بيع الكتب قليلة وغير ذات ثراء، كما كانت المكتبات هزيلة، قد عفا عليها الزمن. وفوق كل ذلك، لم يكن لدي علماً بما أريد أن أقرأه وكنت اقرأ ما أجده في طريقي بشكل عشوائي. أما في إنجلترا، فقد بدت الفرصة للقراءة سانحة، وبشكل غير محدود، وبالتدريج شعرت برحابة اللغة الإنجليزية وسخائها في استيعاب الكتابة والمعرفة. هذا أيضاً كان طريق آخر للكتابة. فأنا أظن أن الكُتاب يتبنون الكتابة عن طريق القراءة أولاً، بمعنى، أنه بفضل عملية التراكم والتكرار فإنهم يشكلون إدراكاً وموقفاً يمكنهم من الكتابة، وهو أمر غاية في الدقة، غير قابل للوصف في بعض الأحيان على الرغم من تفاني بعض نقاد الأدب في محاولة ذلك، كما أنه أيضاً ليس بالأداة الفعالة في بناء القصة، ولكنه حين يصبح ذلك، فهو يكون بمثابة مجموعة من خطوات السرد عالية التوافق والإقناع. أنا لا أرغب في أن أخلق لغزاً هنا، وأن أقول إن الكتابة أمر يستحيل الحديث عنه أو أن النقد الأدبي ما هو إلا وهم ذاتي. يثقفنا النقد الأدبي بشأن النص والأفكار التي تتخطى ذلك النص بمراحل، ولكنني لا أظن أن الكاتب يجد ذلك الإدراك الذي أتحدث عنه عن طريق النقد الأدبي، ولكنه يأتي عن طريق مصادر أخرى أهمها القراءة.
كان التعليم المدرسي الذي تلقيته في زنجبار تعليماً بريطانياُ استعمارياُ، وذلك على الرغم من أننا في مراحله الأخيرة كنا قد بدأنا في التحول إلى دولة مستقلة بل وثورية. من الأرجح أن معظم الصغار يخوضون مراحل تلقى العلم وتخزين المعلومات والمعرفة عن طريق التعليم المدرسي والذي يبدو لهم في حينها كأمر مؤسسي غير ذي معنى أو صلة. أما نحن، فقد بدا لنا الأمر أكثر غموضاً وغرابة، وبدا لنا أننا مستهلكين لمواد لم نكن نحن المعنيين بتلقيها. ولكن كما هو الحال مع غيرنا من طلاب المدارس، شيئاً مفيداً نتج عن ذلك. ما تعلمته عن طريق التعليم المدرسي إلى جانب العديد من الأمور القيمة، كان يعبّر عن كيفية رؤية البريطانيون للعالم وكيف يرونني. لم استوعب ذلك في الحال بطبيعة الحال ولكن تطلب الأمر بعض الوقت والتدبر في معيَّة ومساعدة مصادر أخرى للتعلم. لم يكن ذلك النوع من التعليم هو النوع الوحيد الذي تلقيته، فقد كنت أتلقى التعليم من المسجد، من مدرسة القرآن، من الشوارع، من المنزل ومن قراءتي الفوضوية في بعض الأحيان، كان ما أتعلمه من هذه الأماكن متناقضاً بشكل قاطع مع ما أتعلمه في المدرسة. ولم يكن ذلك بالشيء المعرقل أو المُعجز كما يبدو عليه الأمر، ولكنه كان أحياناً مؤلماً ومخزي مع الوقت، بدا لي التعامل مع كل تلك المتناقضات كعملية ديناميكية بالرغم من أنها -بطبيعتها- قد بدأت من موضع ضعف منها تولدت الطاقة للرفض وللتمسك بمبادئ وتحفظات يعضدها الوقت والمعرفة، ومنها أصبحت هناك طريقة لاستيعاب الاختلاف وأخذه بعين الاعتبار، والتأكيد على إمكانية وجود طرق أكثر تعقيداً للمعرفة.
لذلك، عندما بدأت في الكتابة، لم يكن في مقدوري أن أمتزج ببساطة مع جموع الناس آملاً، بقليل من الحظ والوقت، أن يُسمع صوتي. كان لزاماً على أن أكتب وأنا على دراية بالمنظور الذي يراني من خلاله بعض قرائي المحتملين والذي يجب أن آخذه بعين الاعتبار. كنت مدركاً أنني سأقوم بتقديم نفسي إلى قراء ربما يرون أنفسهم في حِلّ من ثقافة أو عرقية، أحرار من الاختلاف. تساءلت كم أستطيع أن أقول، حجم المعرفة الذي على أن أفترضه، وإلى أي مدى يمكن أن يكون منظوري مفهوماً إذا لم أسأل نفسي تلك الأسئلة. تساءلت عن إمكانية أن أقوم بكل ذلك بينما أنا أكتب روايات خيالية.
بالطبع لم أكن متفرداُ في اختباري لتلك التجربة، على الرغم من أن التفاصيل دائماً ما تبدو فريدة بينما كنت تبكي بسببها. يمكن القول إنها ليست حتى تجربة معاصرة أو خاصة بالشكل الذي كنت أصفها به، ولكنها تجربة مميِّزة للكتابة بشكل عام، إذ تبدأ الكتابة من ذلك الإدراك الذاتي للتهميش والاختلاف. من هذا المنطلق، الأسئلة التي أثيرها ليست بالأسئلة الجديدة. ولكن إن لم تكن جديدة، فهي شديدة الخصوصية والتأثر بالإمبريالية، بالتفكك، بواقع العصر الذي نعيش فيه، وواحد من حقائق هذا العصر هو نزوح الكثير من الغرباء إلى أوروبا. تلك الأسئلة إذاً، لم تكن فقط شغلي الشاغل، بينما كنت أقلق بشأنها، كان هناك آخرون غرباء مثلي في أوروبا يعكفون على حل مشاكل مماثلة محرزين في ذلك نجاحاً كبيراُ. نجاحهم الأكبر يكمن في أنه لدينا الآن فهماً أكثر دقة لقصتنا وكيف تنتقل وكيف تُترجم، هذا الفهم جعل العالم أقل غموضاُ، جعله أصغر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مجلة رائدة في المملكة المتحدة للكتابة العالمية المعاصرة.