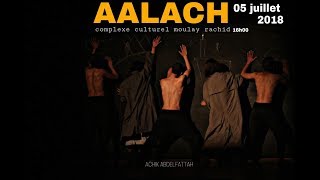أصاب المُخرج المسرحي الشاب عبد الفتاح عشيق في اختياره. بأنْ تكون المرأة المغربيّة موضوعاً أثيراً لصناعته الفنية داخل مسرحيته الأخيرة “علاش”. إذْ ارتأت لجنة مهرجان “القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي” في أنْ تكون العمل المسرحي الوحيد، الذي يُمثّل المغرب. رغم عدم حصول المسرحية على دعم ماديّ أو معنوي من وزارة الثقافة أو حتى من الجهات الوصية على الشأن المسرحي داخل المغرب. استطاع المُخرج رفقة طاقمه من الممثلين، أنْ ينزع اعتراف الجمهور المصري بمثقفيه ونقاده. حتى لو كان النصّ، يُشرّح واقع المرأة المغربيّة البدوية العاملة. إلاّ أنّه ظلّ مُؤثراً في مُخيّلة الجمهور المصري، الذي لم يتوانَ نُقاده في التعريف بهذا المُنجز المسرحي الواعد. بسبب وضعية عامة مزرية تعيشها المرأة العربيّة وسط مُجتمع قاهر ينظر إلى المرأة كجسد وآلة للإنجاب والتكاثر، دون مراعاة أحساسيها ومشاعرها. وبدت المسرحية في عموميتها منذ دقائقها الأولى وكأنّها نُسخة مُصغرة عن واقع المرأة داخل الوطن العربيّ، بحكم تشابه الهموم اليوميّة والمنطلقات المُجتمعية، التي تحكم مسار وتطوّر نظرة المُجتمع العربيّ إلى المرأة، لكن عبد الفتاح عشيق وبانتمائه إلى الجيل الجديد داخل المسرح المغربي المعاصر لم يعمل فقط على تصويرٍ ميكانيكيّ لواقع المرأة المغربيّة، بل جعلها أداة لإدانة هذا الحاضر سياسياً واجتماعياً. فمن خلال المسرحية يظلّ المُتلقي مشدوهاً أمام سيلٍ من الرسائل السياسية، عن مصير عدد من النساء مثل عائشة داخل مجتمع تقليدي لا يرحم حقوق المرأة. ولا يُفكّر في أنْ يجعلها تتنزّل منزلة رفيعة، بوصفها ذاتاً مُستقلةَ عن الرجل.
تحكي المسرحية قصة امرأة (عائشة) تعيش سنوات طويلة بمنطقة بدوية جبلية وعرة، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل الفوز بلقمة عيشٍ بسيطة تغنم بها كل ليلة. ما يجعلها عرضة للاستغلال الجسدي من رجال القبيلة. من ثم، يبدأ الصراع ذات يوم بين أطفالها الثلاثة حول هوية والدتهم بين العفة وعدمها. هكذا يغوص بنا عبد الفتاح عشيق في دوامة من الحرب العائلية والمأساة النفسية التي يتسبب فيها أحياناً أفراد المُجتمع عن طريق القيل والقال، وأمام اكتشاف صحة الاتهمام من تفنيده، تُسافر بنا المسرحية إلى تخوم لا مفكّر فيها من المغرب المنسي، وكيف تعيش النساء العاملات داخل هذه المناطق الجبلية التي يغدو معها الخبز بمثابة فردوس مُشتهى، وذلك من خلال رصد مأساة هذه الفئات من النساء اللواتي تخلى عنهن الأزواج. إذ لم تعُد المرأة حسب المسرحية هي فقط الضحية من هذا الغياب، بل أطفالها وما لحق بهم من ألم ومعانات نفسية جراء معرفة الأب وأصابع الاتهام الموجهة إليهم من مجتمع قاهر لا مكان فيه لإمرأة هجرها زوجها، فظلّت وحيدة تعمل من أجل إطعام أطفالها. من هنا، يصطدم المُشاهد للمسرحية بجملة من الأسئلة والعوائق السياسية والاجتماعية والنفسية، التي تحول دون تقدّم المجتمع المغربي ومعه مواصلة الأطفال لحياتهم الطبيعية داخل مثل هذه المجتمعات التقليدية.
عبر حكاية “عائشة” غير المرغوب فيها تارة من طرف أطفالها وتارة أخرى من مُجتمع ذكوري، تغوص المسرحية في جحيم الواقع المغربي، بكل أحزانه ومآسيه التراجيدية، فهي لا تُجمّل الواقع فنياً، بقدرما تُدينه وتُحاول كشف ما يتستر عنه المجتمع من رؤى وأفكار ماضوية. كل هذا يتأتى من خلال حوار مسرحي درامي، جعل منه المخرج الأداة الثانية لمسرحة مأساة “عائشة” وتعطشها للحرية والاعتراف بها كأمّ تستحق كل الحب من أطفالها، وكي يُبرز المخرج شدّة حقد الأطفال على والدتهم، لجأ المُخرج إلى مُعجم مسرحي مُستمد من قاع المُجتمع المغربي. كلماتٌ قويّة وخطاب شعبي قاسٍ لأذن المُشاهد، زاده حدّة نجاعة الممثلين في تأدية أدوارهم وقدرتهم الهائلة على الجمع بين أداء الحوار والتعبير الجسدي. هذا الأخير، ميّز المسرحية وجعلها مُنفلتة من قبضة المسرحيات المغربيّة. ففي الوقت الذي يستمتع فيه الممثل بجودة النصّ وهسيسه في مُخيلّة المُشاهد يستمر جسد “عائشة” على الخشبة في التعبير بصمت عن الألم النفسي، الذي تُعاني منه، لكن في غمرة جماليّات الألم الدراماتورجي يضعنا عبد الفتاح عشيق داخل دوامة من التساؤلات الأنطولوجية عن سر عنوان المسرحية “علاش”(لماذا) وعن المسؤول الحقيقي وراء هذا التشرذم العائلي. لنكتشف في نهاية الأمر أنّنا جميعاً مسؤولون عن مثل هذه المأساة العائلية من خلال تربيتنا وتنشئتنا. من ثم، يجعلنا المُخرج أمام واقع مُتعدّد لا يتقوقع داخل نقطة واحدة، وإنّما يغدو هذا الواقع أشبه ببلوْر مُتعدّد الأضلاع. إذ عبر فروع هذا الواقع، يتشعب خيط المسرحية، ويتدفق شلال الجدل لدى هؤلاء الأطفال عن المسؤول عن تشرذم حياتهم داخل تلك المنطقة الجبلية، التي أضحوا فيها حديث الناس.
يستند المُخرج في مسرحيته على الجسد بكافة حمولاته الاجتماعية والسياسية والنفسية. فهو من يرسم جماليّات الأداء وليس الحوار، مع أنّهما ينطلقان معاً في مسرحة الواقع. لكن خفوت الحوار في مراحل مُتعدّدة من المسرحية يجعل الجسد يُسيطر على ميكانيزمات الصورة في مُخيّلة المُشاهد. بحكم أنّ حضوره يأتي بكيفيات مُتفاوتة بين الحرمان الاجتماعي والاحتجاج السياسي، لكنهما يرسوان حول نقطة واحدة مُشتركة هي: جرح الجسد. هذا الأخير، يُمثّل وقود المسرحية وعليه تُشيد جميع المشاهد الفرجوية. بما يجعل مفهوم الجسد الخيط الناظم،بين جميع هذه المشاهد الدرامية بمُختلف سياقاتها وجمالياتها. إنّ حضور جسد عائشة الواقعي/ التخييلي داخل أغلب هذه المشاهد. يعطي انطباعاً لأول وهلة في كونها امرأة خيالية. لكن بعد تسلسل المشاهد، يغدو جسدها وكأنّه شيء لا يُمكن فصله عن الممثلين(الأطفال). إنّه يُطاردهم مثل كابوس مُرعبٍ يتكرّر داخل كل مشهدٍ دراميّ. ليوحي بحجم الحيف والظُلم الذي عانت منه “عائشة” داخل مُجتمعٍ قبليّ، وبما أنّ مفهوم الجسد في الفلسفة المعاصرة لدى كل من جيل دولوز وميشيل فوكو يأخذ طابعاً مُتشعباً لجأ عبد الفتاح عشيق إلى هذا الرأسمال الفلسفي ليجعل من جسد عائشة آلية للاحتجاج الأيديولوجي- السياسي للبنية القبلية. من خلال حوارات تُضمر في طياتها أسئلة أنثروبولوجية حقيقية عن مصير المرأة داخل المجتمعات القبلية المُركبة، وتكريس قيّم الاختلاف والتحرّر والفردانية، عوض التماهي داخل موروث ثقافي لا يُساير التطورات المُجتمعية. هكذا أضحت درامية بعض الحوارات. بمثابة صرخة قوّية في وجه نظامٍ قبليّ لا يعترف بحقوق المرأة وحريتها، لكن أحياناً يُغيّر المُخرج من حدّة الحوار؛ ليبرز الجسد من جديد كقضية مركزية ومأساة مُجتمعية ويكتسح معها عين المُشاهد ووجدانه.
وإذا كانت السينوغرافيا في تاريخ المسرح المغربي إعادة خلق أو بناء لواقعٍ جديدة فوق الخشبة، فإنّها تغدو في مسرحية “علاش” إعادة تفريغ لهذا الواقع، وأحياناً تظهر بشكلٍ مُتقشفٍ، حيث أنّ وجود الملابس والديكور والمؤثرات البصرية تكاد تكون غائبة. أمام قوّة فراغٍ يُسيطر على خشبة تُغذيها جمالياً أضواءٌ شاحبة تبرز آلام الجسد ضد كل آلات ووسائل الاستهلاك اليومية. فالمخرج بهذه الطريقة يثور على مفهوم “الشيء” ليجعل من أجساد الممثلين سينوغرافيا بديلة عن كل أشكال البذخ التي يحبل بها المسرح المغربي الحديث. رغم بعض المشاهد الكوميدية داخل المسرحية، إلاّ أنّ المُخرج تعمّد في أحيانٍ كثيرة الخروج من بوتقة مفهوم الفرجة والاحتفال الذي طبع المسرح المغربي مع عبد الكريم برشيد، إذْ أنّ الفعل المسرحي لدى عبد الفتاح عشيق ليس ترفيهاً أو تجمهراً للاحتفال أو حتى تطهيراً للروح حسب التعريف الأرسطي. وإنّما عملية أنثروبولوجية حفرية،تقوم بتخييل قاع المجتمع المغربي. وجعل أسئلته وقضاياه تبرز إلى السطح. قبل أنْ تتم مُعالجتها جمالياً ووضعها داخل قالب مسرحي معاصر. رغم مظاهر أيديولوجية قدد تتبدى على أيّ عملية تخييلية. تجعل من “الواقع” ذريعة للصراخ والاحتجاج. لأنّها لا تعمل سوى على التأكّد من نجاعة نظريات فلسفية وسوسيولوجية داخل العمل المسرحي. بحكم أنّ العمل المسرحي الناجح هو من يقوم بخلق واقع جديد من داخل النصّ. ومُعالجته بطُرقٍ فنية معاصرة. عِوَضَ التفكير في هذا الواقع من خارج العمل المسرحي. وهذا مطبّ بعض أعمالٍ مسرحية مغاربيّة. حاولت أنْ تنسُج علاقة فكرية بين النصّ المسرحي وواقعيه السياسي والاجتماعي.