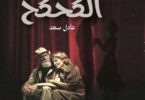• الكتابة المغامرة جلبت قاعدة عريضة من القراء.
• غياب المواكبة النقدية يذهب بالفن الروائي بعيدا عن القارئ الحقيقي.
• الرهان الأساس للرواية هو أن تتوجه إلى قارئ من مستويات ثقافية متعددة.
• النص التقليدي يطرح كل شيء ببساطة ويقود القارئ إلى النهاية السعيدة.
الناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين من أبرز النقاد العرب المهتمين بالسرد والرواية العربية الحديثة وتطوراتها، لاسيما التقنيات الأسلوبية وتحليل الخطاب الروائي، كما يولي السرد القديم المتمثل في السير الشعبية عناية خاصة، إلى جانب كونه أحد النقاد المهتمين بنظريات النقد الجديدة، وقد نشر دراساته ومؤلفاته النقدية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مثل: “القراءة والتجربة- حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب”، و”تحليل الخطاب الروائي: الزمن، السرد، التبئير”، و”انفتاح النص الروائي- النص والسياق”، و”الرواية والتراث السردي- من أجل وعي جديد بالتراث”، و”ذخيرة العجائب العربية”، و”الكلام والخبر- مقدمة للسرد العربي”، و”قال الراوي.. البنيات الحكائية في السير الشعبية”. بالإضافة إلى “الأدب والمؤسسة- نحو ممارسة أدبية جديدة” (2000)، و”من النص إلى النص المترابط” (2005)، و”النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية” (2012)، و”الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق” (2015).. وغيرها. حصل الدكتور يقطين على جائزة الشيخ زايد عام 2016، فضلا عن عديد من الجوائز الأدبية المغربية والعربية الأخرى تقديرا لدوره النقدي لا سيما ما قدمه عن السرد العربي.. هنا محاولة لمعرفة آرائه في تطورات المنجز الروائي العربي، حيث نتوقف عند أشكال الرواية العربية وأبرز الإشكاليات التي تثيرها طرائق التعبير المتمثلة في البناء، والزمن، والراوي أو الرواة.. إلخ. فضلًا عن بعض القضايا النقدية والإبداعية ومشكلة المصطلح النقدي، إلى غيرها من المشكلات الأدبية والنقدية المثارة على ساحة الثقافة العربية.
- على الرغم من تاريخها القصير نسبيًا؛ حظيت الرواية العربية بالعديد من الإنجازات الفنية في الشكل والمضمون، وسعي كثير من الروائيين إلى تقديم رؤى مغايرة في البناء، والتقنيات، واللغة، مما حذا بالنقاد إلى تطوير أدواتهم النقدية من أجل مواكبة هذه الإيجابيات.. في اعتقادك ما هي السلبيات الفنية التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق مزيد من التطور للرواية العربية؟
- إن إيجابيات الرواية العربية الحديثة كثيرة ومتعددة واهتم بها الباحثون، أما عن سلبياتها فأری أن أول سلبية تعترضها هي مسألة الأفق، وهل للرواية العربية الحديثة في ضوء ما يتراكم الآن من نصوص أفق تُظهر لنا من خلاله انها قابلة للتطور وقابلة للتقدم؟ سؤال الأفق يفرض نفسه الآن بعد أن لاحظنا العديد من التراكمات التي تدور بصورة أو بأخرى في فلك شبه موحد وكأن هناك سمات مشتركة صارت تفرض نفسها على العديد من التجارب.
الشيء الذي يمكن أن نتبينه بصورة أو بأخرى في عديد من الروايات العربية وجود سمة أساسية هي سمة المغامرة الشكلية التي لا حدود لها، وغياب مواكبة نقدية متميزة تقوم على ضبط وتقنين أشكال هذه المغامرة، مما قد يذهب بالفن الروائي بعيدا دون أن يجد القارئ الذي يمكن أن يتفاعل معه، وأعطيك مثالا على ذلك من الرواية المغربية التي تسير في هذا المنحى الذي نجده على صعيد الرواية العربية الجديدة، والتي تفقد واحدا من أهم خصوصياتها الفنية وهي أن تكون نصا منفتحا على القارئ كيفما كان مستواه الثقافي ومستواه المعرفي. ويبدو لي أن هذا هو الرهان الأساسي للرواية لكي تبقى هي النوع الأدبي المميز بحق والذي يمكن أن يعالج كبريات المشاكل وكبريات القضايا التي يزخر بها الوطن العربي، وفي الوقت نفسه تراهن على أن تجد قارئا من مستويات ثقافية متعددة. - كيف تقيّم الرواية العربية الجديدة في ضوء المتغيرات التي طرأت عليها فنيًا، وفي ضوء إنها أوجدت لها قاعدة عريضة من القراء في أنحاء الوطن العربي من خلال اعتمادها على طرح هموم وقضايا الواقع؟
- الرواية العربية الجديدة ظهرت مع جيل الستينيات في مصر والذي حاول تقديم تجربة روائية مغايرة للتجربة السابقة التي كانت تسمى بالرواية الواقعية وهي الرواية ذات الاتجاه التقليدي النمطي في بناء الزمن، والشخصيات، والتقنية، وأسلوب السرد، إلخ. هذه الرواية التي ظهرت في مصر كانت لها مبررات حقيقية إبان ظهورها وهذه المبررات كانت تتمثل في أن الرواية ليست فقط محاولة لنسخ الواقع أو نسخ على منوال الواقع أو على تجربة واقعية ما، بقدر ما هي محاولة لخلخلة التصورات الجاهزة عن الواقع والتفكير فيها بطريقة جديدة. كان هذا هو الإطار العام الذي اختطته الرواية العربية بصفة عامة ومنذ تلك المرحلة كان الشكل هو الأداة المناسبة لتجسيد هذا المضمون أو هذا المحتوى وتبرز هذه الخلخلة بصورة واضحة في تقديم صور جديدة عن الواقع وإبراز تجليات مغايرة على صعيد الرؤية وعلى صعيد الوعي للمجتمع والتاريخ والتراث والثقافة بصفة عامة.
الرواية من هذه الناحية، وخاصة الرواية المغامرة، استطاعت فعلا أن تجلب لها قاعدة عريضة من القراء على الصعيد العربي وأصبح الجمهور (القارئ) يتعامل مع الرواية بصورة خاصة باعتبار انها حققت مناخًا جديدًا لتجسيد الواقع والتعبير عنه بطرائق فنية فيها ما فيها من عمق ودقة في التعبير وفي الرصد، وما وقع منذ ذلك الزمان إلى الآن هو أننا بدأنا نلمس في الآونة الأخيرة نوعا من التكرار على صعيد هذه التجربة. لذلك فسؤال الأفق يفرض نفسه على الروائي، ويفرض نفسه على الناقد لكي تكتسب الرواية خصوصيتها في حقل الإبداع العربي.
تفكيك الزمن الروائي - يسعى بعض الروائيين إلى تقديم زمن مفكك في أعمالهم على المستوى الظاهري عبر بنى سردية تتخلى عن وحدة الزمن التصاعدي ونرى ذلك جليًا في تلك الأعمال التي تطرح أحداثها بشكل غير مرتب (ظاهريا) من خلال وحدات أو فقرات سردية غير مرتبة زمنيًا أو حدثيًا.. كيف ترى إلى هذه الإشكالية؟ وإلى أي مدى يمكن لمثل هذه البني أن تضيف للرواية العربية عبر نزوعها نحو الشكل في مقابل البنية التصاعدية (التقليدية). وهل جاءت هذه النقلة الشكلية إن جاز التعبير استجابة لظروف فنية معينة؟ وما هو تقييمك الشخصي لها وما الذي يمكن أن تضيفه في علاقتها بالقارئ؟
- أقيّمها تقييمًا إيجابيًا إذا كان الكاتب يحسن بالفعل بناء الزمن بهذه الطريقة غير المتسلسلة وغير المترابطة، لأنه بتكسيره لوتيرة الزمن المنطقي الذي يقدم في الأعمال التقليدية فهو يقدم منظورا جديدا للزمن، بما انه ليس هو ذلك الزمن المنطقي، وليس هو ذلك الزمن الخارجي الذي نفترض انه هو الزمن الحقيقي أو الزمن الذي يمكن ان تتجسد لنا من خلاله الأشياء التي نريد إيصالها. لذلك فتقييمي لهذه المسألة يكون إيجابيا إذا ما نجح الكاتب فعلا في ممارسة ما يمكن أن نسميه بمصطلح “اللعب الزمني”، ممارسة تنبئ عن كثير من المهارة وكثير من الوعي بالزمن.. لماذا؟ لأنه يفرض على القارئ أن يعيد ترتيب الأحداث وأن يعيد بناء الزمن من وجهة نظر مغايرة لما قدمه الكاتب. وفي هذا المجهود الذي يبذله القارئ ليستوعب دلالة النص هو يقيم حوارا إيجابيا مع النص، في حين أن النص التقليدي يقدم كل شيء للقارئ جاهزا ومرتبا بطريقة بسيطة ويقوده بيديه ليصل به إلى النهاية السعيدة، بينما الروائي الجديد الحقيقي يعرف كيف يبني نصه بصورة جديدة ومغايرة للمعتاد، ويخلق عند القارئ تصورات وتوقعات جديدة تدفعه ليكون قارئًا منتجًا لا قارئًا مستهلكا.
- إذن ماذا تقول في الأعمال الروائية التي تظهر لكتاب عرب معروفين وهي أعمال تقليدية من حيث بنية الزمن، التقنية، تتابع الأحداث.. إلخ، ماذا تمثل هذه الروايات للحداثة الروائية وللمبدع الذي يكتب الآن وحوله هذا الركام الهائل من الأعمال المغايرة والمتفردة؟
-القارئ لا تهمه الأسئلة المتعلقة بتاريخ الرواية، وتطورها، وإشكالياتها، وأنواعها، مثل الباحث الذي يطرح هذه الأسئلة. بالنسبة للقارئ العادي يمكن أن يتفاعل مع رواية تقليدية لكاتب كبير أو لكاتب مبتدئ، كما أنه قد يتفاعل مع قصيدة عربية جديدة ومع قصيدة عمودية في الوقت نفسه. ولكن في صيرورة الإنتاج وفي تطوره التاريخي الزمني لا يمكن للأشكال التقليدية في الكتابة أن تكون متجاوزة إلا إذا نجح الكاتب الحقيقي، وهذا نادرا ما يحدث، في استغلال هذه الأشكال التقليدية بالاشتغال في نطاقها وتقديم تجربة مغايرة للشكل التقليدي الذي يوظفه. - تقصد أن الشكل التقليدي يمكن تطويعه أو توظيفه لتقديم رؤية مغايرة لها مواصفات مختلفة؟
- نعم، الكاتب يمكن أن يقدم لنا شخصيات عادية متطورة من حيث الزمن، ومن حيث السرد، ولكن ما يظهر لنا على السطح تقليديا يمكن بطريقة الاشتغال وبالتقنية التي يوظفها على صعيد اللغة أن نجد أنفسنا أمام نص إبداعي له مواصفاته الخاصة. الشيء الذي يعني أن القوالب العامة يمكن إخضاعها لأشكال تنتمي إلى مرحلة من الزمن الماضي، ولكن الكاتب يمكن أن يشتغل من داخلها ويقدم تجربة جديدة ومغايرة.
- حقا يا دكتور مثل هذا الطرح نلمسه حتى على الصعيد العالمي في أعمال روائية لكبار الكتاب إذ يتم توظيف البنية التقليدية في إنتاج أعمال غير تقليدية كما عند ميلان كونديرا وباولو كويلهو مثلا؟
- هذا ما كنت أقصده، كنت أحيل إلى مثل هذا النوع من النصوص لكتّاب من أمثال: كونديرا، جارثيا ماركيز، جورجي أمادو، والعديد من الروائيين العرب الذين يسيرون على هذا النمط. لكن من داخل هذا الشكل أو القالب نجد فنية خاصة ووعيا متميزا بالكتابة، كما انه على عكس هذه الصورة مثلا، يمكن لكاتب ما أن يقطع الزمن وأن يعطي صورا متعددة للشخصيات، أن يكسر السرد وأن يدخل خطابات متعددة، لكننا عندما نقرأ الرواية وننتهي منها نقول إن بها توظيفا تقنيا، ولكن ليست بها “روائية”، أو العكس، وذلك ما يبين أداء الكاتب وتميزه على صعيد الشكل أوعلى صعيد المادة الروائية، والتضافر بينهما هو ما يصنع الرواية الجديدة أو الرواية الملائمة للتطور الذي يتحقق على صعيد الرواية.