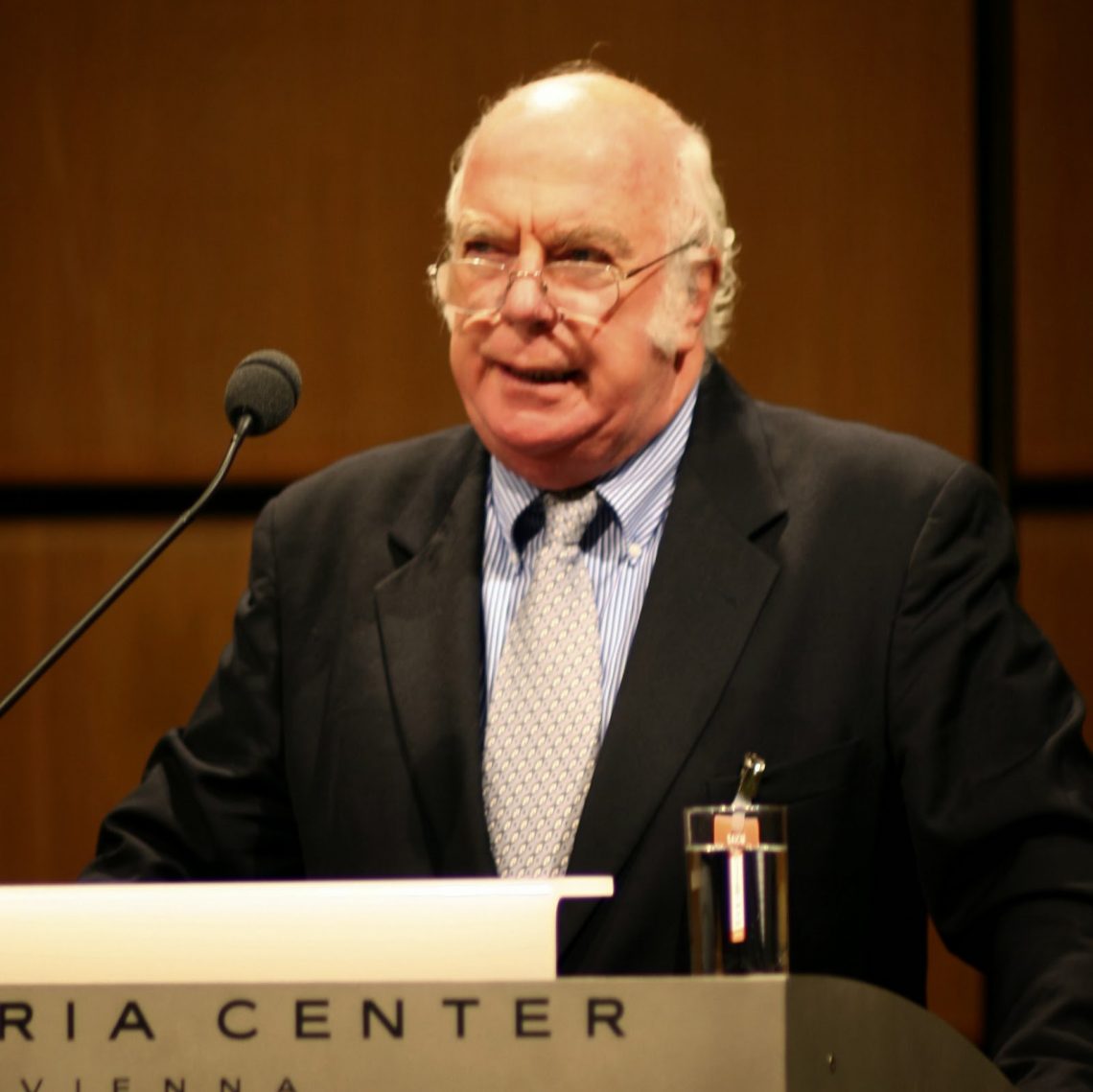في كتابه “إنسانية الإسلام” يناقش المفكر الفرنسي موضوع الإسلام من جوانب شتى، ولعل أهمها الجانب الإنساني والعلاقات الأخوية مع الآخر المختلف، وما نتج عن ذلك من بناء مجتمع موحد لا عنف ولا تطرف. ولهذه الأهمية سوف نتوقف مع هذه القضايا لبيان مدى مركزيتها في رسم عالم إنساني أكثر تسامحا.
الإنسان الجماعي:
يرى بوازار أن الإسلام منذ البداية ظهر حركة تؤيد أولية الشأن الاجتماعي على الشأن الجماعي، وبالتالي أولية الشخص الحر المسؤول في مقابل الفرد مرتبطا بالزمرة التقليدية. وسرعان ما وعى المجتمع الذي لمّ الإسلام شمله أن عليه تأليف كيان خاص يتميز عن العالم الخارجي بمثل أعلى مشترك للحقوق والواجبات المتبادلة.
ولم يكن بدّ من أن يتأكد أن هذه الجمعية ليست ذات نزعة حصرية، بل هي منفتحة للغاية، لأن انخراط أعضاء جدد فيها معدّ على أساس من معايير ثابتة وشروط عامة، وهكذا جاء الإسلام بمفهوم جديد وسخي للقومية. وغدا الرباط الذي يشد أعضاء المجتمع بعضهم إلى بعض رباطا دينيا وسياسيا في وقت معا.
وبالفعل يعني الدين للمسلم الخضوع لله والامتثال لشريعته. وعلى هذا يضفي الإسلام على المجتمع طابعا استثنائيا عن طريق ثلاثة مظاهر أساسية خاصة به وحده.
أولها، أن التنزيل يحدد الواجبات المترتبة على المؤمن في جميع حقول الحياة ويعرّفه بواجباته سواء كانت نحو الله أو نحو المجتمع. فمن الواجبات المفروضة عليه بشكل صريح أن يشارك في تماسك المجتمع وازدهاره، ولو على حساب حياته إذا اقتضى الأمر. والظاهرة الثانية أن ممارسة الشعائر تسهم، عن طريق الدقة المحدد بها بالذات، وفي توفير شعور حاد بالانتماء إلى زمرة منظمة. وأخيرا يسهم بمفهوم القرآن للعالم، إذ يقدم الخليقة على أنها كل متناسق ومتوازن في التبعية لله، وفي رصّ بنيان المجتمع، إذ يغدو تجمّع المؤمنين نظاما يتبوأ فيه كل إنسان مكانه الحقيقي.
ويلاحظ بوازار، إن الإسلام لا يميز بين إنسان وعدة أناس، بين الإنسان والأمة، وهذه المفارقة أساسية لأنها تتيح فهم الخلق الاجتماعي الإسلامي الذي ينظم علاقات جماعية أكثر مما ينظم علاقات بين الأفراد، كما تتيح إدراك المدنية الإسلامية والعلاقات بين المجتمع والعالم الخارجي.
ويؤكد هنا بوازار أنه إذا كان في الإسلام فصل واضح بين الإنسان كإنسان وبين الإنسان الجماعي، فذلك لا يعني أن هاتين الحقيقتين ليستا متضامنتين تضامنا عميقا، نظرا لأن المجتمع مظهر من مظاهر الإنسان. وأن المجتمع هو، بطريقة عكسية، تعدد أفراد، وينشأ عن هذا الترابط، أو هذه المقابلة، أن كل ما يتم لمصلحة المجتمع. قيمة روحية بالنسبة للفرد، والعكس بالعكس.
وعليه فإن المؤمن يؤدي واجباته نحو سائر أعضاء الفريق الاجتماعي، بمقدار ما يتقيد بالشريعة المنزلة، على الصعيدين الفردي والجماعي. والجماعة المنظمة هي الشكل الاجتماعي الوحيد الممكن في نظر المسلم. وهكذا تبدو الفضيلة الإسلامية جماعية بشكل جوهري، لا فضيلة قائمة بين فرد وآخر.
وبالفعل يوصي القرآن نصا بأن تكون الأمة مجتمعا يأمر أعضاؤه، فرادى أو جماعات، بالمعروف وينهون عن المنكر. ويستتبع تطبيق القيم الدينية تغييرا في الإنسان والمجتمع والعالم. ولما كان الإسلام دينا وحضارة، فهو يترسخ تعبيرا حيا وناشطا عن إرادة جماعية. وتضامن أعضاء المجتمع الإسلامي مؤكد بشدة ومنصوص بدقة كبرى على قانونيته في الشريعة القرآنية، وقد فُهم على أنه شعور محتم بالتبعية المتبادلة وحاجة إلى التعاون الجماعي، وحافزه في الدرجة الأولى قياسي وإيثاري وإحساني أو عاطفي بعد ذلك. ويتأكد واجبا شبه قانوني ملزما مسؤولية كل شخص، وعلى هذا يتخذ ارتباط الأفراد صورة المسؤولية الخلقية المشتركة فيما يخص مراعاة القوانين الإسلامية والتعاون الاجتماعي لإنماء الأمة.
زمالة دينية المركز:
هنا يقول بوازار أن للمعاهدة التي عقدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى وصوله المدينة مع قبائلها العربية الاثنتي عشرة وقبائلها اليهودية الشعر شأنا رفيعا جدا فقد أمكن اعتبارها أول دستور مكتوب في العالم. ويتضمن هذا العقد القانوني بكل معنى الكلمة قسمين متميزين، فالقسم الأول يرسّخ الاخاء الاسلامي وينشأ كيانا واضحا يضم قبائل المدينة العربية ومهاجري المدينة. ويؤلف القسم الثاني تحالفا عسكريا مع القبائل اليهودية.
وأما أحكام الدستور التي وحدت شعبا غير متجانس وأوجدت جنين الدولة الإسلامية، فكانت التالية: تبقى الجماعات القبلية على حالها، لكنها تتضامن لخلق تنظيم سياسي موحد.
ولم يكن يحق لأعضاء الجماعة الموحدة أن يقيموا العدالة بأنفسهم، بل كان عليهم أن يعودوا إلى محاكم الاتحاد –بتعبير بوازار- أو إلى حكومة النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ تملك هذه الحكومة صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسهر على ألا يضطهد أحد أحدا، وتؤمّن العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة الثروة المشتركة.
هكذا تبيّن حسب بوازار أن النظام الذي أقامه محمد -صلى الله عليه وسلم- وحافظ عليه في خطوطه العريضة خلفاؤه الأربعة، كان آلة حكم مثالية وبسيطة وواقعية وقابلة للتطبيق.
فلا مناص حينئذ من أن يفضي التقيد بالوحي الإسلامي إلى مجتمع متوازن لا طبقية فيه ولا صراع طبقات، نظام مثالي مبني لا على العقل البشري، وإنما على الإرادة الإلهية التي تضمن من غير تنازع ترسيخ الحرية والمساواة، وهما الحقّان الرئيسيان للإنسان ضمن العدالة الاجتماعية.
التعامل مع الغير:
لقد كان المسلمون يهبون للذميين حق الإقامة على أرض الإسلام والاحتفاظ باعتقاداتهم الدينية، والحماية من الأخطار الخارجية والداخلية، وسلامة أنفسهم وممتلكاتهم، وكذلك ضمان حرياتهم الأساسية. وتشمل هذه الحريات مبدئيا ومع مراعاة القيود التي فرضتها في البداية ضرورة الأمن: حرية المعتقد والعبادة، وحرية الملكية والتجارة والعمل، وحرية التعاقد، إلى جانب احترام مؤسساتهم الخاصة.
ويؤكد بوازار على أن الإسلام يتراءى أكثر تسامحا كلما قوي واشتد على الصعيدين الداخلي والخارجي. وينمّ نص الآية القرآنية التي تمنع الإكراه على اعتناق الدين عن تأكيد لا يتزعزع. وقوة الأمة توفر للمؤمن ألا يخشى اليهودي ولا المسيحي، وأن يحترم بالتالي شخصهما ودينهما ومؤسساتهما.
ويختم بوازار قائلا: إننا لم نسع إلى إصدار الأحكام، بل سعينا إلى أن نثبت ببعض المستندات الموجزة أن الإسلام قد أكد بشكل رائع، وقبل أي حضارة أو دين على ما يبدو، احترام الإنسان في مجتمع يؤمن بالمساواة بحثا عن أفضل عدالة ممكنة. ولا ريب أن القيم التي يعبّر عنها القرآن ما تزال هي، كما ما تزال قادرة على أن تسهم، حتى في أيامنا هذه، في بناء عالم أكثر إنسانية.