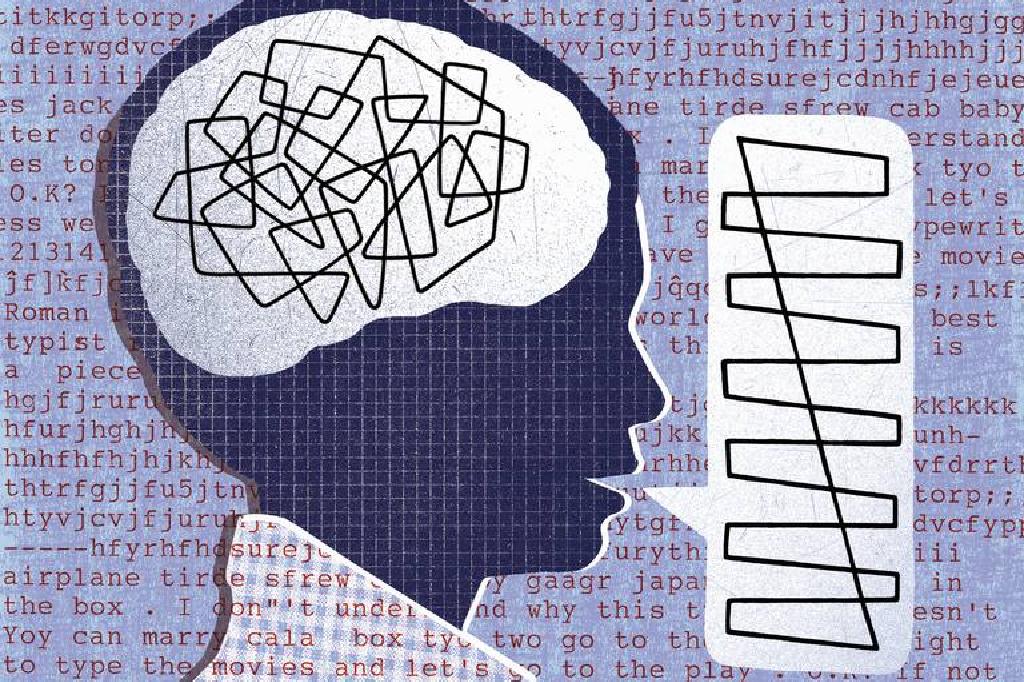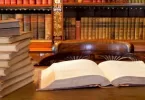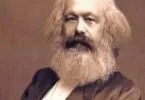نقد العلامة عند جاك دريدا
يعتبر جاك دريدا من الفلاسفة الفرنسيين الكبار الذين بصموا الفكر الفلسفي بكتاباتهم حول فلسفة الكتابة. تقوم دراسته على إعادة قراءة للفكر الغربي في خصائصه ومكوناته. انطلاقا من تساؤلات تبدأ من الهامش لتجعل منه موقعا ممكنا للكتابة وفضاء فعليا للنص والتفكيك. إنها قراءة تتوسع لتبدو معها مساحات التفكير والتفكيك أكثر اتساعا باتساع دروب الميتافيزيقا.
شهدت الجامعات الفرنسية اضطرابات خاصة مع انتفاضة الطلاب المعروفة في ماي 1968 ضد الأساليب القديمة في التعليم والثقافة، انتشرت موجة من النقد لكل الأشكال الثقافية الموزونة في العقل الغربي منذ اليونان مرورا بالمسيحية والعقلانية الديكارتية والماركسية إلى البنيوية المعاصرة.
في هذا المناخ الثوري تأسست مجلة “تيل كيل” وضمت إليها مفكرين ونقاد وازنين عرفوا بتمردهم على نظام الدولة والمؤسسة الثقافية الغربية، أمثال ميشيل فوكو ورولان بارت وجوليا كريستيفا وفليب سولير وجون بيير فاي وجاك دريدا. ستشهد الساحة الثقافية الفرنسية مع هذه الجماعة الساخطة فيضا نقديا سيغير من مراكز الحصون الميتافيزيقية الغربية ومنها العلامة البنيوية والذات.
كان هدف هذه الثورة الفكرية، تحريك الطبقات الاجتماعية، وتفجير مجموعة من الأفكار ناتجة عن هذا المزيج من الفرضيات المختلفة. ويمكن القول إن أقطاب هذه المجلة أصبحوا يحملون لواء الحداثة في العلوم الإنسانية بفضل ما أدخلوه على البنيوية. كذلك حققت على المستوى الرمزي، هذه الوضعية التوافقية للتحديث في العلوم الاجتماعية. ونقول إنه كان تيارا أدبيا ثوريا، يحمل راية تحرر الدال من المدلول.
هكذا، انطلق دريدا في نقده لمفهوم العلامة من مساءلة أبستمولوجيا تتابع تاريخ “المعنى” في الفلسفة الغربية منذ العصر اليوناني، بما أنه الأساس أو المركز الذي فكرت داخله كل الظواهر الثقافية. وتتالى البحث في المعنى في تاريخ الفكر الأوربي عبر العصور بمفاهيم متعددة منها الروح، الفكر، العقل، الجوهر، الباطن المادة، المعقول…
يعترف دريدا بعلمية اللسانيات، نظرا لأساسها الفونولوجي، فالفونولوجيا توصل علميتها إلى اللسانيات، التي تشتغل هي نفسها كنموذج أبستمولوجي لكل العلوم الانسانية. هكذا تتحدد اللغة في بساطتها التي تختزل إلى جوهرها، كوحدة للصوت “phone”. ويحدد مفهوم الكتابة عند دريدا، حقلا للعلم، كما أن السؤال عن أصل الكتابة لا يمكن أن ينفصل عن السؤال عن أصل اللغة. هكذا، “سوف يغطي علم للكتابة قبل الكلام وداخل الكلام، الحقل الأكثر توسعا، الذي سترسم اللسانيات فضاءها الخاص داخله، في الحدود التي وصفها دوسسير لنسقها الداخلي، الذي يجب أن نعيد وصفه بحدر داخل كل نسق الكلام/ الكتابة عبر العلم والتاريخ “1
صرح جاك دريدا في إجابته عن سؤال لجوليا كريستيفا حول حدود نزعة العقل المركزية، وكيف يمكن أن تشكل قاعدة لدلالة تطمح إلى الانفلات من قبضة الميتافيزيقا بأن « مفهوم العلامة (الدال / المدلول) يحمل في ذاته ضرورة تفضيل المادة الصوتية ومنح السيميولوجيا دور” السيادة”، فالصوت بالفعل هو الماهية الدالة التي تظهر للوعي كونها الأكثر اتحادا مع فكر المدلول. ومن هذا المنظور يكون الصوت هو الوعي بذاته. فحين أتكلم فأنا أكون واعيا بكوني حاضرا فيما أفكر فيه، لكن أيضا أكون على وعي بأني أحتفظ على مقربة من تفكيري، ومن “المفهوم” بدالّ لا علاقة له بالعالم وأستطيع سماعه بمجرد ما أتلفظ به دالا يبدو ملتصقا بعفويتي الحرة الخاصة ولا يطالب بأية أداة ولا بأية إضافة لها مصدرها في العالم. هنا لا يتعلق الأمر بعلاقة وحدة. لكن يبدو أن الدال، داخل هذا التمازج، ينمحي أو يصبح شفافا كي يترك المفهوم (المدلول) يقدم نفسه كما هو بدون أية إحالة سوى إلى حضوره هو، تبدو لذلك برانية الدال خاضعة للا اختزال2″
يذهب دريدا إلى أن تمييز الدال/ المدلول عند دوسسير، قد فتح المجال أمامنا للتفكير في مدلول في ذاته، في استقلال عن اللسان، كما أنه يمنح الفرصة لظهور الفرضية التي يسميها دريدا “المدلول المتعالي” الذي لن يحيل في ذاته على أي دال، وبالتالي يصبح هذا التمييز السوسوري إشكاليا. وهذه الإشكالية تفرض المرور بعملية تفكيك تاريخ الميتافيزيقا الذي يفرض نفسه على كل باحث سيميولوجي، في إطار بحثه عن مدلول متعالي وعن مفهوم مستقل للسان. طبعا، هذا الاشتغال لا تفرضه الفلسفة، إنما الضرورة التي تربط لساننا وثقافتنا وتفكيرنا بتاريخ ونسق الميتافيزيقا.
يستعيد الفصل الذي أوجدته اللسانيات والسيمائيات المعاصرة بين الدال والمدلول في قلب العلامة اللغوية، التمييز الميتافيزيقي المعروف بين المحسوس والمعقول أو بين الداخل والخارج الذي كان أساس الخطاب الميتافيزيقي الغربي3 . ومع تأكيد السيمائيين البنيويين على الإعلان أن الدال والمدلول وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان، فإنهم مع ذلك قد انجرفوا وراء أفضلية المدلول عن الدال ومنحه الشرعية في الحديث باسم العلامة. فالمدلول هو جوهر العلامة المتعالي الذي يمكن أن يفكر فيه باستقلال عن الدال. ويتشكل الدال ممثلا للمدلول عارضا له، ولا معنى له إلا بإحالته على مدلول متعالٍ. في حين أن المدلول لا يحيل إلا على ذاته لأنه ماهية مستقلة قائمة الذات. هكذا بدأت تتأسس حول المعنى والمدلول من جديد سلسلة من الامتيازات على حساب الدال أو على حساب كل ما هو مادي في العلامة.
إذا كان لابد من الاهتمام بالدال، فقد تم الاهتمام بما أنه مادة صوتية فيزيائية، وهو ما حصل مع اللسانيين تروبيتسكوي وجاكبسون ومارتني3. لقد أسسوا الدرس اللساني على الأصوات وحبسوا الدال في تمظهره الصوتي في تهميش لمظهره الكتابي الذي هو أوسع من تمظهره الصوتي.
عمل اللسانيون على نقد الكتابة في كل مظهر كتابي وحرفي الدال أكثر من اختزال الدال في مجرد صورة صوتية. فعدّوا الكتابة فرعا من الصوت ودونه وأقل شأنا منه، وأنها لا تعدوا أن تكون مجرد علامة على العلامة أو دال على الدال الصوتي اللغوي، وأن موضوع عالم اللغة هو الصوت لا الكتابة4.
يتساءل دريدا” لماذا رفض سوسير أن يعتبر اللغة مجرد تمثيل للشيء الخارجي والحد من استقلاليتها واعتباطيتها في حين أنه رفض أن يمنح هذا الامتياز للكتابة وجعلها مجرد ممثل للغة. إما نعدّ الكتابة مثلها مثل اللغة، نظاما مستقلا قائما بذاته وبالتالي نكون منطقيين مع مبدأ الاعتباطية واستقلالية العلامة اللغوية عن الأشياء الخارجية أو نعدّ الكتابة مجرد تابع ولاحق تمثل اللغة وتحيل عليها. وبالتالي فإن هذا ينطبق على اللغة نفسها، فتكون هي أيضا مجرد ممثل للأشياء والوقائع الخارجية كما اعتقدت الدراسات اللغوية الكلاسيكية التي تصدى لها سوسير بنجاح علمي في حين عجز عن ذلك بصدد حديثه عن الكتابة، فأدخلته الميتافيزيقا في أوضح صورها. هكذا نقرأه يتخبط في حديثه عن الكتابة محاولا تهميشها والتقليل من قيمتها وإعطاء أهمية كبيرة للصوت وتأصيله موضوعا لعلم اللغة يقول: “تكون اللغة والكتابة نظامين متميزين من أنظمة العلامات ولا مبرر لوجود الكتابة سوى تمثيل اللغة وموضوع اللغة لا يتحدد في كونه نتيجة للجمع بين الكلمة المكتوبة والكلمة المخطوطة، بل ينحصر في الكلمة المنطوقة فقط، إلا أن الكلمة المكتوبة وما هي إلا صورة للكلمة المنطوقة، تمتزج وإياها امتزاجا عميقا ينتهي إلى اغتصاب الدور الاساسي حتى أن الأمر يؤدي بالناس إلى أن يغيروا صورة العلامة الصوتية في الخط لأن للخط أهمية تساوي بل تفوق أهمية العلامة نفسها…5 ثم كيف يستقيم هذا الدال. وقد سبق لسوسير أن أكد أن قيمة العلامة لا تكمن في مادتها الصوتية أو التصور الذهني الذي تحيل عليه، بل علاقات الاختلاف داخل النسق. فمبدأ الاختلاف كما طرحه سوسير. يشير إلى أن الدلالة هي لعبة صورية للاختلافات التي تعطي المدلول كأثر ناتج عن احتكاك الدوال لا كموضوع مستقل.
يعيد دريدا بناء منظومة جديدة للفكر الغربي، عن طريق استراتيجية التفكيك والخلخلة، بتحليله وإرجاعه إلى العناصر المكونة له. وفلسفة الحضور والإنصات للذات تقود إلى التفجير من الداخل. ويمكن تفكيك الخطاب العلمي اللساني، ونقضه بسهولة انطلاقا من هذا الهامش والمكبوت داخله وهو الكتابة 6 وعلم الكتابة هو الذي سيمنح دريدا الاداة الصلبة لتفكيك ميتافيزيقا العلامة كونها قبل الكلام وداخل الكلام، سوف يغطي هكذا الحقل الأكثر توسعا، الذي سترسم اللسانيات فضاءها الخاص داخله، بالحدود التي وصفها دوسسير لنسقها الداخلي، الذي يجب أن نعيد وصفه بحذر داخل كل نسق الكلام/ الكتابة عبر العالم والتاريخ.
هامش:
1- ـ جاك دريدا. مواقع . ترجمة فريد الزاهي ـ دار طوبقال 1992، ص25ـ26 ( هذه الحوارات تواكب كتاب “علم الكتابة”، تقتبس منه أو تتجاوزه . وفي الترجمة العربية لفريد الزاهي يشير إلى إضافات الكاتب لهذه الحوارات وإغنائها بهوامش من قبل المترجم)
2- Jacques Derrida. De La gramatologie.Editions de Minuit.1967 p74
3- T. Todorov.et O.Ducrot Encyclopédique de sciences et de langage.Collections Points.1972. p438
4- Jacques Derrida. De la gramatologie Ed Minuit. 1967. Paris
p.45
5- نفسه ص 67
6- نفسه.