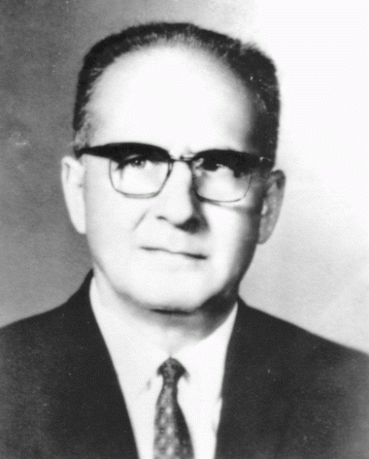من المتفق عليه أن الأفكار تعد حجر الزاوية في توجيه المجتمع في مسار من المسارات المختلفة، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، ولعل هذا ما عشناه ونعيشه اليوم؛ إذ أن هناك من يرى أن سبب تخلفنا هو الإسلام والحل حسب رؤيته هو الانفتاح على الغرب وقيمه هكذا بصفة عامة، وبين من يرى أن الإسلام هو المنبع لأي تطور وتقدم منشود انطلاقا من القرآن الكريم والهدي النبوي. هذه الثنائية تجعل الحديث عن مسألة “الأفكار” أمرا لا محيد عنه، وهذا ما سيجيبنا عنه المفكر مالك بن نبي.
انطلق مالك بن نبي من فكرة مهمة وهي أن للعالم الثقافي بنية (ديناميكية) تتوافق مظاهرها المتتالية مع علاقات متغيرة بين العناصر الثلاثة الحركية: الأشياء، والأشخاص، والأفكار. ويرى أن أزمة أي مجتمع تكون عندما يكون في عالمه الثقافي انقطاع لحبل التوازن لصالح طغيان عنصر من العناصر الثلاثة. يقول ابن نبي: “والفاصل الزمني: هو صراع بين العناصر الثلاثة في قلب العالم الثقافي. أما الأزمة فهي نهاية هذا الصراع عند انتصار واحد من الأبطال المتصارعين وظهور طاغية يستولي على السلطة في قلب العالم الثقافي”[1]. فكيف نفهم هذه العلاقة بين الأشياء والأشخاص والأفكار؟
إن هذه العلاقة حسب ابن نبي لا تجد تعبيرها فحسب في المجتمع الإسلامي الذي يواجه الشيئية وسائر نتائجها النفسية والاجتماعية، بل يمكن اعتبارها بالنسبة للمجتمع المتحضر وسيلة تحليل لوضعه الراهن؛ من وجهة النظر النفسية الاجتماعية، يقول “فالمشكلة في الواقع ذات وجه مزدوج. ففي بلد متخلف يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته، تنشأ فيه عقد الكبت والميل نحو التكديس الذي يصبح في الإطار الاقتصادي إسرافا محضا. أما في البلد المتقدم وطبقا لدرجة تقدمه: فإن الشيء يسيطر بسبب وفرته وينتج نوعا من الإشباع”[2]. إن حضور الشيء من عدمه رهين بمكانة المجتمع، فيغيب تقديس الأشياء عند المتحضر بين المتخلف يقدسه؛ لكن رغم ذلك من وجهة نظر ابن نبي فالنتائج النفسية المنطقية واحدة. فالشيء يطرد الفكرة من موطنها في حين يطردها من وعي الشبعان والجائع معنا.
إن صراع الفكرة والشيء يكون تارة من نتاج التاريخ في اطّراد الحضارة، وتارة أخرى حصيلة مناورة سياسية، يقول ابن نبي: “لقد اجتاز المجتمع الإسلامي هذه الخطوة المشعرة باقتراب الانفصام في قلب العالم الثقافي؛ يوم أن قال عقيل أخو علي بن أبي طالب “إن صلاتي مع عليّ أقوم وطعامي عند معاوية أدسم”. إن هذه الحياة النفسية المنقسمة بين الطعام والصلاة كانت من أعراض بداية الصراع بين الفكرة والشيء. وقد واصل هذا الصراع طريقه منذ ذلك الوقت. وعندما فكر الغزالي بعد مضي أربعة قرون أن يجد في العلاقة الدينية بين المجتمع المسلم والعالم الثقافي كان الأوان قد فات. فقد كانت المرحلة الثالثة من الحضارة قد بدأت، ولم يكن بمقدور المجتمع الإسلامي إلا أن يواصل انحداره حتى يصل إلى عصر ما بعد الموحدين. ولم يكن بمقدوره وهو يسترسل في المنحدر المشؤوم أن يسترد توازنه الأصلي”[3].
– أصالة الأفكار وفعاليته:
يؤكد ابن نبي أن فكرة أصيلة لا يعني ذلك فعاليتها الدائمة. وفكرة فعالة ليست بالضرورة صحيحة. والخلط بين هذين الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة، وتحلق أشد الضرر في تاريخ الأمم حينما يصبح هذا الخلط في أيدي المتخصصين في الصراع الفكري وسيلة لاغتصاب الضمائر. يقول عن ذلك: “إن الأصالة ذاتية وعينية وهي مستقلة عن التاريخ. والفكرة إذ تخرج إلى النور فهي: إما صحيحة أو باطلة. وحينما تكون صحيحة فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر الزمان. لكنها بالمقابل، يمكن أن تفقد فعاليتها وهي في طريقها؛ حتى ولو كانت صحيحة. فلفعالية الفكرة تاريخها الذي يبدأ مع لحظة (أرخميدس) حينما تأتي دفعتها الأصلية لتهز العالم، أو يعتقد فيها نقطة ارتكاز ضرورية لقلب ذلك العالم”[4].
وبالمقابل فالتاريخ يزخر بالأفكار التي ولدت باطلة، ليس فيها أصالة لكنها مع ذلك كان لها فعالية مدوية في أثر الميادين تنوعا. وغالبا ما تكون هذه الأفكار حسب ابن نبي محجبة مضطرة لحمل قناع الأصالة لتدخل التاريخ كلص يدخل منزلا بمفتاح مزيف. إن إضفاء القدسية على الأفكار بغض النظر عن أصالتها يجعل لها قيمة عند الناس.
وبالرجوع إلى حالنا يرى ابن نبي أن هناك الكثير من المثقفين المسلمين الذي يفتنون بالأشياء الجديدة، وبالتالي يسحرون بمنطق الفعالية، ولا يميزون بين حدود توافقها مع مهام مجتمع يريد أن ينهض دون أن يفقد هويته. فهؤلاء “المفكرون يخلطون بين أمرين: الانفتاح الكامل على كل رياح الفكر، وبين تسليم القلعة للمهاجمين كما يفعل الجيش الخائن. هؤلاء مردوا بإدمان على تقليد الآخرين: ليس لديهم أي مفهوم عن ابتكار هذا الغير، ولا عن دوافع هذا الابتكار، عن تكاليفه في جميع المجالات التي يقلدونهم فيها، وكان الأجدر بهم أن يبتكروا هم أنفسهم وفق دوافعهم الخاصة بدل أن يقلدوا”[5].
ويرى ابن نبي أنه يجب أن نلاحظ أن هذا التقليد ليس تقليدا لفعالية أي مجتمع دينامي، كما فعلت اليابان مثلا، ولكنه تقليد لقالب فلسفي يصبح دفعة واحدة منطقا معاديا للإسلام. إنهم يختارون (الماركسية) وعلى الخصوص (التروتسكية)، يضعون عليها سمة الماوية ليدخلوا الإعجاب في عيون المتفرجين. يقول: “على كل حال فإن حالتهم تفرض علينا أمثولة. فالعالم الثقافي في البلاد الإسلامية ليس فقط المسرح الذي يدور عليه الصراع بينن الفكرة والشيء… إنه أيضا الحلبة التي ينبغي فيها الانتصار في صراع يفرض منطلق الفعالية، فالفكرة الإسلامية لكي تقارع الأفكار الفعالة للمجتمعات المتحركة في القرن العشرين عليها أن تستعيد فعاليتها الخاصة، أي أن تأخذ مكانها من جديد وسط الأفكار التي تصنع التاريخ”[6].
نستخلص مما سبق، أن ثنائية الفكرة والشيء ثنائية خطيرة جدا، خصوصا علينا نحن في العالم الإسلامي، خصوصا وأن الإعلام الغربي المغرض منكب على جعلنا تابعين للشيء، وكلما حاولنا شد حبل الأفكار بدل الأشياء يقوم الغرب بوضع العراقيل بكل ما يملك كي يوقف نهضتنا وجعلنا معلقين بالأشياء كي لا ننهض ونبقى مجرد مستهلكين لا منتجين.
[1] – مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ترجمة: د. بسام بركة، د. أحمد شعبو، إشراف وتقديم: عمر مسقاوي، دار الفكر دمشق، 2002، ص: 85
[2] – نفسه، ص: 86
[3] – مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص: 94
[4] – نفسه، ص: 102- 103
[5] – مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص: 109
[6] – نفسه، ص: 110