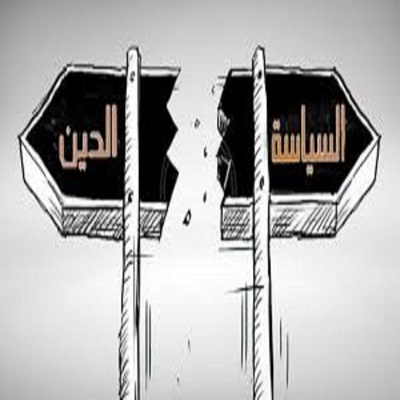عام 2007، نشر الفيلسوف الكندي تشارلز تيلور كتابًا بعنوان ” A Secular Age” (عصر علماني) في (900) صفحة، وهو مسح شامل للتحولات التاريخية والفلسفية التي أدت إلى عصر حديث يفترض الافتقار إلى السحر والميتافيزيقا. ويناقش عمل تيلور العديد من الافتراضات الشائعة فيما يتعلق بعملية وقيمة وكيفية وصول العالم الغربي إلى ما هو عليه الآن. كما يتحدى فكرة أن مِن خلال العلم والتعليم قضينا ببساطة أو نضجنا بما يتجاوز الحاجة إلى الإيمان بالمُتعالي. وأخيرًا يفحص تيلور كيف تشكل وجهات نظرنا تجاه الأفراد والمؤسسات الإنسانية أنظمة معتقداتنا بطرق شديدة الدقة، وإن كانت غير محسوسة تقريبًا.
يبدأ تيلور مِن “قصة الطرح” لنظرية العلمنة السائدة، والتي ترى العلمانية المعاصرة كأثر حتمي لانحدار المعتقدات الدينية والخرافات التي بدأها عصر التنوير. حيث يؤكد أن خيبة الأمل من الحداثة هي اختراع غير متوقع لحركات “الإصلاح” المتأخرة في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث التي عملت على تسطيح التسلسل الهرمي الديني، وتبسيط الممارسة الدينية، وأثارت اهتمامًا جديدًا بالطبيعة والحياة العادية. وسواء البروتستانتية أو الكاثوليكية، لم يكن لدى وكلاء الإصلاح أي فكرة بأنهم كانوا يساعدون في خلق طريقة أكثر علمانية لتخيل المجتمع والعالم؛ ومع ذلك، يتتبع تيلور جذور “الإنسانية” الحديثة لهذه التغييرات في اللاهوت المسيحي.
على الرغم من أهمية كتاب تيلور، إلا أنه لا يزال صعبًا بالنسبة للكثيرين بسبب مادته الكثيفة وحجمه الكبير. ما دعى الحاجة لتقديم كتب لشرحه ولعل أهما كتاب بعنوان: ” How (Not) to Be Secular: Reading Charles Taylor”، يتولى جيمس سميث المهمة الضخمة المتمثلة في توضيح وتكثيف عصر تيلور العلماني. وبغض النظر عن التطبيقات، فإن الجزء الأكبر من “كيف (لا) تكون علمانيًا” مكرس لعرض دقيق وشامل لكتاب تيلور.
يركز كل فصل من فصول سميث الخمسة على جزء من كتاب “عصر علماني”، مع التركيز على الموضوعات الرئيسية دون التورط في التفاصيل المعقدة لحجة تيلور. وتُستخدم المخططات والقوائم والاستعارات بشكل مُخفف لتوضيح النقاط الرئيسية بالكتاب.
مثل “تأثير نوفا”، وهو مصطلح يشير إلى “انفجار جميع أنواع” الطرق الثالثة “بين الأرثوذكسية وعدم الإيمان.
من وجهة نظر تيلور، فإن العلمانية تتعلق بأكثر من مجرد أفكار: إنها ظاهرة على مستوى “خيالنا الاجتماعي”، والتي تُعرَّف على أنها الطريقة التي “يتخيل بها الناس العاديون محيطهم الاجتماعي، وغالبًا لا يتم التعبير عنها بمصطلحات نظرية “. وطريقة معينة لتفسير الفرد والعالم، التي شكلها التنوير بشكل كبير ، تأتي إلينا “في حليب أمنا، إذا جاز التعبير ، لدرجة أنه يصعب علينا تخيل العالم بطريقة أخرى”. شكلت الأفكار القوية (مثل المادية واستقلالية الفرد) ما نجده معقولًا. ومع ذلك، فإن العديد من هذه المواقف فعليًا سابقة للعقلانية؛ نحن ببساطة نأخذها كأمر مسلم به على أنها “الطريقة التي تسير بها الأمور”.
إحدى السمات الرئيسية لكتاب “عصر علماني” هي تطوير مفردات جديدة لمساعدتنا على تسمية الضغوط الوجودية المعقدة للحياة في المجتمعات العلمانية. إنه جزء لا يتجزأ من محاولة تيلور الجريئة للوصول إلى نسيج لحظتنا الثقافية، وتحديد التيارات والتوترات التي شعرنا بها إلى حد ما ولكننا لم ندركها بالكامل.
سميث، بدوره، يأخذ حجج تيلور كنقطة انطلاق لدليل حول كيفية عيش الإيمان بالحداثة. ويستكشف أولاً العلمانية من خلال تأملات جوليان بارنز اللاأدري، الذي لا يؤمن بالله ومع ذلك يشعر بأنه مسكون بالدين في الطريقة التي توضح ما يسميه تيلور “صدى” التعالي. وبالمثل، يسلط سميث الضوء على روايات ديفيد فوستر والاس على أنها تضيء “الضغوط المتقاطعة” لكوننا المغلق بشكل متزايد. وينقل سميث، عن والاس قوله: “مات الله، لكنه حل محله الآخرون”. غالبًا ما يقترح سميث أيضًا أسئلة محتملة وتطبيقات لأفكار تيلور للممارسين، مع تجنب التقوى السهلة، مجادلًا على سبيل المثال بأن الدفاعيات المسيحية المعاصرة هي غالبًا ما يسميه تيلور “الدوران”، أو “صورة” مفرطة الثقة لا يمكننا تخيل وجودها”.
في المقدمة، يبدأ سميث بتأطير نصه على أنه أكثر من مجرد دفاع. ويشرح أن العصر الحالي يحمل إحساسًا بأنه مسكون، إنه “مضغوط” بين اللزوم الخانق والتعالي الضائع. لا يتعارض الكتاب وحجة تيلور مع الاعتذار الحديث في حد ذاته، بل يتطلع بدلاً من ذلك إلى شيء ما إلى جانب الاعتذارات. إنه سرد أكثر منه حجة، وهو قائم على المشاعر أكثر من البيانات أو المنطق.
في مقدمته، وضع سميث أيضًا تعريفاته العملية الثلاثة للعلمانية:
- المفهوم الكلاسيكي للانقسام المقدس/العلماني الذي يشير فيه العلماني إلى ما هو أرضي أو عادي.
- إنشاء عصر التنوير مجال محايد أو ديني. هذه هي فكرة “العلمانية” المقبولة بشكل عام في عقلية اليوم.
- الخيار الثقافي لأن تكون علمانيًا، ويتعلق بـ “ظروف العقيدة” حيث يكون الانتماء الديني واحدًا فقط من العديد من الخيارات -ومثير للتحدي في ذلك الوقت. يؤدي هذا المفهوم العلماني إلى ظهور “الإنسانية الحصرية” حيث يتم ببساطة رفض أي شيء يتجاوز العالم الجوهري.
تبدأ الرحلة إلى هذا العصر العلماني في خلفية الوعي البشري: إنه تحول في كيفية رؤيتنا للعالم وأنفسنا فيه. يقول تيلور ، وبالتالي سميث، إنها ليست قصة طرح بسيطة، خط مستقيم من الاعتقاد الخرافي إلى الإلحاد الناضج. تبدأ هذه الرحلة المتشابكة مع حركات الإصلاح التي فتحت الأبواب للعلمنة. على الرغم من أن الإصلاح لم يكن مسؤولاً حصريًا، فقد أدخل الإصلاح في القرن السادس عشر تحولات زلزالية، بما في ذلك إنكار الخط الصارم بين المقدس/العلماني -يمكن الآن أن يعيش كل شخص حياة بلا قيود. بالإضافة إلى ذلك، تم تفكيك الأسرار المقدسة في نوع من “إزالة السحر” من العالم. ولم تعد الحقائق الملموسة تشير إلى شيء خارج نطاقها أو تغلفه. بدلاً من احتواء الحقائق الفائقة، بدأوا في الإقامة فقط في العالم الجوهري.
يهتم سميث بتجاوز ادعاءات المعتقدات البسيطة، وبدلاً من ذلك فهم كيف غيرت الحركات التاريخية والاجتماعية والفكرية أساس ما يمكن تصديقه. الجانب الاجتماعي هو المفتاح. القصة إنسانية فوضوية، مليئة بالتعرجات ، والطوارئ، والفروق الدقيقة، والعوامل غير المنطقية. لكن توليفات “الصورة الكبيرة” هذه، بالنسبة للبعض، ستكون نقطة ضعف في المشروع بأكمله. هناك القليل في طريق الحجة الخطية والمنطقية. حيث أصبح البشر أيضًا “محصنين” من خلال عملية مماثلة من التحرر من الوهم. لم يعد يُنظر إلى الأشخاص على أنهم مساميون؛ منفتحين على قوى خارجية مثل: الحصول على النعم من خلال الأسرار، أو القصاص الإلهي على العصيان. بدلاً من ذلك، نحن الآن فرديون مع وجود منطقة عازلة حول أنفسنا. بمعنى ما، نحن نغوص في أنفسنا بعقلانية، ويصبح العقل مكان الإخلاص لله (فكر الإصلاح العقلاني)، بدلاً من تبني تجربة مجسدة أكثر اكتمالاً للحياة والإيمان.
وهكذا يصبح الدين غير مُجسد، فبدلاً من رؤية الله المتعالي أصبح إنسانًا يسكن بيننا، تبدأ المسيحية عملية الانتقال إلى واقع بلا جسد – “هروب” من الشركة والأسرار المقدسة إلى العقلانية، مطهرة من أشياء مثل الطقوس والآثار. لم يعد الله متورطًا معنا الآن. هذا الانهيار للعالم من كون معقد ومسامي إلى عالم جوهري لم يمر بسلاسة. على الرغم من أن السرد العلماني النموذجي هو قصة بسيطة من الطرح أو النضج من الأسطورة، يزعم تيلور وسميث أن هذا غير كافٍ. ولا يمكننا أن نؤمن بشيء، لذلك لم نبدأ في عدم تصديق كل شيء.
الآن، بما أن المعنى والسمو لم يعد متوفرًا للبشرية، يجب علينا توفيرهما لأنفسنا. هذا هو المكان الذي يجد المجتمع نفسه فيه اليوم: البحث عن التعالي في الجوهر. ومع ذلك، يشير سميث إلى أن هذه المحاولة لا تتحول إلى لا شيء. الأهداف والإنجازات وتحولات الحياة مسطحة وتفتقر إلى العمق والوزن. نحن نشعر بإحساس مستمر بالخسارة والضيق في الحياة العادية.
لكن تيلور ، وبتبعية سميث، لا يجادلان من أجل العودة إلى العالم المسحور. في الواقع، يشير سميث أن هذا غير ممكن. العصر العلماني مسكون، صحيح. لكن لا يمكننا أبدًا العودة ببساطة وننسى أنه كان لدينا في مرحلة ما شك. بدلاً من ذلك ، يوصي سميث بأمرين: - توسيع مساحة فاعلية البروتستانتية، مع الاعتراف بالحاجة إلى الإيمان الفكري والشراكة العلائقية مع الله.
- إعادة التقديس داخل العالم المعاصر.
ويجادل بأن العديد من أولئك الذين تحولوا إلى الإلحاد على أساس “الدليل” يفعلون ذلك في الواقع لأنهم يجدون معنى في الخيار الرومانسي: التعالي إما من خلال وسائل الفن والموسيقى ، أو القصة التي يرويها العلم و “الصورة الذاتية التي تأتي مع [تلك القصة] (العقلانية = النضج) “.
يوضح كتاب سميث الحال عندما يجيب على سؤال: ما إذا كنا نعيش في إطار علماني (“جوهري”) أم ما إذا كنا “نسكن إطار مغلق بسقف نحاسي أو إطار مفتوح مع المناور منفتحة على التعالي”. يسبر سميث أيضًا تعقيدات تيلور، مما يشير إلى أن “التوتر الظاهر بين الخيرات المخلوقة والخيرات الأبدية”. ويفضل سميث استمرارية أكثر إصلاحًا بين الطبيعة والنعمة. وينتقد استعداد تيلور “للتخلي عن جوانب التعاليم المسيحية التاريخية” بدلاً من تخيل طرق جديدة لتلبية التطلعات الروحية الحديثة. ومع ذلك ، يقيد سميث نفسه بشكل عام بتقديم أفكار تيلور بدلاً من انتقادها.
ويختتم سميث بسؤال كيف يمكن للمرء الآن أن يسكن الإطار الجوهري الذي يحيط بالغرب الحديث وساكنيه. لا يتعلق الأمر بما إذا كان: لا أحد يستطيع الهروب من إطار العمل حتى لو كان يؤمن بنظام متعالي. للأفراد خيار: إدراك أن وجهة نظرنا هي مجرد “وجهة نظر” قابلة للجدل حول العالم أو الاعتقاد بأن وجهة نظرنا “كما هي” ورفض الآخر من خلال إضفاء طابع خاص عليها -سواء كانت أصولية دينية أو “الأكاديمية” . أخيرًا، بعد اتخاذ هذا الاختيار ، يشير سميث إلى أن الدين، وخاصة المسيحية، غالبًا ما يُتهم إما بقمع ما يجعلنا بشرًا أو تجنب مشاكل الواقع من خلال الوعود المستقبلية. في إعادة التقديس، يدعونا سميث (وبالضرورة تيلور) إلى تجاوز هذا التوتر.
كتاب سميث مثير للإعجاب لأنه يأخذ مجلدًا هائلًا لتيلور ويجعله في متناول أولئك الذين لم يتعاملوا مع النسخة الأصلية. ويقدم نظرة ثاقبة للعالم الحديث، وثقافة ما بعد الحداثة، وكيف وصلنا إلى هنا، مع تقديم استراتيجيات للمستقبل. وتعتبر تعريفاته للعلمانية/ المذهب في الفصل الأول مفيدة بشكل استثنائي في تأطير ليس فقط نصه ولكن أيضًا في مساعدة القراء على وضع اللغة حول تجاربهم اليومية.
إن نقد سميث للدفاعية الحديثة مهم. يشير سميث إلى أن المؤمنين اليوم كثيرًا ما يتحدثون عن “إثبات أن الله هو الخالق” بدلاً من التركيز على عمل يسوع المسيح الخلاصي أو تشجيع التقوى والصلاة (على غرار باسكال). عند القيام بذلك، غالبًا ما ننكر الرموز في الكتاب المقدس أو الحياة، ونرفض الغموض. ولكن كما يشير سميث مرارًا وتكرارًا، لا يتم تحويل الأشخاص بالبيانات، بل يتم تحويلهم حسب الشكل والقصة. وبالتالي، فهو يوفر الفرصة للقراء للبحث عن شيء أوسع من الدفاعية في كيفية وصفهم للإيمان أو الدفاع عنه. بدلاً من التقليل من قيمة التجربة والمشاعر والسرد (سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي)، يُمنح القراء فرصة لتحديد كيفية تأثيرها على الإيمان ذي الخبرة وحتى تقديم الدفاع عنه.
يتناول سميث مشكلة الثيوديسيا أو نظرية العدالة الإلهية، التي غالبًا ما تصيب المؤمنين وتؤثر على الكرازة-(الخلاص الرباني من خلال يسوع المسيح)- أيضًا. ويشير إلى أنه نظرًا لأننا نظن أنه يمكننا معرفة كل شيء (مع ملاحظة النظرة المتفائلة للإنسانية)، فإننا نفترض بالتالي أننا يجب أن نعرف كل شيء. لا يمكن السماح لأي شيء أن يرتبط بإرادة الله الغامضة لأنه لا يوجد شيء يجب أن يكون غامضًا بالنسبة لنا. يتعلق هذا بقضية نظرية المعرفة ونظرة العالم “الناضجة” التي ترى كل شيء من خلال عدسة البيانات. يعتبر عمل سميث في هذا المجال منجم ذهب لأولئك الذين يحاولون القيام بالكرازة أو الذين يتم رعايتهم ومساعدتهم بعد معاناة أو خسارة الآخرين.
تتمثل إحدى المشكلات الأساسية في كتاب سميث كما لدى تيلور أن بعض المفاهيم في النص لا تزال غير قابلة للفهم بالنسبة للقارئ العادي، على الرغم من محاولات سميث لجعل تيلور مكثفًا وقابل للقراءة. ربما يكون هذا بسبب افتقارنا إلى تعلم نظرية المعرفة والفلسفة. ولكي نتغلب على هذه المشكلة، سيتطلب حجمًا أكبر من الصفحات يمكن أن يعالج فيه بشكل أكثر شمولًا كل مجال من مجالات الفلسفة التي يعمل من خلالها. ويرجع التحدي الثاني لفهم تيلور إلى نضالنا الفطري للتفكير خارج الاستعارة والنظرة العالمية (أو النص الفرعي) التي نعمل فيها كل يوم – وهي صعوبة يعترف بها سميث. وهذا النص الفرعي هو بالضبط ما يطلبه سميث (وتيلور) من فحصه، ومع ذلك فإنه لا يزال أصعب شيء يجب أن نبتعد عنه ونعيد النظر فيه. بعد كل شيء، ليس فقط ما نفكر فيه ولكن كيف نفكر. على الرغم من صعوبة عمل سميث في بعض النقاط الفلسفية، إلا إنه عمل مهم يسمح لنا برؤية مخطط تيلور لكيفية ولماذا جاءت ثقافتنا إلى المكان الذي هي فيه وكيف يمكن للمُتدين أن يستجيب بطريقة مؤمنة وصادقة وعملية.