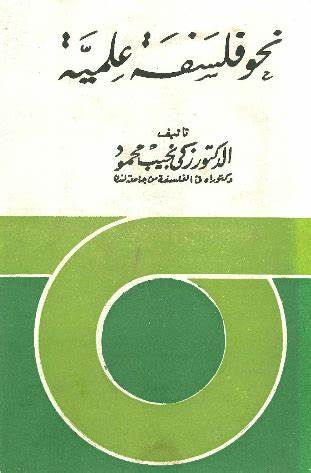قارِنْ بين عالِمَين يتحدَّثان عن «سرعة الضوء» وفیلسوفَين يتحدَّثان عن «خلود النفس»، وانظر إلى هذا الفارق الشاسع بين ذَينك وهذين في تحديد المُدرَكات التي يستخدمونها.
زكي نجيب محمود
الفيلسوف والمفكر والباحث المصري زكي نجيب محمود، أحد رواد الفلسفة في العالم العربي، ولد في عام 1950م وتوفي عام 1993م، وصفه العقاد قائلا بأنه: فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة؛ فهو مفكِّرٌ يصوغ فكره أدبًا، وأديبٌ يجعل من أدبه فلسفة.
سيتعرض المقال لكتاب من كتبه الكثيرة والغنية بما تعنيه الكلمة من معنى، كتاب ” نحو فلسفة علمية “، والذي ألفه في عام 1985م، ولكننا إذا ما تدبرنا ما يتضمنه الكتاب من أفكار سنكتشف أنها ذات الأفكار التي تتداول إلى يومنا هذا، مما يدل على أمرين، أولهما أن زكي نجيب محمود كان مفكرا مستشرفا للمستقبل ومشكلاته الفلسفية والعلمية، والثاني أن هذه الأفكار من الصعوبة بمكان أن يتم حسمها والفصل فيها، وتبقى رهينة ما يقدمها الباحثون من أدلة وبراهين على صدق قولهم.
قبل الانصراف لمضمون الكتاب سنتوقف عند العنوان وما يعنيه المؤلف بقوله ” فلسفة علمية”، إذ يسلم زكي نجيب محمود تسليما بأنه ما من شك من أن هذا العصر عصر يسوده العلم، ويعلل ذلك بأنه ما من عصر في عصور التاريخ الماضية اعتمد فيه الإنسانُ على العلم في حياته الفردية والجماعية بمثل ما يعتمد عليه اليوم ” فليس في حياته الفردية جانب من عمل أو من لهوٍ يخلو من استخدامه لهذه الآلة العلمية أو تلك، وليس في حياته الاجتماعية مشكلة لم يعد يلجأ في حلها إلى شيء من العلم قليل أو كثير “.[1]
لا يريد المؤلف بإشارته للفلسفة العلمية أن يشارك العلماء في أبحاثهم فيبحث في الضوء والكهرباء كما يبحثون، ولا أن يبحث في الحياة وفي الإنسان كما يبحثون، “فلهم وحدهم أدوات البحث في الأشياء وفي الكائنات، وليس لنا إلا ما يقولونه من تلك الأشياء والكائنات من عبارات وما يصوغونه عنها من قوانين؛ فإذا حصرنا اهتمامنا — ا في إضافة عبارات إلى عباراتهم، أو في صياغة قوانين غير قوانينهم— بل في عباراتهم نفسها وقوانينهم نفسها، نُحلِّلها من حيث هي تركیبات من رموز، لنرى إن كانت تنطوي أو لا تنطوي على فرض أو على مبدأ فنخرجه، لعلَّ إخراجه من الكُمون إلى العَلن يزيد الأمر وضوحًا، أقول إننا إذا حصرنا اهتمامنا في هذا كانت فلسفتنا علميةً بالمعنى الذي نريده لها.”[2]
إذن فليس الهدف من هذه الفلسفة مزاحمة العلم بقدر ما تكون العملية عملية تكاملية، تُعنى بتحليل قضايا العلم.
وقد قسم المؤلف الكتاب لقسمين حسب ما ذكر في المقدمة بقوله ” وقد قسمت هذا الكتاب قسمَين؛ فقسم بسطتُ في فصوله بعض الأُسس العامة التي منها تتكوَّن وجهة النظر الفلسفية التي أعتنقها وأُدافع عنها، وقسم آخر عرضتُ فيه طائفةً من مشكلات الفلسفة التقليدية عرضًا أعدت به النظر إلى ما كان يُقال فيها، ثم ماذا تصير إليه إذا ما صبَبْنا عليها ضوء التحليل الحديث”[3].
منطق جديد:
يبدأ الفصل الأول من الكتاب بعنوان فرعي هو ” منطق جديد “، ذاكرا فيه إلى أن الفلسفة ظلت لفترة طويلة مقترنة في الأذهان بأنواع من العبارات تختلف عما ألِفها الناس في حياتهم العلمية وحياتهم اليومية على السواء؛ فلا يتحرج الفيلسوف من أن يمارس تأمله “بخالص فكره هذا الكون الذي نعيش فيه، بُغية الوصول إلى «حقيقته»، غیر مُستنِد في ذلك إلى عين أو أذن، حتی إذا ما حدَس الحقيقة المنشودة حدسًا أخرجها للناس في طائفة من ألفاظ اللغة يسلكها في عبارات لغوية، كما يفعل سائر عباد الله حين ينطقون أو حين يكتبون ليصِفوا خبراتهم، إلا أن سائر عباد الله يردُّونك – إذا شئت- إلى المصادر الحسية التي استقَوا منها تلك الخبرة التي جاؤوا يصفونها في عباراتهم، أما الفيلسوف فيأبى أن يكون ذلك شأنه؛ إنه يزعم لأقواله الصدق، فإذا ما أردتَ أن تتبيَّن موضع الصدق فيها وسألته أين عساك أن ترى أو تسمع أو تلمس هذه الحقائق التي يزعمها لك مؤكِّدًا صدقها، أجابك بأنه لا يستند إلى ما يستند إليه سائر الناس لأنه ليس كهؤلاء يستمدُّ أحكامه من خبرة حواسه، بل هو «فيلسوف» من شأنه أن «يتأمل» بالفكر الخالص ما يريد أن يتَّخذه موضوعًا لتفكيره؛ ولذلك فهو يری ما يراه عن حقيقة الكون بعين بصيرته لا بعينَيه المفتوحتين في جبهته. وما دام أمره كذلك فلا يجوز لك أن تُطالبه بما تُطالب به غيره من الناس؛ لأن أداته إلى المعرفة ليست كأدواتهم. وبعبارةٍ مُوجَزة، ليست الفلسفة —عند فلاسفة التأمل— علمًا يقوم على مشاهدة وتجريب حتى تخضع لما يخضع له العلم من طرائق الإثبات.[4]
ويذكر أن الفيلسوف التأملي لا يريد أن تعرض عباراته للتحليل والتفكيك وتحليل خيوطها، واصفا إياه بأنه أقرب في تعبيره إلى لغة الشاعر منه إلى لغة العالم، ذلك أن العالم الطبيعي يرى ما يراه أولا ثم يطلق عليه اسماً يتفق عليه مع زملائه مستندا على ما شاهدها في الطبيعة من صفة معينة أو صفات ثم يختار لها مصطلحا مختصرا يدل عليها ولهذا السبب فهو على استعداد في مناقشته ويحدد لك على وجه الدقة ما تستطيع أن ترجع إليه من كائنات الطبيعة، أما الفيلسوف فشأنه غير هذا، لأنه يبدأ بلفظة معينة لم تسبقها مشاهدة ثم يتورط بها، فيطيل أو يقصر في الحديث عنها، “وليس على استعداد بأن يردَّك إلى أشياء الطبيعة المحسوسة لتلتمس بينها ما عساه أن يكون مُسمًّى لتلك اللفظة التي جعلها مدار حديثه، أو ما عساه أن يكون ناتجًا عن تعريفها؛ فالفيلسوف التأمُّلي —مثل الشاعر وعلى خلاف العالِم— يقول كلامًا مَرجعُ الصدق فيه إلى ما يدور في نفس المتكلم، لا ما يحدث على مسرح الطبيعة الخارجية من حوادث.”[5]
ويقترح المؤلف في هذا الصدد مقترحا ربما يضبط هؤلاء الشاطحين حسب تعبيره وهو ” أن يعكس «المفكِّر» طريق سيره هذا، فبدل أن يبدأ بالكلمة لينتهي إلى معناها، يبدأ بالمعنى لينتهي إلى الكلمة، وفي هذا ضمان بألا نُبقيَ بين أيدينا إلا الكلمات ذوات المعنى الحقيقي؛ فأرى اللون المُعيَّن أولًا قبل أن أقول كلمة «أحمر»، وأذوق الطعم المُعيَّن أولًا قبل أن أقول كلمة «مُر»؛ وعلى هذا القياس أنتظر حتى تأتيني حواسِّي بالعناصر التي أريد لها اسمًا، ثم أختار لها اسم «نفس»، حتى إذا ما سئلت بعد ذلك ما معنى هذه الكلمة؟ قلت: هو العناصر الفلانية التي يمكن أن تراها العين أو تسمعها الأذن، أما إذا لم يكن هنالك من هذه العناصر الحسية ما يريد التسمية كففت عن استخدام الكلمة، وإلا استخدمتها بغير مُسمًّى؛ أي بغير معنًی”.[6]
إذَن فتحدید الألفاظ الفلسفية تحديدا لا يدَع كلمةً بغير مُسمًّى مما يمكن تعقُّبه بالحواس، هو أول ما يريده المؤلف حين يطالِب بأن تكون الفلسفة «علمية» في منحاها ومنهجها، ثم يريد لها بعد ذلك أن تحصر بحثها في مشكلات جزئية مُحدَّدة؛ ” فبدل أن يُحاول الفيلسوف مُستحيلًا ببحثه عن «مبدأ» يضمُّ الكون كله بما فيه ومن فيه، يَقنع بالبحث في مفهوم واحد من مفاهيم العلم كمفهوم «السببية» مثلًا، يتعاون في تحليله مع زملائه الفلاسفة كما يتعاون العلماء في المعمل على تحليل مادة من موادِّهم؛ وبهذا يستفيد بعضهم من بعض ويُكمل بعضهم بعضًا، وتنمو المعرفة الفلسفية عن الموضوع الواحد نموًّا تدريجيًّا يجعل آخره أقرب إلى الصواب من أوله”.[7]
ثانيا أن يكون مجال الفلسفة هو التحليل والتحليل وحده، إذ يقول ” دعوانا في هذا الكتاب هي أن الفلسفة تُحسِن صُنعًا لو عرَفَت على وجه التحديد والدقة أن مجالها هو التحليل، والتحليل وحده؛ فذلك يُحقِّق لها الصفة العلمية التي نريدها لها، وبالمعنى الذي حدَّدناه في القسم الثاني من هذا الفصل؛ لأن كل جملة تركيبية يقولها فيلسوف —غیر مُستنِد في قولها إلى ملاحظة وتجرِبة كما يفعل العلماء في أقوالهم— هي من قَبيل التخمين الذي قد يضرُّ التطور العلمي وقلَّ أن ينفع”.[8]
على أن يكون التحليل تحليلا صرفا لقضايا العلم خاصة، ويعدّ هذا ضامنا لها لتساير العلم وقضاياه، فتفيد بذلك توضيح الغوامض، والتحليل الذي يدعو إليه المؤلف يجب أن يتصف ويتطبع بطابع الفلسفة التجريبية العلمية المعاصرة، ويعني بذلك الطابع الذي يتوفر عند «جورج مور» و«برتراند رسل» و«لدفج وتجنشتين» ومن لفَّ لفَّهم، وإنهم لكثيرون.
النزعَة التجريبية والمنطق الأرسطي:
يعدّ المؤلف الثورة -ليس بمعناه السياسي طبعا- قد حدثت، “كان مركزها الرئيسي جامعة كيمبردج بإنجلترا، حيث أنشأها زعيماها الأولان وهما «مور» و«رسل»، ثم تَبِعهما «وتجنشتين»، وبعد ذلك أخذ الأتباع يزدادون في القارَّة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وهم ما يزالون في ازدياد حتى يومنا هذا، لكن الثورة التي تجتثُّ كل صلة بالماضي ضربٌ من المُحال”.[9]
ورغم اجتياح إنجلترا موجة من المثالية الهيجلية في القرن التاسع عشر، حيث امتدَّت من بداية القرن إلى آخره، فمالت بأنصارها إلى الطرف الآخر؛ وتعجبوا من التجريبيين كيف يُفتِّتون المعرفة الإنسانية إلى هذه الخيوط، مع أن معرفة أي جزء على حِدة ضربٌ من المُحال في رأيهم، إلى أن جاء «برتراند رسل» “فلم يتردد في أن يُقِيم فلسفته التجريبية على أساس منطق جديد يتلافی به أوجه النقص التي كانت تؤخذ على سالفيه «لُك» و«هیوم» وأمثالهما، وما هذا الأساس المنطقي الجديد في صميمه إلا أن يجعل «القضايا الأولية» —لا المُدرَكات المُفرَدة— هي الوحدات البسيطة الأولى في تحليل المعرفة. ولم يكن «رسل» وحده في هذا الاتجاه، بل سار معه فيه زميله «مور» وتلميذه «وتجنشتين»، ثم تَبِعهم في ذلك بقية الأتباع”.[10]
وعاد لنقد المنطق الأرسطي قائلا إن المنطق الأرسطي كان تحليلًا للفكر العلمي الذي ساد أيام اليونان وما بعدها واستمر قرونًا طويلةً تضمن العصور الوسطى وما بعدها، ذلك أنها وجدت هذا المنطق أداة طيِّعة نافعة لخدمة أغراضها؛ فها هو ذا كتاب أو كتبٌ نزل بها الوحي؛ وإذَن فكل ما فيها صادق، ويمكن اتخاذ هذا العلم الصادق مقدمات لا سبيل فيها إلى الشك، فننتهي من تلك المقدمات إلى نتائجَ يقينيةٍ كذلك.
حتى طرأ على التفكير العلمي تغيُّر جوهري، وفكرة المنطق الأرسطي ” مؤدَّاها أن الوحدة الأولية لكل تفكير هي «القضية» التي لا بد أن يكون قوامها «موضوعًا» نحكم عليه بصفةٍ ما، و«محمولًا» يكون هو تلك الصفة التي ننسبها إلى الموضوع؛ فإذا ما ضمَمْنا قضيَّتَين من هاتيك القضايا الحملية بحيث تتوافر فيهما شروط خاصة، أمكن أن نستنتج منهما نتيجةً يقينية على نحوِ ما يحدث في التفكير الرياضي”[11].
وضرب المؤلف مثالا -على سبيل التوضيح وليس الحصر- يوضح به قيام المنطق الأرسطي ” على دعائم أولية يعدُّها «قوانين» للفكر لا بد من سريانها في كل عملية فكرية، وأول تلك «القوانين» قانون الذاتية، الذي يرمزون له بقولهم «أ هي أ»، وهم يريدون بذلك أن الشيء المعيَّن يحتفظ بذاتيَّته مهما تغيَّر السياق من حوله؛ فهذه المِنضَدة التي أكتب عليها هي نفسها التي كانت بالأمس، على الرغم مما قد تغيَّر من التفصيلات المحيطة بها “.
ويرد على هذا القانون بقوله: “ماذا تكون الحال إذا ما تحدَّثنا بلغة العلم الحديث، فقلنا إن هذه المِنضَدة التي تبدو للعين المجرَّدة «شيئًا واحدًا بذاته» إن هي في الحقيقة إلا كومة هائلة من الذرَّات الصغرى التي لا تنفكُّ مُتحرِّكة مُغيِّرة من أوضاع كهاربها؟ إنها وإن تكن قد حافظت على الإطار الخارجي لشكلها محافظةً نسبية، إلا أن حشوها في تغيُّر دائب لا ينقطع، إنها في حقيقتها سلسلة من «حالات» أو من «حوادث»، أفنكون على صواب إذا قلنا للعالِم الطبيعي الذرِّي «تمسَّكْ بأهداب المنطق الأرسطي، واحسب هذه المِنضَدة «شيئًا واحدًا بذاته» حتى لا تُجاوز «قانون الذاتية» لأنه قانون من قوانين الفكر»؟ كلا، إنه لو أخذ بنصحنا كان خائنًا لعلمه”.
على هذا النهج سار المؤلف في هذا القسم حتى توصل لنتيجة مفادها أنه ” هكذا تغيَّرت وجهة النظر إلى العالَم، فتغيَّرت أُسسُ العلم؛ وبالتالي وجب أن يتغيَّر منطق التفكير”.
وفي المقالة القادمة سنواصل تقديم القراءة لهذا السفر الثمين والذي لم يأخذ حقه من التمعن والتدبر والشهرة وشاعت كتب أقل منه فائدة ومنفعة.
2- نفس المرجع، ص 8.