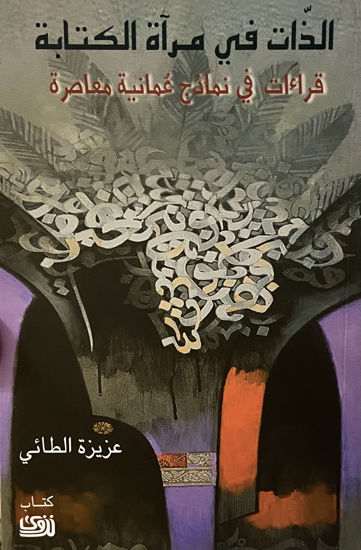“تذكُّر الأشياء التي حدثت في الماضي، لا يعني بالضرورة تذكرها كما حدثت”
مارسيل بروست
(1)
تمثل الذات مرتكزًا رئيسًا في فعل الكتابة والإبداع، بصفة عامة؛ إذ أنها البؤرة التي تنتقل منها الحالة الإبداعية لتلتحم بالأنا الأخرى ومثيلاتها لتصنع علاقة التجاور والتشابك التي تسم الفعل الإنساني، ومن ثم تسم الفعل الإبداعي المتكئ عليه والنابع منه، وبصفة خاصة عندما يكتب الكاتب ذاته فإنه يعبر عنها بتلك الحميمية التي تقترب من الصدق الواقعي المماثل لما يحدث معه، وما تجبله عليه هذه العلاقة بالذات الراصدة لكل ما حولها وما يمس وجودها من خلاله؛ فترتقي كتابات الذات تلك المكانة التي تجعل منها شهادة إنسانية على تفاصيل الواقع الذي يكمن فيما وراء الكتابة المرتبطة إلى حد بعيد بتجارب الماضي، ويحركها على أساس توثيق تلك العلاقات والتجارب، وبيان أثرها في تكوينه ومن ثم تكوين مجتمعه/ بيئته الحاضنة، وهو ما تشير إليه الباحثة “عزيزة الطائي” في كتابها “الذات في مرآة الكتابة“.. قراءات في نماذج عُمانية معاصرة، حيث تقدم له بقولها: “إن قيمة كتابات الذات لا تكمن في صدقها الواقعي إزاء الأحداث التي تسردها، ولا في أسلوبها الجمالي، بل تكمن في الشهادة الإنسانية التي تقدمها، ومن يقوم بهذه التجربة يضع نفسه في هذا الرهان“
تجارب مرحلة الطفولة.. آثارها/ انعكاساتها
ومن هذا المنطلق يبدو رهان من نوع آخر، وهو رهان النقد والبحث، على تلك الحالة حاملًا عبء تجسيد الملامح المميزة في رحلات إبداعية تتجاور معها الحالة النقدية لتؤسس لحالة من الترجمة عن الذات من ناحية، والترجمة عن الآخرين من ناحية أخرى، حيث تمثل تلك الترجمة السبيل الوحيد لتقصي الحالة الإنسانية التي يتغياها السرد وتمثل دقائقها المسيرة الحياتية التي يراهن عليها الكاتب/ المبدع من خلال عناصر تشاكله مع الواقع المحيط، والذي يمتح من تجارب طفولية ومكانية واعترافات صريحة أو مضمرة، وكما تقول الباحثة:
“فالمترجم لذاته لا يهتم بالحدث التاريخي الذي يحكي قدر اهتمامه بالذكرى التي علقت في ذاكرته، فغدت حكاياته الذاتية باعتبارها شرطًا ملازمًا لوجوده الخاص، مادة سرية خصبة لم ينضب معينها ولن ينقطع جريان سردها، فيختار نوع الكتابة التي سيعبر بها عن ذاته من خلالها نثرًا أو شعرًا”
وحيث تعرج الباحثة على معالجة “جورج غوسدورف” للأنا ضمن سياق روحي رومانسي في قوله أن: “السيرة الذاتية جنس أدبي رومانسي بتشديده في الآن نفسه على الذات المبدعة وعلى الخطاب الشفهي” ووصفه كتابات الذات على أنها تمارين الذات في شكل كتابة، وهو ما يرتبط بالبوح أو ربما العلاج النفسي الشارح والمقوم لمرحلة عمرية موغلة في القدم، وفي وعي الذات الساردة، وهي بلا شك فلسفة مرتبطة بالملمح المعنوي المتواري خلف تلك الكتابة المتسقة إلى حد بعيد مع أدبيات السيرة الذاتية والرواية معًا في تداخلهما في الخصائص التي تتشبع بها الكتابة في نواح، وافتراقهما في نواح أخرى تقنية أو فنية تميز بينهما وتجعل لكل منهما ميزته وتوجهه في الخطاب السردي..
فيما ترى الباحثة في معالجة “فيليب لوجون” لموضوعة السيرة الذاتية على أنها: “حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلى تاريخ شخصيته” وهو مما يعمل على بيان الفارق بين العمل الروائي القائم على تناول حياة شخوص في حالة اشتباك وتداخل واندماج وانزياح مع حبكة سردية قادرة على الربط بين تلك العناصر المتشعبة، ربما دون تطابق واقعي، وبين ما تقدمه رواية السيرة الذاتية من شرطية تطابق بين المؤلف/ الراوي/ الشخصية التي تقوم عليها حالة البوح والتسجيل، ربما لحدوث ما أسمته الباحثة “ميثاق السيرة الذاتية”، والذي يختلف عن الميثاق التخييلي/ الروائي، وكما استندت إلى ما قاله “جورج ماي” أن “السيرة الذاتية قد استثمرت أساليب السرد التي أشاعتها الرواية، ولكن الرواية قد استثمرت بدرجة واضحة السرد المباشر الذي يعتمد على ضمير المتكلم في السيرة الذاتية”
وهو ربما كان المفهوم الذي ينطلق منه اختيار الباحثة لنماذجها السردية في ترجمة الذات استنادًا إلى رؤيتها المتكئة إلى ذلك الكم/ الرصيد المتواجد من المحاولات التي ارتبطت بالسرد الذاتي والإبداع السيري ومن خلال التنظيرات التي سبقت وواكبت تلك الحركة السردية، فهي تلج عبر هذا الكم المتراكم إلى رصيد حقيقي آخر يمثل السرد العماني الذي توافر على أسماء بارزة استطاعت أن تقتحم هذا الحقل السردي بآلياته وجمالياته وعمقه في البعدين النفسي/ الذاتي، والاجتماعي/ العام، لتشكل هذه النصوص بؤرة معبرة عن اتجاه من اتجاهات الكتابة السردية في عمان، حيث تبرز هذا المقطع العام على خلفية غلاف كتابها:
“أخذت ترجمة الذات في الكتابة مساحة إبداعية جديدة لها حضور متنوع الكتابات في عُمان خلال الألفية الجديدة، وهي سائرة يوما بعد يوم إلى التشكل والتنوع من جهة، وإلى التطور والنضج من جهة أخرى بفضل ما يتحقق لها من روافد كتابية حديثة، فهي على ذلك جديرة بالدرس والاستقراء لكونها تندرج ضمن المنظومة الإبداعية السردية فحسب، بل كونها تعبر عن قضايا الإنسان العماني في شفافيتها المرتبطة عضويا بالتعرية عن الشخصية الحميمة وهو ما يؤهل مقام الذات الكاتبة لتكون الموقع الفاعل الذي يرصد خصوصيات منظور الإنسان العماني في صياغة الرؤيتين الذاتية والموضوعية (الأنا)”
وهو مما تؤكده الباحثة على ارتباط المدونة السردية العمانية بتلك الحالة الفريدة من كتابة السيرة التي لا تقف عند حدود الذات فقط، بل تتخطاها نحو الأسرة/ المجتمع الصغير، ثم المجتمع بكل فئاته، ثم البيئة الحاضنة بشكل عالم وهي الوطن وما يمر به من أحداث وتغيرات وتحولات ربما نبتت من وعي طفولة الشخصية الساردة ليكون السرد بلسانها وعنها من خلال المكان ودواله وعلاماته الدالة وارتباط كل ذلك بالزمن الذي يمثل مروره وتراكمه، تكوين التاريخ الخاص بتلك الأماكن الأثيرة المحفورة في وعي السارد الذاتي، والمسرود عنهم بخلفيات ثقافية وجغرافية ونفسية وتاريخية عميقة لا ينمحي أثرها النفسي والوجداني والمعرفي من خلال الموروث الذي يظاهر هذه الحالات المتوهجة من الكتابة.
(2)
“الطفولة وذاكرة المكان”
يمثل ارتباط الطفولة بملامح المكان ملمحا مائزًا من الملامح التي تؤكد عليها الباحثة في مبحثها التوثيقي والتحليلي لتلك الظاهرة الكتابية/ كتابة السيرة الذاتية، وإشكالية السيرذاتي، والعلاقة بين التخييلي الذي قد يلجأ إليه الكاتب لتضفير سرده بالواقعي من جهة، والواقعي الذي يريد فرض هيمنة حضوره كشاهد وموثق للحياة/ الوجود مجسدًا لسيرة المكان من خلال هذا الوعي الطفولي الزخم بالصور والأحداث المختزنة في ذهنه المتيقظ؛ حيث تورد الباحثة نموذجًا سرديًا عُمانيًا مائزًا بارتباطه بالذات والمكان معًا، هو نص “حياة أقصر من عمر وردة” لعبد الله البلوشي، والذي جاء بضمير المتكلم، ودون الإعلان عن هوية صاحب الضمير، لتكون الشخصية المجردة في المطلق الذاتي الذي يمثل الجميع، مع الارتباط بالمكان/ البيئة الحاضنة المشكلة للوعي الإنساني الإدراكي لما حوله؛ على الرغم من أن التماهي بين المؤلف والمكان لا يفرض تحديدًا للهوية الإبداعية، ولا للهوية الجسدية فحسب، ولكنه – بحسب الدراسة – يقودنا إلى المعرفة الحقيقية لاستيعاب الفضاء العام للمكان، مع إبراز ذكريات مرحلة الطفولة بما تحمله من تجارب قاسية لها أبعادها النفسية والأسرية/ الاجتماعية.. ربما تمثلت في المرض، والأساليب البدائية التي تحمل موروثًا للمكان/ البيئة، مع توثيق الحالة الخاصة جدًا، بعيدًا عن الحالة العامة التي ربما ميَّزت المكان تاريخيًا/ توثيقيًا؛ فالإبحار في الذات هنا هو المحك الرئيس الذي تستد إليه المحكيات والمرويات، ومن ثم المعالجة الفنية لهذا النص الذي يدخل في سياق ومضمون محكي طفولي خالص تدعمه الذاكرة الطفولية، ويدعمها بوجوده الإبداعي المائز.
“هذا المشروع هو محكى طفولي يتكلم فيه المؤلف عن هويته الشخصية، ويفضل عدم البوح بأناته التي تمثل هويته، لذلك فالسيرذاتي جاء مُقنَّعَا ومَخفيًّا، والقارئ وحده يستطيع اعتمادًا على قرائن خارجية أن يعقد الصلة بين هوية الكاتب وهوية الراوي غير المحددة“
هنا تبدو الكتابة على أنها “تمارين الذات” – كما أشار فيليب لوجون – في الوقت ذاته الذي تبدو فيه كسمة من سمات الكتابة الروائية الإشارية التي تشير إلى المضمون دون الإفصاح به، ربما بحثًا عن قارئ يستقرئ كل الدلالات التي يبثها الكاتب كي يستنطق العمل الأدبي ويقرن بينه وبين السارد السيرذاتي نفسه لبيان مصداقية ما يربطه به؛ فالعلاقة التي تثيرها الباحثة في هذا الموضع، هي علاقة تأسيسية مرتبطة بالهُوية الذاتية التي تضطلع إلى إقامة مشروع تواصلها مع العالم الخارجي بقرائنه الدالة عن انفصامها عن هذا الواقع واتجاهها للداخل/ الذات بديلًا عن مد جسور التواصل مع الآخر/ البيئة/ المجتمع الذي لم يكن حاضنًا جيدًا لتلك الذات، وهي من الإشكالات النفسية التي تطرح ذاتها دومًا في دهاليز عالم الكتابة بشكل عام، وتسهم في ظهور ظاهرة الانعزال التي لولاها ما كان هناك هذا البوح السيري المرتبط بكل تلك العناصر المحيطة بالسارد/ الذات/ المؤلف، وعلاقته المبتغاة مع متلق يستطيع التحاور معه بربط القرائن والأدلة، وصناعة التواصل المفتقد نفسيًا وعضويًا..
ومن ثم فهي القضية التي يعتمدها ويثيرها السارد/ الكاتب من خلال التشكيل الذاتي بالتوقف عند مرحلة الطفولة ومواقفها المحددة من العالم حولها، ليطرحها بوعي حساس وقادر على توظيف الدلالات التي يطرحها في متن نصه السردي، حيث تقول الباحثة:
“والكتابة عند عبد الله البلوشي – كما برزت في هذا النص – فلسفة الانعزال المؤقت عن العالم طلبا لفهمه وتأويله وخروجًا من الذات المنفعلة كما يجسدها عادة (أنا) المتكلم، إلى الذات المعاينة، أو الموضوع كما تنعكس في ضمير المفرد الغائب“
حيث تبدو فنيات الكتابة على وعي تام بالمدلولات التي تضعها كمفاتيح لتلك الشخصية التي تمر بعدة مراحل منطلقة من الطاقة الانفعالية للتعبير عن الأزمة مع الواقع، والتي ربما خرجت بعد فترة إلى التعامل مع الضمير الغائب الذي ربما جسد صورًا محايدة بعيدًا عن تلك الحالة من الانفعال، واتساقًا مع حركة زمانية تعمل الكتابة على تقسيمها وتعاقبها، خضوعا لمفهوم الأطوار الزمنية التي تمثل – بحسب الباحثة – المراحل العمرية المتباينة زمنيًا فيما بين: الميلاد، والطفولة، والصبا، ومن ثم بدايات الشباب.. تلك التي تأخذ خطًا أفقيًا مستقيمًا يعتمد التسلسل الزمني، مع رصد التغيرات في الثابت وهو المكان، ومدى حدوث التحولات فيه من وجهة نظر الشخصية التي تنمو في طورها الزمني، حيث تقول الباحثة:
“هكذا يختلط الزمن بالمكان والشخصية على نحو بالغ التكثيف والازدهار والصيرورة، فالشخصية تتجلى بمنطق تأليف كتابي يتدخل فيه التخييلي بالمرجعي على نحو خصب، ولا يمكن للقارئ بإزاء هذا التداخل من فصل الفضاء التخييلي عن الفضاء السيرذاتي، لأن طبيعة التشكيل الكتابي تقوم عليه”
تبرز الباحثة هنا أهمية المزج بين السرد التخييلي والحكي المرجعي في إزكاء حركة الكتابة وإثارتها للمضامين الخفية التي يكنها السارد – الذي يتحول في أوقات أخرى إلى مسرود عنه لأسباب وجدانية ونفسية يبتعد بها السارد بضمير الأنا ليتحمل السارد بضمير الغائب ربما لإلقاء التبعة بعيدًا عن الحمولة النفسية الذاتية، فضلًا عن ولوجها في مضامين ودلالات النص الفنية التي يلعب عليها الكاتب جيدًا من حيث تبرز أهمية النمو الجسدي للشخصية والوعي بها واستكشافها، وهو ما تقوم الحالة السردية برصده من خلال هذا الإحساس الذي يعكس أيضا أثر حركة الزمن والتفاوت بين المراحل العمرية التي يتشكل فيها البنيان مع الوجدان ويرتبطان معا بهذه الوشيجة النفسية، مع حضور التجليات البصرية والتصوير والتشخيص وفكرة الالتقاط التصويري للوحدات المكانية المنتقاة، نظرًا لهذا النمو الإدراكي الطفل للمكان بشخوصه ودواله؛ وبحيث تصنع الكاميرا (العدسة الداخلية الذهنية) الراصدة للطفل كل تلك البانوراما المعانقة للذات في حيز المكان ومستوياته، وكلها من آليات الكتابة السردية الروائية، لتؤكد الباحثة أن:
“نص حياة أقصر من عمر وردة في أنموذجه لا يستوي على حال أجناسي معين، ولا يخضع لرؤية كتابة محددة، إذ أعطى المؤلف/ الراوي/ الشخصية لنفسه كل الحرية في الكتابة والتنقل والاستعادة والاستشراف والحلم والذكرى، داخل سرد مشحون بالبؤر بعنوان مكتظ بسحر الطفل، وقد سلط عليه كاميرا ذات عدسات عنيفة في تصويرها تصور الذكرى والحلم معا”
تلك الشهادة البحثية على نص تجاوز التجنيس الأدبي – في نظر الباحثة – التي ارتأت من الفضاء الكتابي المفتوح/ المطلق كملمح من ملامح الكتابة السيرذاتية التي تتهجى أبجدية الذات ووجودها في هذا الحيز المكاني المرتبط بالزمن ومروره وتحولات المكان من خلاله ربما على صورة ما من الصور مع الانغلاق النفسي للذات وتجذرها وتشظيها، خير معبر عن تلك الحالة الإنسانية المتفجرة من ينابيع الطفولة المحفورة في الذات الإنسانية المغامرة بطبعها على مستوى تفريغ ما تدركه وتشعر به ليكون تجربة إنسانية تستحق التسجيل والتوثيق، وكإبداع يستحق المغامرة والمقامرة، ومن ثم البحث وإعادة سبر الغور ربما لاكتشاف الذات من جديد، وربما لتكون الكتابة الذاتية خط الدفاع الأول عن مقدرات السارد/ الإنسان القادر على ذلك، تحت ضغط عبء نفسي يريد التخلص منه، وإن كان بجعله قطعة أدبية تحاكي الواقع وتحاكمه في نفس الآن، واختلاطا بين الحلم والواقع والتي ربما انتصر فيها الحلم – على مستوى الإدراك والتخييل – على مادية الواقع وجموديته.
(3)
ملامح الطفولة، وتحولات الزمن داخل المكان
كما تلج الباحثة في نموذج آخر يعانق مرحلة الطفولة وفضاء المكان، هو: “مقنيات، وطن وطفولة” للكاتب العُماني “عادل الكلباني” الذي تمهد له الدراسة بقولها أنه يسجل شهادته لطفولته على قدر من الحميمية للمكان، نافذًا إلى أعماق قريته “مقنيات” التي تمثل المكان المختار بامتياز، وأيضًا من خلال معاناة طفل مصاب بشلل الأطفال، وتحدد الفترة الزمنية ارتباطا بتاريخ عمان، مع الخوض في تفاصيل المكان/ القرية العمانية تحديدًا وتوثيقًا، وما تحمله من موروث تكاد تنعدم منه ملامح التطور، وتقول عنها: “إنها شهادة بها من التراكم والذكريات والتفصيلات بأسلوب يتلاءم مع تشكل الحياة”
كما تقول عن سمات هذه الكتابة أنها تأتي في سياق مبحث السيرة الذاتية القائمة على المصارحة والمكاشفة والمخاطرة بالاعتراف، اعتمادًا على أن تلك الصراحة “تتعارض في كثير من تجلياتها مع الخطاب الاجتماعي القائم على الكتمان وضرورة الاستتار“ما يكشف بالتوازي عن سمات المسكوت عنه الذي يرعى في هذه البيئة الاجتماعية التي يمثلها المكان، وتواجهها الكتابة السيرية المتحررة من القيود لتكشف ستر هذا المسكوت عنه بفعل التكتم وربما العادات والتقاليد الضاربة في جذور المجتمع.
تعرج الباحثة على العتبات النصية كتقنية سردية تمثل استهلالات الكتابة لتمثل الولع باستعادة المكان بكل جغرافيته وثقافته التاريخية وموروثه الشعبي، وشخوصه المؤثرين، وهو مما يميز الترجمة الذاتية، وتبدأ العتبات النصية – بحسب الباحثة – بالغلاف الذي يتصدره صورة حافظة للمكان في قرية الطفولة “مقنيات”، وهو ملمح شكلاني، ويبدو فيه الحصن شامخًا، والشخوص متمسكين بهويتهم التراثية من مظهر ولباس، وتحيط بهم كل مظاهر الطبيعة التي تميز المكان وتنتمي إليه في بيئة صحراوية جافة، ليمثل هذا الارتباط العضوي الذي تسبغه البيئة على الجو العام..
كما يلجأ الكاتب إلى الاقتباس في عتبة تالية ليبرز شخصية تاريخية من تلك الذاكرة التي يحملها المكان، ثم الإهداء الذي تقول عنه الباحثة: “يقودنا فيه المؤلف إلى جمال التعايش وجلال الانتماء للمكان “مقنيات” وناسه، فهو يهدي العمل إلى جدته ووالدته، وإلى الطيبين الذين عايشهم في سنوات الطفولة والبساطة، والزمن الجميل“
حيث تبدو من الإهداء حميمية العلاقة بين العنصر الأنثوي في حياة السارد عن ذاته، وهو مما يدل على خشونة الحياة وافتقارها إلى العديد من عناصر الأمان والائتناس، حيث تمثل الأنثى في الضمير الإنساني بصفة عامة منبعًا للحنان والاستقرار النفسي الذي تبتغيه الذات، في مقابل قسوة الواقع وما يفرزه من آلام ودواع لها، وهي العلامات التي تهتدي بها ذاكرة الطفل في احتوائه النفسي لذاكرة المكان وتضاريسه فهو يجنح فيما يجنح هنا إلى الروحانيات والعلاقات الوجدانية التي كانت تربطه بالعنصر الإنساني بالمكان.
في حين تأتي العتبة الرابعة، وهي الملحق التوثيقي الذي يحوي صورًا حقيقية استمد منها الكاتب كل هذه الحكايات والذكريات والمرويات وهي تتطابق مع صدق الانفعال والمعاناة والتوثيق.. حيث تعد كل تلك العتبات ملمحًا من ملامح التقنية في الكتابة كتابة الذات تحديدًا، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه فيليب لوجون “ميثاق السيرذاتي” من أن المترجم لذاته بمقدار جرأته في البوح، وشفافيته عند الاعتراف فإنه يتعاقد مع القارئ ليقدم له أمرين في غاية الأهمية، هما: “الأول الإدلاء بالذكريات الخاصة التي أسهمت في تشكيله الوجداني والنفسي والفكري بالاقتراب من التجارب الحساسة التي يتحفظ البوح عنها، الثاني: أنه يسعى بوعي وقصدية إلى رسم معالم الذات وبناء معالمها وشخصيتها المتفردة“
كما تعرج الباحثة على ما أسمته “مدارات الذاكرة”، والتي تتسع وتتوغل لتشمل العديد من المناطق المثيرة للذكرى ومحاولة التذكر معًا، فالمحفور في الذاكرة يضفي على المشهد الكثير من الأشجان والهموم مع الارتباط النفسي الحميم لتلك المرحلة من الطفولة التي يصعب نسيان تفاصيلها أو محاولة محوه من الذاكرة، والتي تشكل أيضًا علاقته بالعالم الخارجي/ خارج الذات، وهو الفضاء المجتمعي الزاخر بشخوصه، المتباينة فيما بين القرب والبعد من تلك الشخصية الطفولية الساردة بوعي الطفل، ووعي السارد/ الكاتب:
“وإذا كان المؤلف قد وظَّف أجزاءً من حياته في نوع من التوازن مع العالم الخارجي عبر استحضار الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في عُمان في فترة السبعينيات وحتى الثمانينيات، فإن قراءة النص تفسح المجال أكثر لتفاصيل الطفولة وفضاءاتها، وتلتقط ملامح المكان بمسمياته في الملحق“
ثم تعرج الباحثة على تحولات الزمن داخل المكان، فتقول في معرض حديثها عن تلك العلاقة التي تؤثر أيما تأثير في البنية السردية التي تحمل النص السردي وتقومه لتسييره في اتجاهه الديناميكي الصحيح، دون عرقلة للوعي النفسي والحسي لهذا السارد الذي ربما لم يحافظ على الترتيب الزمني لحكيه/ بوحه لكنه كما يقول “لوجون” يحافظ على رسم معادلة الذات واتزانها وبناء معالمها، وملامح شخصيته التي يخالها متفردة ومنفردة بحق السرد والحكي وانتقاء الفترة الزمنية التي قد تسبق أخرى أو تتخلف عنها في ميثاقه الخاص مع الحكي، لدواع نفسية ووجدانية من الممكن تواجدها بقوة لها تأثيرها على مسارات الكتابة.
“في هذا النص يتجلى الفضاء المكان والزماني وكأنهما فضاءان متلازمان متداخلان لا فرق بينهما، فيبرز التمرد الطفولي بفضوله وشقاوته وبراءته وعذاباته“
فهنا يلتحم الفضاءان: الزماني والمكاني لصنع هذه المتاهة السردية المقصودة والتي ينزع إليها الكاتب/ السارد للتأكيد على الحالة النفسية أو الرؤية التي تنتابه حال الكتابة/ السرد، وهو عنصر لا يمكن إغفاله في لعبة السرد بشكل عام، وهي التأسيس أيضًا الذي يتكئ على البناء المعماري للنص الذي يركن الكاتب ويعتمد على تقسيمه إلى إحدى عشرة مجزوءة كل منها يحمل عنوانًا يشي بتشظي الذات وانعزالها، ومع توالي المقاطع داخل المجزوءات (حسب أهميتها في ذكره، وهي السمة التي أشرنا إليه) يحضر في كل مجزوءة للمكان حضور قوي فيها، وذلك بالتعالق بين طبيعة المكان وكائناته المميزة، ما إلى ذلك من التعالقات النفسية والوجدانية التي ترتبط بكل جزء سواء من الحكاية المروية أو المسرودة على نحو خاص يتعلق بتقنيات الكتابة:
“كما تتسع الحكايات في النص، ويتعقد معها الصراع من خلال دلالات متعددة من دون أن تلح على واحدة منها، ذلك أن العلامات والكلمات المولدة للدلالة تنطوي على التعارض والمفارقة، وتقدم أكثر من وجهة نظر عبر هوية سردية ذاتية مركبة بين ضمير الغائب العليم، وضمير المتكلم المبرأ، واللوحات المرسومة، والمشاهد المعروضة من خلف عين الرائي لكاميراته والحوارات الداخلية المنقولة“
حيث تبدو هنا جليًا التقنيات السردية التي استند عليها الكاتب قي ترجمته لذاته، تلك الترجمة المبدعة التي تعاملت مع تقنيات الكتابة بوعي – بحسب ما أوردته الباحثة وأكدت عليه – وهو الدخول في متاهة الضمائر السردية والصراع المرير بينها لإبراز كل السمات والتحولات التي اكتنفت النص الإنساني بترتيب أحداثه ترتيبًا فنيًا منطقيًا، لكنه ربما اختلف عن الترتيب الزمني والسردي لما كان يجري على أرض الواقع، أو انحيازًا إلى ذاكرة نفسية تقصي وتدني ما تشاء، وتقنع نفسها/ قارئها بهذه التراتبية العجيبة التي يلعب الفن فيها دورًا بالغ الإثارة والتمكن من القيمة التي يطرحها الفكر هنا.. لتسجل الباحثة شهادتها عن النص:
“تبرز أهمية هذه السردية بما قدمته لنا كقراء من ذاكرة المكان العماني وتحولاته بين الماضي والحاضر اجتماعيا وثقافيا وفكريا وتاريخيا وجغرافيا، فمقنيات وطن وطفولة من هذا المنطلق، هي وثيقة تاريخية وجغرافية وسيرة الصراع ضد الفقر والمرض والجهل والبؤس كما هي سيرة البحث عن العلم والعدالة وتحقيق الوجود“
لتمثل هذه الشهادة البحثية، والناتجة عن تحليل عميق لتلك الملامح السردية التي قدمتها الباحثة في نموذجيها نتيجة من النتائج المهمة التي تخرج بها الباحثة، حيث الكتابة السير ذاتية تمثل توثيقا تاريخيا وجغرافيا واجتماعيا، وكغاية من غايات الوصول إلى سبر الغور ومن ثم العلم وتحقيق الوجود، كقطع أدبية بديعية تعبر عن الإنسان في لحظاته الصعبة مع الوجود حيث تأكيد الهوية والارتباط بعنصري المكان والزمان اللذين يمثلان جغرافية الوطن وتاريخه وموروثه الثري في كل أحواله..