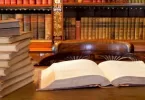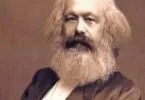أن نعيش في المجتمع معناه، على الأقل بالنسبة إلينا نحن البشر، اللجوء إلى أشباهنا بغية تحسين حياتنا الفردية. هذا التحسين يكتسي أشكالا متعددة ويمكن أن يكون صعب الإدراك. ولا يتعلق الأمر فقط بخدمات يؤديها الآخرون لنا، فمجرد المرافقة يمكن أن تكون مصدرا للرضى والطمأنينة. عندما نرى شيئا جميلا، نحب أن يكون بجوارنا أحد لاقتسام إحساسنا ونشعر بأنه يشارك في فرحتنا. بهذا التقديم بدأ إريرك بويسنس حديثه عن موضوع الفعل السيميائي.
يرى إيريك أنه لكسب مشاركة الآخرين، ينبغي طبعا أن نعرّف بم يجري في داخلنا، لنقُل في حالة وعينا. لكن حالة وعينا لا يمكن أن يدركها أي فرد آخر وليس هناك أية وسيلة لنقلها إليه. غير أن السلوك الإنساني يسمح لنا، بواسطة الاستدلال أي داخل وعينا الذاتي، بإعادة تكوين جزء مما يدور في وعي شخص آخر. مثلا- يضيف إيريك- إذا رأيت طفلا ينتصب على أصابع رجليه ويمد يده نحو شيء ليس في متناوله. أتذكر بأنني قمت بالفعل نفسه: وبما أنني كنت أقوم به لأخذ الشيء، أستنتج بأن الطفل له الرغبة نفسها. عندما يحرك الكلب ذيله وعندما يموء القط نقول بأنها فرحان لأننا نلاحظ بأنهما يتصرفان هكذا كلما أرضيناها.
ومن هنا، يرى إيريك أنه قد نتج عن هذا التأويل للظواهر فكرة وجود نقلة نوعية؛ فأغلب تصرفات الإنسان والحيوان على السواء مرتبطة فعلا بحالات نفسية، وذلك بكيفية طبيعية ومنتظمة إلى درجة أن الحدث المحسوس- حركة، إيمائية- موقف- يسمح لمن يعاينه بأن يرى فيه تجليا لحالة نفسة. غير أن هذه اللغة الطبيعية لا يمكن تشبيهها بالكلام لأنها تفتقد لخاصية أساسية: فالطفل والكلب الذين والقط الذين وصفناهم آنفا لا يفكرون البتة في إظهار حالة وعيهم، ولا يريدون أن يُؤول الناظر سلوكهم لتنتج عن ذلك مشاركة ما: إنهم يتواصلون. ما يٌزعم أنه لغة طبيعية هو إمكانية لتحديد الحالة النفسية لفرد آخر من خلال تجليات هذه الحالة: فهو مؤشر.
هنا يعلق إيريك قائلا “ما نسميه هنا بالفهم أو التأويل هو الرجوع إلى أصل وسبب ما نلاحظه. ومنهج من هذا القبيل هو اساس التشخيص الطبي، ويسمى في هذه الحالة السيمولوجيا. هكذا، نقوم بتأويل عدد من الظواهر… عندما يهرع الناس صوب سيارة متوقفة، نفهم بأن حادثة وقعت. هناك لغة طبيعية، فالظواهر تكلمنا لأن لها دلالة. لكن عندما نقول هذا نستعمل استعارة خطيرة: فالظواهر لا تتواصل معنا. فالرجل الذي يرتعد خوفا لا يريد أن يظهر لنا خوفه: قد يرتعد ولو كان وحده”.1
وعلى هذا يؤكد إيريك أنه ينبغي الحضر من إعطاء إجراء تواصلي دلالة أكثر مما يتضمنها. على سبيل المثال، إذا سمع الزوج، وهو يتأهب للخروج، زوجته تقول له: “المطر يهطل” سيعرف أنها ترغب في أن يأخذ مظلته أو معطفه. لكن هذا التمني لا يشكل جزءا من دلالة الجملة المنطوقة. يقول إيريك “تقتصر هذه الجملة على التعريف بحدث هو المطر. وتترك الزوجة الحرية لزوجها في أن يختار السلوك المناسب له. وما يسمح لنا بالقول بأن جملة “المطر يهطل” لا تعني “خذ معطفك” هو بالضبط كونها قابلة للاستعمال في حالات مختلفة كهذه: إذ تنحصر الدلالة فيما هو مشترك بين هذه الحالات، أي أن المطر يهطل. أما النية غير المعلن عنها (خذ مظلتك – خذ معطفك) فلا تظهر إلا إذا أخذنا في الاعتبار السبب الذي جعل المرأة التقول بأن المطر يهطل؛ لكن دراسة الأسباب التي تجعلنا نقول هذا بدلا من ذاك أو نكست عوض أن نتكلم لا تتعلق باللسانيات”.2 لكن السؤال هل يمكن إقصاء الاعتبارات الدلالية من اللسانيات بسبب عدم قابليتها للملاحظة؟
للإجابة، يستحضر إيريك ما كتبه ليونارد بلومفيلد سنة 1933 في كتابه “اللغة” حيث لاحظ بأن السيرورات النفسية غير قابلة للملاحظة، فرفض أن يأخذها في الاعتبار “الأمر البديهي الوحيد فيما يخض هذه السيرورات الذهنية هو السيرورة اللغوية، إنها لا تضيف شيئا إلى النقاش، بل تُعتمه”. هذا الموقف علق عليه إيريك بالقول “ليس صحيحا أننا لا نعرف السيرورات النفسية إلا من خلال اللغة: فكل الوسائل السيمائية الأخرى تُعرفنا بذلك أيضا، ينضاف إليها سلوك الفرد بأجمعه”.3
يخلص هنا إيريك، إلى الثوة التي أحدثها علماء الصوتيات تكمن تحديد في إدخال الدلالة بكيفية رسمية إلى علم الأصوات: تدرس الفونولوجيا النطق بصفته وسيلة اجتماعية للتواصل؛ ولاستخراج الفونيمات، تقارن بين الدوال أي بين أشكال مرتبطة بمدلولات. وقد اعتُقد في الماضي أن الآلة هي أساس هذه الدراسة، ومع علماء الصوتيات أصبحت الدلالة مقياس كل شيء لساني.
وقد اعتبر إيريك أن المشكل الحقيقي هو استنباط الدلالة من الوضعية الاجتماعية. “إن الأمر سهل في جملة مثل تُحضر أمك الطعام: يكفي أن نرى ما يجري؛ لكن جملة ستحضر أمك الطعام لا تتعلق بأي نشاط متصل بالوضعية الاجتماعية التي نُطقت فيها هذه الجملة. ينبغي إذًا أن ننكب على مقارنات بين عدة وضعيات”.4
يذكر إيريك، صحيح أننا لا نستطيع إدراك الدلالة إلا بمساعدة الأشكال سواء كانت لسانية أو غير لسانية، لكننا ندركها. مثل، يمكن أن نسأل فرنسيا: ما معنى جملة كيف أنت؟ وسيجيب بجملة: كيف حالك؟ أو ما هي حالتك الصحية؟ ويمكن كذلك أن تظهر له لوحة الإشارة الطرقية ونسأله عن معناها وسيجيب بأنها تفيد منع الوقوف. إن إثبات التكافؤ بهذه الكيفية بين جملتين أو بين لوحة الإشارة وعبارة لغوية يسمح لنا بالوصول إلى الدلالة.
صحيح أن الوضعية الاجتماعية- في نظر إيريك – في نظر لا تسمح لنا إلا بصياغة افتراض، وأحيانا يكون من الصعب تحيد نصيب الدلالة الذي يؤديه هذا الجزء من السيمياء وهذا الجزء من الجملة؛ لكن الإرسالية في كليتها تكون واضحة على العموم.
أخيرا وليس آخرا، يمكن القول مع إيريك إن الدلالة هي التأثير الذي نريد إحداثه باللجوء إلى وسيلة عرفية؛ إنها ظاهرة اجتماعية، وهذا هو بالتحديد ما يسمح لنا بأن نَعْرفها أحسن بكثير من الفكر الفردي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- السيمولوجيا والتواصل، إريرك بويسنس، ترجمة وتقديم: جواد بنيس، الناشر دار رؤية القاهرة، ط2، 2017، ص: 30.
2- السيمولوجيا والتواصل، إريرك بويسنس، مرجع سابق، ص: 36
3- نفسه، ص: 46
4- السيمولوجيا والتواصل، إريرك بويسنس، مرجع سابق، ص:47