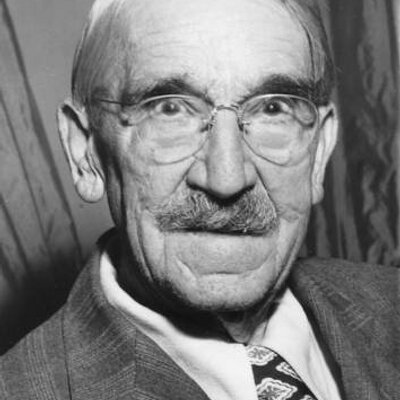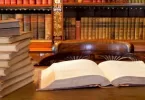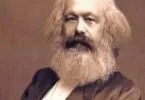ذة بورجا مريم
ليست الأخلاق عبارة عن كتالوج أو قائمة بالأفعال والقواعد التي يمكن تطبيقها مثل وصفات الأدوية ووصفات الأطعمة في كب الطبخ. تحتاج الأخلاق إلى مناهج بحث وإلى التدبر والابتكار. يتم بمناهج البحث تحديد مواضع الصعوبات وأماكن الشر. وتحال عملية الابتكار تشكيل الخطط التي يتم استخدامها كفروض عاملة لمعالجة هذه الصعوبات. ويهدف المعنى البراجماتي من منطق الحالات الفردية أو لكل مقف علاجه الخاص به تحويل انتباه النظرية الخلقية من الانشغال بالمفاهيم العامة المسبقة إلى الانشغال بمشكلة تطوير مناهج البحث المفيدة والمؤثرة.
هنا يجب الالتفات إلى نتيجتين أخلاقيتين في منتهى الأهمية. لقد أدى الاعتقاد في “القيم” الثابتة إلى قسمة الغايات إلى “جوهرية” و “أداتية”، غايات لها قيما في ذاتها، وأخرى لا تتمثل قيمتها إلا في أنها عبارة عن أداة لتحقيق الفضائل الأساسية. حقيقة يُعتقد دائما أن هذه التفرقة تمثل بداية الحكمة الخلقية وأن التفرقة من الناحية الجدلية شيئا مفيدا، إلا أنها حين يتم تطبيقها في الواقع العملي تؤدي إلى مأساة حقيقية. لقد كانت من الناحية التاريخية مصدرا لفصل دائم بين الفضائل المثالية والمصالح والاهتمامات المادية. ولئن أدرك الليبراليون الأشياء الخيرة الجوهرية باعتبارها ذات طبيعة جمالية وليس دينية أو تأملية خالصة إلا أن النتيجة واحدة.
لقد استند أرسطو على هذه التفرقة لاعتبار “العبيد” طبقة عاملة لا يُعدون من المواطنين بالرغم من أهمية وجودهم لقيام الدولة. ليسوا جزءا منها ولا يشاركون في حكمها. لا يمكن لمن يُنظر له كأداة أو يقوم بعمل شاق أن يستحق أي قيمة فنية أو فكرية أو خلقية. يفقد كل شيء قيمته إذا قلت جوهريته أو قيمته الذاتية. هكذا اختار أصحاب الاهتمامات “المثالية طريقة الإهمال والهروب. وعدم إبراز الغايات الدنيا وأهميتها باعتبارها غير أخلاقية أو نسبها إلى فئة متدنية من البشر حتى تتمتع فئة قليلة منهم بالفضائل الخيرة في ذاتها.
لا يستطيع أحد أن يتصور أن ذم المادية والنفور منها وقسوة الحياة المادية مسألة تعود إلى النظر للغايات الاقتصادية كمجرد أدوات. وحين نحاول النظر إليها كغايات في حد ذاتها ولها قيمتها الجوهرية مثل باقي القيم الأخرى تصبح قابلة للتعقيل والتنظير وتصبح للحياة الاقتصادية قيمتها الذاتية. كذلك نلاحظ أن الغايات الجمالية والدينية والغايات الأخر ى باتت مهملة وهشة وكمالية حيت يتم فصلها عن الغايات الاقتصادية أو الأداتية.
وتتمثل الصورة الشاملة الأخرى “للتغير” في استبعاد التفرقة التقليدية بين الخير الأخلاقي والفضائل الطبيعية مثل الصحة، والاقتصاد، والأمن، والفن، والعلم وما يشابهها. ولا تعد هذه النظرة، النظرة الوحيدة الي حزنت لعملية الفصل الحاد وحاولت القضاء عليه. فلقد ذهبت بعض المدارس الأخر إلى أبعد من ذلك وأكدت على أن القيم الخلقية والصفات الشخصية تستمد قيمتها من الفضائل الطبيعية أو ما يسم بالقيم المادية وليست قيمًا في ذاتها.
وحين أكد المنطق التجريبي عند تطبيقه في الأخلاق على القواعد الأخلاقية أن الحكم على صفة ما بالخيرية يتم وفقه مدى مساهمتها في علاج الحالات الشريرة إصلاح جوانب النقص. وبذلك دعّم المعنى الخلقي العلم الطبيعي. وكذلك عندما يتم نقد كل العيوب الاجتماعية القائمة وفحصها بدقة، ربما يتعجب المرء ويتساءل عن ما إذا كانت المشكلة الحقيقية والعيب الأصلي لا تكمن في الفصل بين الأخلاق والعلم الطبيعي. فحين تساهم الفيزياء والأحياء، والطب، في تحديد مصائب البشرية، وتقوم بتطوير الخطط لعلاجها، وتحقيق الرفاهية للبشرية تصبح علوما أخلاقية وجزءا من البحث الأخلاقي أو العلم الخلقي. فتفقد الأخلاق حرفيتها ولهجتها الآمرة تتخلص من التزمت ولغتها التاريخية، وتقضي على هشاشتها وتصبح واضحة وفعالة. ومع ذلك لا تقتصر المكاسب فقط على الجانب الأخلاقي وإنما تمتد إلى العلوم الأخر. فيقضي العلم الطبيعي على عملية فصله عن الإنسانية، يصبح علما إنسانيا في حد ذاته. لا يتم البحث فيه بطريقة متخصصة وفنية عن ما يسمى الحقيقة في ذاتها بل البحث عن دورها الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه المجتمع. ويصبح علما فنيا فقط بمعن أنه يمد المجتمع بفن الهندسة الأخلاقية والاجتماعية.
تنهار الثنائية الكبرى التي أثقلت كاهل الإنسانية حين يتم تلقيح الوعي العلمي بالقيمة الإنسانية. يتم القضاء على الفصل بين المادي والآلي، العلمي والأخلاقي والمثالي. تتحد القيم الإنسانية التي تتأثر بهذا الفصل. فطالما لا يتم التفكير في الغايات باعتبارها غايات فردية تشبع حاجات إنسانية مجردة، ويتم السعي لها لتحقيق غرض معين، فإن “العقل” يقنع بالمجردات والصور الخالصة، وينتفي الدافع أو الحافز لاستخدام المجتمع أو الأخلاق للعلم الطبيعي وللمعلومات التاريخية المتراكمة. بينما حين يتم تركيز الانتباه على الحالات الجزئية المنفصلة تتم الحاجة إلى كل الماد الفكرية وإل كل العلوم التي نستعين بها لتوضيح حالات معينة. كذلك عندما يتم تركيز الأخلاق في “الذكاء” فإن كل الموضوعات الفكرية تعد موضوعات أخلاقية، ونقضي على الصراع المميت الذي لا نهاية له لا طائل منه بين الطبيعي والإنساني. ويمكن تلخيص هذه الاعتبارات العامة كلها كما يلي:
أولا: تحتل عملية “الكشف” والبحث في الأخلاق نفس المكانة التي تحتلها في العلم الطبيعي. تصبح عملية البرهنة والتحقق والإثبات والحكم مسألة تجريبية، تترتب على النتائج. يتحول مصطلح “العقل” الذي كان ساميا ومحل تقدير في الأخلاق إلى وسيلة فعالة يتم بها وضع المناهج التي تدرس الحاجات والظروف والعقبات وتفحص المواقف فحصا دقيقا، وتضع الخطط الذكية لعلاج الأخطاء وإصلاح الخلل. تؤدي التعميمات المجرد إلى القفز إلى النتائج وما يسمى بالتوقعات الطبيعية، ويتم استهجان النتائج السيئة باعتبارها تعود إلى عناد الطبيعة والظروف غير المواتية. أما حين يتم تحويل المسألة إلى تحليل لموقف معين تصبح عملية البحث مسألة مفروضة والملاحظة الجادة للنتائج ملزمة.
ومن هنا، لا يتم الاعتماد على حكم أو قرار سابق أو مبدأ قديم لتبرير موقف معين أو فعل ما. لا تؤخذ مسألة الشعور بالآلام هدفا نهائيا في حالة معنية وإنما يجب بحث نتائج الشعور بها واعتبارها مجرد “فرض” يجب التحقق منه. لا تصبح “الأخطاء” حينئذ حوادث لا يمكن تجنبها ويجب الشعور بالحزن لارتكابها أو النظر لها باعتبارها رذائل خلقية يجب التكفير عنها أو الصفح. إنما تُعد دروسا نتعلم منها المناهج الخاطئة التي يجب أن يتجنبها ذكاؤنا في المستقبل أي عبارة عن مؤشرات تدعو الحاجة إلى المراجعة والتطوير وإعادة الضبط. فتنمو الغايات وتتحسن معايير الحكم، يُصبح الإنسان ملزما بتطوير معايير أحكامه ومثله العليا بدلا من اعتماد على المعايير القائمة المثل العليا السابقة.
ثانيا: تتساوى كل الحالات التي تتطلب فعلا أخلاقيا من حيث الدرجة الأهمية. ليس هناك أفضلية لحالة على حالة أخرى. إذا كانت الحاجة لموقف معين تطالب بالاهتمام بالصحة فأن الصحة تُعد الغاية القصوى لهذا الموقف والمثل الأعلى. ليس هناك غايات تُعد وسائل لغايات فكل الغايات نهائية وغايات في ذاتها. وينطبق نفس الوضع على تحسين الحالة الاقتصادية وطرق المعيشة، والاهتمام بالعمل والأسرة. يكون كل شيء في موقف معين غاية في ذاته ويتساو من حيث الدرجة والقيمة مع المثل الأعلى لأي موقف آخر. ويستحق نفس درجة الانتباه والذكاء.
ثالثا: نلاحظ أثر هذا التلاحم في القضاء على جذور النافق والتظاهر بالتقوى بعد أن تعودنا دائما على أن نسلم به ونغفل أسبابه الفكرية. لن نحكم على غاية الفعل في موقف أخلاقي معين بنفس مقياس الحكم الذي نحكم به على كل الحالات. إذ يختلف الحكم على الموقف الأخلاقي لأحد الأفراد المثقفين عنه حين نحكم على موقف صاحبه محدود الثقافة. ويبدو التناقض ظاهرا حين نطبق على البدائيين نفس المعيار الخلقي الذي نحكم به على المتحضرين. لن يتم الحكم على فرد معين أو جماعة معينة وفقا للنتيجة التي وصلوا إليها أو فشلوا في تحقيقها. إنما نحكم عليهم وفق الاتجاه الذي بدأ والسير فيه الحركة تجاهه.
لذلك، يُعد الاتصال والمشاركة والمساهمة الطرق الواقعية الوحيدة التي يتم بها تعميم الغالية الخلقية والقانون الأخلاقي. فالمعنى الحديث للإنسانية والديمقراطية الاعتراف المتزايد بأن “الخير” يتحقق بالمشاركة والتواصل. إذ يؤدي التعاون والمشاركة إلى تحقيق الغيرية والإحسان دون أن يعني تحقيقهما التدخل في حياة الآخرين. لهذا إن كلاًّ من المجتمع والأفراد في حاجة إلى بعضهما البعض أي كلاهما تابع أو ثانوي وليس منهما ما هو أساسي وما هو تابع. يكون الفرد ثانويا وتابعا لأنه دون التواصل في الخبرة وعملية انتقالها من فرد إلى آخر يظل جاهلا، ولا يكون مركزا واعيا بالخبرة إلا عن طيق المشاركة مع الآخرين.