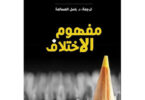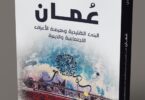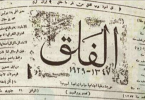مَنْ أَحْسَنَ الإِنْصَات أَحْسَنَ الفَهْم…
لعله من المفيد أن أذكر -على سبيل التناظر- ما كتبه لويس كارول (Lewis Carroll) في الفصل السابع من سردية “آليس عبر المرآة”، إذ قال وحيد القرن في مشهد حواري: “كنت أعتقد أن الأطفال وحوش خرافية! هل هي كائنات حية؟”. ثم نظر إلى “آليس” نظرة محتَقِرةً، وقال: “تكلمي أيتها الطفلة”. لم تتمكن “آليس” من مقاومة ابتسامة ارتسمت على شفتيها، فقالت: “هل تعلم؛ أنا أيضا كنت أعتقد أن وحيد القرن وحشٌ خرافي! لم أر من قبل واحدا قط”. قال وحيد القرن: “حسنا، الآن وقد رأى كل منا الآخر، لو آمنتِ بوجودي، فسأومن بوجودك… هل اتفقنا؟”(1). إن لمرآةِ المحافلِ الرياضية الكبرى –وفي مقدمتها محفل بطولة العالم في كرة القدم الذي أقيم في قطر- القدرةَ على إثراء وجودنا من خلال إظهار صورتنا في الآخر المتجلي أمامنا؛ إن لها القدرة على “تجلينا معا” وإدراك “وجودنا معا”. ذلك أن شرط تحقق وجودنا هو أن نكون مُدْرَكَينَ من قبل الآخر ومُدْرِكِينَ له في الآن ذاته. إن “معرفة أننا موجودون تستلزم معرفة الآخرين الذين ندركهم ويدركوننا”(2).
بعد هذه التوطئة الاستعارية، أرى أنه من اللازم التأكيد على أنه لا إبداع بغير تَمَيُّز، ولا تَمَيُّز بدون خصوصية، ولا خصوصية بدون اختلاف. لكن قبل نَسْقِ الصلة بموصولها، قد من الحكمة أن نستحضر أننا سنجد -إلى جانب مطلقي النار على فكرة الحلم العربي- ألوانا مِنْ أعين التَّسَخُّطِ لدى صُنوف من الجهات والأشخاص ممَّنْ تعودوا على أن “يقرؤوا معاني القبح في آيات الجمال”. أما أعين الإنصاف والرضا تلك التي تقرأ معاني الجمال في محافل الجمال فقد أقرت بأن “مونديال العرب” شكل لحظة فارقة في سيرورة رمزية دالة، كادت تكون خطيةً لولا التناصرُ والثباتُ الذي أبداه ذوو العزم والحزم والهمة في الدفاع عن “الحق العربي في الاختلاف”، على وَفْقِ المنوالِ المستنيرِ نفسِه الذي نَسَجَ عليه البيروني بإزاء “طريقة الهندوس الخاصة في رؤية الأشياء”، وأسلوبِ التمثيلِ الاستعاريِّ ذاتِه الذي انْتَهَجَهُ لويس كارول ضمن حوارية “آليس مع وحيد القرن”.
في هذه الجزئية بالذات من سيرورة الاستقراء، أجدني في صلب ما كتبه الفيلسوف طه عبد الرحمان في أثناء حديثه عن “الحق العربي في الاختلاف الفلسفي”(3)، إذ استشكل مصطلح “الفكر الواحد” و”الأمر الواقع” اللذيْن يُصِرُّ الغربُ على تكريسهما في سياق إحكام هيمنته، وفَنَّدَ ما يستبطنه مفهومُ “التسوية الثقافية” من حيث هي “تسليط نمط فكري واحد [هو فكر الأقوى] على جميع الثقافات المختلفة”، ثم حاجج من أجل إقرار “الحق العربي في الاختلاف”؛ إذ قال: “يحق لكل قوم أن يتفلسفوا على مقتضى خصوصيتهم الثقافية، مع الاعتراف لسواهم بذات الحق، بحيث يجب أن ينشأ بين الأقوام المختلفة تنوعٌ فلسفيّ يوازي تنوعَها الثقافي؛ وكل فلسفة تدعي لنفسها الانفراد بهذا الحق لا تكون إلّا فلسفةً مستبدةً أشبهَ بالعقيدة المتسلطة منها بالفكر المتحرر، حتى لو تَوَسَّلَتْ بأقوى الأدلة العقلية، لأن فلسفة مثل هذه تنتحل حيازة الحقيقة المطلقة؛ والحال أنه لا مطلق في الفلسفة، حتى ولو كان العقل نفسه، بل حتى ولو كان الاختلاف نفسه”(4). إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الفلسفة من حيث هي ممارسةٌ ذهنيةٌ خالصة، فمن “بَابِ الأَوْلَى” أن ينطبق الأمر نفسُه على ممارسة كرة القدم من حيث هي في الأصل منافسة تخضع لقواعد اتفاقية متجددة وليست جبرية متعالية.
وإذا كان قد تقرر سلفا بأنه لا إبداع بغير تميز، ولا تميز بدون خصوصية، ولا خصوصية بدون اختلاف، فقد لزم من ذلك أن نخلص إلى أن توصيفات الرائقية في “القيمة” (قيمة قبول الاختلاف وعوائدها الثقافية والحضارية والرمزية)، والشائقية في “الإقامة” (على مستوى التجهيز والتنظيم والمنافسة والإبهار والفرجة)، والفائقية في “المقاومة” (مُدافعة فكرة الهيمنة الغربية والفكر الواحد المستعلي)، وهي جميعا توصيفات لروعة الإبداع في “مونديال العرب”، إنما تَحَصَّلَتْ من جهة الحرص على مقومات “التميز” و”الخصوصية” و”الاختلاف”… لعلنا في “مونديال العرب” تأكدنا فعليا مما قرره خورخي لويس بورخيس(5) (Jorge Luis Borges) إذ قال: “إن السطر الجيد ليس حكرا على أي أحد”. وصلا بهذا النسق، لا شك في أن قطر وبجانبها كلُّ الدول العربية والإسلامية قد كتبوا سطرا مجيدا بحبر الفخر في مدونة الاختلاف الـمُخَصِّب والتنوع الذي يُثْري ويُضِيف.
ارتأى إدواردو غاليانو (EDUARDO GALEANO) أن كرة القدم يمكن أن تكون “علاجا تواصليا”(6) لحالات الانغلاق وسوء الفهم والاستعلاء على الآخرين. ولعله من المفيد أن أذكر -ارتباطا بهذا السياق- أنه خلال الحقبة الفكتورية، بَادَرَ روديارد كيبلنغ (Rudyard Kipling) –في محاولة منه لإرشاد مواطنيه الإنجليز إلى مدى شساعة الإمبراطورية البريطانية وتنوعها- بطرح السؤال: “ما الذي ينبغي لهم أن يعرفوه عن إنجلترا، وهم لا يعرفون إلا إنجلترا؟”(7). يخامرني إحساسٌ بأن سؤال كيبلنغ لم يكن محضَ تأنيب أو سخرية. بل إقرارا بالتعريف المضمر لإنجلترا التي صارت تنفض بعيداً عنها كلَّ “مَنْ وما هو ليس إنجليزيا”، وفق ما تُجَلِّيه شخصيةُ “السيد بودسناب” المغرور في رواية “صديقنا المشترك”(8) لديكنز (Charles Dickens)؛ إذا كان كلما عجز عن فهم أمر ما، ينفضُ بتلويحة من يده كلَّ العالم القابع خارج أسوار معرفته الضيقة جدا(9).
على جهة التقريب، ثمة مبدأ كان قد مَحَضَهُ فيرجيلو (Vergilius) في صيغة نصحية لدانتي (Dante Alighieri) في أثناء رحلتهما خلال الدائرة الثالثة من الحلقة السابعة من الجحيم، إذ قال: “من أحسن الإنصات أحسن الفهم”(10). ها قد انتهى مونديال العرب (فيفا – قطر 2022) بتتويج الأرجنتين في مباراة مثيرة أمام فرنسا، بعد حوالي أربعة أسابيع من المنافسات المحتدمة والاستعراضات الثقافية الموازية الملهمة، تجلى فيها لكل الذين يؤمنون بالحق في الحلم والحق في الاختلاف أن للعرب “مجالا تداوليا مخصوصا [يستمد روافده من قيم مركوزة في الثقافة العربية الإسلامية] كما لغيرهم مجالهم التداولي الخاص بهم”(11). بعد هذا التجلي، سيظل الأمل معقودا على أن يكون الغربُ قد “أحسن الإنصات وأحسن الفهم”، كي يستخلص أن الذين طالما دُفِعَ بهم -في الرياضة أو الثقافة أو السياسة أو الاقتصاد بتعمد ومكر وإصرار، أو من جراء سوءِ فهمٍ- إلى الهامش، لا يمكن أن يظلوا في الهامش إلى الأبد…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Lewis Carroll, (1871), Through the Looking Glass, Global Grey ebooks, 2018, p87-88.
2 – ألبرتو مانغويل، مدينة الكلمات، ترجمة يزن الحاج، دار الساقي، بيروت، ط1، 2016، ص20.
3 – ينظر: طه عبد الرحمان، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2006.
4 – طه عبد الرحمان، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص21.
5 – لعله من المفيد أن نُذَكِّرَ بأن خورخي لويس بورخيس كان يبدي الكثير من الريبة تجاه كرة القدم، ويكفي أن نشير إلى أنه أصر على أن يلقي محاضرة حول موضوع “الخلود” في اليوم ذاته والساعة نفسها التي كان يخوض فيها المنتخب الأرجنتيني مباراته الأولى في مونديال 1978. ينظر: إدواردو غاليانو، كرة القدم بين الشمس والظل، ص51.
6 – إدواردو غاليانو، كرة القدم بين الشمس والظل، ص127.
7 – ألبرتو مانغويل، مدينة الكلمات، ترجمة يزن الحاج، دار الساقي، بيروت، ط1، 2016، ص56.
8 – Charles Dickens, 1864, Our Mutual Friend, London: Chapman and Hall, Piccadilly.
9 – ينظر كتابنا: الاستعارة والاستنارة، من الاستعارات الحية إلى استعارات سر الحياة، عبد الكريم الفرحي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2022، خاصة فصل “الآخر الإكزوتيكي أو محنة إنكيدو في مرايا الاستعارة” من ص33 إلى ص45.
10 – الكوميديا الإلهية، دانتي ألجييري، ترجمة كاظم جهاد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2002، ص259.
11 – طه عبد الرحمان، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص198.