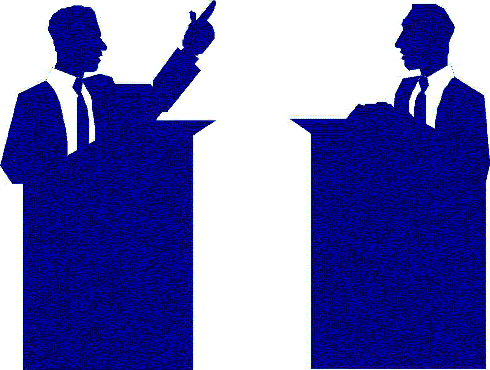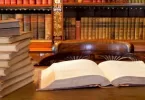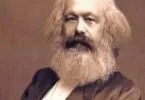فيليب بروتون وجيل جوتيه
تتأسس مشروعية هذه القراءة على الأهمية البارزة للحجاج في مجتمع المعرفة، باعتباره مجتمعا لتداول المعلومة والتواصل بامتياز، لذلك وجب على الباحثين إعطاء أهمية قصوى لدراسة نظريات الحجاج. بناء على ذلك سنروم تقديم قراءة في الباب الأول من كتاب “تاريخ نظريات الحجاج”، لكل من فيليب بروتون وجيل جوتيه.1 يتكون هذا الكتاب من ثلاثة أبواب رئيسة، يدرس الأول ارتقاء الحجاج البلاغي وانحطاطه، في ما يُعنى الباب الثاني بالوقوف عند مرحلة النهضة مع كل من بيرلمان Perelman وتولمين Toulmin، أما الباب الثالث فينفتح على الدراسات المعاصرة للحجاج.
يتقدم هذه الأبواب تقديمان، أولهما للمترجم محمد صالح ناحي الغاميدي، والثاني للمؤلفين. خلاصة التقديم الأول أن الحجاج صار علما دقيقا أصبح من غير الممكن تجاهله، إذ يحضر الحجاج في كل أنواع الخطابات السياسية، الاقتصادية، الدينية والفلسفية…الخ، من ثمة فالكتاب بحث في الحجاج من منظورين، لغوي بلاغي، وآخر منطقي طبيعي، وهو يحاول بذلك تقديم نظرة شاملة عن تطور دراسة الحجاج.
أما التقديم الثاني فيقف عند مسألتين أساسيتين: تهتم المسألة الأولى ببيئة ظهور نظريات الحجاج، إذ يجب أن تكون بيئة يتم فيها الاهتمام بالمنطق والإقناع والتواصل، فالحجاج بني على هامش المنطق تارة، وتارة أخرى بالتعارض معه، حيث تتموقع الحجة على طرف نقيض من البرهان Démonstration، وهي تعتبر شكلا من المحتوى التواصلي، وترتبط بالإقناع من حيث الغاية التي ترومها.
بالإضافة إلى هذه الارتباطات لا ينمو الحجاج إلا في مجتمع علماني ديمقراطي ومسالم، حيث إن الحجاج يفترض عدم الانطلاق مما هو مقرر سلفا، وهو يعمد إلى التوافق وليس إلى القطيعة، فضلا عن ذلك ينمو الحجاج في مجتمع لا سبيل إلى حل الاختلافات الحاصلة فيه إلا بالمواجهة الخطابية واللغوية، وليس بالقوة والعنف، وينمو أيضا في مجتمع تنتشر فيه أساليب السيطرة الإيديولوجية، على شاكلة الدور الذي كانت تقوم به السفسطائية على عهد أفلاطون وأرسطو، والدور الذي تقوم به تقنيات الإعلام والاتصال في هذا العهد، مند النصف الثاني من القرن العشرين.2
أما المسألة الثانية فتهم المسائل المختلف حولها وبسببها في نظريات الحجاج، وأول قضية خلافية هي قضية تعريف الحجة، حيث يختلف تعريفها باختلاف طبيعة العلاقة التي يقيمها المهتم بالحجاج بالبلاغة والمنطق والأخلاق، فهناك فئة ترادف الحجة بالبلاغة، وأخرى تختزل هذه البلاغة في آليات التعبير وبالتالي تفصل الحجاج عنها، وفئة ثالثة تربط الحجة بالاستدلال البرهاني. ورابعة تقول بلا أخلاقية الحجاج عن طريق ربطه بالاستدراج La manipulation لا بالإقناع والعكس.
البلاغة والحجاج
يربط المؤلفان بداية الحجاج بالبلاغة ربطا صميميا، ويريان فيها الإطار المثالي لنظريات الحجاج كما يتحدثان عن هذا الارتباط من خلال ما سمياه بالحجاج البلاغي القائم على احتمالية الصواب La vraisemblable، لا على الحقيقة La vérité ، بحيث يهتم الحجاج البلاغي بلحظات التواصل التي تنتمي للحياة الاجتماعية والدينية والسياسية التي انتظمت أول الأمر تحت راية الديمقراطية اليونانية ومؤسساتها، قبل أن تتجاوز الخطاب الاستشاري السياسي Délibération politique، إلى القضائي Judicaire و الاستدلالي épidictique حول جيد القيم من قبيحها، إلى الخطاب الوعظي الديني الذي رافق ظهور المسيحية، والخطاب الرسائلي في القرون الوسطى، وصولا إلى الإعلان التجاري وحقل الإعلام في العصر الحديث.
لقد كان ارتقاء الحجاج البلاغي بالانتقال من لحظة التأسيس ذات المنشأ السفسطائي، إلى لحظة النضج مع أرسطو من خلال كتاب “البلاغة”، وامتدادات ذلك مع شيشرون Cicéron وكنتيليان Quintilien، وكان الانحطاط مزامنا لانهيار الإمبراطورية الرومانية إلى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث اختزلت البلاغة في المحسنات اللغوية وأعطيت الأولوية للبرهان بشكل راديكالي.
ارتقاء الحجاج البلاغي
لقد كان لميلاد الحجاج وارتقائه محدد أساسي حسب جون بيير فرنان Jean- Pierre Vernant تمثل هذا المحدد في انقلابه إلى “أداة السياسة بامتياز ومفتاح كل سلطة في الحكومة، ووسيلة القيادة والسيطرة على الآخرين”، مما تطلب الفصاحة التي صارت موضوعا للتعليم وكان المرجع هو كتيب كوراس Corax، وهو عبارة عن “مجموعة من الإرشادات العملية المصحوبة بأمثلة يستخدمها كل من يخضع للمحاكمة”. قدم كوراس في هذا الكتاب أربعة إجراءات ينبغي أن ينضبط لها كل خطاب يريد أن يكون بلاغيا، وهي على الشكل الآتي: الاستهلال، تقديم الأحداث، المناقشة و الخاتمة.
لقد كان مبتغى الحجاج البلاغي في هذه المرحلة هو تأمل الممارسة الخطابية أمام القضاء حتى تكون مقنعة، وقد شكل ذلك ضرورة ملحة لكل الناس حتى يتمكنوا من إقناع القضاة، حيث كان الدفاع عن النفس فرديا، “فكم من حق ضاع لضعف حجته وكم من باطل داع لقوة حجته”.3
أسهم هذا الدفاع الفردي عن النفس في ظهور معلمين للخطابة بالأجر، هم السفسطائين الذين وضعوا نظرية لقوة الكلام اهتموا فيها بالقدرة الإقناعية للغة وجماليتها، ناظرين إلى الكائن الإنساني ككائن يحتويه القول. وقد اهتموا كذلك بالعمل السياسي وعملوا على تعليم كيفية النقد والمناقشة وترتيب المناظرة بين العقول. واهتموا كثيرا بالمحسنات اللغوية التي تجعل من القول الضعيف قولا قويا، معتبرين أن هناك أكثر من طريقة لرؤية الأشياء.
هذا الطابع النفعي الذي اتسم به الحجاج البلاغي في هذه المرحلة استدعى قيام ردود فعل، هي تلك التي مثلها سقراط الذي انتقد نظرية المعرفة عند السفسطائين بصفة عامة، محاولا تلخيص البلاغة من الشوائب التي ألصقت بها، حيث فتحها على مجال أوسع فأصبحت تشمل حتى الاجتماعات الخاصة، وقد عرفت البلاغة في هذه المرحلة بكونها “امتلاك التأثير على الأنفس”. أكد سقراط على كون الخطباء لا يستخدمون تقنيات متقنة واقترح لتجاوز ذلك نهجين هما: التوليف Synthèse والتقسيم ويكملهما معرفة الجمهور الذي ينبغي إقناعه، ومن يتبع هذه الطرق يسمى جدليا.
إن هذه التطورات التي شهدها تناول الحجاج البلاغي بالانتقال من كوراس إلى السفسطائين، ومنهم إلى سقراط وأفلاطون، هي التي ستمهد الطريق لأرسطو (384 ق م- 322 ق م) ليضع أساسيات نظرية الحجاج، من خلال كتاب “البلاغة”، الذي ألفه ما بين 325 و 323 قبل الميلاد. أسس أرسطو من خلال هذا الكتاب لانفصال مزدوج مع اللذين سبقوه، مع أفلاطون الذي قال أن كل بحث بلاغي لا يتغيا الحقيقة هو لا أخلاقي، وبذلك يكون قد رفض الربط بين البلاغة والحقيقة والأخلاق مؤكدا أنها آلية تفتقد الحس الأخلاقي لكنها غير منافية له، فهي أداة وتقنية حجاجية لما هو قابل للصواب لا للحقيقة، ومع السفسطائين فهؤلاء يدرسون نتيجة الفن وليس الفن نفسه، وبذلك أصبحت البلاغة عند أرسطو مرتبطة بالاستدلال أكثر من ارتباطها بالمشاعر.
لقد أصبحت البلاغة مع أرسطو نظرية منظمة وشاملة، تُعّرفُ على أنها “القدرة على الكشف بتفكر عند كل حالة، لما يمكن ان يكون مقنعا فيها”، واستخدام تلك القدرة فعليا في كل المواقف التي تظهر فيها الحاجة للإقناع. فقد اعتبر أن المتلقي هو منتهى كل خطاب، وبذلك تختلف الضروب الخطابية باختلاف المتلقين؛ لقد أنتج أرسطو نظرية لمواقف الحجاج، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل موقف وكأنها نظرية في التلقي، وفصل في المواضيع التي يقوم عليها كل ضرب والأدلة المرافقة ، فالخطاب الاستدلالي يجري في الزمن الحاضر وموضوعه القيم، والخطاب القضائي، يدور حول أحداث الزمن الماضي وموضوعه البراءة أو الإدانة، والخطاب الاستشاري يهم زمن المستقبل ويتمحور حول قضايا الأمن والاقتصاد وتسير شؤون المدينة.
وفي حديثه عن الاستدلال الحجاجي ميز أرسطو بين ثلاثة أنواع من الأدلة، أولها تعتمد شخصية الخطيب L’éthos، والثانية تعتمد على محتوى الخطاب Le logos، أما الثالثة فتعتمد مشاعر المتلقي Le pathos. فاستدعاء شخصية الخطيب أو مشاعر المتلقي ينبغي أن يأتي من الخطاب ذاته، فغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى المرافعة خارج إطار القضية، كما أن الخطيب لا يستطيع الاستغناء عن دراسة الحالة النفسية للمتلقين. وعلى الحجج التي تعتمد محتوى الخطاب أن تركز على إظهار احتمالية الصواب فيما يحتويه كل موضوع من قدرة على الإقناع. وقد رأى أرسطو أن خطاب الحجاج مركب من نوعين ممكنين من الاستدلال، وقد رأى المؤلفان إضافة نوع ثالث ينسجم وتقسيمه الخطاب إلى ثلاثة ضروب، هذه الأنواع هي كالآتي:
- المثال L’exemple: يرتبط بالضرب الاستشاري من الخطاب حيث يتم الاعتماد على حالة شبيهة بتلك التي نود الإقناع بها لاستنباط المشروعية.
- القياس المضمر L’enthymème : وهو ينتمي للقياس المؤلف Syllogisme يكون بالانطلاق من مقدمة ما بهدف استنتاج فكرة جديدة ومختلفة لكنها ناتجة بالضرورة من تلك المقدمة.
- الإسهاب L’amplification : يهتم بتبيان السمو وعلو الشأن ومادته هي أحداث متفق عليها من الجميع ويضفي عليها الاهتمام.
تتناول البلاغة القابل للمناقشة والصواب، أما ما ينتمي للبداهة والبرهان العلمي فهو خارج حقل المواضيع البلاغية، فحقل البلاغة يمكن أن يضيق تحت تطورات العلم، حيث تهتم البلاغة بالمواقف التي لا يمكن للبرهان أن يدخل فيها، وتتشابه البلاغة حسب أرسطو مع الدياليكتيك، حيث يتعلقان معا بمسائل يشترك فيها كل الناس ولا تتعلق بالعلم. إن الدياليكتيك هو أداة المعرفة المحتملة ومنهج لإنتاج المعارف العامة. أما البلاغة فهي لا تنتج المعارف مثل الدياليكتيك، فهي منهج للإقناع وبذلك فهي تنتمي للعلوم الشعرية التي هي معرفة قوانين فن الإقناع.
إن هذا النضج الذي بلغه الحجاج البلاغي مع أرسطو جعل من البلاغة ثقافة مشتركة للعالم القديم، حيث صارت تعرف حسب رولان بارث بكونها تقنية وحقل علمي وأخلاق وممارسة اجتماعية، وقد انتشرت مع كل من شيشرون من خلال كتابه “في الخطابة”، وكتاب “أدهرنيوم Ad hernnium” وهو مجهول المؤلف، ثم كتاب “المؤسسة الخطابية” لكنتيليان، وكتاب “دروس البلاغة” لهيرموجين Hermogène.
مع هذه الكتابات الوازنة ازدهرت نظرية الحجاج، مقترنة بذلك بعصر جعل من الخطاب في قلب كل شيء بهدف الإقناع، وقد حاول المؤلفان اختزال المعايير التقليدية لبناء الخطاب البلاغي في خمسة مراحل، هي: الإبداع، التنظيم، التعبير، الاستظهار، الفعل.(20) لقد تأكد في هذه المرحلة أن البلاغة ليست منهجا لإنتاج الأفكار والآراء، حيث يستحيل الفصل بين التفكير والتعبير، فهذا الفصل حسب شيشرون ضار، عكس ما سبق تأكيده مع أرسطو.
هكذا نخلص إلى أن رقي الحجاج البلاغي، كان بالمرور من مرحلة التمهيد والتأسيس مع كوراس والسفسطائيين، إلى مرحلة النضج والذيوع مع أرسطو وشيشرون وكانتليان، غير أن هذا الشيوع سرعان ما سيخفت ضوؤه وستدخل البلاغة في مرحلة انحطاط، فما هي الأسباب التي أدت إلى دخول البلاغة مرحلة الانحطاط؟
انحطاط الحجاج البلاغي
لم يكن موقع البلاغة موقعا مطمئنا منذ نشأتها، فقد كان يسمو وينحط حسب الأغراض التي يقصد المتكلم إنجازها، لذلك كانت موضع انتقاد حتى في فترة الارتقاء المذكورة، فقد نُظر إليها على أنها تقوم على لغة خادعة غرضها الحجاج والإقناع فهي لا تبقي على اللغة في طبيعتها من حيث هي لغة تلقائية، بل تعمل على جعلها مصطنعة حتى تتوافق وتحقيق الغرض المذكور، من تم كان هذا التعارض بين الطبيعي والمصطنع موضع نقد في البلاغة.
بالإضافة إلى نقد لا أخلاقية الممارسة البلاغية الحجاجية على الشاكلة التي جسدها بها السفسطائيون، إذ جعلوا من خدمة قضايا محددة سبيلا للارتزاق، ومن بين الانتقادات الموجهة للبلاغة على الطريقة السفسطائية هناك نقد أفلاطون، فقد انتقد تأسيسها لنسبية الحقيقة وأراد جعلها أداة لخدمتها. ثم هناك الانتقاد القائم على كونها موصلة إلى الديمقراطية (الحكم). وهو انتقاد موجه من قبل مناصري تفرد الأقلية بالسلطة.
إن مجموع الانتقادات التي رافقت البلاغة مند بدايتها، أدت إلى تراجع أهمية نظرية الحجاج داخلها، فقد ارتبطت البلاغة في هذه المرحلة بالتعبير الأدبي دون غيره، ففقد الحجاج مكانته وأعطيت الأولوية بشكل راديكالي للبرهان العقلاني خاصة مع ديكارت. لقد تزامن تراجع الحجاج البلاغي مع ظهور الإمبراطورية الرومانية، حيث نقلت السيادة للإمبراطور بشكل متطرف مما حدّ من هامش الحرية، فلم يعد المتلقون هم أساس الحكم على مدى صلاحية الحاكم للحكم، بل أصبح الحكم مفروضا عليهم. وقد كانت هناك محاولة من طرف اليسوعيين في القرن الثاني عشر بغرض إعادة اكتشاف بلاغة أرسطو، إلا أن ذلك كان لفترة قصيرة، عادت بعدها البلاغة إلى التركيز على البعد التجميلي واختزلت فيه. فقد تقدم فن القول عن فن الإقناع، ولم تكن العودة الحقيقية حسب فليب بروتون وجيل جوته إلا في النصف الثاني من القرن العشرين مع بيرلمان وتولمين.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فيليب بروتون أستاذ زائر بجامعة السربون بباريس، حاصل على الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، من أبرز مؤلفاته كتاب ثورة الاتصال، نشأة إيديولوجية جديدة (L’explosion de la communication, La découverte, Boréal 1989)، وكتاب الحجاج والتواصل. أما جيل جوتييه فهو أستاذ فلسفة اللغة في قسم المعلومات والتواصل بجامعة كيبيك Québec، مهتم بدراسة الحجاج في الخطاب السياسي. أما الكتاب الذي يتمحور حوله هذا المقال فهو:
- بروتون فيليب وجوتييه جيل، تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة محمد صالح ناجي الغامدي، (جدة: مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، ط 1، 2011).
2- الربط الصميمي لظهور الحجاج وازدهاره بالمجتمع العلماني، مفهوما على أنه تحرر من أية قيادة دينية لمركز القرار قد لا يكون صائبا، خصوصا إذا ما استحضرنا حجم النقاشات التي أثيرت في الثقافة العربية الإسلامية حول قضايا كلامية أساسية خصوصا في ما يعرف بجليل الكلام، وكان ذلك في ظل خلافة دينية إسلامية، فهذه النقاشات من وجهة نظرنا الخاصة يمكن أن تزود المهتمين بالحجاج بما من شأنه تطوير النظريات الحجاجية.
3- الراضي رشيد، السفسطات المنطقية في المنطقيات المعاصرة، التوجه الجدلي التداولي نموذجا، ضمن: مجلة عالم الفكر، العدد 4، المجلد 36، أبريل يونيو 2008، ص، 127.
4- نسجل في هذا السياق الإغفال غير المبرر للإرث البلاغي في الثقافة العربية الإسلامية، وبالتالي لحمولته الحجاجية حيث عرف أوجه مع الجاحظ من خلال كتابه “البيان والتبيين”، إذ نجد لديه تلازما بين الإقناع والإفهام والبيان، حيث يقول “فبأي شيء بلغت الإفهام فذلك هو البيان في ذلك الموضع”.أنظر:الجاحظ أبو عثمان، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون ذكر التاريخ) ص، 76.فهذا الكتاب مؤسس للحجاج وبلاغة الخطاب ألإقناعي، بالإضافة إلى كتاب ابن وهب “البرهان في وجوه البيان”، الذي يعتبر إلى جانب الجاحظ ممثل التيار البياني في التراث البلاغي العربي. هذا التراث الذي يغيب في كتابة تاريخ البلاغة الحديثة. أنظر: العمري محمد، البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج، ضمن مجلة: عالم الفكر، العدد 4، المجلد 40، أبريل، يونيو 2012، ص، 267- 268.لذلك نقترح تقييد إطلاقية عنوان الكتاب موضوع قراءتنا بجعل عنوانه “تاريخ نظريات الحجاج في التراث الغربي” عوض “تاريخ نظريات الحجاج”.