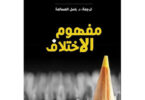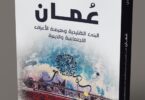(الكلام هو الطريقة المضمونة لإساءة فهم كل شيء، لجعل كل شيء ضحلًا ومملًا.)
هيرمان هسّه كلاين وفاجنر، ص٦٩
ت. أحمد الزناتي
تويتر ضد تويتر:
انتقلت ملكية موقع التواصل الشهير تويتر أواخر العام الماضي، كما هو معروف، إلى أحد نجوم المال والإعلام ايلون ماسك، والذي قام بتسليم بعض أرشيف مراسلات شركة تويتر إلى صحفيين (مستقلين) أشهرهم الكاتب مات تيبي (صاحب كتاب شركة الكراهية وغيرها)، وبدأ مات تيبي في نشر سلسلة مقالات موثقة عن خبايا موقع التواصل، استفتحها باقتباس من رواية ماري شيلي الشهيرة فرانكشتاين (والرواية كما هو معروف تتحدث عن المسخ الذي يتمرّد على صانعه)، وانتشرت تلك المواد في وسائل الإعلام وأثارت ردود أفعال مختلفة منذ ديسمبر الماضي وما تزال تنشر تباعًا حتى إبريل الحالي، على موقع substack فيما أصبح يدعى “ملفات تويتر” التي أصبح بمقدور من يشاء الاطلاع عليها في موقع ويكيبيديا بأكثر من لغة -النسخة الإنجليزية منهن أكثر تفصيلًا من العربية- وهي في مجملها تفصح علانية عما كان مجرد شكوك سابقة حول التنسيقات الوثيقة للموقع مع الأجهزة الأمنية كمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، الذي كان بعض متقاعديه من مدراء تويتر، والتنسيق بين تويتر وجهاز الاستخبارات المركزية CIA، التي عمل بعض متقاعديها كذلك كمدراء في تويتر، وحول تعاطي الموقع مع بعض القضايا المثيرة مثل إغلاق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، ومحاولة التغطية على فضيحة هنتر بايدن ابن الرئيس جو بايدن، وغيرها من تدخلات الأحزاب الأمريكية والأجهزة الأمنية الدولية لدى تويتر لسحب التغريدات وإيقاف الحسابات، وتحوي إشارة إلى تلاعب دولي لترجيح تيارات على أخرى في بلدان ذكر منها الكويت واليمن وسوريا، كل ذلك حسب موقع ويكيبيديا.
إذًا هل ما زال مستخدمو تويتر ينظرون إلى شاشة الخط الزمني في هواتفهم بوصفها مرآة اجتماعية لمحيطهم؟ مثل مرآة الساحرة في حكاية بياض الثلج (من أجمل امرأة في العالم؟) في حكايات الأخوين جريم، لكن ما مدى مصداقية المرآة ما دام وجودها كله مستندًا على جدار بيت الساحرة التي بمقدورها تدميرها برمية حجر؟!
هناك فترة في تاريخ تويتر يسميها آدم هودكجين فترة المثل، في كتابه (متابعة سيرل على تويتر ٢٠١٧ Following Searle on Twitter)، وهي فترة الإنطلاقة الأولى لموقع تويتر، فترة الاستقطاب الجماهيري بالخدمة الجديدة، فترة المثل والمبادئ، وعدم التورط في التكسب المالي من الخدمة، لكن كل ذلك سقط في قبضة المال وقبلها في قبضة النفوذ.
هكذا حين تأمل الناقد المعاصر محمد العبّاس موخرًا في كتابة (تويتر مسرح القسوة ٢٠٢١) تلك المرايا التويترية رأى حسب تعبيره (غابة وحوش) و(حفلة جنون تويترية)، طبعًا دون أن يقلل من أهمية الموقع بوصفة فرصة تواصل ولقاء إنساني رفيع، بل وكإمكانية حديثة لتلاقح الأفكار والتخلص من الانغلاق، لكن واقع حال تلك المرآة الرقمية كان كما وصفه:
“يتحول تويتر من فضاء للالتقاء الإنساني إلى مسرح للقسوة، وللتنكيل بكل من يحاول الإبلاغ الجمالي عن أي فكرة ذات قيمة؛ إذ لا أفق للحديث بنبالة وبوعي حتى عن القضايا العادلة. ولا سبيل إلى ترويض تلك الوحوش التويترية إلا بالتحول إلى وحش. وهذا هو منطق التدمير العبثي المراد فرضه لتأكيد الرداءة التربوية، وتكثير الوحوش في فضاء يراد له أن يكون غابة تويترية لها معجمها الطافح بمفردات البذاءة، ولها قانونها الدائم القائم على شبقية اجتماعية محمولة على رغبات واعية ولا واعية لإيذاء الذات وقهر الآخر، ولها سلطة الإجهاز على ما تبقّى من منسوب الآدمية عند الفرد.” تويتر مسرح القسوة، ص١٠.
يمكننا أن نرى في كتاب العبّاس محاولة دفاع عن مكتسب حضري في وجه السيول الرقمية التي أرادت إغراق الموقع في وحل خطابات الكراهية، لكن هل نستطيع أن نمنع أنفسنا اليوم من التساؤل إن لم يكن تويتر مقادًا بواسطة المتحكمين في مفاعلاته الخوارزمية للوقوع في ذلك الوحل عن قصد؟ وإن لم تكن كل المحاولات الجمالية والمجاهدات الفنية لمستخدميه النبلاء، المدفوعة بالمثل وبحسن النوايا، محكومة سلفًا بالفشل؟
تلاعب أم نتيجة طبيعية؟
يفتح المستخدم تطبيق تويتر على حسابه، لكنه يصاب بالخدر من التواصل، يظل يرفع المتصفح بإبهامه سدى، لا يسمي ما يبحث عنه، هو بالأحرى يعرض نفسه لذلك الخط الزمني لشاشة تويتر، ربما تعجبه تغريدة لكنه يتردد قبل أن يضغط زر التفضيل أو إعادة التغريد، يحسب حسابات، خوارزمياته الخاصة، لكن استخدام وإدمان تويتر، قاد في النهاية لنوع من الكسل الإنساني مقابل الكفاءة الرقمية كما يشرحها هودكجين في كتابه آنف الذكر:
المستخدمون على تويتر يقضون معظم الوقت في تجاهل الأشياء. وبالكاد ينتبهون. لكن نظام تويتر (برمجته) موضوع ليكون دقيقًا ومتيقظًا. ص٧٦
إنه تلاقي نقائض، بين من يبحث عن تزجية وقت الفراغ، وبين برمجة كهربائية ليست الراحة مدرجة في قاموسها، إنه اختلاف حاسم بين طبيعة التفاعل الإنساني والبرمجة الإلكترونية:
هناك تفاوت هائل بين طبيعة التفاعل الإنساني الملتوية والغير قابلة للتنبؤ، وبين استجابة تويتر صريحة الموثوقية والقابلة للتنبؤ الخوارزمي. ص٧٦.
بين الدقة الرقمية وبين الفوضى الإنسانية، بين التنظيم وبين العشوائية، بالأحرى بين النظام وبين الفوضى؛ لكن كتاب آدم هودكجين آنف الذكر “متابعة سيرل على تويتر” لم يكن مهتمًا كثيرًا بالفاعل الإنساني للتواصل الرقمي وشخصياته، وإن كان يشير إليه أحيانًا ببعض الجوانب السخيفة، وبالرغبة التنافسية بين مستخدميه، لكنه كان مهتمًا أكثر بالجانب النظري ومدى مطابقة بناء تويتر لنظرية اللغوي وعالم اللسانيات الفيلسوف جون سيرل صاحب النظرية اللغوية “بيانات الأوضاع الوظيفية”، وانطباق نظرية التواصل اللغوية تلك على مؤسسة رقمية مثل تويتر. رغم ذلك فإن هودكجين يضع تحليلاته بناء على أساس أن مستخدمي تويتر هم من يقودون دفة الخط الزمني، وهو افتراض يبدو اليوم عرضة للشك أكثر فأكثر، فمن جهة ما بسبب كسل المستخدمين أنفسهم وضغط الخوارزميات لمزيد من الجذب أصبح البرنامج يقدم المثيرات على المواد الهادئة، وفي المحصلة كانت الجواذب هي المثيرة أكثر فأكثر، بغض النظر عن قيمة المحتوى الذي تقدمه، وشيئًا فشيئًا ظل المحتوى التواصلي الذي يحاول السمو بالتواصل يسقط أمام المحتوى المثير الذي وجد نفسه في النهاية في زاوية إطلاق النار الكلامية حصرًا، هذا إذا نحن أغضضنا البصر عن التلاعب المباشر وافترضنا عدم حدوثه.
أما أذا افترضنا التلاعب المسبق فيمكننا القول أن التقنية أصبحت تسمح بالتلاعب بحصيلة التواصل اللغوي للمستخدمين ودفعها لتصب في مصلحة القوى المختلفة التي تملك السلطة والنفوذ والمال، وهو ما أصبح يقود اتجاه الخدمة، وأصبح المستخدمون، في هذه الحالة إن صحّت، لا أكثر من بيادق تحسب أنها تتحرك بإرادتها، فيما تقودها أيد خفيّة، وكان التوقف هو الخيار الوحيد المتاح أمام عدد كبير من المستخدمين، وجدوا أنفسهم محاصرين وسط حروب كراهية ثقافية، لم تكن معنية بغير إلغاء الآخر، وتضخيم الذات، أو التسلية السخيفة على السقطات اللسانية، واحتساب الزلات، كمن يكمنون في زاوية الشارع للحديث على عيوب الناس، نفوس متأزمة ومثقفين تأزيميين يشرّحهم العبّاس بما لا مزيد عليه:
“من يفحص طبيعة الخطاب الذي يتبناه ذلك الفصيل من المغرّدين (من يعتبرون أنفسهم مشاهير تويتر) فسيجد أنه على غاية من الالتصاق إلى حد الاستنقاع في أمراض الثنائيات الحادة.. لأن لعبة الحضور التويتري تعتمد في المقام الأول، بالنسبة لتلك الذهنيات، على مقدار الرغبة والقوة في استفزاز الآخر.”
لكن ألا يبدو اليوم بوضوح أن تلك النماذج رأت واقع الحال، “الحالة” بالتعبير الرقمي الشائع اليوم، وعرفت كيف تتصيّد منه، وهو ما أدى إلى صعود السخافة والرداءة، دون تعميم طبعًا، وتسيدها للمشهد التويتري بوصفهم كما يسميهم العبّاس “سادة المشهد التويتري”
في المحصلة يعيدنا كل ذلك إلى تعليق ورأي قديم للمفكر المعاصر المعروف نعوم تشومسكي في تويتر: “تويتر يتطلب أفكارًا موجزة في غاية الاختصار، وذلك يؤدي للسطحية، ويجذب الناس بعيدًا عن التواصل الحقيقي الجاد، والذي يتطلب معرفة الآخر، وما يفكر به الآخر، والتفكير بنفسك فيما تود الحديث حوله، الخ، إنه ليس وسيط تبادل حقيقي.” هودكجين متابعة سيرل في تويتر ص١٨.
محاجة تشومسكي تقوم على الحجم، المساحة المتاحة للتعبير، وهي محاججة تستنتج من الحجم ولادة السطحية، فإذا دققنا في الحجم التأسيسي رأيناه أنسب لنوع مقتضب من التواصل، بدائي، ولعل ذلك فعلًا هو ما حصر التواصل في محصلة الخوارزميات بشكل ما ليصبح تواصل كراهية وقسر وهدم أكثر منه تواصل تفاهم واحترام وبناء.
تواصل مضاد للتواصل:
هكذا لا يبقى أمام القارئ الرقمي المتخدر، قارئ تويتر الكسول، وفق هودكجين، غير أن يبتلع حبوب النصوص المعروضة أمامه، وهو لا يتفاعل معها مباشرة، بل ببطء شديد، لأنه مصاب بنوع من التبلد الرقمي، ربما بفعل الوسيطة الرقمية نفسها، ولا يبقى أمام منتج ترياقات النصوص إلا أن يتبع المواضيع الرائجة، Trend الترند، والتي تبدو أكثر فأكثر شبيهة بالموضة، ولن نتفاجأ إن عرفنا أن الزي الشائع من معاني الترند في الانجليزية، هكذا تتكون الثقافة الرقمية المعاصرة، بين ركود وخمول مستهلكيها، والحالات النفسية المتطرفة التي تتحكم بمنتجيها، بين الخمول الزائد والنشاط الزائد، لتعطينا حالة لا يفلح في معالجتها لا محتوى التغريدة ولا كل الأزرار الموضوعة للتواصل في كل تغريدة، ولا النداءات الرقمية النبيلة، فيما تفلح في جذب انتباه القارئ واستثارته أكثر المجابهات، ومحتويات العنف، المحاجّات، اللعان، المباهلات، ومصارعات الديكة الفكرية، أو الثيران، معارك البرهنة المستميتة على الصواب والخطأ، أمهات أجواء الصراخ والزعيق، ومتواليات الشتم، والسب، والسخرية، شيئًا فشيئًا تحول تويتر بالفعل إلى غابة وحوش، أو سوق صاخب بالأبواق، غابت فيها لحظة المتأمل، وصعد الزعيق، حتى يعن لنا التساؤل إن لم يكن تويتر بالنسبة لغالبية مستخدميه لعبة فيديو، أو نسخة محدثة غير معترف بها بعد من ما أطلق عليه في فترة ما تلفزيون الواقع؟
طبعًا يبقى التساؤل قائمًا إن كان ذلك بفعل المستخدمين أنفسهم أم بسبب طبيعة الوسيطة الرقمية وخوارزمياتها؟ لكن بغض النظر عن ذلك ففي النهاية هناك إنسان ما أينما كانت الجهة التي يقفها من هذه الخدمة الرقمية، ولا شك أن هذا الحديث بأكمله لا ينطبق على تويتر وحده، بل تشاركه بقية المواقع الإلكترونية المعروفة نفس الطابع، نفس إمكانيات التلاعب، حتى لا يجد القارئ والكاتب لأنفسهما بدًا من الاستجابة، ولو على مضض، لاتجاه الموجة السائدة، بوصفها النموذج الرائج الذي يلاقي احتفاء الأغلبية، والابتعاد عن الخط الذاتي الذي قد لا يجد القبول العام.
مقاومة دائمة وتواصل مضاد
لكن المثقف خاصة، لا يمكنه أن ينسى أن الثقافة كما عرفها إدوارد سعيد هي منزل مقاومة دائمة، وهي تساؤل قبل كل شيء خاصة للسائد والثابت، وهذا ما يجعل الشد والجذب قائمًا كما كان، بين وسائل إعلام موجهة وأقلام حرة، لا تستسلم للوهم الذي يداعب العامة بوصفهم خبراء في كل وأي شيء، لأن ذلك لا يعبّر إلا عن نقيضه، وهو الافتقار لأي خبرة حقيقية في أي شيء كان، وليست مواقع التواصل شرًا مطلقًا كما حاولت الأنظمة الخائفة من التغيير تصويرها، لكنها كذلك ليست خيرًا مطلقًا، بل كالعادة وكما في المثل الشائع يولد الخير من بطن الشر.
إن نص تويتر ليست التغريدات التي تكتب فيه فحسب، بل حركة تلك التغريدات كذلك وتقديمها وتأخيرها وإبرازها وطمرها، وكل ما تنتجه خوازمياته من أساليب تحريرية، كل تلك جزء لا يتجزأ من النص الكامل، والقارئ مطلوب منه أن يتحول إلى شبه عرّاف كما اقترح رولان بارت مرة، لكن هناك داخل كل تواصل أدبي، نوع من الضجيج كما يذكرنا رولان بارت، بل ونوع من عيوب التواصل: الآداب في مجملها فنون ضجيج: ما يستهلكه القارئ، هو هذا العيب في التواصل، وهذا الخصاص في الرسالة؛ ما تشيّده البنيَنة (المابين) بحذافيرها لأجله وتمده إليه، بوصفه أنفس الأغذية، هو المضاد للتواصل؛ القارئ متواطئ وشريك.. مع الخطاب نفسه، باعتباره يلعب لعبة تقسيم الاستماع، عدم صفاء التواصل.
رولان بارت، س/ز، ت. محمد البُكري، ص٢٠٠. قد يستمر موقع تويتر وغيره أو يجري استبدالها بمواقع أخرى، لكن المؤكد أن خطاب التواصل نفسه، وهو البطل حسب رولان بارت، يبقى أعلى من تلك التقنيات بما أنه طبيعة بشرية لكائن اجتماعي الطبع، وبغض النظر عن الراهن فإن ما قد يبدو لنا خوارزميات متلاعب بها أو خمولًا ظاهريًا في التفاعل هو نفسه ما يوطّد في أعماق التيار أسس التواصل الحقيقي، وداخل بطن ضجيج الآليات والأزيز الكهربائي يشق نهر جديد بين الثقافات المختلفة مجراه، وأقل ما أنجزه حتى الآن على الأقل هو فتح الأبواب المغلقة، حتى وأن بدا لنا الآن أن ذلك لا يغير شيئًا من حولنا، بل يلد مزيدًا من الانغلاق والتقوقع، فمن زاوية أخرى يبدو كل ذلك الانغلاق والتقوقع ليس أكثر من لحظة تردد، وشك، وانعدام ثقة، في ذات تدور حول نفسها أمام نوافذ جديدة مفتوحة، مثل بضع أوراق الشجر على الأرض، أو على ضفة النهر، لا تمنحها تيارات الطبيعة غير برهة، ليتوازن جسمها وتتأهب للسباحة والطيران، قبل أن يحركها هي الأخرى في خضم التيّارات