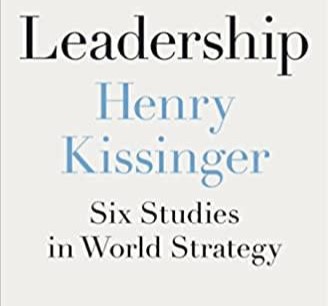الكتاب : القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية الدولية
المؤلف : هنري كيسنجر
الناشر: Penguin Press, 2022
عدد الصفحات : 528.
لغة الكتاب : الانجليزية.
في زمن تراجعت فيه القيادة وتأثيرها على المستوى العالمي، وأصبحت وظيفة روتينية مثل الكثير من الوظائف الإدارية الإعتيادية، كان لابد من بيان عملي ومفصل عن طريق شخص عاصر الكثير من الأحداث السياسية العالمية التي غيرت مسار التاريخ من جهة، وساهم في تغيير وتحليل الكثير من المعطيات والأحداث المختلفة.حيث أن هذا البيان لا يمكن القيام به دون سرد الكثير من القصص العملية التي حدثت في أزمنة تاريخية معاصرة ولكنها مختلفة.فهذه التجارب تعاملت مع وقائع مختلفة، وظروف متباينة، لكنها كانت تتسم بطابع القيادة الذي كما نراه لاحقا ً يمتلك الكثير من السمات والوظائف المختلفة.
يرى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد نيكسون(1969م – 1974م)، وجيرالد فورد (1974م- 1977م)، في عمله الجديد بأن القادة، يفكرون ويتصرفون عند تقاطع محورين: الأول، بين الماضي والمستقبل.والثاني، بين القيم الراسخة وتطلعات من يقودهم.حيث يجب أن يوازنوا بين ما يعرفونه، والمستمد بالضرورة من الماضي، وما يتخيلونه عن المستقبل، والذي هو بطبيعته تخميني وغير مؤكد، فهذا الفهم الحدسي للاتجاه هو الذي يمكّن القادة من تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجية.
ففي هذا العمل يحلل كيسنجر حياة ستة قادة غير عاديين – بحسب وجهة نظره – من خلال الإستراتيجيات المميزة لفن الحكم، والتي يعتقد أنهم جسدوها، فبعد الحرب العالمية الثانية، أعاد كونراد أديناور Konrad Adenauer ألمانيا المهزومة والمفلس أخلاقياً إلى مجتمع الأمم من خلال ما يسميه كيسنجر “استراتيجية التواضع” “The Strategy Of Humilit.بينما وضع شارل ديغول فرنسا إلى جانب الحلفاء المنتصرين وجدد عظمتها التاريخية من خلال “استراتيجية الإرادة، في حين ” خلال الحرب الباردة، أعطى ريتشارد نيكسون ميزة جيواستراتيجية للولايات المتحدة عن طريق “استراتيجية التوازن”. وبعد خمسة وعشرين عاما ً من الصراع، جاء أنور السادات برؤية سلام إلى الشرق الأوسط – كما يرى كيسنجر – من خلال “إستراتيجية السمو”. كما أنشأ لي كوان يو مدينة – دولة قوية، في سنغافورة متحديا ً بذلك الصعاب والخلافات الكثيرة، من خلال “إستراتيجية التميز”.وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت تُعرف باسم “رجل أوروبا المريض” عندما وصلت مارجريت تاتشر إلى السلطة، فقد جددت معنويات بلدها والموقف الدولي عن طريق “استراتيجية القناعة”.
ذلك أن أي مجتمع، بغض النظرعن نظامه السياسي، يمر بشكل دائم بين الماضي الذي يشكل ذاكرته ورؤية المستقبل التي تلهم تطوره. على طول هذا الطريق، لا غنى عن القيادة: حيث يجب اتخاذ القرارات، وكسب الثقة، والوفاء بالوعود، وطريقة مقترحة للمضي قدماً،ففي داخل المؤسسات البشرية – الدول والأديان والجيوش والشركات والمدارس – هناك حاجة للقيادة لمساعدة الناس على الوصول من حيث هم إلى حيث لم يكونوا من قبل.وفي بعض الأحيان، لا يمكنهم أن يتخيلوا الذهاب للمستقبل، فمن دون قيادة، تنحرف المؤسسات، وتتعرض الدول لانعدام الأهمية المتزايد، وفي النهاية، تقع الكوارث.
فلكي تُلهم الاستراتيجيات المجتمع، يجب أن يعمل القادة كمعلمين، عن طريق توصيل الأهداف، وتهدئة الشكوك وحشد الدعم.ففي حين أن الدولة تمتلك من حيث التعريف احتكار القوة، فإن الاعتماد على الإكراه هو أحد أعراض عدم كفاية القيادة؛ ذلك أن القادة الجيدون يثيرون في شعبهم الرغبة في السير إلى جانبهم، كما يجب عليهم أيضا ً أن يلهموا بطانتهم بشكل ٍ مباشر وفوري لترجمة تفكيرهم بحيث يؤثر على القضايا العملية اليومية، فمثل هذا الفريق الديناميكي المحيط هو المكمل المرئي للحيوية الداخلية للقائد؛ فهذا الفريق يوفر الدعم لرحلة القائد ويخفف من معضلات القرار، فعن طريق صفات هذه البطانة تنعكس الصورة الحقيقية للقائد كما يرى كيسنجر.
فالقيادة ليست من الكماليات بل هي ضرورية للغاية وبشكل ٍ خاص خلال الفترات الانتقالية، أوعندما تفقد القيم والمؤسسات أهميتها، وتكون الخطوط العريضة للمستقبل موضع جدل.ففي مثل هذه الأوقات، يُطلب من القادة التفكير بشكل خلاق ودقيق وطرح أسئلة مهمة، مثل: ما هي مصادر رفاهية المجتمع؟ ما الذي جعلها تتراجع؟ ما هو ميراث الماضي الذي يجب الحفاظ عليه، وكيف يتم تكييفه أو التخلص منه؟ ما هي الأهداف التي تستحق الالتزام وما هي الخيارات التي يجب رفضها مهما كانت مغرية؟
غير أن القادة ليسوا أحرارا ً، فهم محاصرون بالكثير من القيود والعقبات والتحديات.فهم يعملون في ندرة من الموارد في معظم الحالات، لأن كل مجتمع يواجه حدودا ً لقدراته ونطاقه، تمليه الديموغرافيا والاقتصاد. حيث أن هذه القرارات لا تعمل في كل الأوقات بل تصلح في بعض الأوقات المناسبة، ذلك أن لكل عصر ولكل ثقافة قيمها وعاداتها ومواقفها السائدة التي تحدد النتائج المرجوة.فالقادة ليسوا وحدهم في الميدان بالرغم من انفراد الكثير منهم بالسلطة، لأنهم يجب أن يتعاملوا مع لاعبين آخرين – سواء كانوا حلفاء أو شركاء محتملين أو خصوم أو حتى مواطنين – الذين ليسوا جامدين بل متكيفين ويسعون للتأقلم مع المعطيات المختلفة، ومع قدراتهم وتطلعاتهم الخاصة. علاوة على ذلك، غالبًا ما تتحرك الأحداث بسرعة كبيرة جدا ً للسماح بإتخاذ قرارات دقيقة وحاسمة؛ غير أنه أحيانا ً يتعين على القادة إصدار أحكام تستند إلى الحدس و الفرضيات التي لا يمكن إثباتها وقت اتخاذ القرار.فإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية للقائد مثل المهارة التحليلية.
لا يكتفي كيسنجر بالحديث النظري فقط، بل يناقش ست حالات معينة – كما سبق القول – وهي مرتبطة بالدرجة الأولى بسياقها التاريخي الذي لا نستطيع الفرار منه، أو تجاهله.فالجمع بين الشخصية والظروف هو الذي يصنع التاريخ، والقادة الستة الذين تم وصفهم سابقا ً قد تشكلوا جميعا ً وفقا ً لظروفهم الدرامية، والحقبة التاريخية، ثم أصبحوا جميعا ً أيضا ً مهندسي تطور مجتمعاتهم بعد الحرب والنظام الدولي.كان من حسن حظ كيسنجر كما يقول أنه قابل هؤلاء القادة الستة جميعا ً في ذروة تأثيرهم وعمل معهم بشكل ٍ وثيق في فترة ريتشارد نيكسون.لقد ورثوا عالما ً تلاشت حقائقه المؤكدة بسبب الحرب، وأعادوا تعريف الأهداف الوطنية، وفتحوا آفاقا ً جديدة، وساهموا في بناء هيكل جديد لعالم يمر بمرحلة انتقالية، كما يرى وزير الخارجية الأمريكية.
حيث عبر كل واحد من القادة الستة، بطريقته أو بطريقتها، عبر الخط الناري ل”حرب الثلاثين عاما ً الثانية” – أي سلسلة الصراعات المدمرة التي امتدت من بداية الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914م حتى نهايتها، ومن الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1945م. مثل حرب الثلاثين عاما ً الأولى، بدأت الحرب الثانية في أوروبا ولكنها انتقلت إلى العالم الأكبر.فالأولى حولت أوروبا من منطقة كانت الشرعية فيها مستمدة من العقيدة الدينية ووراثة الأسرة الحاكمة إلى نظام قائم على المساواة السيادية للدول العلمانية مع رغبة في نشر مبادئها في جميع أنحاء العالم.بعد ثلاثة قرون، تحدت حرب الثلاثين عاما ً الثانية النظام الدولي بأكمله للتغلب على خيبة الأمل في أوروبا والفقر في معظم أنحاء العالم بمبادئ جديدة لنظام عالمي جديد.
يستدعي كيسنجرلتوضيح وجهات نظره حول القيادة من مثالين للقيادة: رجال الدولة والأنبياء، حيث يرى أن معظم القادة ليسوا أصحاب رؤية ولكنهم إداريين. ففي كل مجتمع وفي كل مستوى من مستويات المسؤولية، هناك حاجة إلى وكلاء بشكل ٍ يومي لتوجيه المؤسسات الموكلة لرعايتهم. لكن خلال فترات الأزمات – سواء كانت حربا ً أو تغيرا ً تكنولوجيا ً سريعا ً أو اضطرابا ً اقتصاديا ً متناقضا ً أو اضطرابا ً أيديولوجيا ً – قد تكون إدارة الوضع الراهن هي المسار الأكثر خطورة على الإطلاق، حيث تستدعي مثل هذه الأوقات قادة تحوليين.
يفهم رجال الدولة بُعد النظر أن لديهم مهام أساسية مزدوجة.الأولى هي الحفاظ على مجتمعهم من خلال التلاعب بالظروف بدلاً من أن تطغى عليهم، وذلك بتبنى هؤلاء القادة التغيير والتقدم، مع ضمان احتفاظ مجتمعهم بإحساسه الأساسي بنفسه من خلال التطورات التي يسعو للقيام بها داخله. والثاني هو تلطيف الرؤية بالحذر، وإضفاء الشعور بحدود الأشياء والتحولات.مثل هؤلاء القادة يتحملون المسؤولية ليس فقط للأفضل ولكن أيضا ً عن أسوأ النتائج. إنهم يميلون إلى إدراك الآمال العديدة التي فشلت، والنوايا الحسنة التي لا حصر لها والتي لا يمكن تحقيقها، والإصرار العنيد في الشؤون الإنسانية على الأنانية والجوع والعنف. في هذا التعريف للقيادة كما يرى كيسنجر، يميل رجال الدولة إلى إقامة تحوطات ضد احتمال أنه حتى أكثر الخطط جيدة الصنع قد تفشل، أو أن الصياغة الأكثر بلاغة قد تخفي الكثير منبذور الفشل.إنهم يميلون إلى الشك في أولئك الذين يخصصون السياسة، لأن التاريخ يعلمنا هشاشة الهياكل التي تعتمد إلى حد كبير على شخصيات فردية، فهم طموحون ولكن ليسوا ثوريين، كما انهم يعملون ضمن ما يعتبرونه ذروة التاريخ، ويدفعون مجتمعاتهم إلى الأمام بينما ينظرون إلى مؤسساتهم السياسية وقيمهم الأساسية على أنها موروث يجب نقله إلى الأجيال القادمة (وإن كان ذلك مع التعديلات التي تحافظ على جوهرها). سوف يدرك القادة الحكماء في وضع رجل الدولة متى تتطلب الظروف الجديدة تجاوز المؤسسات والقيم القائمة. لكنهم يدركون أنه لكي تزدهر مجتمعاتهم، سيتعين عليهم ضمان ألا يتجاوز التغيير ما يضمن للمنظومة بالإستمرار بالرغم من كل الظروف المحيطة.يشمل رجال الدولة هؤلاء – كما يرى كيسنجر – قادة القرن السابع عشر الذين صاغوا نظام دولة ويستفاليا، بالإضافة إلى قادة أوروبيين في القرن التاسع عشر مثل بالمرستون وجلادستون ودزرائيلي وبسمارك، بينما في القرن العشرين، كان ثيودور وفرانكلين روزفلت ومصطفى كمال أتاتورك وجواهر لال نهرو جميعا ً قادة في نمط رجل الدولة.
النوع الثاني من القادة – أي ذو البصيرة، أو الأنبياء – الذين يتعاملون مع المؤسسات السائدة بشكل أقل من منظور الممكن منه من رؤية الضرورة، حيث يستدعي القادة النبويون رؤاهم المتعالية كدليل على صلاحهم، فهم يتوقون إلى لوحة قماشية فارغة يضعون عليها تصاميمهم. فضيلة الأنبياء أنهم يعيدون تعريف ما يبدو ممكنا ً، إنهم “الرجال غير المنطقيين” الذين نسب إليهم جورج برنارد شو “كل التقدم الممكن حدوثه”، وذلك إيمانا ً منهم بالحلول النهائية، حيث يميل القادة النبويون إلى عدم الثقة في التدرج باعتباره تنازلًا غير ضروري عن الظروف وسياقات المرحلة؛ ذلك أن هدفهم هو تجاوز الوضع الراهن بدلاً من إدارته.وهذا ينطبق على أخناتون، وجوان دارك، وروبسبير، ولينين، وغاندي هم من بين القادة النبويين للتاريخ.
قد يبدو الخط الفاصل بين الوضعين كبيرا ً ولا يمكن ردمه ؛ لكنها ليست كذلك.حيث يمكن للقادة الانتقال من وضع إلى آخر، أو أخذ وجهات نظر طرف بينما يسكن إلى حد كبير في الطرف الآخر، حيث انتمى تشرشل في “سنوات الحياة البرية” وهي تسمية لمنفاه القسري من المنصب السياسي في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، وديغول كزعيم للفرنسيين الأحرار، لهذه المراحل من حياتهم، في النوع الثاني، كما فعل السادات بعد عام 1973م، كتوليفة من كلا الاتجاهين، على الرغم من الميل نحو رجل الدولة.
غالبا ً ما تكون المقارنة بين هذين الأسلوبين محبطة، وهذا ناتج عن مقاييس مختلفة لقياس نجاحاتهما: ففي حالة رجال الدولة يقع الاختبار على عمل واستجابة متانة الهياكل السياسية تحت الضغط، بينما يقيس الأنبياء إنجازاتهم مقابل المعايير المطلقة.فإذا قام رجل الدولة بتقييم مسارات العمل المحتملة على أساس فائدتها بدلاً من “حقيقتها”، فإن النبي يعتبر هذا النهج تدنيسا ً للمقدسات، وانتصارا ً للمنفعة على المبدأ العالمي. بالنسبة لرجل الدولة، يعتبر التفاوض آلية للاستقرار. بينما بالنسبة للنبي، يمكن أن يكون وسيلة لتحويل أو إضعاف معنويات الخصوم.وإذا كان الحفاظ على النظام، بالنسبة لرجل الدولة، يحدث عن طريق تجاوز أي نزاع داخله، فإن الأنبياء يسترشدون بهدفهم ومستعدون لقلب النظام القائم.
من الممكن اعتبار كلا الأسلوبين في القيادة تحوليين أو يقومان بتحول كبير في المجتمع، خاصة في فترات الأزمات، على الرغم من أن الأسلوب النبوي، الذي يمثل لحظات تمجيد، عادة ما ينطوي على مزيد من الاضطراب والمعاناة. فلكل نهج له خصومه ومعادوه أيضا ً.حيث أن رجل الدولة يسعى لهذا التوازن، على الرغم من أنه قد يكون شرطا ً للاستقرار والتقدم على المدى الطويل، إلا أنه لا يخفي زخمه الخاص.في حين بالنسبة للنبي، فإن الخطر هو أن الحماسة قد تُغرق البشرية في اتساع الرؤية وتحول الفرد إلى موضوع.
فمهما كانت الخصائص الشخصية للقادة أو أنماط عملهم، فإنهم يواجهون حتما ً تحديا ً لا هوادة فيه: منع مطالب الحاضر من التغلب على طموحات المستقبل، فالقادة العاديون يسعون إلى إدارة الأحداث الفورية واللحظية؛ بينما العظماء يحاولون رفع مجتمعهم إلى مستوى رؤاهم. لقد تمت مناقشة كيفية مواجهة هذا التحدي في العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر وتحديدا ً حول العلاقة بين الإرادة والحتمية. كان الحل يُعزى بشكل متزايد إلى التاريخ كما لو أن الأحداث طغت على الرجال والنساء من خلال عملية واسعة كانوا أدوات فيها، وليسوا مبدعين بمحض إرادتهم. ففي القرن العشرين، أصر العديد من العلماء، مثل المؤرخ الفرنسي البارز فرناند بروديل، على النظر إلى الأفراد والأحداث التي يشكلونها على أنها مجرد “اضطرابات سطحية” و “قمم من الرغوة” في بحر أوسع من المد والجزر الواسع الذي لا يمكن تجنبه. إن كبار المفكرين – المؤرخون الاجتماعيون والفلاسفة السياسيون ومنظرو العلاقات الدولية على حد سواء – قد عزوا أو أرجعوا هذه الأحداث لقوى مثل القدر، وذلك، قبل “الحركات” و “الهياكل” و “توزيعات القوة”، التي يُقال، بأنها تُحرم الإنسانية من كل خيار – وبالتالي، لا يمكن إلا أن تتخلى عن كل المسؤولية. هذه ، بالطبع، مفاهيم صالحة للتحليل التاريخي، ويجب على أي زعيم أن يدرك قوتها، لكن يتم تطبيقها دائما ًعن طريق الأفراد ويتم تصفيتها من خلال الإدراك البشري، ومن المفارقات أنه لم تكن هناك أداة أكثر فاعلية للتوحيد بين هذه القوى التي تبدو متناقضة من قبل الأفراد بديلا ً عن نظريات قوانين التاريخ الحتمية.
والمسألة التي يطرحها هنا هي ما إذا كانت هذه القوى ثابتة لجميع اللحظات التاريخية أم خاضعة للفعل الاجتماعي والسياسي المشروط من التاريخية.فالفيزياء تُعلمنا أن الواقع يتغير من خلال عملية الملاحظة، بينما يعلمنا التاريخ بالمثل أن الرجال والنساء يشكلون بيئتهم من خلال تفسيرهم لها. والسؤال الختامي هنا: هل الأفراد مهمون في التاريخ؟ لن يفكر أي شخص معاصر لقيصر أو محمد أو لوثر أو غاندي أو تشرشل أو روزفلت في طرح مثل هذا السؤال، حيث أن هذه الصفحات تتعامل مع القادة الذين فهموا، الصراع اللامتناهي بين الإرادة والحتمية، أن ما يبدو حتميا ً يتغير بالفاعلية البشرية.لقد كانوا مهمين لأنهم تجاوزوا الظروف التي ورثوها وبالتالي حملوا مجتمعاتهم إلى حدود الممكن.