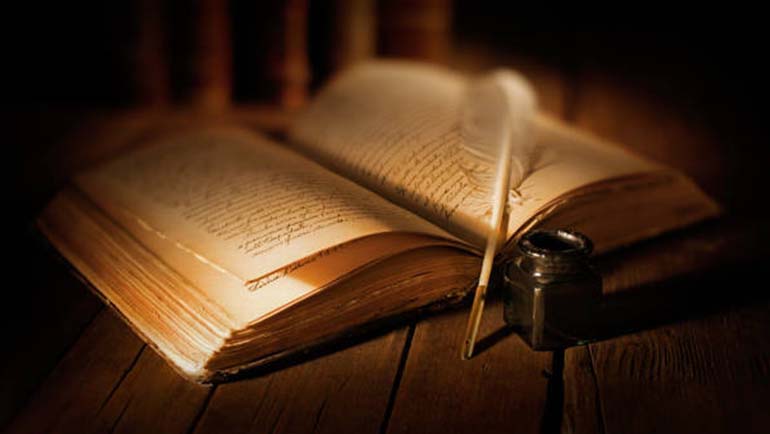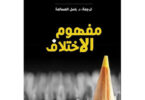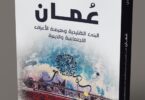تتسع الدائرة الفِقهية بالآراء المتنوعة والمتعددة، وهذا بحد ذاته إثراء معرفي وثقافي؛ فمن يتصفح المدوّنات الفقهية يجدها تزخر بمختلف المعلومات والأقوال، ويكاد لا يُطرحُ رأيٌ عصريٌ في مسائل الدين إلا وقال به المتقدمون أو لا يخرج عن تأصيلهم وتقعيدهم، لدرجة أن البعض قال: “ما ترك الأولُ للآخر شيئًا”، وإن كنا لا نتفق مع هذه المقولة؛ لأن هذه المقولة إجهاض للمعرفة، وقد نقدها السابقون حتى قال الجاحظ في (البيان والتبيين): “إذا سمعت الرجل يقول ما ترك الأول للآخر شيئًا؛ فاعلم أنه ما يريد أن يفلح”؛ لكن المقولة السابقة أيضًا تشير إلى التوسع المعرفي الذي تركه الأوائل لنا.
إن تعدد الآراء وتنوعها ليس خطأ؛ بل هو أمر محمود لاختلاف الأزمنة والأمكنة والاجتهادات والفهم، وهذا من طبيعة الحراك المعرفي التراكمي لتتقدم العقول وتتنوع الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية، بيد أنه من الخطأ بمكان إخفاء هذه الآراء عن الناس بحجة أنهم (عوام)، فلا تقال للعوام؛ لأن (العوام) قد يتساهلون في أمور الدين أو أنهم قد يأخذون بالرُّخَص أو قد يؤدي ذلك إلى تمييع الدين، هكذا ينظر إليهم البعض.
إن مقولة “لا يقال للعوام” أو “لا يظهر للعوام”، مقولة خطيرة جدًا؛ لأنها تتناقض مع منهج القرآن الذي يدعو إلى العلم والمعرفة؛ فـ(العوام) أو بالأحرى الجمهور لكي ننقلهم من مرحلة (العوام) إلى مرحلة (الخواص) علينا أن نعلمهم ونثقفهم، وذلك لا يكون إلا إذا عَرَّفناهم بهذه الآراء وتنوعها، ثم الذين يحذرون من إظهار هذه الأقوال للعوام هم أنفسهم الذين يعظون الناس ويحذرونهم من كتمان المعرفة والعلم بالرواية القائلة: “من سُئِل عن علم؛ فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار”، وربما يجدون لأنفسهم مخرجًا؛ فيجيزون كتم العلم والمعرفة إنْ كان في ذلك مصلحة، غير أن كل شخص أدرى بمصلحته وليس المسؤول أو رجل الدين هو أدرى بمصلحة السائل، وكيف تكون المصلحة في كتم العلم والمعرفة؟! فكتمان العلم والمعرفة هو هيمنة وسيطرة على الناس لإبقائهم في الجهل، والرسول عليه السلام لم يكن يكتم شيئًا؛ بل امتثل أمر ربه وبلَّغ ما أوحي إليه {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} المائدة: 67، لهذا لم يأت ليسيطر على الناس ويبقيهم في الجهل؛ بل جاء يذكرهم كما ذكر القرآن: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} الغاشية:21-22.
ذكر فرانسيس بيكون بأن “المعرفة قوة”؛ فإن كانت قوة فلما لا نقدمها للناس؟! هل خشية أن يكونوا أقوى منا؟! وعندما نتأمل العبارة “المعرفة قوة” هي قوة في العقل وقوة في الحرية وقوة في الشخصية وقوة في التقدم وقوة في الإيمان، لذا يفترض أنْ لا يَخشى الذين يكتمون الآراء عن (العوام) على حد تعبيرهم من هذه القوة؛ لأنها ستزيد (العوام) إيمانًا وحرية وعقلًا وشخصية بدلًا من إساءة الظن بهم بالخشية عليهم من التساهل في الدين، وكأنهم هم المسؤولون عن الدين، الدين له رب غني عن العباد؛ لذا لا داعي للخشية من ضياعه أو التساهل فيه، الدين عَلاقة بين العبد والرب، لا يتدخل فيها أحد.
كتم ذكر اختلاف الآراء وتنوعها في المسألة الواحدة بحجة أن (العوام) سيأخذون بالرخص؛ فالرُّخَص في حقيقتها هي ليست رُخَصًا؛ وإنما هي رأي صدر من فقيه مجتهد، له اعتبار في المعرفة، ورأيه مبني على حجة، وبغض النظر عن قوة الحجة وضعفها لأن ذلك أمر نسبي، غير أن من حق أي شخص اقتنع بها أن يأخذ بذلك الرأي، وعليه لا يعد من أخذ برأي من الآراء متتبعًا للرخص؛ لأنه أخذ بدليل مقتنع به، بالإضافة إلى أن الأخذ بالرخص له اعتبار وذكر في القرآن الكريم؛ فالله تعالى جعل الدين يسرًا سهلًا لا تكلف فيه ولا تعنت، فقال:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة:185، وروي عن النبي عليه السلام: (إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا؛ ولكن بعثني معلمًا ميسرًا)، ثم هل كتم الرأي خشية على الناس من تتبع الرخص أن الكاتم هو المسؤول عن دين هؤلاء الناس؟! إن لهم ربًّا يراهم ويحاسبهم، وهل الدين ضعيف لكي نخشى عليه؟!
يعد البعض الأخذ برأي يخالف السائد هو من التمييع بالدين، وهو اعتبار في غير محله؛ لأن الدين قوي متين، والآراء ليست هي الدين، الآراء اجتهاد، والاجتهاد يؤخذ ويرد، ويتكون وفق متغيرات الزمن والمكان واجتهادات الأفراد والجماعات وأفهامهم، وتتأثر الآراء بالمتغيرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها؛ فمن أخذ برأي يراه صحيحًا ليس تمييعًا للدين، بل يفعل ذلك لقناعاته التي ربما تتوافق مع الإسلام أو العقل أو الزمان والمكان، لذا يقول ناصر بن أبي نبهان: “لو كانت مسألة رأي واتفقت على رأي من آرائها جميع أهل السماوات والأرض، ورأى أحد غير ذلك أقوى وأقرب للحق، ما جاز له أن يحكم إلا بما أراه الله أنه الحق”.
يتهم البعض الأشخاص الذين يأخذون برأي مخالف للسائد أنهم متبعون للهوى، وهذا الاتهام هو سوء ظن ما لم يدخل في قلوبهم أو أن يعترفوا له بأنهم أخذوا ذلك وفق هواهم، وقد يكون الرأي السائد لا يعرف أحد من الناس من أين جاء أو كيف قيل أو ما هي حجته؛ فلذلك لا يؤخذ به، ويا ليت بعض فقهاء اليوم يحذون حذو أبي حنيفة القائل: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه)، وقد يكون الرأي السائد فيه شدة أو لا ينسجم مع متطلبات العصر كما هو واقعنا اليوم؛ فكثير من الآراء تجاوزها الزمن، ومازال بعض الفقهاء يتغنون بها ويدعون إليها، وربما الرأي السائد أو المتشدد أو غير المنسجم مع متطلبات العصر يُتمسك به ويُدعى إليه لهوى في نفس أحدهم؛ لأن اتباع الهوى ليس فقط في الأخذ بالرأي الأيسر والأخف والمنسجم مع متطلبات العصر، بل قد يكون اتباع الهوى في الآراء المتشددة والمبتعدة عن روح العصر لأنها أيضًا لا تخلو من هوى.
إن لفظة (العوام) ومفردها (عامي) للتمييز بين جمهور الناس وبين الفقيه أو رجل الدين للتقليل من شأنهم في هذا المجال، وربما لإبعادهم عن التحدث في أمور الدين؛ فلا أحبذ إطلاقها على جمهور الناس من المسلمين، ففي ذلك مغالطة كبيرة؛ لأن الدين عند الله الإسلام وهؤلاء كلهم مسلمون، أما المعرفة؛ فهي نسبية من شخص إلى آخر، حتى الفقيه هناك من هو أفقه منه؛ فهل نسميه (عاميًّا) لأن هناك من هو أفقه منه؟! وجمهور الناس تتفاوت المعرفة الدينية بينهم، كما تتفاوت بين الدارسين لها، وكلٌ أخذ نسبة معينة، وإلا لصح أيضًا إطلاق لفظة (العوام) على رجال الدين والفقهاء في المجالات الأخرى، فهم لم يدرسوا المعارف الأخرى كالمعرفة النفسية والاجتماعية والتاريخ وعلم الطب والبيولوجيا وغيرها؛ لكن ربما لدى بعضهم معرفة نسبية ويسيرة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، فهم عوام في هذا المجال.
إن استخدام لفظة (العوام وعامي) للتقليل أو التقزيم من شأن المسلم بين رجال الدين أمر يرفضه الإسلام ذاته؛ لأن الإسلام ساوى بين الجميع، والمعرفة درجات ونسب لا تدعو إلى التقليل والتقزيم، بل العارف والعالم يتواضع مع جمهور الناس ومختلف شرائح المجتمع دون إطلاق هذه الألفاظ التمييزية بينهم.
يظهر من إظهار الآراء وتثقيفها للناس أن ذلك ينقل الناس إلى مستوًى واعٍ وراقٍ في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع ومختلف الآراء، وربما ينتج هؤلاء الناس آراءً جديدة تفيد المجتمع. والإنسان الذي يفهم بأن المسألة الواحدة فيها أكثر من رأي؛ تذهب عنه نزعة التشدد والتزمت، ويتعامل مع الناس بكل أريحية لأنه مدرك أن في ذلك سعة؛ فيتعايش بكل محبة ووعي مع كل الآراء وكل المذاهب والأفكار، وبلا أي غضاضة أو تهكم أو ازدراء؛ فالاختلاف كما يقال “لا يفسد للود قضية”، ولا يمنع الناس أن تأخذ بما شاءت مما وقع فيه الاختلاف، كما قال عثمان بن أبي عبدالله الأصم: (إذا تنازع الفقهاء ذووا الرأي من المسلمين في شيء من الحلال والحرام؛ فخذوا بأيهم شئتم)، وما أكثر المسائل التي تنازعوا فيها واختلفوا، لأن دائرة الحلال والحرام واضحة في القرآن، وما عداه وقع فيه الاختلاف أو لا يخلو منه.