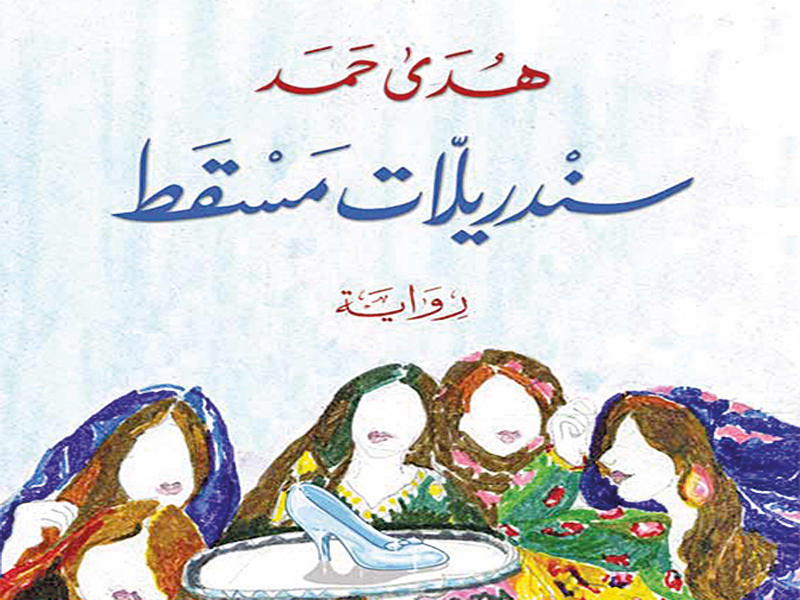(تحقيق)
ممدوح عبد الستار
أصبح اتجاه النقاد إلى الإبداع نثراً وشعراً ظاهرة لافتة، بعد أن كانت حالات فردية فيما مضى، وكان أبرز النقاد الذين يكتبون النقد والإبداع عربياً “عباس العقاد”” يحيى حقي”، و”أدوار الخراط”، و “طه حسين”، والمازني، ومن العالم الغربي” أمبرتو إيكو، و”كولن ويلسون”، و”ديفيد لودج”، و”بارغاس يوسا”، و”ميلان كونديرا”، و”ماركيز”. وبالنظر إلى ظاهرة المزج بين النقد والإبداع في العصر الحديث نجدها تعود إلى زمن بعيد، وتبدو هذه الظاهرة لافتة للانتباه في المشهد الثقافي العربي، معلنة نهاية زمن الكاتب ذي الاختصاص الأدبي الواحد، وهذا يدخل في ظاهرة أعمّ: وهي انفتاح الأجناس، وتظافرها، وترافدها، ومحو الحدود بينها. ومن خلال هذا التحقيق طرحنا السؤال: (لماذا يتجه النقاد إلى الإبداع السردي، أو الشعري؟).
يقول الدكتور الناقد والشاعر المغربي “محمد أحمد المسعودي”:
قبل الإجابة عن السؤالين الهامين اللذين طرحتهما، سأطرح بدوري سؤالاً: (كيف يصبح الناقد ناقداً، والسارد سارداً، والشاعر شاعراً؟) إن الجواب عن سؤالي هذا سيكون مدخلاً للجواب عما يثيره موضوع اتجاه النقاد إلى الكتابة الإبداعية شعراً، ونثراً.
مما لا شك فيه أن الشاعر، والسارد، والناقد لم يكن بإمكان أحد منهم أن يصير لما صار إليه لولا إدمانه على قراءة الأدب، والتمرس بفنونه، ومعرفتها منذ الصغر، فمن باب القراءة تتبلور الموهبة، ويأخذ كل فرد منهم مساره في الكتابة. ومن هنا أرى أن الناقد هو مبدع بالضرورة، وربما يشغله النقد والتفكير النقدي عن الكتابة الشعرية أو السردية خلال مرحلة من مراحل حياته، لكن الشغف الكامن والجذوة الإبداعية تنبثق في لحظة ما، وفي ظل حالة نفسية أو وجدانية ما، فيجد نفسه يحمل القلم لا ليكتب النقد، وإنما ليعبر بواسطة الرواية، أو القصة، أو القصيدة عما يجول في نفسه، وما يضطرم به فكره ووجدانه. ولهذا لا أجد أي غرابة في أن يتجه النقاد إلى الكتابة الإبداعية بشتى أشكالها. كما أنني أعد النقد إبداعاً من نمط آخر، وهو امتداد للكتابة السردية والشعرية غير أن قوامه التحليل والتركيب والتفسير، وهو بذلك ينفلت من إسار انسيابية التعبير الأدبي وجماليته ليلج مداخل التفكير العقلي والمنطقي في مقاربته للظاهرة الأدبية والنصوص التي يشتغل بها. ثم لا ننسى أن الناقد الجيد يشترك مع المبدع الجيد في حرصهما معاً على جمالية الكتابة وإبداعيتها، ومن هنا حينما نقرأ للنقاد الكبار، وخاصة من زاوج منهم بين الممارسة النقدية والكتابة السردية أو الشعرية، أو من خاض في مختلف فنون الأدب، نلمس رقي كتابتهم وجمال أسلوبهم الذي يأسر القارئ، ولنا في الأدب العربي الحديث أمثلة كثيرة: مصطفى صادق الرافعي، وطه حسين، وإبراهيم عبد القادر المازني، ومحمد شكري عياد، ويوسف نوفل.. وغيرهم كثير. وفي النقد الغربي نجد رولان بارت، وأمبرتو إيكو، وكولن ويلسون، وديفيد لودج.. وغيرهم يمتعون المتلقي بإبداعهم ونقدهم معاً.
وجواباً عن سؤالكم الثاني أقول: أعتد ظاهرة اتجاه النقاد إلى الكتابة الإبداعية السردية والشعرية إغناء للمشهد الأدبي، وخاصة إذا تمكن الناقد من إنتاج نصوص إبداعية وازنة تجذب القارئ وتلقى صدى في الساحة الثقافية. وأظن أن الناقد الجيد، بإمكانه أن ينتج أعمالاً جيدة أكثر من بعض الأقلام التي صارت تتطفل على الكتابة الإبداعية، وهي لا تمتلك أدنى موهبة، ولا معرفة لها بخصائص الأنواع الأدبية التي تدعي أنها تكتبها، وخاصة أن المطابع صارت تقبل طباعة كل شيء، ولم تعد دور النشر تمتلك رؤية واضحة، وإنما غشى أعينها بريق المال ورغبة الغنى الفاحش، حتى لو كان ذلك على حساب قتل اللغة الإبداعية، ونشر التفاهة والابتذال.. وهذا ما يقلقنا أكثر في المشهد الثقافي العربي.
ويحدثنا الدكتور الناقد، والمبدع المصري “مصطفى سليم” عن هذه الظاهرة:
بالنظر إلى ظاهرة المزج بين النقد والإبداع في العصر الحديث نجدها تعود إلى زمن بعيد يعيدنا إلى المشهد الأدبي في القرن العشرين، فقد كان عباس العقاد ناقداً مبدعاً، قدم النقد الذي أثرى به المشهد الأدبي والثقافي، ولم يفلت من ربة الشعر والنثر، “طه حسين” كان كذلك أيضاً بعبقرية فذة، عبرت الظاهرة ذاتها إلى بعض التابعين المخضرمين، بينهم صاحب الرؤية الثاقبة “شكري عياد” على سبيل المثال لا الحصر، بل مس الشغف بعض المبدعين أيضاً فمزجوا بين الفنين؛ الإبداع والنقد، فنجد “يحيى حقي”، و”إدوار الخراط”، فقد كانا عظيمين في الرواية كما في النقد، ولو دققنا النظر أكثر سنرصد الكثير والكثير في المشهد العربي، لو اتسعت دائرة الرصد سنجد أيضاً أمبرتو إيكو، وبارغاس يوسا، وميلان كونديرا، وماركيز وتنظيرهم في السرد، وإن اتخذ بعضهم منهجاً تعليمياً، لكنه في غاية الأهمية، خصوصاً أنه من واقع تجارب رواد هذا الفن وسادته؛ إذن نحن أمام تاريخ بعيد للظاهرة على تنوع مستوياتها الجمالية والمعرفية والجغرافية، لماذا إذن يتجه النقاد إلى الإبداع؟
من واقع تجربتي في الكتابة وعوالمها، فقد تنوع الأمر بين الجمالي، والواقعي، أما الأول؛ فقد ضاق بيّ النقد والبحث العلمي، على أهميتهما كنصٍ موازٍ للنصوص، عن البوح بما يدور في خاطري من أفكار تجلت أمامي مجسدة ومصورة على نحو درامي مليء بالحيل الفنية، فدعّمتها بالتقنيات المناسبة لها. شعرت أن صوتاً بداخلي يخبرني أن أكتب فاستجبت، فالكتابة نداهة، ومن دعي فليجب. هذا الإحساس كان مدعوماً على نحو جيد، على ما أظن، إذ جاء في وقت كنت أسعى جاهداً للتحقق من أدواتي ومهاراتي في الكتابة عبر التخصص الأكاديمي والقراءة في تاريخ الأدب والنصوص، لا سيما الرواية منها. بدأت الرحلة فأنتجت “سفر المرايا” التي حصدت جائزة دبي الثقافية في 2013، وكتبت مجموعتي القصصية “نفق سري” 2018، وتوالت التجربة في “الليالي العمياء” 2022، وحالياً أعمل على مخطوطة لرواية جديدة، قبلها بسنوات كنت قد أنجزت دراسة نقدية عن تاريخ المناظرة في التراث العربي كجنس أدبي، وانهمكتُ بعدها في رصد البُنى السردية في منجز الروائي الليبي ذي الأصول الأمازيغية إبراهيم الكوني، وتحديداً “سداسية الأسلاف والأخلاف”، ومن وحي عالمي الروائي والنقدي، على تواضعه، أرى أن الإخلاص في معايشة النصوص الأدبية بكافة أنواعها يكسب صاحبه مهارة أدبية ويمنحه بعضاً من أسرارها تثمر حين يتابعها بالتمرس، ويصقلها بالعمل الجاد وسعة الاطلاع، شريطة أن يعرف متى يفرّق وسط مخاض الكتابة بين الناقد والمبدع بداخله، والواقع أن الأمر ليس يسيراً، فكثير من نصوص النقاد لم تكن من الجودة بمكان، كما أن لكل عملية إبداعية منها آلية مغايرة تماماً تتحكم فيها نسبة إعمال الخيال الإبداعي أو الفكر النقدي. المبدع والناقد، ثنائية داخل صاحبها، حينما يراوغه المبدع أظن أن الخيال قد يصل إلى ما يزيد على 80% مقابل 20% للفكر النقدي فيما يصنع، وحينما يطرق الناقد أبواب العقل يتبادلان النسب ذاتها.
الأمر الثاني والأخير وهو الواقعي، وتمثل أمامي في “أن الأعمال النقدية مهما علا شأنها، لا تحظى بالتقدير المطلوب وتتسم بقصر العمر”، وفق ما رصد “إدوارد سعيد”، على العكس تماماً مما يحدث في حالة إنتاج نص أدبي محكم له دوي. ناهيك عن ضآلة نسبة قرّاء الأعمال النقدية، فهم قلة من الباحثين وأحياناً بعض المثقفين، قياساً بنظرائهم من القاعدة الجماهيرية من قرّاء الرواية أو الشعر، الذي إن أخلص المبدع لهما وراكم إبداعاً حقيقياً دون النظر إلى مغازلة الجمهور أو ما تطلبه الأسواق على نحو يُهين النص، ويغض الطرف عن البعد التجاري للإبداع، أظن لو حالفه الحظ يحقق جهداً مثمراً، وتحقق أعماله جماهيرية ويكون لها مكانة وقيمة في عقول وقلوب القراء، لكن هذا الأمر أحد وجوه الظاهرة؛ إذ لا تختزل المسألة في فكرة الجماهيرية والانتشار والبعد التجاري، فإذا لم يكن الكاتب موهوباً ومحترفاً بالأساس، وإذا لم يكن في منجزه تجربة جمالية حقيقة ووعي بتاريخ الفن وأدواته الذي يعمل به، مبدعاً كان أو ناقداً، فلن ينال لا هذه ولا تلك فـ”المتلفت لا يصل”. الكتابة الحقيقية خط فاصل بين الحياة والموت، نزيف للروح، وقليل من الكتّاب يبحرون في عوالمها على هذا النحو من المغامرة والتجريب والسعي نحو إضفاء وجوه وملامح وأقنعة للحياة من وحي خيالهم الخصب في محاولة لتقديم رؤية وتفسير لعوالمهم وما يجري من حولهم تهوّن من قسوتها واغترابهم الروحي فيها، وهذا كله بعيد كل البعد عن أولئك الذين يظنون في الكتابة وجاهة اجتماعية. في نهاية المطاف سيكون سؤال ماذا تبقى من الكاتب؟ بل ماذا عن أثر ما تبقى في الشأن الذي يعمل عليه ويكتب عنه؟، وبما أننا ندور في فلك الواقع، فمنه وإليه نعود، فإن هذا السؤال يطرحه الموهوبون المخلصون للفن بعدما ساد عصر التفاهة في المشهد العالمي، إذ لم يعد العالم المعاصر من حولنا يلقي بالا لأي قيمة تذكر، في أي مجال إلا نادراً، وانكفأ يفكر في الهيمنة والسطوة ونهب الثروات عبر الحروب ومآسيها هنا وهناك، وفاتورة باهظة التكاليف يدفعها إنسان العالم الرقمي. وإن شئت الحق، في تقديري، وسط هذا المناخ القاتم لم يعد البعض يسأل عن شيء بقدر ما يفعل ما عليه فعله، ولسان حاله يقول “قلها، وامض”.
ويحدثنا الدكتور الناقد والمبدع التونسي “رياض خليف”، ويقول عن هذه الظاهرة:
في حقيقة الأمر، تبدو هذه الظاهرة لافتة للانتباه في المشهد الثقافي العربي، معلنة نهاية زمن الكاتب ذي الاختصاص الأدبي الواحد وهذا يدخل في ظاهرة أعمّ: وهي انفتاح الأجناس وتظافرها وترافدها ومحو الحدود بينها. هذا هو السياق النظري الذي تبدو فيه هذه الظاهرة، ولعل الكاتب العربي يبحث أيضاً عن الجنس الأدبي الأكثر رواجاً، وانتشاراً. بالنسبة لي قد تكون رحلة معاكسة لهذا السؤال، فلقد انطلقت من أعمال أدبية إبداعية نحو النقد، وليس من النقد إلى الإبداع. نشرت الشعر والقصة في الصحف والمجلات ثم بدأت بإصدار قصصي هو مجموعة “هنا لندن ذات مساء” إلى جانب مسودات كثيرة لم تنشر، أو أُهمِلت لتسارع نسق الأحداث، فهذه الكتابة الإبداعية تنطلق من الذات واليوميات والهواية، كل هاو للأدب مؤهّل لأن يكتب الشعري أو السردي جيداً، أو رديئاً. المهم أن تتوفر الهواية والرغبة، ولكن الهواية لا تكفي لكتابة النقد؛ فهو ميدان يلزمه بعض المعرفة العلمية وبعض التدريب على التعامل مع النصوص الأدبية، هذا ما اندفعت في دروبه بعد تحصيل بعض المعرفة الأدبية، وهو ما جعلني أمارس الكتابة النقدية، وأتعامل لاحقاً مع النصوص بطرح أكاديمي. ولكني مع ذلك، لم أنقطع عن الفعل السردي ومازلت أمارس كتابة القصة والرواية، وأتحين الفرصة لإصدار أعمالي السردية الجديدة، ولعلي أختصر الأمر في كون الرواية والقصة هواية ورغبة في البوح، أما النقد فهو ممارسة محايدة وصارمة للمعرفة، فهما جناحان يرافقانني في هذا الطريق الشائك، وأملي أن أوفق بينهما.
ويقول الناقد المغربي الذي أصدر حديثا رواية له “عزيز العرباوي”:
تصعب حقيقة الإجابة عن هذا السؤال بصفة عامة، إذ تختلف الأسباب والدوافع عند كل ناقد على حدة؛ فلا يمكن حصر إجابة واحدة، أو سبب واحد في هذه الظاهرة اللافتة للانتباه منذ مدة طويلة، أما إن كان الأمر يتعلق بي شخصياً فإنني أقول: إن هناك أسبابًا كثيرة دفعتني إلى التوجه إلى كتابة الرواية بالدرجة الأولى، حيث صدرت لي مؤخراً رواية تحت عنوان “شهوة السؤال: رحلة الحب والثورة” وإن كنت كتبتها منذ أكثر من سنتين على الأقل؛ ومن بين هذه الأسباب هو أنني قبل أن أتوجه إلى النقد، كنت أكتب الإبداع في بداياتي الأولى، كالشعر والقصة القصيرة، وهذا دافع قوي لإعادة إحياء الجانب الإبداعي عندي، ثم هناك سبب ثانٍ لا يقل أهمية عن الأول وهو أن كتابة الرواية بالدرجة الأولى هي كتابة تحتاج إلى دربة وتمرين قوي في القراءة والتفكير وتحليل الظواهر والمواقف الإنسانية مثلها مثل النقد، فهو عمل مضنٍ ويحتاج بدوره مثله مثل الرواية، إلى هذه الأمور كلها وأكثر. وبالتالي فتوجهي إلى كتابة الرواية مرده إلى قناعتي الخاصة بأنها تعبير ذاتي عن المشاعر والأفكار والمواقف الإنسانية التي يمر بها الفرد، أو يعيشها في مراحل حياته كلها. ومن هنا نقول إن توجه النقاد إلى الرواية، والذي يرتبط أساساً بقناعتهم الخاصة بقدرتهم على كتابتها والإبداع فيها والاتيان بالجديد، يتأسس على نظرتهم ورؤيتهم النقدية لما يقرؤونه من نصوص وما يحللونه من روايات تحتاج التعديل والتنقيح والتشكيل من جديد، فالقول إن النقاد العرب على الخصوص يتجهون إلى الرواية لأنها صارت ديوان العرب الجديد ولها قراء كثر وأنها مفتاح الشهرة هو قول مجانب للصواب على الأقل في نظري الشخصي؛ نظراً لأن الشهرة والقراءة يكسبها الناقد أيضاً إن تميز في مجاله، ولعل نقاداً مثل “جابر عصفور”، و”عبد الله الغدامي”، و”محمد مفتاح”، و”سعيد يقطين”.. وغيرهم أفضل مثال على هذا الكلام.
ويقول الناقد والمبدع الفلسطيني “أمين الدراوشة”:
تحتاج الكتابة الإبداعية إلى استعداد فطري، والكثير من الدربة والممارسة، لذلك ليس مستغرباً أن يلج الكاتب المجتهد عوالم الأدب المتنوعة. بالنسبة لي بدأت الكتابة منذ الصغر، وكانت لي محاولات في الخاطرة والمقالات القصيرة، ومع تقدم السنوات، وزيادة تعليمي ووعي بأدوات الكتابة، شرعت في كتابة القصة القصيرة، وكانت البدايات صعبة، ونجحت بعد جهد كبير في إنتاج قصتين قصيرتين مكتملتين فنياً، ونشرتا ضمن مجموعة قصصية مع مجموعة من الكتّاب، وكان هذا حافزاً لي كي أستمر. ونجحت وأنا في أواخر العشرينيات في إصدار مجموعة قصصية عن اتحاد كتاب فلسطين (الوادي أيضاً). وبعد سنوات حالفني الحظ بنشر مجموعة ثانية (الحاجة إلى البحر)، وهنا نرى أني بدأت قاصاً، وما زلت.
أنا قارئ جيد لأني أريد أن أكون كاتباً يمنح القراء بعض المتعة والفائدة، لذلك طالعت الكثير من كتب النقد، وشاءت الظروف أن ألتحق بورشة طويلة حول المجتمع الإسرائيلي، والتي خرجت منها بدراسة عميقة حول إحدى الروايات الإسرائيلية، استهواني الأمر، فبدأت القراءة في الأدب الإسرائيلي، وأفلحت بإصدار كتاب (الأنا والآخر في الراوية الإسرائيلية)، ومن خلال مطالعتي لكل جديد في الأدب الفلسطيني والعربي، وجدت تصحرًا في النقد التطبيقي، والتعريف بالأعمال الأدبية، ونظرت إلى قصصي التي يمكن أن تكون أكثر حظاً من غيرها، إذ حازت قصصي عبر سنوات طويلة على اهتمام الدكتور “سامي مسلم”، والناقد التونسي “صلاح بوزيّان”، والقاص “محمود شقير”، وشعرت بالفرح والغبطة، وفكرت لما لا أستمر بالنقد وخصوصاً أنني وجدت التشجيع من الصديق والناقد الكبير “وليد أبو بكر”، فكان انخراطي بالقراءة الكثيفة، حتى نجحت في نشر كتاب (الأنا والآخر في الرواية الفلسطينية)، كما انشغلت جداً بالقراءة وعمل دراسات لكتّاب كبار، ومبدعين شباب. وجدت نفسي مندفعاً للكتابة النقدية عن الأدب الفلسطيني والعربي كي أقدم بعض الدعم للمبدعين وخاصة الأجيال الجديدة، بعد أن شعرت بالحزن أن قصصي لم تجد الاهتمام المناسب من النقاد، إما لقلتهم وإما سعي البعض للكتابة عن الكتّاب الكبار كي يجني الفائدة، ثم توالت مؤلفاتي في النقد والبعض وجد طريقه إلى النشر، وما زلت أكتب القصة القصيرة جداً، والمقطوعات الشعرية القصيرة، والحقيقة أن الكاتب يجد نفسه مندفعاً للكتابة الإبداعية التي تشفي غليله، وتهبه المساحة والحرية ليقول ما يريد، لذلك نرى بعض المبدعين يكتبون بعدة أنواع أدبية.
أما لماذا قد يلجأ الناقد للكتابة، فهذا نابع من إحساس الناقد بعد أن بذل مجهودات كبيرة، وتمكن من أدوات الكتابة، أنه قادر على الكتابة بهذا النوع الأدبي أو ذاك، البعض يقول إن الناقد هو في الأصل كاتب فاشل، لم يفلح بالكتابة (رواية، قصة، شعر) فيلجأ إلى النقد، وهذا كلام قاصر، ذلك أن النقد يتطلب مهارة وفلسفة وثقافة واسعة، فعلى الناقد أن يكون ملماً بالمناهج النقدية الحديثة والقديمة، كما أن عليه أن يتابع آخر المستجدات في الفنون الأدبية كالمسرح والرواية والقصة والشعر، فالتقنيات الإبداعية في تطور مستمر ودائم. إذن يلوذ الكاتب أو الناقد إلى النوع الأدبي الذي يتيح له التعبير عن رؤيته الفكرية اتجاه العالم واتجاه الذات، وهناك الكثير من النقاد الذين ولجوا الأجناس الأدبية المختلفة، وأبدعوا، وأغنوا المكتبة العربية -عدا دراساتهم النقدية- في الرواية أو القصة أو الشعر.
ويحدثنا الناقد والمبدع المصري الدكتور “أحمد الباسوسي” عن هذه الظاهرة:
عن نفسي أنا في الأصل قاص أمارس كتابة القصة القصيرة منذ طفولتي، ولم أتوقف عن كتابتها رغم انشغالاتي بالعمل البحثي والأكاديمي والإكلينيكي. وبخصوص توجه النقاد لكتابة الشعر أو السرد الروائي ففي رأيي الشخصي يمكن تقسيم من يكتب في النقد إلى قسمين: نقاد أكاديميون يعملون بالجامعات والمراكز البحثية المتعلقة باللغة العربية وآدابها أو اللغات الأجنبية، هؤلاء يسيطر عليهم الطابع الأكاديمي ويكتبون النقد بأسلوب متخصص كالبنائية مثلا، أو غيرها من مدارس النقد، ويفككون العمل وفق رؤية شديدة الخصوصية والتخصص. هذه المسألة قد تستغرقهم وتستنزف ما بهم من طاقة إبداعية حرّة خارج نطاق العمل الأكاديمي المقيد، وإذا فاجأهم شيطان الشعر أو القصة مثلاً ربما يفعلونها في الخفاء من دون نشر أو إفصاح. وهناك نقاد في الأصل مبدعون يقرؤون الأعمال الإبداعية شعراً، ونثراً من منظور انطباعي ويتماهون فيه مع كاتبه ويسبحون في تياره وينتجون نوعاً خاصاً من النقد المبدع الموازي للنص الإبداعي، وأزعم أني أحد هؤلاء، وأعد النقد عملية إبداعية في الأساس في حاجة إلى قراءة إبداعية موازية واستكشاف مواطن الإبداع الخفية التي ولجها الشاعر أو الكاتب وتسليط الضوء عليها. النقد إذن إبداع مواز.
ويطرح الناقد والمبدع الجزائري الدكتور “عزالدين جلاوجي” رؤيته، ويقول:
لعل السؤال يقصد (لماذا صار النقد يتجه إلى الإبداع السردي بدل الإبداع الشعري)، وهو فعلاً ما صارت تشهده الحركة النقدية منذ مطلع الثمانينات، وراح الأمر يتضخم حتى أصبح في أيامنا هذه يكاد يحقق سيطرة مطلقة على المشهد النقدي، مقابل الفتور الذي تشهده الحركة النقدية التي تقارب المنجز الشعري والقصصي والمسرحي، والسبب يعود إلى هذا الانفجار الكبير الذي تشهده الكتابة الروائية في العالم العربي، ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن مئات الآلاف من النصوص الروائية ترى النور سنوياً، مما يجعلها تفرض نفسها على النقد، الذي من مهامه أن يتابع ما ينجز، بل وأحياناً يجد نفسه منساقاً مع التيار شاء أم أبى، في الوقت الذي نشهد فيه شحاً إبداعياً شعرياً وقصصياً ومسرحيا، وهذا يدفعنا أيضا لنطرح عن ذلك سؤال لماذا؟ وأعتقد أن هناك سببين، الأول أن الرواية وهي الجنس الأحدث زمنياً بالنسبة للأجناس الأخرى، قد استطاعت أن تفتح حضنها لكل الأفكار وأشكال التعبير، وبالتالي كانت أكثر تعبيراً عن الإنسان والحياة، ومن هناك أقبل عليها الناس قراءة والباحثون نقدا، أما السبب الثاني فيما أعتقد هو سهولة كتابة الرواية مقارنة مع الشعر والمسرح والقصة، لما تتصف به هذه الأجناس من خصائص الدقة والتكثيف والإيقاع، مما يجعلها لا تلين كتابة إلا للمبدعين الكبار، ولا تلين أيضاً قراءة والنقاد إلا لطبقة معينة منهم، وبتركيزنا على الشعر مثلاً فقد دخل متاهات الإبهام منذ أن ارتاد عوالم التجريب اللامحدود لغة وأسلوباً وصورة، مما جعل متلقيه أمام لوحة سريالية دادائية لا يمكن حل شفراتها إلا بالاتكاء على خلفية معرفية وجمالية كبيرة، وبشكل أقل نرى ذلك في القصة خاصة وقد تبنت التكثيف روحاً لها، والأمر ذاته ارتبط بالمسرح الذي ارتبط في أذهاننا بالخشبة، وأوهم القارئ أن المسرح فعلا يشاهد وليس حكاية تقرأ. لقد قدمت في تجربتي الإبداعية عشر روايات، وثلاث عشرة مسرحية، وثلاث مجموعات قصصية، كما قدمت أحد عشر كتاباً نقدياً، حاولت في النقد أن أرتاد كل العوالم: المسرح والشعر والقصة والرواية، لأتمرد نقدياً على سطوة الرواية، ولاحظت من خلال كتاباتي الإبداعية أن اهتمام النقد انصرف إلى تجربتي الروائية، فقدم مئات الدراسات والرسائل، في حين ظلت مقاربة المسرح والقصة باهتة وخجولة جداً، ولعل هذا من الأسباب التي دفعتني أن أبتكر شكلاً جديداً للنص المسرحي، أطلقت عليه مصطلح “المسردية” حيث يقدم نفسه شكلياً وبصرياً على أنه سرد، يمكن قراءته بمتعة، ولكن جوهره وعمقه مسرح يمكن أن يؤخذ إلى الخشبة بسهولة ويسر، ولا يتطلب إعادة مسرحَتِه، وكان ذلك كافياً لإقبال القراء على قراءة المسردية، ولإقبال النقاد للكتابة عنها أيضاً.
ويطرح الدكتور الكاتب والباحث المغربي “محمد أنقار” رؤيته عن هذه الظاهرة، ويقول:
أظن أن العوامل التي تجعل الناقد يتجه نحو اختيار الإبداع السردي أو الشعري هي ذاتية في المقام الأول وأخرى موضوعية، نعلم أن كل نفس بشرية تميل نحو شيء ما، وتنجذب إليه دون الآخر؛ لأسباب عدّة وجدانية وعاطفية، وأحياناً عقلية ومنطقية، ومن منطلق تجربتي النقدية المتواضعة كنت ميالاً منذ صغري نحو الحكي، أنجذب بشدة إلى سماع القصص والحكايات التي كانت تروى في الساحات الشعبية؛ خاصة التي موضوعها يثير مخاوفنا ونحن أطفال صغار من قصص الجن والعفاريت والنساء اللواتي يختطفن.،لا أزال أتذكر أول مجموعة قصصية قرأتها وأنا بعد في سن مبكرة كانت للقاص المغربي مصطفى يعلى بعنوان “أنياب طويلة في وجه المدينة”، في ذلك العمر لم أكن أعي ما أقرأ، لكن كنت أنجذب إلى الطريقة الممتعة في سرد القصص، وقد أتيحت لي فرصة دراسة التجربة القصصية للأستاذ يعلى حينما هيأت بحثي في الماجستير عن قصصه سنة 2005، وقد نشرت البحث بعد ذلك بسنوات بعنوان: “بلاغة التصوير في قصص مصطفى يعلى”. إذن هل العوامل الذاتية هي التي تتحكم في اختيارات الناقد؟ أظن أن ما هو ذاتي قد يكون عاملاً إلى حد ما في ذلك، بيد أن عوامل موضوعية أخرى قد تتدخل في هذه الظاهرة، منها المسير العلمي والأكاديمي الذي سلكه الباحث بحيث يؤثر في طبيعة اختيار النصوص، في هذه السنوات الجامعية تتشكل شخصية الناقد من خلال احتكاكه بالنقد العلمي والمنهجي الذي ينبني على الدقة والموضوعية. لذلك، قد يجد الباحث ضالته في النصوص السردية أو في النصوص الشعرية، لكن العامل الحسم في هذا الشأن هو جودة النص سردياً كان أم شعرياً، فالنص الجيد يفرض نفسه بقوة على النقد.. بل يعلو عليه ويسمو، لأن النقد ما كان أن يوجد لولا الإبداع الأصيل والخالد.