كتاب “الطب النبوي بين الفقيه والطبيب”
للدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي
أمر على كتاب (الطب النبوي بين الفقيه والطبيب) للدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي أكثر من مرة في معرض الشارقة للكتاب في عام 2014م بدار مدارك، فأعرض عنه ولا أتصفحه، ذلك لأنني اطلعت على العديد من الكتب القديمة والحديثة التي تناولت موضوع الطب النبوي، ولا أجد فيها إلا جعل الرسول عليه السلام طبيباً، بل وجعل الروايات المنسوبة إليه في الطب معجزة تباري الطب المعاصر، فمللت من تصفح مثل هذه الكتب والعناوين، والتي لم أقتنع بأطروحاتها.
وفي معرض مسقط للكتاب لهذا العام 2015م مر علي الكتاب مرة أخرى، فقلت في نفسي: لما لا أتصفحه وأرى، لعلي أجد شيئاً جديداً. وكنت مستبعداً ذلك، ولكن يفاجئني المؤلف بأطروحته المغايرة للأطروحات التقليدية، والتي ضمت دراسة معظم أدوية ما يسمى بالطب النبوي بدقة وموضوعية، وهنا أضع بين أيديكم قراءتي للكتاب.
المؤلف ومصادره
هو الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، مواليد خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، خريج الكلية الملكية للجراحين في جمهورية إيرلندا سنة 2009م بكالوريوس طب، وطبيب مقيم تخصص باطنية، نشرت له عدة مقالات فكرية واجتماعية طبية في الصحف الإماراتية والخليجية، وله كتاب تحت مسمى (37 درجة مئوية، أوراق طالب طب) ويقدم أيضاً برنامج “وصفة” الطبي على إذاعة الشارقة.
وفي كتابه الطب النبوي يرجع إلى 165 مرجعاً، وتحتوي المراجع على كتب التفسير، والفقه وأصوله، والتاريخ، وكتب الطب النبوي، وكتب طبية حديثة، والمراجع والدراسات الأجنبية، والصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى كتب أخرى في مجالات مختلفة.
من خلال سيرة المؤلف، يتبين قيمة الدراسة المطروحة لكونها صادرة من طبيب متخصص، بالإضافة إلى اهتمامه بالجانب الاجتماعي، وهذا يقدم دور الطبيب المهتم بشؤون المجتمع من المنظور الإنساني.
ومصادره تؤشر على سعة إطلاعه على كتب التراث والدراسات والكتب الطبية الحديثة، وهذا بدوره يقوي من قيمة هذا الكتاب.
منهج المؤلف
1- اللغة والأسلوب
الكتاب في مجمله يتكون من 280 صفحة من القطع المتوسط، واستخدم اللغة العربية الواضحة بأسلوب ميسر يفهمه الفقيه والطبيب وغيرهما من القراء الآخرين مثقفين كانوا أو غير مثقفين، بمعنى لغة وأسلوب يصلان لجميع القراء، ويطرح الأسئلة التعجبية والاستفهامية التي لم تبحث بعد، ويترك المجال للباحثين والدارسين والقارئ ليبدئ رأيه ووجهة نظره حول ما طرحه من قضية دون أن يلزم أحداً بما توصل إليه من رأي.
2- المقدمة
أخذت المقدمة 12 صفحة، وبدأها بالسؤال القمعي الذي يوجه له ولغيره لمن لم يتخصص في الدراسات الفقهية، والسؤال هو (هل أنت متخصص؟)، وهنا لا يعتبر المؤلف الشهادة الجامعية هي المعيار، لأن هناك الكثير من الفقهاء والمحدثين لم تكن لديهم شهادات ومثل بالألباني، مع كون المؤلف جالس وسمع وقرأ كتب أهل الحديث والفقه والأصول منذ نعومة أظفاره، منطلقاً من أن فهم الإسلام ليس حكراً على فئة معينة، وكما أنه ذكر قصته مع الكتاب، وناقش موقعة بول الإبل، ويختم مقدمته بعيداً عن التكفير والتضليل والتبديع، زاعماً أنه أول من جمع مادة علمية مفصلة في هذا الموضوع، ومن وجهة نظري أن زعمه في محله حسب قراءاتي وإطلاعي.
مقدمة المؤلف يظهر فيها الحس الاجتماعي للواقع المعاش، والصراع الحادث بين مقدمي رؤى جديدة وبين المتمسكين بالرؤى الموروثة، على أن الكاتب لا يرفض الموروث وإنما يحاكمه بالقرآن والعلم، سواء كان هذا الموروث متعلق بالروايات الطبية أو آراء الفقهاء والمفسرين، بل حتى آراء المعاصرين يحاكمها بالعلم ويطالبهم بإثبات الدليل العلمي فيما يزعمونه من دراسات.
3- الكتاب
قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: استعرض فيه الطب قبل الإسلام مع الأمم والحاضرات السابقة، فتناوله تاريخياً في مصر والعراق والصين والهند واليونان والرومان والعرب، وكل ذلك تحت عنوان الطب الجاهلي، ويرى الكاتب أن العرب أخذوا الطب من تجارب الأمم السابقة، وهذا رأي ذهب إليه مجموعة من العلماء المسلمين مثل ابن خلدون والشاطبي، ثم ينتقل إلى عنوان الطب الإسلامي، وناقش هنا أطباء الحضارة الإسلامية، ويعتبر العرب لم يختلفوا عن غيرهم في التداوي بالأعشاب والعقاقير التي هدتهم إليها الصدفة ثم التجربة، وجاء الإسلام ينقل العرب من الجهل إلى نور المعرفة، فالطب الذي مورس في عهد النبوة هو جزء من الطب العربي والإسلامي وليس رديفاً له، فليس من مهمة الأنبياء كما يذكر تعليم الناس الطب والفلك أو الهندسة وغيرها، بل مهمتهم هي التوجيه الأخلاقي لهذه العلوم حتى تستخدم لصالح الإنسانية، ويستشهد على ذلك بمجموعة من الروايات مثل رواية (تداووا فإن الله لم يضع داء إلا ووضع له دواء غير داء واحد الهرم).
ويشيد الكاتب بالأطباء المسلمين الذين استفادوا من تجارب الأمم السابقة وطوروا المعرفة ولم يحتكروها لهم وحدهم بل ينسبون كل قول لأهله، فأشاد بابن سينا والكندي والرازي، مع مشاركة أطباء غير مسلمين في الحضارة الإسلامية مثل قسطا بن لوقا البعلبكي وأبو نصر المسيحي وهبة الله الإسرائيلي وغيرهم.
ويعتب الكاتب على المسلمين بعدما كان طب الحضارة الإسلامية سيد العالم لمدة 8 قرون، إلى أن دخلوا عصر الظلمات الذي خرج منه الغرب، والسبب في ذلك هو أن توقفوا في نفس المربع الذي توقف فيه ابن سينا والرازي، وصار الممارسون الشعبيون يتحدثون بنفس لغة القرون الأولى ويستخدمون أدويتهم بزعم أنها نبوية أو تراثية مجربة.
كما أن الكاتب وضع بعد ذلك عنواناً لمؤلف عماني وهو كتاب (منهاج المتعلمين) لراشد بن عميرة، الذي عاش في القرنين 16 و17 الميلادي، ويضع الحمادي رأيه حول الكتاب العماني، ويراه كتاب طب تجريبي يتبع أفضل المعايير العلمية الشائعة في عصره، ويذكر المصادر التي اعتمدها ابن عميرة في تأليف كتابه حسبما ذكرها المؤلف، كما أنه يذكر أقسام الكتاب والتي تعتبر أقساماً بطريقة تقسيم الفصول الطبية الحديثة، ويشيد بطريقة ابن عميرة حينما يذكر علاجاً ذكر في حديث نبوي، فإنه لا يصيح فيمن حوله انظروا إلى هذا الإعجاز الإلهي، وانظروا كيف فاق إمام الأنبياء أئمة الأطباء، وإنما يتعامل مع الأدوية بأسلوب طبي هادئ متناغم مع قواعد الطب الحديث.
ويتحدث الكاتب عن قواعد الطب وتاريخ الطب النبوي، ومما ناقشه في ذلك ظهور كتب تحمل عناوين (الطب النبوي) ومنها كتاب ابن القيم والذي اعتمد عليه في دراسته هنا دراسة نقدية، وكذلك أخذ المؤلف جولة في كتب أصول الفقه كتهيئة ضرورية لمناقشة ما ورد من روايات وقواعد وأصول فقهية في كتاب ابن القيم وآراء الفقهاء،ويقسم الأدلة إلى أدلة صحيحة وهي الآيات القرآنية، وصحيح المنقول عن السنة النبوية، وأدلة غير صحيحة الروايات الموضوعة والضعيفة والتي تصب في فكرة إلهية الطب النبوي، ويناقش الحمادي كتاب ابن قيم بكل دقة وموضوعية، مع عرض الأمراض وعلاجها والاستدلال عليها، وينتقد ما لا يتوافق مع الطب الحديث ولا الطبيعة البشرية ولا الواقع والزمان والمكان، وغير ذلك.
ثم يناقش كتاب (الطب النبوي في نسيجه الجديد) للدكتور عبدالباسط الدرويش، والذي قدمه لنيل درجة الدكتوراه عام 1996، وهنا قدم الحمادي مختصراً من هذا الكتاب مع مناقشة ما جاء فيه على ضوء القرآن والطب الحديث والطبيعة الإنسانية ومدى صحة الروايات المستشهد بها.
ثم يعرض وجهة نظر أخرى لا تعتبر الطب النبوي طباً إليهاً وهي رؤية ابن خلدون، كما أنه عرض رؤية محمد الأشقر وموقف الذهبي، مع عرض رأيه حول رؤاهم، بالإضافة إلى مناقشة آراء كثيرة صدرت من فقهاء ومتخصصين متقدمين ومعاصرين مثل: السرخسي، والدكتور مصطفى خضر التركي المحقق لكتاب (الطب النبوي) للأصفهاني.
ويذهب الكاتب إلى أن هناك تشريعات صحية نبوية،لكنها تصلح لزمانها، لكون الرسول رئيس دولة إسلامية، فتشريعاته الطبية مثلها مثل تشريعات من سبقه من الأمم السابقة كانت رائعة وصحيحة في أوانها، ويرى أنه لا شك بأن التشريعات النبوية الصحية متناغمة مع شخصية الرسول عليه السلام بالمنطق والعقل، وضرب على ذلك بعض الأمثلة مثل إزالة النجاسة بالثوب والأكل باليمنى والاستنجاء وغير ذلك.
وبعدها يقدم نبذة عن الطب الحديث وكيفية ممارسته، ونبذة أيضاً عن التاريخ الطبي، والفحوصات السريرية ووالمختبرية والأشعية والعلاج وكيفية اعتماد الدواء عالمياً، ليقف بعد ذلك لمناقشة آراء طرحها عبدالمجيد الزناني وينتقدها بكل موضوعية حسب الطب الحديث والذي يعتبره مثال للعجلة في النتائج.
الفصل الثاني
وهذا الفصل يعد أهم فصول الكتاب، إذ يعرض فيه مجموعة منتقاة من الأدوية والممارسات المستمدة من الطب النبوي ويضعها تحت مجهر البحث العلمي والطبي، ويخرج بنتيجة أن هذه الأدوية والأعشاب ما هي إلا تراث مشترك بين جميع الأمم ولا يوجد فيها ربع أو نصف معجزة، ومثل بالعسل وغيره، ويستعرض إنجازات بعض العلماء تفوق أدوية الأعشاب والطب النبوي ولم يدعي أحد منهم الإعجاز ولا خرق العادات.
ثم يمثل بالأدوية والأعشاب التي تعتبر من الطب النبوي ويناقشها بمجهر الطب الحديث والواقع، ولا يهضم حق أي دواء، فما فيه فائدة مرجوة ونافعة لبعض الأمراض يذكره وما لا فائدة فيه بل قد يزيد من المرض يذكره ويبين أضراره، وقد أورد أهم الأدوية المعروضة في الطب النبوي مع تحليلها تحليلاً طبياً حديثاً ومناقشة آراء الفقهاء فيها، وهي: العسل والتمر والقسط والصبر والتلبينية ونبات السنا والإثمد وزيت الزيتون والحجامة وألبان الإبل والسواك، وذكر في ذلك 15 دواء.
الفصل الثالث
وبدأ فيه بمفاهيم يجب أن تصحح، وهذه المفاهيم متعلقة بالواقع الاجتماعي الصحي للناس في العالم العربي والإسلامي، فناقش قضية المس والصرع مناقشة علمية من خلال القرآن وآراء الفقهاء والطب الحديث، ونقد كتاب (آكام المرجان) للشبلي، وقف ثمان وقفات مع مشروع افتتاح عيادات الرقية والأعشاب، وناقش الموضوع برؤية الطبيب العارف بعمله ومضار هذه الممارسات على المجتمع، كما أنه لم يغفل عرض رؤيته حول ماء زمام والروايات المقدمة حوله، بعرض كل ذلك على العلم وآراء الفقهاء والمحدثين.
ثم تتطرق إلى مناقشة بعض ما جاء تحريمه في القرآن، وهو مع التحريم، مثل الخنزير والخمر ومضار ذلك، وما ينسبه البعض من أضرار في ذلك باسم الطب والعلم، والعلم منه برئ، ومن الرؤى التي ناقشها ناقش رؤية الدكتور زغلول النجار في كتابه (الحيوان في القرآن الكريم) وما عرضه زغلول من أمور نسبها إلى العلم والعلم لم ينطق بها أو أن العلم قال بها لكنه لم يخصصها في الخنزير وحده مثلاً.
كما تعرض إلى أضرار الكحول وأمراض القلب، ثم تتطرق إلى الصيام وما ينسب إليه من فوائد قد تتعارض مع صحة الأفراد، وتطرق كذلك إلى العادة السرية من الرؤية الفقهية والطبية، وكذلك قضية الختان والتي مازال الجدل فيها الجاري فهو يعرضها بالرؤية التاريخية والفقهية والطبية، ويبدئ رأيه حولها، وكذلك بول الغلام وبول الصبية والرضاعة، وهنا يقف مع هذا الحد، ثم يختم الكتاب برواية يراه صحيحة منسوبة إلى النبي محمد عليه السلام، وكذلك بأقوال الفقهاء والمفسرين.
رأيي حول الكتاب
أرى أن الكتاب قدم رؤية عصرية تتماشى مع منهجية الواقع المعاش، فهو حينما يناقش تلك القضايا الطبية، يعرض تاريخها ويناقشها ناقش فقهي من عرضها على القرآن والسنة النبوية والواقع، ثم يناقشها مناقشة طبية حسب ما توصل إليه الطب الحديث، فهو بهذا المنهج لم يسبقه أحد في تحليل ومناقشة الطب النبوي، قد تكون هناك رؤى عرضت قبله مثل: زغلول النجار، وعبدالمجيد الزنداني، وغيرهم، لكن على رؤاهم ملاحظات موضوعية، فهم ينتصرون للطب النبوي دون عرضه بكل موضوعية على العلم والطب الحديث.
لا ينفي طبعاً الكاتب وجود علاج مارسه الرسول عليه السلام وأخبر به الصحابة، ولكن يتعبر ذلك لزمانه، ويصلح لزماننا لكون الطب تقدم.
الكتاب ابتعد كل البعد عن الإيديولوجية المتعصبة، بل يناقش الأمور من الرؤية الموضوعية حسب تسلسل سلس يقودك إلى نتائج مقنعة.
من وجهة نظري يؤخذ على المؤلف مع كونه حسب أطروحته هنا صاحب فكر معاصر تجديدي أن يعنون موضوعاً باسم (الطب الإسلامي)، وذلك لأنه يذكر أن العرب والمسلمين استفادوا من تجارب الأمم السابقة، لذا لا ينبغي أن ننسب مثل هذه التجارب البشرية إلى الإسلام، بل ينبغي نسبتها إلى أصحابها سواء أفراداً أو جماعات أو شعوباً أو أوطاناً، وهذا ما ابتلي به الفكر التقليدي في الوقت الراهن وهو أسلمة الحداثة، فما من اختراع أو رؤية جديدة يكتشفها غير المسلمين إذا بأصحاب الفكر التقليدي ينسبونها إلى الإسلام، كأن يقال الشريط الإسلامي واللباس الإسلامي، فالصناعات والقيم والأفعال الإنسانية لا تنتسب لدين معين، وإنما الذي ينسب إلى الدين هو العقائد والعبادات.
وأخيراً هذا الكتاب لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة تخدم طلبة العلم، وينبغي للفقهاء والأطباء الإطلاع عليه وإبداء وجهة نظرهم حوله، لكون الموضوع يمس منظومتهم المعرفية.


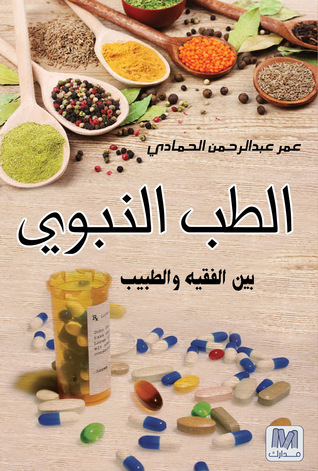






للاسف خالف هذا الكاتب العلم الحديث ،
اولا: حيث انه وجد ان لحم الخنزير غير ضار وانه لايوجد دراسات تشير الى ان لحم الخنزير ضار معالعلم انكثير منمراكز الابحاث الغربية الاوروبية والامريكية اثبتت ان لحم الخنزر ضار لاحتاءه على مواد لا يهضمها الانسان ويحتوي على الكثير من الامراض. وللاسف يدعي هذا الكاتب انه لا يوجد دراسات تثبت ذلك.
ثانيا: انه يدعي ان ختان الاولاد غير مهم وعدم الختان لا يؤدي الى انتقال الامراض كما يقول، وانكر الابحاث الغربية التي تشجع على لختان الاولاد وازالة الجلدة الزائدة التي تعمل على تجميع الاوساخ وان كثير من الاوروبين والامريكان المسيحين الذكور الشباب يقومو بهذه العملية بشكل كبير وحملات الاتمم المتحدة بافريقيا تعمل الختان لتقليل انتشار فيروس الايدز.
حيث هدف هذا الكاتب نسف كل الطب النبوي بحجة العلم الذي هو لايعترف به لانه لايعترف بالابحاث العلمية وينكرها.