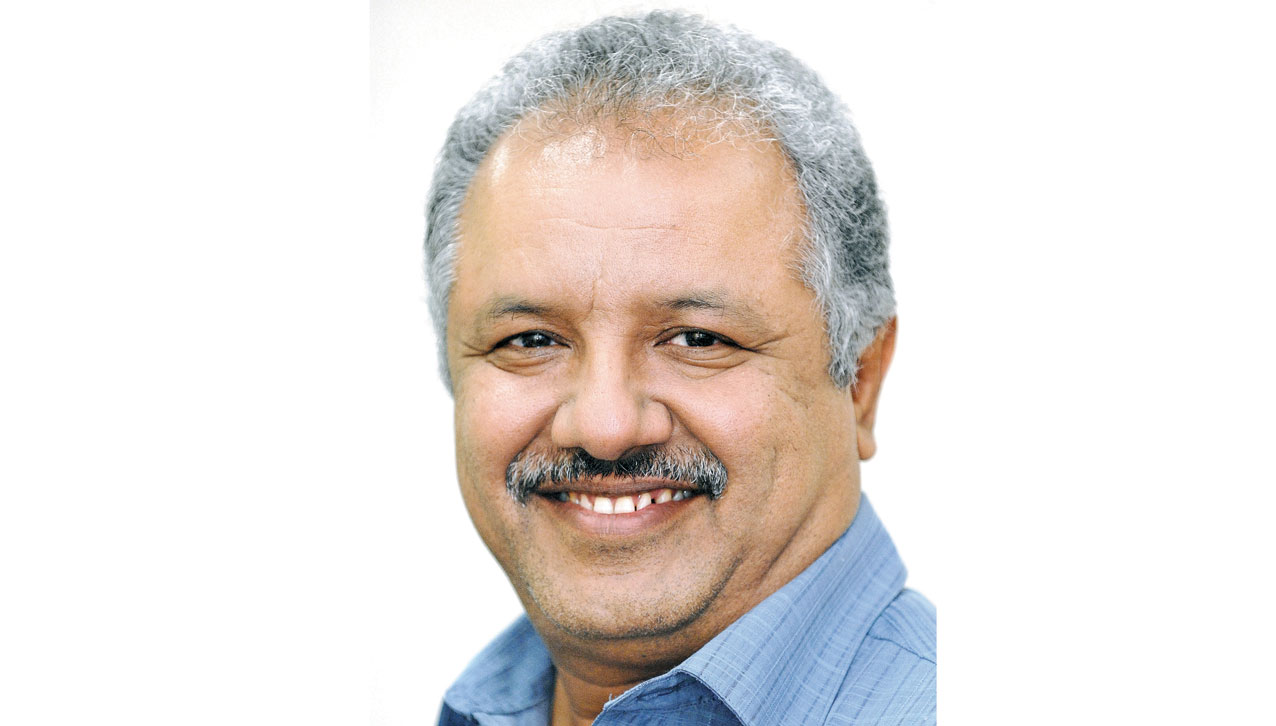غانم النجار:
• أن تكون سياسيا في منطقة الخليج إذن عليك بأن تكون جزءً من النظام وهنا تكمن المشكلة.
• لقد غرس في جيلنا أن كل الأنظمة السابقة كانت أنظمة غير جيدة ، أو ضد الناس، وهذا يحتاج إلى دراسة.
• هناك إشكالية تاريخية مع العمل العام بصورة عامة والعمل السياسي بصورة خاصة، وبالتالي فإن أي نشاط عام محكوم عليه بالشك حتى قبل أن يبدأ.
• أحيانا يعمل البعض كنشطاء في مجال حقوق الإنسان ولا يدركون حقيقة بأنهم يقومون بعمل سياسي.
• الدولة قائمة على المواطن والإقليم ، والسيادة والحكومة ، هذه أربعة أركان لما نسميه بالدولة القومية ، وهي مخلوق جديد ، لم يكن موجودا قبل 1648.
الدكتور غانم النجار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، وأستاذ زائر بجامعة هارفارد بين عامي 1999 و2002، وخبير دولي معتمد لدى العديد من المنظمات الدولية. حاضر في العديد من الجامعات الأجنبية و العربية. ترأس و شارك في العديد من لجان تقصي الحقائق في عدة دول آسيوية و أفريقية و عربية. له رأي وصوت مهم في قضايا حقوق الانسان في الخليج والعلاقة بين المواطن والسلطات الحاكمة. زار الدكتور غانم النجار السلطنة مؤخرا لإلقاء مجموعة من المحاضرات في العلوم السياسية وحقوق الإنسان في عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية بالسلطنة . وخلال زيارته كان لمجلة الفلق جلسة حوارية معه اشتملت على عدة محاور أهمها وضع النشاط الحقوقي في منطقة الخليج بشكل وقراءته للتحولات التي ستطرأ على النظم السياسية في المنطقة مستقبلا. كما تطرق الحديث إلى وجهة نظره حول الثورات العربية أو ما بات يعرف بالربيع العربي.
– ما هو تقييمك للعمل الحقوقي في منطقة الخليج؟
في الحقيقة هناك تداخل بين مفهوم العمل الحقوقي ومفهوم العمل السياسي. هذا التداخل يسبب إشكاليات عدة وقد يضر بالاثنين معا أحيانا، ومن ثم فنحن بحاجة ضرورية للفصل بينهما .
كانت لي مقالة نشرت مؤخرا في الصحف عن موضوع الحقوقي والسياسي ، وقد تم تداولها في المنتديات بشكل كبير حسبما عرفت. فكرة العمل الحقوقي في الحقيقة مرتبطة بالفضاء العام للمجتمع، وبالتالي فأن العمل الحقوقي ليس منفصلا عن العمل العام أو ما نسميه نحن بالمجتمع المدني. والتداخل بين العمل الحقوقي والعمل السياسي منطقي ، فالسياسة تتعامل مع الإنسان كونه موضوعاً لهيكل بناء القوة في المجتمع، وحقوق الإنسان تتعامل مع الإنسان كونه قيمة مطلقة لا يمكن تحييدها في نطاق الصراعات بين القوى.
– على ضوء التداخل بين مفهوم العمل الحقوقي والعمل السياسي، ما هي نظرتك لواقع الحركة السياسية في دول الخليج؟
أن هامش الحركة السياسية في الخليج يكاد يكون معدوما . فعندما نقول أن هناك تداخلا في المجالين الحقوقي والسياسي فإن ذلك نتيجة لعدة أسباب منها مثلا أن تعلن نفسك كناشط سياسي في الخليج عامة غير ممكن – استثني بعض الحالات في الكويت والبحرين – لأن إعلانك عن نشاطك السياسي يعني بالضرورة أنك معارض. أن تكون سياسي في منطقة الخليج إذن عليك بأن تكون جزءً من النظام وهنا تكمن المشكلة. ربما يكون هناك مجال لتشكيل تنظيمات سياسية في المنطقة، ولكن هذا يحتاج إلى وقت، فالأنظمة في الخليج لا تسمح بتشكيلها ، وإذا ما تم تشكيل تنظيمات سياسية جدية ومعارضة فإنها تتخفى تحت الأرض ، وهذه التجربة حدثت في بعض الدول العربية خلال فترة نشوء الأنظمة العربية المستقلة .
الأنظمة السياسية الموجودة لا تسمح بالعمل السياسي الخارج عن نطاق النظام الحاكم، ما عدا استثناءات بسيطة وفي حقب تاريخية معينة سمح فيها بالعمل السياسي والمعارضة ، كما حدث في مصر ولبنان وسوريا بعد الاستقلال أو بعد نهاية الحكم الملكي. ومن الملفت للنظر أن الحكم الملكي كان اكثر انفتاحا على العمل السياسي من الحكم الذي يدعي بأنه أتى من خلال الشعب أو بشكل جماهيري.
– ما مدى التطور التاريخي الذي حدث في المنطقة فيما يخص تعامل الأنظمة الحاكمة مع العمل الحقوقي والسياسي؟
لقد غرس في جيلنا أن كل الأنظمة السابقة كانت أنظمة غير جيدة ، أو ضد الناس، وهذا يحتاج إلى دراسة. في الحقيقة لم أصل حتى الآن إلى نتيجة تقول بأن الأنظمة الملكية أنظمة ممتازة ، ولكن بالتأكيد كان هامش العمل السياسي موجود فيها ، سواء كان في العراق أو مصر أو ليبيا. والمتتبع لتاريخ المنطقة يدرك أنه بعد ما حدثت الانقلابات وجاءت الأنظمة العسكرية وحكمت ، منعت الناس من المشاركة السياسية مما دعى السياسيين إلى العمل في الخفاء ، وبعد فترة من الزمن بدأوا يجدون متنفسا في العمل العام لذلك تجد الأنظمة العربية عموما – والخليج ليس استثناءً – تميل إلى النظر بشك وريبة إلى العمل العام ، ومن أهم المؤشرات على ذلك هي قوانين تنظيم العمل العام، جمعيات النفع العام ، التراخيص .. الخ . لابد من أن يتغير ذلك بعد فترة زمنية ، ولكن في كل الأحوال ، يصبح الصراع من أجل ممارسة العمل العام من نقابات وجمعيات عامة حقوقية أو غير حقوقية يأخذ طابعا سياسيا .
– حدثنا عن بداياتك في مجال العمل الحقوقي ورغبتك في دراسة العلوم السياسية وكيف كانت السلطات تنظر لهذه التوجهات في تلك الفترة؟
كنت في أيام الدراسة نشطا، كنت رئيسا لاتحاد طلبة الكويت في القاهرة ولندن، وعضو لجنة تنفيذية عندما كنت في الكويت لفترة من الزمن. لم أكن قط منتسبا إلى أي تنظيم ، ولكنني أستطيع أن أقول أنني كنت أسير ضمن اتجاه عام ، سواء كان اتجاه قومي أو اتجاه يساري. لقد كان الصراع بين المجاميع الطلابية في تلك الحقبة هو صراع سياسي، ربما كان ذلك واضحا في الكويت كونها الأنشط في العمل العام.
من هذه الخلفية تستطيع أن تفهم البعد الزمني للعمل السياسي، هناك إشكالية تاريخية مع العمل العام بصورة عامة والعمل السياسي بصورة خاصة، وبالتالي فإن أي نشاط عام محكوم عليه بالشك حتى قبل أن يبدأ. وقد لجأ البعض إلى الدخول إلى العمل السياسي من خلال حقوق الانسان، أناس كثيرة دخلت العمل الحقوقي غير أنها ليست حقوقية، ولكن نظرة الشك طالت العمل الحقوقي أيضا و اذا ما تداخل العمل في مجال حقوق الإنسان مع أي ارتباط دولي أصبح الشك فيه مركبا.
– كنشاط سياسي، هل يجب عليه العمل في المجال الحقوقي للتعايش مع الأنظمة الرافضة للعمل السياسي؟
ما يهم الناشط السياسي هو الحصول على مساحة ليعمل فيها ، وإذا ما وجد تلك المساحة في الجانب الحقوقي فلن يجد ضيرا في ذلك ، ولن يجد غضاضة في أن يقول بأنه يقوم بعمل حقوقي. وأحيانا يعمل البعض كنشطاء في مجال حقوق الإنسان ولا يدركون حقيقة بأنهم يقومون بعمل سياسي. نحن لا نتحدث هنا عن سوء النية ، فقد يكون صادقا، لكنه واقعيا يمارس عمله بطريقة سياسية، وفي أحيانا كثيرة تجده غير مطلع على أدبيات حقوق الانسان بشكل جيد.
– برأيك كيف نستطيع معالجة أزمات حقوق الإنسان في منطقة الخليج؟
الآن أصبحت حقوق الانسان عنصر معرفي، لا يكفي العمل فيه بحسن النية ، وعلى جميع الدول العمل به وهذا ما نريده من دول الخليج ، نريد منهم أن يسمحوا للناس بالحديث في إطار حقوقهم الانسانية المكفولة. كما أن أدوات وآليات العمل الحقوقي باتت متشعبة ومتعددة ولا يمكنك الوقوف ضدها ، فأنت مضطر مثلا كدولة أيا كنت ، أن تذهب في موعد محدد إلى جنيف وتقدم تقريرك أمام المراجعة الدولية الشاملة ، وتنتقد ، لا مفر من ذلك ، الدولة الوحيدة التي شذت عن هذه القاعدة هي إسرائيل، ثم وافقت مرغمة على ذلك ، كان قد حدد لها موعدا لدورتين للمثول أمام المراجعة الدورية ، فاحتجت واشتكت أن الأمم المتحدة ضدها وأنها لا تعامل بموضوعية ، وبالرغم من كل ذلك تم التفاوض معها إلى أن انضمت. هذه الآلية الجديدة لم تكن موجودة ، وحين أقول جديدة فانا أتحدث عن دورتها الأولى التي انتهت في عام 2012، نحن لا نتحدث عن شيء قديم ، هذه آليات جديدة .
– إذن كيف ستتعامل دول الخليج مع هذه الآليات الجديدة من وجهة نظرك؟
دول الخليج ليست الأسوأ في التعامل مع هذه الألية، فلديك روسيا على سبيل المثال ، ولكن هذا يشكل ضغطا على الحكومات، فدول الخليج تريد أن تعمل بخصوصيتها أو تفترض أن لها خصوصية وتعمل بها. هذه الفرضية تحتاج إلى فحص. هل دول الخليج لها خصوصية فعلا؟ يجوز … فكل دولة لها خصوصية بشكل أو بآخر، ولكنها ليست خصوصية مطلقة، ولا تستخدم ضد البناء المؤسسي في الدولة.
تأسيس الدولة يدخل فيه مفهوم المواطنة، صحيح بأن المواطنة حقوق وواجبات ، ولكن المواطنة لا تخلع ، فإذا حدث وخلعت المواطنة أصبح الشخص “بدون” ، إذن كيف يتعامل الناس مع البدون؟، ستواجه مفهوما جديدا عليك أن تعرف كيف تتعامل معه، لذلك ، ومن هذه النظرة الأوسع ، تستطيع فهم حقيقة ما يحدث في الخليج.
– نجد أن هناك قلة في النضج في العمل الحقوقي في المؤسسات والعاملين في هذا المجال من مواطني دول الخليج .. ما رأيك؟
عندما تعمل في مجال حقوق الانسان ولكي تصلح من حال كرامة الانسان في المجتمع، لديك وسيلتان ، إما أن تلجأ إلى وسائل الإعلام ، أو أن تخاطب صاحب الشأن ، وبالتالي وفي كلتا الحالتين يجب أن تمتاز بلغة خطاب مناسبة. اللغة الحادة والهجومية غير مقبولة أبدا سواء في الاعلام أو عند مخاطبة ذوي الشأن، يجب أن توجه مقالا أو خطابا بلغة مناسبة تذكر فيه تفاصيل الموضوع ، معززا بالقوانين وببنود الاتفاقيات الدولية وغيرها، أظن أن كثير من العاملين في مجال حقوق الإنسان بحاجة إلى أن يتعلموا ذلك. نعم هناك أناس استثمروا في انفسهم وفي وقتهم للعمل الحقوقي ، ولكن لا يجب الخلط بين الكلام الحقوقي والكلام السياسي، فكسياسي ، تختلف لغتك عند التوجه بنقد أو عتب للسلطة ، إذ يمكن أن تكون لغتك حادة، لكن في الجانب الحقوقي ، فاللغة الحادة مرفوضة مطلقا ، ولذلك فإن التقارير الحقوقية عادة ما تمتاز بلغتها الاحتمالية – مزاعم ، ادعاءات -.
– نعود إلى نقطة المساءلة من قبل مجلس حقوق الإنسان ، ألا ترى بأن هذا قد يدفع الحكومات إلى إنشاء مؤسسات حكومية تعنى بالعمل الحقوقي ؟
هذه المؤسسات بدورها هي من سيرفع تقارير العمل الحقوقي، وهي التي ستجيب على هذه الأسئلة.
كلام سليم ، في فترة العشر سنوات الماضية طفى على السطح أسلوب جديد تقوم به الحكومات ، وأكرر بان هذا موضوع دولي وليس خليجي ، ما يقوم به الخليج هو محاولة إيجاد مخرج والاستعانة ببعض المستشارين لمواجهة هذا الضغط الذي يشكل إزعاجا حقيقيا لهم ، فاحد هذه الأساليب هو خلق منظمات حقوقية حكومية ، تسمى GNGOs ، وهي منظمات تأتي بها الحكومات على حسابها ، وتقوم هذه المنظمات بالدفاع عن الحكومة ، وهذه مشكلة ، لأنها تتحول إلى معركة سياسية وليست حقوقية.
– ناديت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان في الكويت، ما هي رؤيتك ، وكيف لنا إنشاء هيئة مستقلة ، وعلى ماذا تعتمد ؟
اللجان الوطنية لحقوق الانسان موجودة حسب ما يسمى بمبادئ باريس، نموذج اللجان الوطنية حسب مبادئ باريس يساعد الانسان ويساعد الدولة إلى حد كبير في متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، مما قد يساهم بالتقليل من حدوث الانتهاكات في مجال حقوق الانسان. وعندما نتحدث عن المؤسسات الرقابية في الدول العربية مثلا والمتمثلة في الاجهزة الامنية فأننا نتحدث عن الكثير من التجاوزات في مجال حقوق الانسان، فحدوث فراغات في المجتمع مثلا يعطي جهاز الآمن أكثر من حقه ، وعادة ما تطالب هذه الأجهزة بصلاحيات واسعة ، وخوفا من حدوث ما قد يزعج الحاكم تعطى هذه الصلاحيات ، ومن ثم تحدث الانتهاكات بتبرير أنها حماية للأمن ، وهذا موجود حتى في دولة مثل أمريكا ، وبدليل وجود جوانتنامو ، حيث تحكم على المعتقلين فيه بالسجن المؤبد ، فهل يجدر بدولة “ديمقراطية” اللجوء إلى هذه الأساليب؟ هذا الامر يعطي سعادة غامرة للدول الصغيرة، ففيه تجد المبرر لما تقوم به أجهزتها الأمنية من انتهاكات.
– الدين قائم على مجموعة من المبادئ ، و أحد أهم هذه المبادئ هي الشورى وحرية الاختيار ، في الوقت الحالي ، يمارس الدين دورا شبيها بالحكومات، القمع .. الرأي الواحد ، الاتجاه الواحد والخضوع والامتثال ، كيف يؤثر ذلك على الحراك الحقوقي ؟
يؤثر على مستويين ، المستوى الحركي ، وهو الجماعات والتنظيمات التي تبث هذا الفكر المتشدد ، وهي تنظيمات صغيرة ، إذ أظن أن السواد الأعظم من الناس معتدلين ، لكنك تتحدث عن التنظيمات التي تملك صوتا عاليا ، وعندها شخصيات كارزماتية ظاهرة تتكلم باسم الدين . الجانب الآخر هو الجانب الثقافي ، هناك ثقافة سائدة على المستوى الديني ، لا تخدم موضوع التعددية .
ما حدث في مصر ضد الأخوان أدى إلى تحويل بعض الناس ضد الدين ، وهذا غير مطلق ، فالدين قناعة إنسانية بشرط أن لا يكون سببا في الاعتداء على الآخر ، لآن للآخر حق حرية التعبير والاعتقاد .
– بعد عام 1948 أقر حق الانسان في الجنسية ، تقره المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فهل الأولوية للمواطنة أم الأولوية للدين ؟
القانون لكل دولة يقول أن الأولوية للمواطنة وليس للدين، والدليل على ذلك هو ما يحدث في الدول الاسلامية، فالمبدأ الديني يقول أن المسلمين من أي بلد كان سواسية في التعامل ، لكن حين تستقدم الدولة المسلمة عاملا من دولة مسلمة أخرى وإن يكن مسلما فإنه يتم التعامل معه بدونية. هناك تناقض جوهري بين الفهم الديني للدولة والفهم المدني للدولة الوطنية الحديثة. كنت أتمنى أن يبحث المفكرون ذوو التوجه الديني في هذا الأمر ، فلم أجد حتى الآن كتابا يحل هذه الاشكالية أو يتنحدث عنها.
الدولة قائمة على المواطن والإقليم ، والسيادة والحكومة ، هذه أربعة أركان لما نسميه بالدولة القومية ، وهي مخلوق جديد ، لم يكن موجودا قبل 1648 ، نشأت من معاهدات “وستفاليا” التي حصلت في ألمانيا (يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول) وقد جاءت بعد حروب طويلة المدى اغلبها حروب دينية في منطقة جرمانيا ، غير أن معاهدات وستفاليا لم تنشئ دولا ديمقراطية بل دولا فقط ، وبناء عليه حصل خليط في الدولة من ديانات مختلفة ، وعليه فطالما أن لديك جنسية الدولة فأنت تعد مواطنا فيها مهما كان انتماؤك، وهنا ظهرت مفاهيم التعايش وقبول الآخر والتعدديه …الخ ، تنجح أو لا ، هذا أمر آخر ، فليست كل التجارب ناجحة ، فبلجيكا مثلا تحتوي على قوميتين يشكلان اتحادا فيدراليا ففيها الفليميش وفيها الناطقين بالفرنسية ، وهما قوميتان غير متفقتان أبدا.
– نلاحظ أنك تركز على الدولة في قضية حقوق الانسان ، ماذا عنه كفضاء عام ؟
الفضاء العام جزء من الدولة ، وأركز عليها لأنه وعاء التحليل ، وهو محور الارتكاز ، فالدولة تحوي الشعب الذي يشكل الفضاء العام .
– إذن كيف تبني الدولة بفضاء عام مستقر؟
كيف تبني دولة كالهند مثلا بما فيها من اختلافات في العرق والدين ؟ لديها ولايات يحكمها المسلمون وولايات يحكمها الشيوعيون وأديان أخرى ومع ذلك كان للهند القدرة على الاستمرار والتطور. في الجانب الأخر انظر إلى باكستان ، إذ تأسست لتكون دولة إسلامية وقامت على أساس ديني واحد حتى بات الدين جزء لا يتجزأ من الشخصية الباكستانية ، ورغم ذلك فقد انفصلت لتكون دولتين ، بنجلادش وباكستان بعد حرب طاحنة أدت إلى هذا الانشقاق.
– دعنا نتحث عن الفضاء العام للقضية ، دول الخليج دول منتجة للنفط ، وهي في نظر شعوب الدول العربية الأخرى دول غنية ، ويرون بأن الشعوب الخليجية أخذت حقوقها نتيجة لثراء حكوماتها ، ما رأيك بذلك ؟
أنت تتكلم عن دول الاستثناء في التاريخ ، انتاجها قليل وعائدها كبير بسبب امتلاكها لثروة موارد طبيعية لا تلعب دورا فيها ، يطلق عليها البعض مسمى الدولة الريعية ، فخروج الناس للمطالبة بحقوقهم في هذه الدول ذو سياق مختلف ، وبحاجة إلى تفسير ذكي ومنطفي . لأن السلطة كاملة في هذه الدول بيد الحكومات.