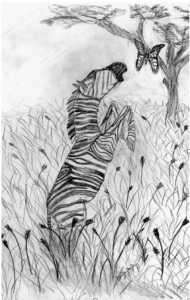بنشر مقدّمة كتاب “أشكال لا نهائية غاية في الجمال”، فإنّ مجلة الفلق تدشّن عموداً شهرياً يُعنى بنشر مقتطفات من كتب عُمانية نُشرت حديثاً.
مؤّلف الكتاب هو البروفيسور شون بي كارول أستاذ علم الأحياء التطوري في جامعة ويكنسُن، وهو كذلك نائب رئيس معهد هاور هيوز الطبي.
ترجم الكتاب إلى العربية عبدالله المعمري وحمد الغيثي، ونشره مشروع كلمة في أبوظبي. ولقد حازت الترجمة على جائزة السُلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الترجمة عن فرع الثقافة.
اسم الكتاب: أشكال لا نهائية غاية في الجمال
المؤلف: شون كارول
المترجم: عبدالله المعمري، وحمد الغيثي
الناشر: مشروع كلمة للترجمة
ISBN13:
توطئة: الثورة #٣
تخبرني أنك تريد ثورةً
حسناً، أنت تعلم
كلنا نودُ تغيير العالم.
تخبرني أنّه تطور
حسناً، أنت تعلم
كلنا نودُ تغيير العالم…
تخبرني أنّ عندك الحل الأمثل
حسناً، أنت تعلم
كلنا نودُ رؤية الخطة
جون لينون (John Lennon) وبول مكارتني (Paul McCartney)
(Revolution#1 (1968
كتب جون بيرين (Jean Perrin) -الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل- ذات مرة أن مفتاح أي تقدم علمي هو مقدرته على “تفسير البنى الشديدة التعقيد ظاهرياً بأجزائها البسيطة المضمرة”، وقد اتسمت أكبر ثورتين في علم الأحياء، وهما نظرية التطور وعلم الجينات، بمثل هذه الرؤية، إذ فسّر دارون (Darwin) السجلات الأحفورية التي دونت مسيرة الأنواع الحية، والتنوع الهائل للكائنات الحية، باعتبارها نتيجة لانتخاب طبيعي (Natural Selection) حدث عبر أزمنة مديدة، وفسر علم الأحياء الجزيئية كيف أن مبادئ توارث الصفات الوراثية في جميع الأنواع مشفرة في جزيئات الحمض النووي (الدنا) المكون فقط من أربعة أجزاء أساسية. ورغم عمق هذه التصورات العلمية وقدرتها على شرح أصل الأشكال شديدة التعقيد -بدءاً بأجسام ثلاثيات الفصوص (Trilobites) البائدة إلى مناقير عصافير جالاباجوس- إلا أنها ظلت ناقصة، ولم يقدم الانتخاب الطبيعي أو الدنا تفسيراً مباشراً لسؤالين مهمين هما: كيف تكوّن شكل الكائن الحي؟ وكيف تطورت هذه الأشكال عبر الزمن؟
ظل النمو (Development) أحد أعظم ألغاز علم الأحياء العصيّة على الحل ما يقارب قرنين من الزمان. ويكتسب النمو أهميته من كونه مفتاحاً لفهم الشكل (Form)، فهو تلك العملية التي تتحول خلالها بويضة مكونة من خلية واحدة إلى حيوان مكون من بلايين الخلايا. وللنمو علاقة وثيقة بالتطور لأن الشكل يتغير تبعاً لتلك التغيرات التي تطرأ على الأجنة. وقد بزغت في العقدين الأخيرين ثورة أحيائية جديدة، فقد كشف التقدم في علم أحياء النموّ وعلم النمو التطوري (يختصر باسم “الإيفوديفو” Evo Devo) الكثير عن الجينات غير المرئية، وبعض قواعدها البسيطة التي تَنْحت شكل الحيوان وترسم تطوره عبر الزمن. معظم ما تعلمناه كان مذهلاً وغير متوقع، وأعاد بعمق تشكيل فهمنا للكيفية التي تتطور بها الأنواع، إذ لم يخطر مثلاً ببال أحد من علماء الأحياء أن الجينات التي تتحكم في صنع جسم الحشرة وأعضائها الداخلية هي ذاتها الجينات التي تتحكم في صنع أجسامنا.
يحكي هذا الكتاب قصة هذه الثورة الأحيائية الجديدة، ورؤيتها العميقة لكيفية تطور المملكة الحيوانية. أهدف من خلال هذا الكتاب أن أرسم صورة واضحة لعملية تشكّل جسم الحيوان، وأن أوضح كيف أن تغيرات شتى طرأت على عملية التشكّل هذه قد أدت إلى صياغة أشكال الحيوانات المختلفة، سواء تلك الحية المعروفة لدينا الآن أو تلك التي حفظتها لنا سجلات الأحافير.
كتبت الكتاب واضعاً في ذهني عدداً من القراء الافتراضيين، القارئ الأول هو ذلك المهتم بالطبيعة والتاريخ الطبيعي، الذي تخلب لبه حيوانات الغابات المطيرة أو الشعاب المرجانية، أو السافانا أو مكامن الأحافير بحفرياتها المتبقية. سيتضمن الكتاب الكثير عن تكوّن وتطوّر بعض من أكثر الحيوانات روعة، سواء تلك التي عاشت في الماضي أو تلك التي نراها في الحاضر.
القارئ الثاني يمثل الفيزيائيين والمهندسين وعلماء الكمبيوتر، وغيرهم من المهتمين بفهم جذور التعقيد (origins of complexity)، سيسرد الكتاب لهولاء قصة التنوع الهائل الذي نشأ من تجميع عدد قليل من مكونات شائعة.
القارئ الثالث يمثل الطلاب والمعلمين، لأني أعتقد اعتقاداً متيناً أن الرؤية الجديدة التي يقدمها علم الإيفوديفو ستمنح نظرية التطور ألقاً جديداً، وتقدم صورة أكثر إقناعاً وإشراقاً مقارنة بالصورة التي عادة ما تعرض في حلقات الدراسة والنقاش.
أما القارئ الرابع فهو ذلك الذي يتفكر في السؤال “من أين جئت؟”؛ فهذا الكتاب يتحدث عن تاريخنا، تاريخ الرحلة التي قطعناها جميعاً من البويضة إلى النضج، وتاريخ الرحلة الطويلة منذ بدء ظهور أول الحيوانات إلى ظهور نوعنا البشري.
رسمة لكريستوفر هير (Christopher Herr) البالغ من العمر عشر سنوات من مدرسة إيجل في ماديسون بولاية ويسكُنسن (Eagle School, Madison, Wisconsin)
المقدمة: فراشات، وحمر وحشية، وأجنة
تتمشى في الغيمات
في رأسها فراشات وحمر وحشية
وحكايات الجنيات وأشعة القمر
تلك هي، لا شيء آخر
جيمي هندريكس (Jimi Hendrix)
”Little Wing” (1967)
في زيارتي الأخيرة إلى مدرسة أطفالي الابتدائية، شدّتني رسومات الطلاب التي كانت تزين الممرات. تكررت رسومات الحيوانات في العديد من اللوحات، كان الحمار الوحشي أكثر الثدييات ظهوراً في هذه اللوحات، أما الفراشة فكانت الأكثر ظهوراً على الإطلاق، لا يمكن تبرير ذلك بأن الأطفال رسموا ما رأوه خارج النافذة، فقد كنا في فصل الشتاء بولاية وسكنسُن. لماذا إذًا كل هذه الفراشات والحمر الوحشية؟
أعتقد يقيناً أن هذه الرسومات تعكس ارتباط الأطفال العميق بشكل الحيوان: المظهر، واللون، والنمط. نشعر جميعاً بهذا الارتباط وهو الذي يفسر تقاطرنا إلى حدائق الحيوان لمشاهدة الحيوانات الغريبة، وتحلّقنا حول أقفاص الفراشات الغريبة، وذهابنا إلى أحواض الكائنات البحرية، وإنفاقنا البلايين على حيواناتنا المستأنسة من كلاب وقطط وطيور وأسماك. إن الدوافع الجمالية تطبع اختيارنا لحيواناتنا المستأنسة. وتفتننا، بل وأحياناً ترهبنا، أشكال الحيوانات الغير مألوفة مثل الحبار العملاق، والديناصورات اللاحمة، والعناكب آكلة الطيور.
إن هذا الارتباط والشغف بأشكال الكائنات الحية حرّك أعظم علماء الطبيعة عبر القرون. ففي تلك الحقبة الباردة والكئيبة ببريطانيا قبل العصر الفيكتوري، قرأ شاب صغير يدعى تشارلز دارون كتاب [سرد شخصي] Personal Narrative لألكسندر فون همبولت(Alexander von Humboldt) الذي يقع في ألفي صفحة ويحكي فيه تفاصيل رحلته في أرجاء أمريكا الجنوبية. أَسَرَ الكتابُ دارون، حتى ادّعى لاحقاً أنّ كل ما شغله كان التخطيط للوصول إلى تلك المناطق المدارية التي وصفها همبولت. وعندما سنحت الفرصة التحق دارون برحلة سفينة بيجل Beagle المتوجهة إلى أمريكا الجنوبية عام 1831. وبعد سنوات كتب دارون لهمبولت قائلاً: “تغير مسار حياتي بأكمله نتيجة لقراءة هذا السرد الشخصي وإعادة قراءته عدة مرات أيام صباي”. حلم إنجليزيان آخران بارتياد الآفاق، لاكتشاف أنواع حية جديدة، هما هنري والتر بيتس (Henry Walter Bates)؛ وهو موظف إداري وجامع حشرات شره في الثانية والعشرين من العمر، وصديقه عالم الطبيعة الذي علّم نفسه بنفسه ألفرد رسل والاس (Alfred Russel Wallace). لقد اتخذ هذان الشابان قراراهما بعد قراءة كتاب أمريكي يصف رحلة للبرازيل عام 1848. استمرت رحلة دارون خمس سنوات، ومكث بيتس في الأدغال 11 سنة، بينما قضى والاس هناك 14 سنة توزعت على مدار رحلتين. فجّر هؤلاء الحالمون، بناء على آلاف الأنواع التي شاهدوها وجمعوها، أوّل ثورة في علم الأحياء.
لابد من وجود شيء ما في المناطق الشمالية الباردة يلهم الناس ليحلموا بالمناطق الاستوائية. لقد نشأت في توليدو (Toledo) بأوهايو (Ohio) محاطاً بالحدائق العامة والمزارع، وعلى مقربة من الشواطيء غير السخيّة لبحيرة إيري (Erie). لكن أحلامي عن الجنّة غذتها المجلات والمسلسل التلفزيوني “مملكة الحيوان” Animal Kingdom الذي كان يُبث بالأبيض والأسود. ولذلك كنت محظوظاً بعد عقود حينما تمكنت سائحاً لا مغامراً شجاعاً من رؤية حيوانات السافانا الإفريقية، وأدغال أمريكا الوسطى، والشعاب المرجانية بأستراليا وبيليز (Belize). وقد أثار ما رأيته رهبة أكبر مما كنت أتخيّله في ذهني.
في مراعي كينيا الواسعة تمرّ الزرافات المتفرقة والنعّام والفهود بمحاذاة قطعان الحمر الوحشية والفيلة المنهمكة في التهام العشب. هناك أيضًا الأحصنة المخطّطة، والثدييّات الرمادية العملاقة التي يبلغ طول أنوف كل منها 6 أقدام، والقطط الرقطاء التي تجري أسرع من سيارة الجيب. لو لم توجد هذه الكائنات، لاستحال تصديق وجودها أصلاً.
خلافاً للمراعي الواسعة، تضج الغابات المطيرة بكائنات أصغر. فتحتَ الضوء المتكسر بفعل أغصان الأشجار الكثيفة ستلمح فراشات برّاقة مثل فراشة الهيليكونيس (Heliconius) ذات اللونين الأصفر والأحمر، أو تستمتع برقصة فراشة مورفو Morpho)) ذات اللون الأزرق المعدني. وفي الأسفل قليلاً، على الأرض، ينهمك ضفدع السهم السام المنقط باللونين الأحمر والفيروزي في النقيق، بينما ينغمس النمل قاطع الأوراق الخضراء في مشاريع حصاده الواسعة. تخرج الكائنات المفترسة من أوكارها للصيد ليلاً. لن أنسى أبداً الإثارة التي تملكتني إثر لقاء أفعى السنان القاتلة (fer-de-lance snake) التي يبلغ طولها 6 أقدام في الظلمة الحالكة والهدوء المطلق في مكان تعمره نمور اليغور (jaguars) في أدغال بيليز (شاهدنا الآثار الحديثة فحسب، لكن ذلك قريب بالقدر الكافي).
يضم البحر أشكالاً أكثر غرابة وإدهاشاً، إذ يكفي أن تغطس في المياه الضحلة قرب جزيرة مرجان أسترالية كي تكتشف التنوّع الكبير للأسماك والشعب المرجانية والكائنات الصدفية التي سترطم وجهك وهي تقفز مع موجة عابرة. أضواء النيون، وأجسام مختلفة الأشكال والأحجام، وتصاميم هندسية رائعة، وقد تلمح سلحفاة بحرية عملاقة أو أخطبوطاً أو قرشاً مسرعاً.
إن هذا التنوّع الهائل في حجم ومظهر ولون وتعضية أجسام الحيوانات يستحضر أسئلة عميقة حول أصول الأشكال الحيوانية: كيف تولّدت الأشكال المتمايزة؟ وكيف تطوّر هذا التنوّع الهائل في الأشكال؟ إنها أسئلة أحيائية قديمة ترجع إلى ما قبل عصر دارون وبيتس ووالاس، لكن أجوبتها اكتُشِفت حديثاً. هذه الأجوبة مدهشة وعميقة لدرجة إحداث ثورة في فهمنا لعملية تكوين عالم الحيوان وموقعنا فيه.
إن الحافز الأولي لكتابة هذا الكتاب هو هذا الانجذاب الذي نتشاركه جميعاً لشكل الحيوان، لكنني أهدف كذلك، إلى جذب نظر القارئ ودهشته نحو كيفية تكوّن شكل الحيوان، -أي فهمنا الحديث للعمليات الأحيائية التي تولّد النمط (pattern) والتنوّع في تصميم الحيوان. تكمن تحت العناصر المتعدّدة والمرئية من شكل الحيوان عمليات مميزّة وجميلة بحدّ ذاتها؛ في تحويلها خلية واحدة غاية في الصغر إلى كائن كبير معقد شديد التنظيم ذي نمط محدد. عمليات مميّزة صاغت مع الزمن مملكةً من ملايين التصاميم المتمايزة.
الأجنّة والتطوّر
إن المنهج الأول الذي اتخذه علماء الطبيعة للتعامل مع التنوع الهائل للحيوانات هو تصنيفها في مجموعات مثل: الفقاريات (Vertebrates) (متضمنة الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات)، ومفصليات الأرجل (متضمنة الحشرات والقشريات (Crustaceans) والعنكبوتيات (Arachnids) وغيرها)، لكن تكمن العديد من الاختلافات بين هذه المجموعات وداخل كل منها. فما الذي يجعل نوعاً من الأسماك مختلفاً عن السمندر (Salamander)؟ أو حشرة مختلفة عن عنكبوت؟ وعلى نطاق أضيق، من الواضح أن النمر قط، لكن ما الذي يجعله مختلفاً عن القط المنزلي؟ وما الذي يجعلنا مختلفين عن أبناء عمومتنا الشمبانزي؟
إن المفتاح الذي يفك لنا رتاج هذا السؤال يكمن في استيعابنا أن الشكل الحيواني هو في الأساس نتاج عمليتين: النمو من بويضة، والتطور عن الأسلاف. وحتى نفهم أصل هذا التعدد في أشكال الحيوانات يجب أن نفهم هاتين العمليتين والعلاقة الوثيقة بينهما. النمو ببساطة هو العملية التي تحول بويضةً إلى جنين، ومن جنين إلى شكل مكتمل، أما التطور فيحدث من خلال التغيّرات التي تطرأ على عملية النموّ.
تحبس هاتان العمليتان أنفاس المراقبين، إذ من خلية واحدة (بويضة ملقّحة) يتشكل كائن بالغ التعقيد. في غضون يوم واحد (كما هو حال يرقة ذبابة)، أو بضعة أسابيع (مثل الفأر)، أو عدة شهور (مثل الإنسان)، تنقسم وتتكاثر هذه البويضة خلال عملية النموّ إلى ملايين أو بلايين الخلايا، وفي حالة الإنسان، ربما تشكّل عشرة تريليونات خلية أعضاءه الداخلية وأنسجته وبقية أجزائه الأخرى. قليلة هي تلك الظواهر الطبيعية التي تخلب ألبابنا وتسمّرنا مشدوهين بالقدر ذاته الذي تفعله تحولات خلية واحدة إلى جنين ثم إلى كائن بالغ مكتمل الشكل. وقد وصف هذه العملية أحد أعظم الشخصيات في علم الأحياء ونصير دارون الوثيق توماس هكسلي (Thomas H. Huxley) بقوله:
إن تساؤلات الدارس للطبيعة تكثر وذهوله يقل، كلما ازداد إلمامه بعملياتها. لكن من كل المعجزات الدائمة التي توفّرها الطبيعة للفحص والتدقيق، ربما كان نموّ نبات أو حيوان من جنينه هو الأكثر استحقاقاً للإعجاب.
[أمثال وتأملات] (Aphorisms and Reflections (1907
لقد فُهمت العلاقة الوثيقة بين النموّ والتطوّر في علم الأحياء منذ فترة طويلة. فقد اعتمد كل من دارون في كتابيه أصل الأنواع The Origin of Species عام 1859 و[سلالة الإنسان] The Descent of Man عام 1871، وهكسلي في تحفته القصيرة [دليل حول موقع الإنسان في الطبيعة] Evidence as to Man’s Place in Nature عام 1863، اعتماداً كبيراً على حقائق من علم أجنة (كما كانت في أواسط القرن التاسع عشر) ليثبتا انتماء الإنسان لعالم الحيوان، ويبرهنا بواسطة دليل غير قابل للجدل على نظرية التطوّر. لقد دعا دارون قارئه لتأمل كيف أن تغيّرات طفيفة طرأت في مراحل مختلفة من عملية النموّ، وفي أجزاء مختلفة من الجسد، على مدار آلاف أو ملايين الأجيال خلال فترة امتدت ملايين السنين، استطاعت إنتاج أشكال مختلفة متأقلمة مع ظروف شتى وتمتلك قدرات فريدة. هذا هو التطور باختصار.
أما بالنسبة لهكسلي، فقد كان لب حجته بسيطاً: ربما نعجب من عملية تحول البويضة إلى فرد بالغ، لكننا نقبلها كحقيقة مشاهدة. ومن ثم فإن فقر الخيال هو المسؤول عن عدم إدراك أن التغيّرات المتراكمة في عملية النمو خلال فترات زمنية طويلة، أطول بكثير من مدى التجربة الإنسانية، تصوغ تنوّع الحياة. وعليه فالتطور طبيعي تماماً كالنمو.
التطور عملية طبيعية مشابهة في أسلوبها لنموّ شجرة من بذرتها، أو طير من بيضته، لذلك فإنه يستبعِدُ الخلق أو أي تدخل آخر فوق طبيعي.
(Aphorisms and Reflections (1907
رغم إصابة دارون وهكسلي في اعتبار النمو مفتاحاً للتطور، إلا أنهما لم يُحرز فعلياً أي تقدم في فهم أسرار النمو طيلة ما يزيد على 100 عام بعد إنجازاتهما الكبرى. لقد كان اللغز المتعلق بكيفية إنتاج بويضة بسيطة فرداً مكتملاً أحد أكثر الأسئلة مراوغة في علم الأحياء. اعتقد الكثيرون أن النمو عملية معقدة جداً، ذلك لأن تفاسير النموّ تتعدد بتعدّد الأنواع الحية المختلفة. كان المسعى محبطاً جداً بحيث إن دراسة علم الأجنة (Embryology) والوراثة (Heredity) والتطور، التي كانت متشابكة معاً وتشكل صميم فكر علم الأحياء قبل قرن، تفرّقت إلى حقول مختلفة، عندما بحث كل منها عن تحديد مبادئه الخاصة.
ولأن علم الأجنة توقف عن النمو فترة طويلة، فإنه لم يلعب دوراً فيما سُميَ ب”النظرية التركيبية الحديثة” (Modern Synthesis) للفكر التطوري التي ظهرت في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين. سعى علماء الأحياء، في العقود التي تلت دارون، لفهم آليات التطوّر؛ ففي زمن أصل الأنواع لم تكن آليات توارث الصفات معروفة، ولم يُكتشف عمل جريجور مندل ثانية إلا بعد عقود، أما علم الجينات (Genetics) فلم يزدهر حتى العقد الأول من القرن العشرين. حاول علماء من مختلف فروع علم الأحياء فهم التطوّر مستعينين بأساليب مختلفة جداً. على سبيل المثال، ركّز علم الأحافير (Paleontology) على المدد الزمنية الطويلة والسجل الأحفوري وتطور الأصنوفات العليا (taxa). أما علماء تصنيف الأحياء (systematists) فقد اهتموا بطبيعة الأنواع وعملية التناوع (speciation). بينما درس علماء الجينات بشكل عام تنوع الصفات في أنواع قليلة. كانت العلاقة بين هذه الفروع منقطعة، بل ظهرت أحياناً فيما بينها العداوة حول أيها الأجدر بتقديم رؤية ذات شأن حول علم الأحياء التطوّري (Evolutionary Biology)، لكن الانسجام حلّ تدريجياً عبر تكامل وجهات نظر تطوّرية على مستويات متعدّدة. فقد أشار كتاب جوليان هكسلي (Julian Huxley) [التطور: النظرية التركيبية الحديثة] Evolution: The Modern Synthesis عام 1942 إلى هذه الوحدة والقبول العام لفكرتين أساسيتين: الفكرة الأولى هي أنه يمكن شرح التطور التدريجي من خلال تغيرات جينية طفيفة تنتج تنوعاً يكون خاضعاً لتأثير الانتخاب الطبيعي. الفكرة الثانية هي أن التطور ذا المقدار الأكبر في المستويات التصنيفية العليا يمكن شرحه من خلال هذا التطور التدريجي لكن على مدى فترات زمنية أطول.
لقد أسست “النظرية التركيبية الحديثة” الكيفية التي نوقش ودرس بها علم الأحياء التطوري في الستين سنة الماضية، لكن على الرغم من مصطلحيْ “التركيب” و”الحديث” فإنّ الصورة ظلّت ناقصة. فمنذ تأسيسها وحتى وقت قريب كان باستطاعتنا القول أن الأشكال تتغير وإن الانتخاب الطبيعي قوة فاعلة، لكننا لم نكن نستطيع قول أي شيء عن كيفية تغير الأشكال، تلك الدراما المرئية للتطوّر كما صوّرت مثلاً في السجل الأحفوري. تعاملت “النظرية التركيبية الحديثة” مع علم الأجنة “كصندوق أسود” يحوِّل بطريقة ما معلومات وراثية إلى حيوانات ثلاثية الأبعاد قادرة على أداء وظائف عديدة.
استمر المأزق عدة عقود؛ فانشغل علم الأجنة بما يمكن دراسته عبر التلاعب ببويضات وأجنة أنواع قليلة، ولكن تلاشى من مجال رؤيته الإطار التطوري. كذلك ظل علم الأحياء التطوري يدرس التنوعّ الجيني في الجماعات، جاهلاً بالعلاقة بين الجينات والشكل. ولعل الأسوأ هو ذلك التصور الذي انتشر لدى البعض من أن المكان الطبيعي لعلم الأحياء التطوري هو المتاحف المهجورة.
هكذا كان الوضع في سبعينات القرن العشرين عندما تعالت أصوات تنادي بإعادة توحيد علمَيْ الأجنة والأحياء التطورية. كان أبرز هذه الأصوات ستيفن جاي ي جود (Stephen Jay Gould) الذي أحيا عبر كتابه [التخلّق والتعرّق] Ontogeny and Phylogeny النقاش حول الطرق التي قد تؤثر بها تغييرات في النمو على التطوّر. وهزّ جود أيضًا الأحياء التطوري عندما قدم مع نيلز إيلدريدج (Niles Eldredge) نظرة جديدة للأنماط الرئيسة في السجل الأحفوري، ليقدما فكرة التوازنات المتقطعة (punctuated equilibria) التي مفادها أن التطور تميز بفترات طويلة من الركود (الاتزان)، تخللتها فترات قصيرة من التغيير السريع (فواصل). أعاد جود في كتابه هذا وكتاباته اللاحقة دراسة ماهية “الصورة الكبرى” في علم الأحياء التطوري وقام بتحديد الأسئلة الرئيسة التي بقيت دون حل. غرس جولد بذوراً في عدد غير قليل من العلماء الشباب سريعي التأثر، وكنت أحدهم.
بدى لي ولغيري، المنبهرين بالنجاحات البارزة لعلم الأحياء الجزيئية في شرح كيفية عمل الجينات، أن الوضع في علمَي الأحياء التطوري والأجنة غير مرض، لكنه مليء بالفرص الواعدة. حوّلت معرفتنا المحدودة بعلم الأجنة أغلب النقاش في علم الأحياء التطوري حول تطور الشكل إلى تخمينات عقيمة. فكيف يمكن أن نحرز تقدماً في إجابة أسئلة تطور الشكل دون أن نملك فهماً علمياً لكيفية تخلُّق الشكل في المقام الأول؟ نجح علم جينات الجماعات (Population Genetics) في تأسيس المبدأ القائل أن التطور ينتج عن تغيرات في الجينات، لكنه كان مبدأ دون دليل. لم يتم توصيف أي جين أثّر في شكل أو تطور أيّ حيوان. إنَّ أيّ فهم جديد في التطور حدوث اختراق في علم الأجنة.
ثورة الإيفوديفو
أدرك الجميع أن الجينات يجب أن تكون في مركز الألغاز في مسألتيْ النمو والتطور. إذ تبدو الحمر الوحشية كالحمر الوحشية، والفراشات كالفراشات، ونبدو نحن البشر بالشكل الذي نظهر عليه بسبب الجينات التي نحملها. لكن المشكلة هي أنه لم يكن بحوزتنا سوى لمحات قليلة عن ماهية الجينات التي تؤثر في نمو الحيوان.
انقطع أخيراً الجفاف الطويل في علم الأجنة بفضل عدد من علماء الجينات اللامعين الذين وضعوا مخططات -أثناء عملهم على ذبابة الفاكهة- حقل التجارب الأساسي لعلم الجينات في الثمانين سنة الماضية، لتحديد الجينات التي تتحكم بنمو الذبابة. أعطى اكتشاف هذه الجينات ودراستها في ثمانينات القرن العشرين أفقاً جديداً مثيراً لدراسة النموّ وكشف المنطق والنظام وراء تكّون شكل الحيوان.
على إثر تمييز المجموعات الأولى من جينات ذبابة الفاكهة، أتت المفاجأة المذهلة التي أدت إلى ثورة جديدة في الأحياء التطورية. افترض علماء الأحياء لأكثر من قرن أن الحيوانات المتباينة أنشأتها جينات مختلفة بطرق مختلفة تماماً. فكلما عظُمَ التباين في شكل الحيوان قل (أو انعدم) ما يتشاركه نمو حيوانين اثنين على مستوى الجينات. كتب إرنست مَيَر (Ernst Mayr)، أحد مهندسي التركيب الحديث: “البحث عن “الجينات المتناددة” (homologous genes) بين الحيوانات عملية عقيمة جداً إن استثنينا الأنواع ذات القرابة الكبيرة”. ولكن على عكس توقعات أي عالم أحياء، فأغلب الجينات التي اكتشف أنها تنظم الجوانب الرئيسة في جسم ذبابة الفاكهة، وُجدْ لها نظائر مماثلة تفعل الشيء ذاته في معظم الحيوانات، بما في ذلك الإنسان. ولقد تبع هذا الاكتشاف معرفة أنّ نمو أجزاء الجسم المختلفة، مثل العيون والأطراف والقلب، التي يختلف قوامها على نحو واسع بين الحيوانات، واعتُقد طويلاً أنها تطوّرت بشكل مختلف تماماً، محكوم أيضًا بنفس الجينات في الحيوانات المختلفة. وهكذا أصبحت مقارنة جينات النموّ بين الأنواع حقلاً جديداً يقع في منطقة تقاطع عِلميْ الأحياء التطوري والأجنة: علم أحياء النمو التطوري أو ما يعرف اختصاراً بالإيفوديفو (Evo Devo).
كشفت المساعي الأولى لثورة الإيفوديفو أنه بصرف النظر عن الاختلافات الكبيرة في المظهر ووظائف الأعضاء، فإن كل الحيوانات المعقدة -الذباب، وصائدات الذباب (flycatchers)، والديناصورات، وثلاثيات الفصوص، والفراشات، والحمر الوحشية، والإنسان- تشترك في عُدَّة أدوات (tool kit) شائعة من “الجينات الحاكمة” (master genes) التي تدير عمليات تكوين وتنميط جميع هذه الأجسام وأجزائها المختلفة. سأصف بالتفصيل اكتشاف “عُدَّة الأدوات” وخصائصها الرائعة في الفصل الثالث. لكن ما ينبغي إدراكه منذ البداية هو أن اكتشاف هذه الجينات قد هشَّم أفكارنا السابقة عن علاقة الحيوانات ببعضها البعض، وعما جعل الحيوانات مختلفة، وقدّم طريقة جديدة كلياً للنظر إلى التطور.
نعرف الآن بعد تحديد متواليةِ الدنا لعدة أنواع (جينوماتها Genome)، أن الإنسان يتشارك مع الذباب مجموعة كبيرة من جينات النموّ، وأن الفأر والإنسان يملكان ما يقارب 29 ألف جين متطابق، وأن الشمبانزي والإنسان متطابقان بما يقارب 99٪ على صعيد الدنا. ينبغي أن تكون هذه الحقائق والأرقام مدعاة لتواضع الراغبين في وضع الإنسان فوق عالم الحيوان وليس جزءًا متطوراً منه. أتمنى أن تنتشر على نحو واسع الرؤية التي سمعت الكوميدي المرتجل لويس بلاك Lewis) (Black يعبّر عنها، حين قال إنه لن يفكر بمجادلة المستخفين بنظرية التطور لأن “لدينا الأحافير، لذلك ننتصر”. ورغم بلاغة بلاك إلا أنّ الأحافير ليست سوى جزء بسيط مما لدينا.
في الواقع، إن الحقائق والرؤى الجديدة التي يقدمها عِلْما الأجنة والإيفوديفو تُضعضع بقايا ذلك الخطاب القديم المناهض للتطوّر بشأن جدوى الأشكال الوسيطة (intermediate forms) أو احتمالية تطور البنى المعقدة. إننا نفهم الآن كيف يُشاد التعقيد من خلية واحدة إلى حيوان كامل، ويمكننا أن نرى، باستخدام تشكيلة جديدة من الأساليب القوية، كيف أن التعديلات الطارئة على النموّ تزيد التعقيد وتوسع التنوعّ. إن اكتشاف “عدة الأدوات” الجنينية الغابرة دليل لا يدحض على أن الحيوانات، متضمنة الإنسان، قد طرأت عليها تعديلات خلال تحدّرها من سلف مشترك بسيط. باستطاعة الإيفوديفو اقتفاء أثر التعديلات على الأشكال خلال حقب طويلة من الزمن التطوري لرؤية كيف تحورّت زعانف الأسماك إلى أطراف في الفقاريات البرية، وكيف أنّ دورات متتالية من الإبداع والتعديل صنعت أجزاء الفم، والمخالب السامة، وزوائد (appendages) التغذية والسباحة، والخياشيم، والأجنحة من أرجل مشي بسيطة تشبه الأنبوب، وكيف نشأت أنواع عديدة من العيون بدءًا من مجموعة خلايا حساسة للضوء. ما قدمه الإيفوديفو من ثروة معلومات جديدة يرسم صورة واضحة للكيفية التي صُنعت وتطورت بها الأشكال الحيوانية.
مفارقة عدة الأدوات وجذور التنوع
تسرب ببطء للوعي العام امتلاك الحيوانات لذات الجينات المسؤولة عن بناء الجسم، وأيضًا حجم التشابهات بين جينومنا البشري وجينومات الحيوانات الأخرى. لكن ما يُهْمَل عموماً هو كيف أن اكتشاف عدة الأدوات العامة المشتركة والتشابهات الكبيرة بين جينومات الأنواع المختلفة يعرض تناقضاً ظاهرياً جلياً. إن كانت هذه التشكيلات الجينية مشتركة على نحو واسع، فكيف تنشأ الاختلافات؟ إنّ حل هذه الإشكالية وتبعاتها محوري لقصتي. ويحلّ التناقض الظاهري للتشابه الجيني الكبير بين أنواع متنوّعة من خلال فكرتين أساسيتين سأطرحهما وأطورهما خلال الكتاب، وسأرجع لهما باستمرار. فهما ضروريتان لإدراك أن التعليمات الخاصة ببناء حيوان مشفرة في دناه، وضروريتان لفهم كيف ينتج الشكل ويتطوّر. لم تجد هذه الأفكار سوى اهتمام ضئيل، إن لم يكن معدوماً، في الإعلام العام، لكن لهذه الأفكار تأثيرات عميقة في فهم الفصول العظيمة في تاريخ الحياة مثل تفشي الأشكال الحيوانية أثناء العصر الكامبري (Cambrian period)، وتطور التنوّع في مجموعات مثل الفراشات أو الخنافس أو العصافير، وتطورنا من سلف مشترك مع الشمبانزي والغوريلا.
الفكرة الأولى هي أن التنوع لا يتعلق كثيراً بعدد جينات عدة الأدوات، لكن “بالطريقة التي تستخدم بها” حسب تعبير إريك كلابتون (Eric Clapton). ويعتمد نموّ الشكل على تشغيل الجينات أو إيقافها في أوقات وأماكن مختلفة خلال المدة الزمنية للنموّ. تنشأ الاختلافات في الشكل من تغيرات تطورية حدثت في مكان وتوقيت استخدام هذه الجينات، وخصوصاً تلك الجينات التي تؤثر في عدد البنى ومظهرها وحجمها. سنرى أنّ هناك عدة أساليب لتغيير الطريقة التي تستخدم بها الجينات والتي أدت إلى خلق تفاوت هائل في تصاميم الأجسام، وتنميط (صناعة النمط) الأشكال المفردة.
أما الفكرة الثانية فمعنية بالموضع في الجينوم الذي يوجد فيه الدليل الحاسم على التطور في الشكل. لقد اتضح أن هذا الدليل لم يكن موجوداً حيث كنا نبحث عنه أغلب وقتنا في الأربعين سنة الماضية. لقد استقر فهمنا منذ فترة طويلة أن الجينات مكونة من سلاسل دنا طويلة تُفك شفرتها في عملية عامة لإنتاج بروتينات تقوم بالعمل الفعلي في الخلايا والأجسام الحيوانية. وقد عرفت الشفرة الجينية التي تنتج البروتينات -المكونة من عشرين مفردة- منذ أربعين عاماً، وعليه تسهل معرفة سلاسل البروتينات الناتجة عن سلاسل الدنا المشفرة. لكن ما لا يتم الانتباه إليه بشكل كاف أن جزءاً ضئيلاً من دنانا -ما يقدر بنحو 1.5٪ فقط- يولِّد ما يقارب ٢٥ ألف بروتين في أجسامنا. ما هي إذن وظيفة الجزء الأكبر من دنانا؟ يتكون نحو ٣٪ منه من ١٠٠ مليون قُطيْعة وظيفتها “التنظيم”. يحدد هذا الدنا التنظيمي توقيت إطلاق ما ينتجه جين معين، والكمية المصنوعة منه، والموضع المستهدف. سوف أشرح كيف أن الدنا التنظيمي موضب في أجهزة صغيرة مبهرة تدمج معلومات عن الموضع في الجنين ومدّة عملية النمو. تُحَوَل مخرجات هذه الأجهزة في النهاية إلى أجزاء تشريحية تكوّن أشكال الحيوانات. يحتوي الدنا التنظيمي على تعليمات لبناء البنية التشريحية، وتقود التغيّرات التطوّرية في هذا الدنا التنظيمي إلى تنوّع الشكل الحيواني.
ينبغي أن أغطي بعض الجزئيات كي يتضح دور وأهمية الدنا التنظيمي في التطور. يجب أن يلم المرء أولاً بالكيفية التي تبنى فيها الحيوانات، وأدوار الجينات في النمو الجنيني. سيغطي هذا الموضوع القسم الأول من الكتاب، وسيحمل لوحده العديد من الفوائد. سأرسم بعض الملامح العامة لمعمار جسم الحيوان، واتجاهات تطور تصميم الجسم التي تتشاركها مجموعات مختلفة من الحيوانات (الفصل الأول). وسأصف بعض الأشكال الطافرة (mutant forms) المذهلة التي قادت علماء الأحياء لاكتشاف عُدة أدوات “الجينات الحاكمة” التي تنظّم النمو (الفصلان الثاني والثالث). وسنرى هذه الجينات وهي منهمكة في عملها، وكيف أنها تعكس منطق وترتيب عملية بناء أجسام الحيوانات والأنماط المعقدة (الفصل الرابع). وسنطلع أيضًا على الأجهزة الموجودة بالجينوم التي تحتوي تعليمات لبناء البنية التشريحية (الفصل الخامس).
سأربط في القسم الثاني من الكتاب ما تعلمناه عن الأحافير والجينات والأجنة معاً لمعرفة عملية صناعة التنوع الحيواني. وسأسلط الضوء على بعض من أكثر الحلقات أهمية وتشويقاً وإقناعاً في تطور الحيوان، تلك التي ترسم كيف صاغت الطبيعة تصميمات مفردة عديدة من عدد قليل من اللبنات. وسأتفحّص بعمق أسس النموّ والأسس الجينية للانفجار الكامبري الذي أنتج العديد من الأنماط الأساسية للحيوانات وأجزاء الجسم التي نعرفها اليوم (الفصلان السادس والسابع). وسأسبر جذور أنماط جناح الفراشة باعتبارها مثالاً باهراً على أنّ اختراع الطبيعة يتم عن طريق تعليم الجينات الغابرة حيلاً جديدة (الفصل الثامن). وكذلك سأروي قصصاً عن تطوّر ريش طيور الجزر وألوان الفراء في الثدييات (الفصل التاسع). كلها قصص تتميز بطابع جمالي وتعطينا رؤية عميقة للعملية التطورية، ولكن لهذه القصص نتائج مباشرة وآنية بحكم كونها دراسات تكشف ذات العمليات التي شكّلت أصل الإنسان. وسأصف في الفصول الأخيرة من الكتاب صناعة نوعنا المُميّز غالباً “بعقله الجميل” أكثر من أية صفة مبدئية أخرى (الفصل العاشر). وسأقتفي أثر بداياتنا من سلف يشبه النسّانين apelike)) قبل 6 ملايين سنة لأتتبع التغييرات الجسدية والنمائية التي قادت إلى ظهور الإنسان العاقل. وسأناقش نطاق وأنواع التغييرات الجينية التي حدثت في أثناء مسار تطورنا، وتلك المسؤولة على الأرجح عن تطور الصفات التي يتميّز بها الإنسان.
العظمة في بناء أحدث: المرحلة الثالثة
يمكن أن ننظر إلى القصة المستمرة لنظرية التطوّر باعتبارها دراما تتكون على الأقل من ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى ختم دارون، قبل 150 سنة تقريباً، أهم كتاب في تاريخ علم الأحياء بحضّ قرائه على مشاهدة العظمة في رؤيته للطبيعة، في كيف أنه “من بداية بسيطة جداً، قد تطورت، ومازالت تتطور، أشكال لانهائية غاية في الجمال”. في المرحلة الثانية وحّد معماريو “النظرية التركيبية الحديثة” ثلاثة حقول علمية على الأقل ليصوغوا تركيباً فخماً. أما في المرحلة الثالثة، فقد وفر علما الأجنة والنموّ التطوّري رؤية حول صناعة شكل الحيوان والتنوّع، وقد تميزت هذه الرؤية بعظمة خاصة. جزء من هذه الرؤية جليّ، حيث يمكننا مشاهدة الكيفية التي تتبلور بها الأشكال اللانهائية لحيوانات مختلفة.
إن الجمال ليس قضية سطحية في العلم، فأسمى العلوم هو ما تنتجه بشكل متكامل جوانبنا العاطفية والفكرية، أي فصا دماغنا الأيمن (العاطفي أو المبدع) والأيسر (المنطقي). إن أعظم نشوات الاكتشاف العلمي هي ما تجمع الجماليات الحسية والرؤية المفهومية. دوَّن الفيزيائي وعازف البيانو فيكتور فايسكوبف مرة أنّ “الجميل في العلم، هو ذاته الجميل في بيتهوفن؛ أحداث ضبابية، وفجأة تبصر رابطاً يعبّر عن هواجس الإنسان التي تسكن أعماقك، ويصل الأشياء التي كانت دائماً بداخلنا لكنها لم توصل أبداً من قبل”.
باختصار يوفر أفضل العلوم تجربة مشابهة لتلك التي توفرها أفضل الكتب أو الأفلام. تشغلنا أحجية أو دراما، ونتابع قصة ما من أجل كشفٍ يجعلنا في أفضل أمثلته نرى ونفهم العالم بجلاء أكبر. وإذا كانت الحقيقة هي القيد الذي يحد من حركة العالِم، فهل باستطاعة العلم الطبيعي أن يلهمنا ويبهجنا كما يفعل عالم الرواية؟
نشر رديارد كبلينج (Rudyard Kipling) قبل مائة سنة كتابه الكلاسيكي [قصص متقنة] Just So Stories، وهو مجموعة قصص للأطفال استلهمها من تجربته في الهند. بعض قصص كبلينج الساحرة حملت عناوين مثل: “كيف حصل النمر على رقطته؟” و”كيف حصل الجمل على حدبته؟” و”الفراشة المدموغة”. نسج الكتاب حكايات خيالية عن كيفية اكتساب بعض حيواناتنا المفضّلة والأكثر غرابة ملامحها البارزة. بذات اللذة التي عللت بها قصص متقنة كيفية ظهور البقع والخطوط والحدبات والقرون، يستطيع علم الأحياء الآن سرد قصصٍ عن الفراشات والحمر الوحشية والنمور التي أؤكد أنّ كل جزء منها لا يقل سحراً عن قصص كبلينج الخرافية. بل الأكثر من ذلك، هو أن قصص علم الأحياء تقدم حقائق أنيقة بسيطة تُعمِّق فهمنا لكل الأشكال الحيوانية، بما في ذلك أنفسنا.
الهوامش:
١. علم الأحياء الجزيئية (Molecular Biology) هو فرع من علم الأحياء معني بدارسة الأساس الجزيئي للنشاط الأحيائي، وتأثير شكل الجزيئات الحيوية، كالدنا DNA) ) والرنا (RNA) والبروتينات، في وظيفتها. المترجمان
٢. نوع (Species) (ج. أنواع) هو أحد وحدات تصنيف الكائنات الحية ويشمل الكائنات التي تستطيع التكاثر فيما بينها منتجة ذرية قادرة على التكاثر. المترجمان
٣. الحمض النووي الرايبوزي منقوض الأوكسجين (DNA) جزيء، الحامل الرئيسي للصفات الوراثية في الكائنات الحية. يشارك وشقيقه الحمض النووي الرايبوزي (RNA) في نقل المعلومات الوراثية للبروتينات. المترجمان
٤. الشكل هو مظهر الحيوان وهيئته وبُنيته، للزرافة مثلاً شكل يختلف عن النمر وهو بدوره يختلف عن النملة، سيرد المصطلح كثيرا وسيغدو مألوفاً جداً كلما تقدمنا في الكتاب. المترجمان
٥. علم أحياء النمو (Developmental Biology) هو فرع علم الأحياء المعني بدراسة المراحل التي يمر بها الكائن الحي منذ التلقيح وحتى الشيخوخة عبر التحكم الوراثي بنشاط الخلايا والأنسجة. علم النمو التطوري (Evolutionary Developmental Biology) معني بمقارنة عملية النمو في كائنات مختلفة، ليستخلص كيفية “تطور” عملية النمو. المترجمان
٦. النمط كلمة تصف في الأصل الشكل المتكرر على اللباس والفرش وهي في سياق الكتاب تعني كل ما يمكن أن يحمل هذا المعنى من الأشكال المتكررة في أجنحة الفراش والطيور، إلى شكل الأصابع وترتيبها، إلى شكل النشاط الجيني عند تمييزه بصبغة كاشفة. راجع مادة “نمط” في لسان العرب للإستفاضة. المترجمان
٧. جريجور مندل (Gregor Mendel ) راهب نمساوي يعتبر مؤسس علم الجينات من خلال اكتشافه أن بعض الصفات الوراثية في نبات البازلاء تنتقل وفقاً لنمط معين. تم الانتباه لاكتشاف مندل العلمي بعد وفاته بعقود. المترجمان
٨. الأصنوفة (taxon) هي وحدة تنظيمية في علم التصنيف (taxonomy) الذي يوزع المتعضيات في أصنوفات (taxa) بناء على الصفات المشتركة بينها، راجع الملحق رقم 1. المترجمان
٩. التناوع هو تكوين نوع جديد في مرحلة ما من مراحل التطور. المترجمان
١٠. كانت ذبابة الفاكهة ( Drosophila melanogaster) من أوائل وأهم النماذج الدراسية (model organism) التي استخدمت في أبحاث علوم الوراثة والنمو والتطور، ويرتبط تاريخها في الأبحاث الأحيائية بتجارب توماس هَنت مورجان في جامعة كولومبيا عام 1910. المترجمان
١١. تحديد المتوالية (sequencing) خطوات معملية تُجرى لتحديد التسلسل الدقيق لقواعد الدنا، في لسان العرب (مادة سلسل): “السَّلْسَلة اتصالُ الشيء بالشيء”. المترجمان
١٢. ينتظم الدنا في جزئيات يختلف عددها حسب نوع الكائن الحي. يسمى كل جزيء كروموسوماً. الجينوم هو مجموع المعلومات الوراثية الموجودة في كل الكروموسومات. المترجمان
١٣. عملية عامة (universal process) أي موجودة بجميع الكائنات الحية، وهي هنا أن المعلومات الوراثية تنتقل من الدنا إلى الرنا الرسول إلى البروتينات. المترجمان
١٤. تبنى البروتينات من 20 حمض أميني، و يكتب كل حمض أميني باستخدام ثلاث قواعد دنا. المترجمان