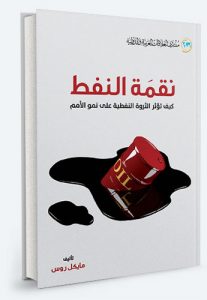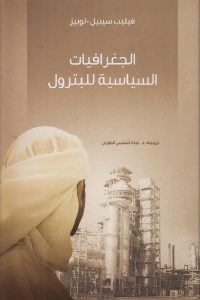لعنة الموارد في كتابي ” نقمة النفط ” و ” الجغرافيات السياسية للبترول”
ابتداء؛ لا بأس من توضيح مسألة مرتبطة بهذه الخدمة التي تقدمها مجلة الفلق الإلكترونية لقرائها ومتابعيها من خلال هذا التناول لإصدارات تستشعر إدارة التحرير بالمجلة أهمية محتواها، وأن فائدة معرفية يمكن للمتابع أن يجنيها في حال أتيحت له فرصة الاطلاع ولو على رؤوس المواضيع أو الأفكار الرئيسة التي تتضمنها هذه الكتب. ولتحقيق مزيد من الفائدة؛ فإن التوجه منذ البداية انطلق من فكرة أن يتجاوز التناول فكرة العرض التقليدي الذي تزخر به معظم المواقع والإصدارات الصحفية، وأن نشق في المجلة طريقًا جديدًا، ما أمكن، بحيث يصبح موضوع الكتاب، مجال المعالجة، مدخلا لتناول الموضوع نفسه، تحليلا وربما نقدًا وإضافة عليه، هكذا كانت الفكرة بالأساس، وهكذا كانت تطبيقاتها في عدد غير قليل من العروض التي جرى نشرها سابقا على صفحة المجلة.
وعندما تقدمت الشهر الفائت إلى رئيس تحرير المجلة، المهندس سعيد المسكري، بعناوين مقترحة للعرض، ذهب في اقتراح له إلى خطوة أبعد من الفكرة الأصلية؛ إذ لاحظ وجود وحدة موضوعية في عدد من العناوين المقترحة، وأبدى ملاحظة تفضي إلى دمج الإصدارات التي تتناول موضوعا واحدا، على اختلاف في طريقة المعالجة، بحيث يتسع التناول لهذه الكتب ليشمل أكثر من عنوان في العرض الواحد، وبذا تتشكل لدى القارئ أو المتابع رؤية أوسع وأشمل عن الموضوع المطروح للتناول، وتغدو الفسحة المعرفية أوسع والمجال الفكري أكثر عمقا. وهذا الذي كان من خلال هذا التناول لكتابين من إصدار باحثين متخصصين في مجالهما، عالجا في كتابيهما قضية واحدة، هي الأكثر حيوية وتأثيرًا على حياة البشرية المعاصرة، إنها الخاصة بما يمكن تسميته بلعنة الموارد، التي يشكل البترول الجزء الأكبر منها، هذه الثروة التي تردد عنها منذ بواكير ظهورها: البترول 10% اقتصاد و 90% سياسة. وهي ذاتها التي قال فيها ملك ليبيا، إدريس السنوسي، عندما بشروه بأن اتحاد الشركات الأمريكية اكتشف النفط في بلاده، فقال :” أتمنى لو أنكم عثرتم على مياه”.
وبالفعل؛ فبعد قراءة الكتابين اتضح أن الأول ” نقمة النفط” يضع هذه الثروة داخل سياقها التاريخي، فيما يضعها الكتاب الثاني ” الجغرافيات السياسية للبترول ” داخل سياقها الجغرافي؛ إلا أن الكتابين يفصحان بصورة واضحة ومباشرة عن الدلالات السياسية لقصدهما في التأليف بالموضوع وتناوله، وهذه أهم النقاط المشتركة بينهما. وهناك نقطة فنية ثانية تجمع بين الإصدارين، أنهما صادران بطبعتهما العربية عن دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي، الأول صادر عن “منتدى العلاقات العربية والدولية ” في الدوحة عام 2013 ويقع في 430 صفحة، والثاني صادر عن ” هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ” في الامارات العربية، ويقع في 445 صفحة، وهذه مسألة لها دلالة أن موضوع النفط وما يكتنفه من حساسية في التناول – عائداته وآثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية – لم يعد قضية محظور تناولها، أو تابو مغلق تحرص كبرى الدولة المنتجة لهذه الثروة حظر فتحه وإعلانه على العموم، وهذه قضية لها دلالة إيجابية، بالغة الأهمية. وللاختصار وعدم التكرار؛ سيُرمز كتاب نقمة النفط حيثما ورد بالإشارة ” أ “، وكتاب الجغرافيات السياسية سيرمز له بالإشارة “ب”.
الإنجليزي مايكل روس، مؤلف الكتاب “أ”، معاصر متخصص في مجال الفلسفة العلمية، وله شهرة ذائعة الصيت نتيجة أعماله المتخصصة في العلاقة بين العلم والدين. والتوظيف الفلسفي في مسألة علمية بحتة تتعلق بالموارد والتبعات السياسية والاقتصادية والثقافية لاكتشافها، مسألة يلمسها القارئ ابتداء من الصفحات الأولى للكتاب، من خلال مقاربته بين شخص يحلم بالعثور على كنز دفين أو الظفر ببطاقة يانصيب، وبين اكتشاف موارد طبيعية ثمينة في بلدان نامية تحديدا، ليخلص أن عواقب كلا الأمرين ستكون وفقا لتعبيره غريبة ومؤذية على مختلف الصعد، وأن تأثيرات هذا الابتلاء تتفاقم في دول الشرق الأوسط بشكل أكبر، التي تمتلك أكثر من نصف الاحتياطي العالمي، ولكنها في المقابل تتخلف كثيرا عن باقي دول العالم في اللحاق بركب الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والإصلاحات الاقتصادية.
الفرنسي فيليب سيبيل- لوبيز، صاحب كتاب “ب” يرى خلال معالجته لأثر هذه الثروة في دول الشرق الأوسط، أن الدول الخمس التي تمتلك ثلثي احتياطات النفط العالمي، وهي: السعودية، إيران، العراق، الإمارات، الكويت، إضافة الى امتلاك إيران وقطر ثاني وثالث احتياطات النفط في العالم. ومع هذه الأهمية العالمية للمنطقة؛ نرى أنها لا زالت على هامش العولمة. إنها إحدى المفارقات الكبرى في المنطقة !
المفارقة في ثروة الأمم
في معالجتهما عن أسباب هذه المفارقة، بقاء الدول الكبرى في إنتاج النفط على هامش العولمة، يرجع لوبيز السبب على نحو أولي إلى طبيعة الأنظمة الراهنة التي أقامت بلادها في سجن من النظم البيروقراطية مع فرض طوق من العزلة عن المحيط الخارجي، على المستوى السياسي تحديدا، ويضيف لهذا السبب سببا ثانيا يكمن في دعم الولايات المتحدة غير المشروط لهذه الأنظمة، ويظهر بالمقابل الفوائد العميمة التي جنتها الولايات المتحدة مقابل هذا الدعم، فبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي لا تحصى، فإن فائدة أخرى جنتها الولايات المتحدة من هذه الدول تحديدا عبر هذا الاستخدام للإسلام باعتباره أداة لخدمة مصالحها الاستراتيجية. وهذه مسألة تذكرنا بملاحظة المفكر العربي إدوارد سعيد، التي أطلقها قبل عقود بعيدة من هذا الطرح، والتي أشار فيها إلى أن العالم الإسلامي موجود من أجل الغرب.
في بحثه عن أسباب لعنة النفط، يستبعد نايكل روس فكرة أن يكون للقوى الأجنبية أو شركات النفط دور حاسم في هذا الشأن؛ فالقوى العظمى: أمريكا بريطانيا فرنسا تغزو وتتدخل بصورة منتظمة في بلدان غير منتجة للنفط، بالطريقة ذاتها التي تتدخل في دول منتجة لهذه الثروة، إضافة إلى أن دولا مثل إيران وفنزويلا والسودان وروسيا أيضا بدت منيعة أمام التدخلات الأجنبية، ومع ذلك فإنها تعاني، أو معظمها، من المفارقة ذاتها المرتبطة بظهور هذه الثروة. كما أن دور شركات النفط وأثرها السلبي مبالغ فيه، والدليل أن ظاهرة التأميم التي سادت في عدد من الدول قد تفاقمت فيها المشكلات بعد هذا الإجراء بدل أن تحلها. ليبدأ روس من هنا بوضع أصبعه على مكامن الخلل الحقيقية من خلال معالجته للمشاكل العديدة في بنية الدول المنتجة للنفط، وتحديدا مظاهر مثل ضعف الأداء الاقتصادي وغياب الديمقراطية والسياسات قصيرة النظر، إضافة إلى مؤسسات الدولة التي جرى إضعافها عمدا. غير أن روس يعظّم كثيرًا من أثر فكرة “السرية” والتكتم الرسمي في إفصاح الحكومات عن عائداتها من النفط، فهو يرى في هذا البعد سببًا رئيسًا في تبديد عائدات النفط، وهو ما يمد الحكام المستبدين بالدعم اللازم الذي يمكنهم من البقاء في السلطة فترة طويلة؛ إذ تتيح لهم السرية إخفاءَ الدليل على جشعهم وعدم كفاءتهم. ويؤكد أنه ما من وسيلة سهلة لتوثيق كمّ المال الذي تحجبه حكومات الدول النفطية عن شعوبها؛ مستندًا في استنتاجه هذا على مسح لسياسات الميزانية في 94 بلدًا أجري عام 2010 ، وأظهر هذا المسح أن الميزانيات الوطنية للبلاد التي تعتمد في تمويلها على النفط والغاز كانت أقل شفافية بصورة جوهرية من الميزانيات التابعة لدول أخرى.
يسلط لوبيز في الكتاب ” ب ” الأضواء على نقطة لم يتطرق إليها زميله روس، في تناول الموضوع، إنها الخاصة بعلاقة الدول المنتجة للنفط مع بعضها. والحديث هنا عن منطقة الشرق الأوسط تحديدا؛ دول مجلس التعاون، إيران، العراق، فيرى ابتداء أنه على الرغم من انتماء هذه الدول إلى أمة واحدة عدا إيران؛ إلا أنها غالبا ما تكون منقسمة فيما بينها، ليس ذلك فحسب؛ بل إن علاقة القادة فيما بينهم تحكمها الأحقاد العميقة، وأفصح عن وجود خلافات دينية وسياسية فيما بينهم؛ إلا أن النزاع القبلي يبقى هو الأساس، وهي – على العموم- خلافات تحاول هذه الدول إخفاءها قدر المستطاع. وبالطبع لو واكب المؤلف النزاع الناشب هذه الأيام بين عدد من دول الخليج؛ لوجد فيه مادة تغني كتابه على نحو واضح، رغم إشارته في كتابه إلى رغبة بعض الممالك الخليجية الخروج عن رغبة الرياض في الهيمنة على الوضع الإقليمي، مشيرًا في أكثر من موضع إلى معارضة السعودية لعدد من المشاريع القطرية في الإقليم، وخصوصا تلك المرتبطة بمد أنابيب غاز لدول خليجية مجاورة، إضافة إلى معارضتها الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي تبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا. إن المجهود القطري في التميّز عن السعودية يثير هذه الأخيرة ويغضبها. ومع أن الإصلاحات السياسية التي تحدثها قطر في بنية دولتها لا تحدث أي تغيير عميق؛ إلا أنها تظهر كدولة طليعية مقارنة بالوضع في السعودية الأكثر تراجعًا في هذا المجال.
ورغم الافتراضات النظرية والتصورات الجيوسياسية التي ظهرت للعلن تحديدًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي بحثت فرضية فصل المناطق النفطية الشيعية شرقي السعودية عن بقية المناطق السنية، بعدما أظهرت تحقيقات هذا الحادث أن المكون السعودي السني هو الأساس في هذا العمل الإرهابي ( 15 من أصل 19 شخصا ) ونصحت هذه الفرضيات أن تقطع الولايات المتحدة علاقتها مع السعودية وتصنفها ضمن الدول الراعية للإرهاب؛ إلا أن الإدارة الأمريكية وقتئذ، والإدارات اللاحقة بقيت تتعامل مع السعودية باعتبار أن هذا التعامل ضروريا لتوازن الولايات المتحدة الطاقي والمالي؛ علمًا بأن حقيقة العلاقة السعودية – الأمريكية، وهي نقطة لم يبلغها لوبيز في تحليله أن هذه العلاقة ليست قائمة على التحالف المرحلي وتبادل مصالح هنا أو هناك؛ بل هي علاقة قائمة على الشراكة، وذلك بحسب الوصف الذي أطلقه قبل أيام السفير الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط، دينيس روس، والشراكة مرحلة أكثر تقدما وكنه هذه العلاقة ومستواها هي التي تضطر واشنطن إلى غض النظر عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تصديرها النسخة المتشددة من الإسلام بحسب وصفه.
وفي البعد المرتبط بالتنافس الديني وتأثيراته على توظيف عوائد الثروة النفطية، يذكر لوبيز أن السعودية، وهي الحارسة للاماكن الإسلامية المقدسة، بذلت قصارى جهدها لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد منذ ثورة عام 1979. فمنذ ذلك الحين، دخلت إيران والسعودية في مزايدة إسلامية؛ إذ تتنافسان في لعبة من يجسد المستقبل السياسي “للإسلام الحقيقي” عبر دعم كل الحركات التي يمكنها أن تخدم تقدم القضية. وإذا كانت إيران اكتفت بتقديم مساعدات كانت قادرة على مراقبتها نسبيا؛ فإن الممالك النفطية أعطت وما زالت تعطي بلا حساب أو مراقبة. لهذا السبب أيضا وعلى المستوى النفطي، يبذل النظام الملكي السعودي منذ عام 2004 كل ما بوسعه لزيادة الإنتاج.
النفط والديمقراطية
من بين الأفكار المشتركة بين الكتابين، اتفاقهما على الملاحظة الضمنية ” نفط أكثر .. ديمقراطية أقل”، وأرجع المؤلفان العلة في العلاقة العكسية بين الثروة والسلوك السياسي، إلى أن الحكام المتمولون من بيع النفط يستخدمون أموالهم النفطية “البترو- دولار” في سبيل ترسيخ أنفسهم بالسلطة والحيلولة دون حدوث إصلاحات ديمقراطية. ومع أن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في كل بلد عربي تقريبًا، إلا أنهم وجدوا أنه من الأسهل بمكان الإطاحة بالحكام في البلاد الفقيرة بالنفط، مثل تونس ومصر، من الإطاحة بحكام البلاد الغنية مثل البحرين والجزائر والعربية السعودية، بحسب الكتابين. كافة الجداول والرسوم البيانية التي توضح حجم الروابط الأساسية بين النفط والديمقراطية أظهرت على نحو لا لبس فيه أنه عندما يكون لدى أنظمة الحكم الاستبدادية مزيد من النفط، يقل احتمال تحول بلادها إلى الديمقراطية.
ويربط كثير من المراقبين لسجلات نمو الدول المنتجة للنفط بافتقارها إلى الديمقراطية على نحو مخيبٍ للآمال؛ ذلك أن النفط يجعل الحكومات أقل عرضة للمساءلة، وهذا بدوره يجعل القادة السياسيين أقل ميلًا لتعزيز الرفاه الاجتماعي. وبتحررهم من تدقيق الناخبين يصبح الساسة أيضًا قصيري النظر وقليلي التبصر. يكرس الساسة القسم الأكبر من مواردهم لحراسة الوضع الراهن بحرص وحذر شديدين؛ بدل أن يستثمروا في التنمية الاقتصادية.
إحساس المواطن الخليجي بثروة بلاده
وماذا عن شعور المواطنين في الخليج العربي تجاه القضايا آنفة الذكر؟ الاستنتاج الذي يخرج به صاحب كتاب ” أ ” هو أن مواطني الخليج عموما معنيون إلى حد الشغف بالحصول على نصيبهم العادل من إيرادات النفط، ويشير هنا الى تحليل للكاتب مايكل هيرب ( من أهم علماء الغرب المتخصصين في السياسات الخليجية)، يقول فيه: ” يُشار أحيانا إلى أن المواطنين في ممالك النفط يشعرون بالامتنان لحكامهم لمنحهم إياهم المال، وأن هذا الامتنان يترجم إلى دعم سياسي”؛ إلا أنه يستكمل فكرته بالقول ” إن فكرة الامتنان تنجم أصلا عن تلقي هدية، في حين يعتقد عرب الخليج أنهم هم أنفسهم بوصفهم مواطنين لا الأسر الحاكمة، يملكون النفط؛ لذلك لا يشعر الكثير منهم بامتنان كبير لتلقيهم شيئًا يعتقدون أنه ملكهم الخاص أصلا”.
وفي معرض حديثه عن الهبات، يتناول مايكل روس مسألة مرتبطة برغبة المواطن الخليجي في الحصول على بنزين رخيص الثمن، واعتبر أنه من المثير للدهشة أن يكون حجم هذا الدعم كبيرًا في الدول الاستبدادية تحديدًا، فكلما تفاقم الاستبداد؛ أنفق الحكام المستبدون بسخاء أكبر على دعم الوقود. وأرجع السبب في هذا الاستنتاج إلى أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى إثارة مظاهرات عارمة يحتمل أن تعرض القادة الاستبداديين للخطر أكثر من القادة الديمقراطيين.
إدامة النظام الأبوي
ومن الاستنتاجات الرئيسة التي خرج بها الكتابان، أن النفط يُديم النظام الأبوي، وجرى الاستدلال على هذا الاستنتاج عبر عدد من الجداول والإحصاءات التي تظهر وضع المرأة في دول الخليج العربي، مقارنة بوضعها في دول عربية تلتزم بالقيم والتعاليم الثقافية والدينية ذاتها؛ غير أن ثمة تفاوتًا صارخًا بين أحوال المرأة في المنطقتين؛ ففي بعض البلدان تشكّل النساء أكثر من ربع القوى العاملة، فيما لا تبلغ نسبتهن 5% في بلدان أخرى. وفي بعض تلك البلدان اكتسبت النساء حق الاقتراع في أربعينيات القرن العشرين؛ فيما لم يكتسبنه في بلدان أخرى حتى عام 2010. في بعض الحكومات تشغل النساء أكثر من 20% من مجموع المقاعد البرلمانية؛ فيما لم تشغل في بلدان أخرى أي مقعد.
المفارقة الأخطر
بدا واضحا، إذا، أن المحتوى في الكتابين يركز على اختلاف في طريقة المعالجة بين الكتابين، على قضية النفط وكيفية توزع موارده، إضافة إلى رصد المفارقات المرتبطة بهذه الثروة ومتابعتها في كافة المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية؛ غير أن الاستكمال الأهم في هذه المعالجة تلك التي تحاول تأكيد فكرة أن النفط لعنة اقتصادية، وأنه كلما ازداد النفط الذي تستخرجه البلدان؛ فإن النمو الاقتصادي يصاب بالتباطؤ. ومن الثقافة الدينية الراسخة معالمها في المنطقة، يستلهم روس تجربة فرعون في سورة يوسف ليصوغ هذا التساؤل: إذا كان فرعون قادرًا على تنمية الموارد وتعزيزها في سنوات الخصب ليفيد منها في السنوات العجاف، فلماذا لا تستطيع الدول المنتجة للنفط أن تحقق الأمر ذاته في الوقت الراهن؟ ثمة إجابة واحدة محتملة تتمثل في أن المؤسسات الحكومية ذاتها تضررت من عائدات النفط، إن كان النفط يجعل الحكومات أقل فاعلية، وأن ثمة متهمًا محتملًا في هذه المسألة هو ما يمكن تسميته بـ ” الإجهاد البيروقراطي المفرط “، وهذا يعني توسع إيرادات الحكومة بسرعة أكبر من قدرتها على إدارتها على نحو مجدٍ. ويستشهد لدعم هذه التحليل في الأيام الأولى لحكم الملك عبد العزيز آل سعود، الذي كان يحمل خزانته الوطنية كاملة في عدلي سرج راحلته. وبعد أن اكتشف النفط في 1938 غمرت حكومته عشرات الملايين، سرعان ما أصبحت عشرات مليارات الدولارات من إيرادات النفط. كانت الحكومة ضعيفة في إدارة هذه الأموال، وقد أدى التوسع الهائج في الدولة السعودية في خمسينيات القرن العشرين إلى فوضى إدارة عارمة. وكأنه يريد الاستدلال من هذه القصة بأن شيئا جوهريًا لم يحدث على مستوى إدارة عائدات هذه الثروة على مستوى الإقليم.
وعموما؛ فإن الفكرة الأساسية التي يود المؤلفان نقلها لنا بالاستناد على قائمة طويلة من البيانات والإحصاءات، إضافة إلى تحليلات ذوي الاختصاص، أن الثروة البترولية تؤدي إلى قيام مؤسسات سيئة تجعل الحكومات أشد ضعفا وأكثر فسادًا وأقل كفاءة، وأقل قدرة في الحفاظ على سياسات مالية حكيمة.
هذه هي الرؤية التي يقدمها الكتابان، مدعمة بالإحصاءات والرسوم البيانية التي غطت فترة تقارب نصف قرن، كان نصيب المنطقة العربية فيها، الأوفى والأهم. وخلصت المضامين الواردة في الكتابين إلى فكرة أن الدول المنتجة للنفط في العالم النامي عانت سلسلة من الاضطرابات السياسية، وأنه بالمقارنة مع دول مماثلة لا نفط لديها، كانت حكومات الدول النفطية أقل ديمقراطية وأكثر سرية وتحفظًا، وقدمت اقتصاداتها فرص عمل أقل للنساء، وقدرًا أدنى من النفوذ السياسي. كما عانت – إضافة إلى ذلك – ضربًا من الاعتلال الاقتصادي الأكثر خفية، فيما كان ينبغي أن تشهد هذه الدول نموًا بوتيرة أسرع.
حلول واقتراحات
يجادل كتاب “نقمة النفط” بفكرة أن هناك بلدانا غنية بالنفط تمتلك مؤسسات سياسية قوية ومشاكلها الاقتصادية ليست عميقة، كما هو حال دول مثل النرويج وكندا، في المقابل نجد بمناطق أخرى من العالم كيف تسببت الثروة النفطية بمشكلات اقتصادية وسياسية عميقة. ومع صعوبة الوضع وتشابكه المعقد في الفئة الثانية من هذه الدول؛ إلا أنه ولحسن الحظ يمكن فعل الكثير لتغيير هذه الخصائص مثل الحد من حجم الإيرادات النفطية، وجعلها أكثر استقرارًا وأكثر شفافية، وحتى تغيير مصدرها. ويمكن كذلك إجراء سلسلة من الإصلاحات الأكثر أهمية بإشراف الحكومات المتمولة من النفط، مع ضرورة تقليل العواقب السياسية السلبية للموارد الطبيعية إلى أدنى حد ممكن، وهذا يعني أن على هذه البلدان أيضًا محاولة تحقيق الحد الأقصى الممكن من النتائج الاقتصادية الإيجابية.
وتكمن أهم خطوة في سبيل معالجة الاختلالات التي تعاني منها الدول العربية المنتجة للنفط تحديدا، في رفع السرية عن عائدات النفط؛ فعالم النفط بمعظمه مخفيٌّ من المشهد العام. في بلدان كثيرة لا يعرف سوى القليل عن العقود التي توقعها شركات النفط وعن مكافآت التوقيع والضرائب وعوائد الحقوق والرسوم وعن تدفق إيرادات النفط إلى داخل الحكومات وعن أوجه إنفاق هذه الإيرادات في نهاية المطاف.
كما يتعين على البلدان المنتجة للنفط أن تتخذ قرارين رئيسين واضحين بشأن كيفية توزيع إيراداتها. يتمثل الأول بتحديد المال الذي يجب أن يدخل في الميزانية السنوية ومقدار المال الذي يجب أن يوضع جانبًا من أجل استعماله مستقبلا، لتحقيق استقرارٍ اقتصاديّ على المدى القصير والتعويض عن نضوب النفط على المدى الطويل.