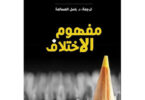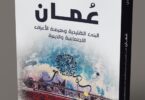- المقدمة:
لا تزال الحركات الاجتماعية محل جدل كبير في العالم العربي لاسيما تلك التي تخص المرأة، كالحراك النسوي مثلاً. سلطنة عمان ليست بمنأى عن باقي الدول العربية حيث يعتبر الحراك النسوي مجالا مثيرا للجدل ينقسم فيه الناس ما بين مؤيد ومعارض وذلك لأن النظام السياسي والاجتماعي في السلطنة مرتبط ارتباطا كبيرا بالدين الإسلامي وآراء علماء المسلمين والمجتهدين في الآراء الدينية، بل ويعدّ الدين في كثير من الأحيان، الأساس الذي تقوم عليه بعض الأنظمة داخل الدولة. ونتيجة لذلك، نجد في كثير من الأحيان أن بعض الأنظمة الاجتماعية والثقافية في الدولة، لا تزال تضع بعض فئات المجتمع في قالب اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي واحد وفقا لما يتم إصداره من المنظومة الدينية والشرعية. ولعل المرأة العمانية إحدى هذه الشرائح التي يحكم عليها أنماط سلوكية محددة في المجتمع وفقا لعدد من القوانين الدينية والمدنية، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك والإنستقرام وغيرها، بدأت تتضح بعض الرؤى الدينية والاجتماعية المختلفة مما أدى إلى انفتاح كبير للتعرف على الآراء المختلفة ومناقشتها.
تهدف هذه المقالة إلى معرفة واقع الحراك النسوي الرقمي العماني من خلال تحليل المحتوى الرقمي الذي يمس واقع المرأة العمانية على منصة تويتر، وعلاقته بالدين الإسلامي والتراث الثقافي الاجتماعي.
- الخطاب الديني الرقمي وقضايا النساء: هل تحتاج المرأة لفتوى لكل فعل وقول؟
لطالما كان الدين أساس تشكيل الاحتياجات الاجتماعية والفكرية للعديد من المجتمعات، ولعل ذلك كان لازما للحفاظ على الوحدة والتماسك في كثير من الحالات. في المجتمعات الإسلامية مثلًا، اعتاد الناس في كثير من الحالات على أخذ رأي علماء المسلمين أو ما يعرف “بالفتاوى الشرعية”. وربما بالغ البعض منهم وذهب بالمطالبة بفتوى شرعية لكل فكرة أو فعل. في بحث أجرته الباحثة (ميلاني، ٢٠١٧) تطرقت قائلة فيه: “أنه من غير المنطقي إن يطلب المسلم رأيا شرعيا في أمر تعتبر معرفته أمرا بديهيا في جميع الأعراف البشرية بل وإن معرفته تأتي من “طبيعته البشرية”، على سبيل المثال: القتل والاغتصاب والسرقة والكذب وخيانة الأمانة وإيذاء الأبرياء، ويمكن فهمها بديهيا على أنها إحساس فطري بالحق أو الباطل”. وتوضح ميلاني في بحثها، ليس المقصود هنا الرفض الشامل للفتاوى والآراء الشرعية ككل وأن الإنسان لا يحتاج إلى الفتوى أبدا، بل هي مسألة المواقف التي تتطلّب اللجوء إلى هذه الفتاوى، بالإضافة إلى من يملك سلطة إصدارها. أصبح رجل الدين في العالم الاسلامي هو المدبر لجُل شؤون حياة الناس، لما أعطي من سلطة من قبل الأفراد أنفسهم، وبعض من المؤسسات المدنية والمجتمعية التي تكون عادة تحت منظومة الدولة. وجعل الدين الإسلامي يتمثل في شخوص ومؤسسات بعينها، والذي غالبا ما قد يؤثر على هوية المجتمع -كالطقوس العبادية ومظاهر اللباس أو العادات الاجتماعية-، التي تتحول لاحقا إلى شكل من أشكال الانتماء المقرونة بالعاطفة الشديدة والتي يصعب على منتميها الإذعان لفكر آخر.
وعلى صعيد شؤون المرأة وحقوقها، تسيء بعض المؤسسات الدينية ذات الدين البطريركي السلطة الممنوحة لهم لإقصاء صوت المرأة، وتهميش دورها في بعض المجالات داخل المجتمع ابتداء من المجال الديني إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية. وقد ينحصر دورها في المجتمع في الحفاظ على اللبس والسلوك الشرعي الذي حدده لها بعض رجالات الدين وصدقت عليه بعض المؤسسات المدنية، حيث إن الخروج عن المسار المحدد لها في اللبس والسلوك قد يخل بالأعراف المتعارف عليها داخل المجتمع كما يتصور بعض هؤلاء. وهو ما تطرق إليه (حجازي، ٢٠١٩) قائلا: “كان جسد المرأة وما زال مادة غنية للتشريع، وتحديد المسموح والممنوع من تحركات الجسم وتعبيراته ومتطلباته، تبعا لأنماط مقبولة اجتماعيا، أي في النهاية تبعا لأنماط تخدم مصلحة المتسلط الذي يمتل هذا الجسد، هناك قوة المنع المدنية وقوة التحريم الدينية، التي تثقل جسد المرأة بقيود الخطيئة ومشاعر الإثم”. ومما لا شك إن بعض الخطابات والتفسيرات الدينية الموجهة للمرأة يغلب عليها طابع الفوقية والتسلط وحجب جوانب فقهية وشرعية كثيرة وإلصاق الطابع اليقيني للحجج والمسائل المطروحة. تستند جُلها على عادات وتقاليد المجتمع التي غالبا لا يكمن في الفاعلية والتطلعات المستقبلية وإنما ينحصر على ما ترسخ في سير الأولين التي يغلب عليه الثبات والجمود.
انتقل السلوك الديني والأبوي من الواقع إلى العالم الرقمي مما أدى إلى الاستغناء عن خدمات المؤسسات التقليدية والاستعاضة عنها باللجوء إلى العالم الرقمي لتلبية الاحتياجات الدينية لدى بعض الجماعات والأفراد، بل وفرض بعض من المعتقدات الدينية على مستخدمي المنصات الرقمية، مما أدى إلى ظهور مصطلح الدين الرقمي والذي يقصد به “ممارسة الدين وطرح المعلومات المتعلقة من خلال الأجهزة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات” (نصر، ٢٠١٩). من هنا استمرت ممارسة الوصاية الدينية والمجتمعية على المرأة العمانية في فضاء الإنترنت في محاولة لفرض آراء دينية وفقهية عليها، إلا أن ذلك قُبِل بالرفض والتصدي من قبل المجموعات النسوية الرافضة لمفهوم الوصاية الدينية في شكله التقليدي، وغالبا ما تثير هذه المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي قضايا تتعلق بمسائل دينية تعنيها في شخصها وفي علاقتها بالآخر وبسلطته بعد أن كان حكرا على الرجال لفترة طويلة في محاولة منها لتصحيحها أو رفضها كليا ما لم تتوافق بشكل صحيح مع تعاليم الدين الإسلامي. واستخلصت الباحثة (كريملي، ٢٠١٨) في دراستها “أن الخطاب النسوي عبر الإنترنت حول الدين مرتبط بشكل كبير بهوية المرأة، إذ تكشف مجموعة من النساء عن القضايا المتعلقة بالجسد الأنثوي، كالحجاب والحياة الجنسية والأدوار الاجتماعية، ومسائل أخرى تتعلق بالزواج والطلاق والقوامة، وهي المواضيع نفسها المتداولة في الخطاب الديني التقليدي الذكوري”. ولعل ما يميز الحِراك النسوي الرقمي على منصة تويتر العماني أنه استطاع فرض رأيه بنفس مستوى المجموعات المعارضة له بأقل ضرر نفسي وجسدي وماديا مباشر خلاف ما هو عليه في الواقع الحقيقي. حيث اتجهت هذه المجموعات إلى مناقشة بعض المسائل الدينية حول المرأة وإسنادها إلى الأدلة الدينية والعلمية، والذي أدى إلى خلق صراعات رقمية بين المتدينين والمحافظين وبين المجموعات النسوية، والتي غالبا ما تتحول هذه الصراعات إلى رأي رقمي عام والذي يتحول إلى رأي عام في العالم الواقعي.
- التحليل الرقمي: ما يدور فعليا في فضاء تويتر العماني:
نص تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٢٠٠٢ على “ضرورة تمكين المرأة عبر إتاحة الفرص، خاصة تلك الممكنة في بناء القدرات البشرية، للبنات والنساء على قدم المساواة مع أشقائهن الذكور”، رغم الشوط الكبير الذي تم قطعه في مجال تعليم المرأة وتمكينها على الصعيد الوظيفي، إلا إن بعض المؤسسات تشهد بطئا في تحقيق معايير المساواة بين الجنسين. الأمر الذي جعل المرأة العمانية تخوض معارك حقوقية وفكرية مع عدد من المؤسسات المدنية والدينية في المجتمع وما تحوي هذه المؤسسات من أفراد متعصبين لمنهج القبيلة والإرث الثقافي والرأي الديني المتعصب فيما يخص المرأة. وتظهر هذه الاختلافات جلياً في الفضاء الرقمي -كمنصة تويتر- عند طرح قضية تخص المرأة العمانية، حيث تُعامل القضية المطروحة من جانب ديني أو جوانب ثقافية تخص المجتمع والذي يذهب فيه بعض المشاركين إلى تقييد سلوك الطرف الآخر وتدجينه ومحاولة الضغط عليه للانصياع لفكرة أو سلوك متعارف عليه في مجموعة محددة من الأفراد أو مؤسسة مدنية ما.
بالرغم من أن نسبة مستخدمي تويتر من الإناث في سلطنة عمان لم يتجاوز ٢٣٪ في عام ٢٠١٩، إلا أن زخم القضايا النسوية والحملات المناهضة للعنصرية ضد النساء تصاعدت وتيرتها أكثر من ذي قبل (أمبوسعيدية والعيسائي،٢٠٢٠). مما أدى إلى صراع حاد بين المستخدمين على منصة تويتر بين المحافظين ومعتنقي آراء دينية محددة وبين مؤيدي الحراك النسوي، وللوقوف أكثر على هذا الموضوعسنقوم في هذا القسم بتحليلٍ رقمي لأبرز ما تم تداوله من هاشتاغات في منصة التويتر العماني فيما يخص الحراك النسوي من جهة والخطاب الديني من جهة أخرى. سيشمل هذا القسم على تحليل المشاعرSentiment Analysis والذي يعنى بدراسة الآراء والسلوك والعواطف المختلفة في النصوص الرقمية كالتغريدات بمساعدة معالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing (NLP). تصنف الآراء المختلفة في النص الرقمي إلى ثلاث فئات وهي: إيجابية وسلبية ومحايدة. كما يعرف تحليل المشاعر أيضا باسم التحليل الذاتي والتنقيب عن الرأيSubjective Analysis, Appraisal Extraction & Opinion Mining. أما بخصوص البرامج المساعدة، سنقوم باستخدام برنامج Orange Data Mining [1]لاستخراج البيانات من منصة تويتر، والذي يعتمد أساسا على واجهة برمجة التطبيقات الخاص بمنصة تويتر أوApplication Programming Interface (Twitter API). ومن ثم سنقوم بتحليل البيانات ومقارنة التحليل الرقمي مع البيانات المستخرجة بشكل يدوي. وبعد ذلك سنقوم بتحليل المشاعر للنصوص الرقمية باستخدام منصة Mazajak [2]ونقارنها في ذات الوقت بالبيانات المستخرجة من برنامج Orange Data Mining.
بادي ذي بدء، ابتدأ الحراك النسوي الرقمي بشكله الواضح وشبه المنظم عند ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ولعل المناصرة لحقوق المرأة العمانية حبيبة الهنائي كانت من أوائل المُطالِبات بحقوق المرأة على منصة الفيسبوك. رغم إنها كانت مطالبات فردية، إلا إنها كان لها الأثر الملحوظ على صعيد التوعية المجتمعية وتوعية الفتيات بحقوقهن. أما على منصة تويتر، ولعلها المنصة الأكثر شهرة في عمان، ابتدأت الأصوات المؤيدة للحراك النسوي بالظهور الواضح في سبتمبر من عام ٢٠١٩، عند ظهور هاشتاغ #أكتب_دفاعاً_عن_حقيّ بعد نشر المحامية بسمة الكيومي مقالا في مجلة الفلق[3]، تطرقت فيه إلى الكاتبة عن المضايقات التي تتعرض لها نتيجة عدم ارتدائها للحجاب والذي أثار الرأي العام الإلكتروني وأصبح محل جدل بين أطراف عدة، منهم من ذهب لطرح رأيه من ناحية دينية وثقافية، ومنهم من رأى حرية الفرد في اعتناق ما يؤمن به ما لم يخدش ثوابت الدين الإسلامي والعرف العام. أعقبه في ذات العام محاولات أخرى لطرح قضايا المرأة العمانية تحت هاشتاغ #نسويات_عمانيات. لم تسعفنا الأدوات الرقمية لرصد جميع ما تم تداوله في الهاشتاغ بسبب حذف غالبيتها من قِبل ناشريها أو غلق بعض الحسابات المؤيدة/ المعارضة للحملة، ولكن في حوار مع إحدى الفتيات القائمات على الحملة ذكرت أن:
“أبرز ما تم طرحه من قبل النسويات في هاشتاغ الحملة كان يتمحور حول تثقيف النساء بحقوقهن المدنية والفكرية التي كفل بعضها الدستور العماني لعام ١٩٩٦ في المادة ١٢ [4] وصدقت الحكومة أيضا على بعض بنود حقوق المرأة في اتفاقية سيداو[5]. لكن الصراع بدأ يتضح فيما بعد بين بعض أطياف المجتمع من جهة والنسويات اللاتي بدأن بالحملة الداعمة لحقوق المرأة العمانية من جهة أخرى. منهم من ذهب إلى تفسير الحملة على أنها فكر “غربي” لا يتناسب مع الفكر الإسلامي وثقافة المجتمع المحافظ، مما أدى إلى إبعاد وتشتيت الحملة عن هدفها الرئيسي ومناقشة ما هو جائز وغير جائز لمجتمع إسلامي محافظ. ومما لا شك فيه في الطرف الآخر كان هناك وعي وتضامن للحملة من قبل من مجموعة من المغردين، إلا ذلك لم يدم طويلا، فبعد محاولات فردية ومؤسسية للضغط على صاحبات الحملة تم اجبارهن على إغلاق الحساب في مارس من عام ٢٠٢٠”
بعد ذلك توالت الهاشتاغات التي تطرح قضايا المرأة العمانية على منصة تويتر، وربما هاشتاغ #لاتسكتي أحد أشهر الهاشتاغات الرافضة للعنف الأسري ضد المرأة العمانية، والذي تطرقنا له سابقا في مقال منفصل[6]، حللنا بعض من جوانبه الاجتماعية والحقوقية.
إلا أننا في هذا القسم سنقوم بتحليل ما جاء تحديدا في هاشتاغ #وداعا_زوينة والذي سيكون كدراسة حالة لمناقشة الخطاب الديني والحراك النسوي. حيث إن عدد التغريدات التي تم تجميعها بلغ (٦٧٣٤) تغريدة. أصبحت قضية الطالبة المنتحرة في سلطنة عمان قضية رأي عام على مدار أسبوع، تم تداول القضية على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث إن الطالبة على حسب ما ورد في تغريدات هاشتاغ #وداعا_زوينة، كانت تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية مما جعلها تقبل على الانتحار. ولعل قضية انتحارها أخذت حيزا من اهتمام المجتمع بسبب قلة قضايا الانتحار التي تتداول في المنصات الرقمية، ولعل ذلك بسبب طبيعة المجتمع المحافظ. بدأ الهاشتاغ بالظهور فعليا والتحول إلى قضية رأي عام، عند طرح القضية من قِبل مجموعة من النساء المناصرات لحقوق المرأة العمانية والمؤمنات في الوقت ذاته بالحق الفكري والحرية الثقافية لكل فرد بالغ يمتلك المقومات الفكرية والبدنية من أفراد المجتمع. ومما زاد حدة انتشار القضية بين أوساط مختلف شرائح المجتمع عندما بدأ المستخدمون بمناقشة معضلة الحلال والحرام حول الإلحاد ودرجات الإيمان والانتحار، والتي تعتبر مناقشتها أمرا في غاية الأهمية لمجتمع مسلم محافظ. بعد ذلك تم نشر رسالة عبر منصة تويتر من قبل أخت المتوفاة تنفي ما جاء من ادعاءات حول وضع الفتاة المتوفاة النفسي والاجتماعي عبر المنصة. مما أدى إلى تصاعد النقاش أكثر في منصة تويتر، بل وأخذ النقاش حيزاً خارج المنصات الرقمية، لتصل مناقشته بين الأسر والأصدقاء في العمل، ليكون رأيا عام.
كما هو موضح في جدول (١)، حيث كانت كلمة (الله) هي الأكثر تداولا في التغريدات التي وردت في الهاشتاغ بعدد (٣١٣٦) مرة، ومن ثم يليها (الانتحار). بعدد (٦٠٧) مرات، وكلمة (المجتمع) بعدد (٤٩٧) مرة.
| الكلمة | عدد المرات التي ذكرت |
| الله | 3136 |
| الانتحار | 607 |
| المجتمع | 497 |
الجدول (١): الكلمات الأكثر تداولاً في الهاشتاغ
ومن خلال النتائج المستخرجة من الهاشتاغ، نلاحظ أن المستخدمين الذين ضمنوا كل من كلمة (الله) و(الانتحار) و(المجتمع)، في تغريداتهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهي كالآتي:
- ذهب جمع من المغردين (وهم الغالبية العظمى) للحكم المصيري – كالهلاك أو الخلود الأبدي- على الفتاة. وفي حالات كثيرة كان بعض المستخدمين في حالةِ تعبئةٍ نفسيةٍ وعاطفيةٍ مستعدين للدخول في صراع يتسم بالمهاترة والتحدي والوعيد للطرف الآخر، والذي بدوره من وجهة رأي شخصية، يقود إلى انهيار التفكير المنطقي ويحجب وضوح الرؤية ويشل القدرة على تقدير الواقع بموضوعية.
- أما الجمع الآخر من المغردين، سعى إلى خلق خطاب يتراوح ما بين الشعبوي إلى النخبوي في محاولة لتغييرٍ بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية، مثل: الإلحاد والإيمان، الصحة النفسية، الاختلاف في الرأي واحترامه من قبل الآخر. إلا أنه في كثير من الأحيان يلقى مروجو هذه الأفكار ردودا تتسم بالعنف اللفظي الذي يتفجر منه سيل من الاتهام والتهديد والسباب من قبل الأطراف المعارضة لها. والتي سرعان ما تصل إلى اصطدام يصعب التقاؤه في نقطة تتسم بالموضوعية، بل ويغلب عليه طابع الأحكام التعميمية والقاطعة.
- وكأي قضية رأي عام، يكون هناك فريق محايد لا يبدي انتماء لأي رأي يطرح في الفضاء الرقمي، غالبا ما يكون بعيدا عن أي تجمع رقمي في ساحة تويتر.
إن السمة الغالبة على بعض النقاشات بين مختلف الكتل والمجموعات الرقمية المشاركة لآرائها في القضية على منصة التويتر العماني، يغلب عليها السخرية والنيل من الآخر المختلف في الرأي والمعتقد الديني عن طريق التخوين وتبادل التهم، وحملات التشويه والاعتداء الرمزي. وأحيانا، تتجه هذه المجموعات إلى الاحتماء بالإرث التقليدي الذي يغلب عليه الإسباغ الديني المتمثل في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية رغبة منها بإقناع الطرف الآخر وتعزيز وحماية هويتها القومية في ذات الوقت خوفا من اندثارها وفقدان الاعتبار الذاتي، وهم كما وصفهم علي الوردي قائلا: “يصفون الدليل القوي الواضح بأنه الشمس في رابعة النهار، ونسوا أن الشمس نفسها على شدة وضوحها لا تصلح دليلا كافيا لدى الإنسان إذا كان أعمى، أو إذا كانت الشمس محجوبة عنه بغلاف سميك”. ومن الملاحظ في الأمر أن بعض هذه الجماعات الرقمية اتجهت إلى التعاطف والتعاضد مع بعضها من خلال إعادة نشر تغريدة تتماشى مع فكرهم والتضامن من خلال الرد على بعضهم البعض، ولعل ذلك تشكل من خلال إحساس تلك الجماعات بضرورة وجود آلية دفاعية تحتمي من خلالها من فكر أو معتقد ما. وربما يأتي ذلك أيضا برغبة الشعور بالانتماء الفكري والعقائدي الذي يمثل مصدر انتماء لهم، والذي ينتج عن هذ الحالة نوع من الاندفاع العاطفي يجعل المواقف والآراء قطعية لا تقبل التعدد في الآراء، بل وتميل إلى الانغلاق على نفسها. والجدير بالذكر أن في كلا الفرقين تشكلت صفحات مجهولة الهوية تساند طرفا ما لتصعيد وتيرة القضية المطروحة الذي قد يكون من شأنه ترجيح كفة على غيرها.
أما فيما يخص تحليل المشاعر للبيانات المستخرجة من الهاشتاغ، فإن المنصة الرقمية “Mazajak” (كما يظهره شكل ١) أظهرت أن المشاعر السلبية في لغة التغريدات المستخرجة شكلت نسبة ٣٤٪، بينما المشاعر الإيجابية في اللغة المستخرجة مثلت ٥٢٪، واللغة المحايدة جاءت بنسبة ١٤٪ فقط. كما أظهرت نتائج Orange Data Mining نتائج مشابهة للنتائج المستخرجة من منصة مزاجك. حيث أن المشاعر السعيدة في البيانات المستخرجة كانت بنسبة ٥٣٪، يليها مشاعر الخوف كانت بنسبة ١٥٪، ومشاعر الحزن شكلت نسبة ١١٪ في البيانات المستخرجة، وتلتها بالترتيب مشاعر الغضب والاندهاش والاشمئزاز بنسبة ٨٪ و٧٪ و٦٪.
وعندما تتبعنا كلا من المشاعر الإيجابية والسلبية في اللغة المستخدمة في بعض التغريدات، وجدنا أن بعضها يحمل طابع السخرية وخطاب يتسم بالتهكم والكراهية -وربما تكون اللغة المستخدمة متعارفا عليها فقط في أوساط المجتمع العماني- مع وضع رموز تعبيرية إيجابية كوجهٍ ضاحك أو قلب نابض. مما أثر على معالجة البيانات المستخرجة وتصنيفها بشكل خاطئ في بعضا الأحيان، وكذلك الحال فيما يخص المشاعر السلبية، وجدنا بعض من اللغة المستخدمة، إيجابية إلى حد ما، لكن استخدام اللغة المحلية والرموز التعبيرية أثر على معالجتها رقميا.

شكل (١): تصنيف المشاعر على حسب اللغة المستخدمة في البيانات المستخرجة من “Mazajak”

شكل (٢): تصنيف المشاعر على حسب اللغة المستخدمة في البيانات المستخرجة من “Orange”
أخيرا إن حرية التعبير عن الرأي والفكر من خلال أي وسيلة متاحة يعد ضرورة من ضروريات التقدم والنمو للمجتمعات، بل يعد حقا من حقوق الأفراد أيا كانت معتقداتهم الفكرية والدينية والاجتماعية. ويحدث تقدم المجتمع -دينيا وثقافيا- من خلال نقد ما جاء في التفسيرات الدينية الاجتهادية والتراث الثقافي، الذي ينتج عنه غالبا تجاوز القطعية المعرفية للمسائل والذي يعتبر سمة من سمات تطور المجتمعات الحضرية. أن الخاصية الأساسية لأي معرفة أو علم تكمن في النقد والنقض وقابلية التجاوز، “حيث إن أكثر قوانين العلم يقينية تظل معرضة للنقض والتكذيب والتجاوز” (حجازي، ٢٠١٩). وكذلك الحال في وسائل التواصل الاجتماعي، التقوقع حول فكر ومعتقد ديني وثقافي واحد لا ينتج عنه إلا الثبات والجمود الذي يضر بمصلحة المجتمع والمؤسسات المدنية، بالرغم من أن هذه الوسائل تعتبر مثالية جدا للاطلاع على الآراء المختلفة ومناقشتها وتقيمها والوقوف عليها من أجل التطوير والنماء والانتقال إلى مرحلة أكثر حيوية. كما أن احترام حريات الآخرين وعدم التمييز بينهم على أساس اللون والعرق والجنس والمعتقد الديني والثقافي يعد أمرا ضروريا لإكمال مسيرة التجديد والتغيير في المجتمع، وهوما أكد عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في خطابه الأول في فبراير ٢٠٢٠عند توليه زمام الحكم في سلطنة عمان، حيث أشار إلى أن عمان دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل وكرامة الأفراد، وتم تأكيده في نظام الدولة الأساسي في يناير [7]٢٠٢١.
- الخاتمة:
يورد تقرير التنمية الإنسانية في نسخته لعام ٢٠٠٢ أن “رأس المال البشري والاجتماعي يسهم بما لا يقل عن ٦٤٪ من أداء النمو، بينما يسهم رأس المال المادي والبنى التحتية بما مقداره ١٦٪، وتسهم الموارد الطبيعية بما مقدراه ٢٠٪”، لذلك أصبحت المساواة بين الجنسين في وطننا من الضروريات لكسب معركة التنمية التي تتمثل أساسا في الكيان البشري وقدرته العقلية والجسدية للمساهمة في التنمية بغض النظر عن اختلاف الجنس والآراء والمعتقدات بين الأفراد، ولا يأتي ذلك إلا بتوفير الحماية والدعم لكل أفراد المجتمع، نساء ورجالا وأطفالا من خلال تشريعات تصدر من الجهات العليا، وكذلك المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تبني جيلا قادرا على النقد والتشكيك والبحث، وذلك لأن الأصل في أي نظام مجتمعي، الحيوية والنمو والتغيير الذي يقود إلى الإثراء الفكري والتعقيد الذي ينتج عنه الفاعلية والإغناء المجتمعي. ولا يتحقق كل هذا إلا بالتجديد في الفكر التقليدي وتجاوز السلطة الأصولية والعصبية التي تفرض هيمنتها الفكرية على أفرادها، نساء ورجالا. وربما يأتي ذلك من خلال إفساح الطريق للفئات الراغبة بتحسين وضعها الاجتماعي ما لم يكن هناك خرق للقوانين المنصوص عليها من قبل الحكومة. حيث إن إقصاء فرد من أفراد المجتمع بسبب فكره ومعتقده ورغبته للانتقال إلى وضع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، يشكل خطرا على مسار التنمية وتأخرها. “كيف يمكن بناء معرفة علمية وعلوم متقدمة في ظل الخشية من التجرؤ على الفكر والقول الذي يهدد بقطع الأرزاق، هذا إذا لم يؤد إلى التهلكة من خلال تسليط سيف التجريم السياسي، والتحريم الديني؟” (حجازي، ٢٠١٩)
- المراجع:
- المراجع العربية:
- 1. إبرهيم علي، حيدر (٢٠١٢). الظاهرة الدينية في المجتمعات العربية. موقع إلكتروني: https://anthropohira.wordpress.com/2012/10/13/الظاهرة-الدينية-في-المجتمع-العربي-الا/
- 2. أمبوسعيدي، العيسائي (٢٠٢٠). قضية المرأة العُمانية في الفضاء الرقمي: بين انهيار السياق وضبابية الحوار. مدونة شخصية: https://safiyaambusaidi.wordpress.com/قضية-المرأة-العُمانية-في-الفضاء-الرقم/
- 3. تقرير التنمية الإنسانية العربية (٢٠٠٢). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. القاهرة: المكتب الإقليمي للدول العربية.
- تقرير التنمية الإنسانية العربية (٢٠١٩). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. القاهرة: المكتب الإقليمي للدول العربية.
- حجازي، مصطفى (٢٠١٩). الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية. الدار البيضاء- المغرب: المركز الثقافي العربي.
- 6. حجازي، مصطفى (٢٠١٩). التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. الدار البيضاء- المغرب: المركز الثقافي العربي.
- 7. الزدجالي، سعود (٢٠١٧). الهويات الدينية. موقع مؤمنون بلا حدود: https://www.mominoun.com/articles/الهويات-الدينية-5152
- الوردي. علي (٢٠٠٨). مهزلة العقل البشري. لندن: دار الوراق للنشر المحدود.
- نصر، رانية (٢٠١٩). التدين الرقمي والمشيخة، مدونة الجزيرة: https://www.aljazeera.net/blogs/2019/7/16/التدين-الرقمي-ومشيخة-التقنية
- كريملي، هدى (٢٠١٨). الفاعلية النسوية في الدين الرقمي، مؤمنون بلا حدود، الرابط: https://www.mominoun.com/pdf1/2017-12/fa33ilia.pdf
- المراجع الإنجليزية:
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, (25/26), 56-80. doi:10.2307/466240.
- Hooda, A. (2018). Sentiment Analysis of Recent Tweets for Agriculture from BRICS Countries. https://www.researchgate.net/publication/340280652_Sentiment_Analysis_of_Recent_Tweets_for_Agriculture_from_BRICS_Countries
- Melanie, K. (2016). “You Don’t Need a Fatwa”: Muslim Feminist Blogging as Religious Interpretation. https://spectrum.library.concordia.ca/981812/1/Riley_PhD_F2016.pdf
[6] قضية المرأة العُمانية في الفضاء الرقمي: بين انهيار السياق وضبابية الحوار
مصدر الصورة: https://2u.pw/YRTGM